أولاً:إضاءة
تحكي رواية «الحياة من دوني» للكاتبة المغربية عائشة البصري عن الغزو الياباني للصين، وما خلّفه من آثار على المجتمع عامة، وعلى النساء خاصة، من خلال شخصيتين أساسيتين هما قوتشين وجين مي، وهما توأمان صينيان، لم تترك لهما الحرب حرية اختيار شكل حياتيهما.
ولدت جين مي وقوتشين في قرية جسر تشو لانغ التي تقع قرب مدينة نانجينغ أكبر مدن مقاطعة جيانغسو عام 1919، وعانتا، مثلما عانى مجتمع قريتهما من حراب اليابانيين ونزواتهم، فقرر أبوهما الرحيل إلى نانجينغ في حدود عام 1937. ولم يكن الخوف من الموت هو الدافع للهرب، بمقدار ما كان الخوف من العار الذي سيلحق بالعائلة نتيجة اغتصابات محتملة أدمن الجنود اليابانيون القيام بها في أي قرية تطؤها أقدامهم في حرب موازية لا يهتم بها المؤرخون كثيراً. تتساءل قوتشين:
«ماذا يعرف المؤرخون عن تلك الحروب الموازية؟ هل أحصوا بدقة قتيلات تلك الحروب، قتيلات طمرت جثثهنّ كموتى لا ينتمون لأحد؟ هل يعرفون كم امرأة اغتُصبت، وكم امرأة قُتلت على أَسِرّة مجهولة؟ وكم امرأة جُنّت أو انتحرت من الذلّ؟»، ص23.
وبعد الوصول إلى نانجينغ تفترق الأختان؛ تبقى جين مي في نانجينغ، وتتزوج، وتعيش حياة مستقرّة نسبياً، وتموت متأثرة بسرطان الرئة عام 1986، ويوضع رمادها في جرّة خزفية كانت لها: «طلبتُ من خزّافٍ معروفٍ أن يصنع لي جرة بلون قرمزي، ويزينها برسوم بماء الذهب، لأزهار اللوتس المباركة، وأكدّتُ عليه ان يترك الطين تحت السماء، ثلاث ليال مقمرة، فأبدع لي تحفة نادرة»، ص19.
بينما تغادر قوتشين إلى سايغون خادمةً مع تاجر السلاح اليهودي الفرنسي باريير الذي يتتبع خريطة الحروب، ويشمّ رائحة الدم من بعيد. غير أن باريير يتركها وحيدة، ويغادر فيتنام مع عائلته حين يدرك قرب انتهاء الوجود الفرنسي هناك. وهكذا تجد قوتشين نفسها وحيدة في أتون حرب جديدة، فتحترف أقدم مهنة عرفتها النساء، بمساعدة ديين ابنة حارس البيت الذي كانت تسكنه أسرة بائع السلاح الفرنسي، حيث كان عليها أن تنسى ذكرياتها، وترتدي قناعاً لم يألفه وجهها: «كان عليّ أن أنسى كل الذكريات، وأنسى من كنتُ، ومن عرفتُ، أن أغمض عينيّ حتى لا أرى مأساتي الشخصية، ولا مأساة شعب آخر أعيش بينه. كان لا بد أن أضع قناعاً سميكاً على وجهي»، ص106.
وإذ تختفي ديين، أو تُقتل، تنزع قوتشين قناع العبث وترتدي قناع العفة، وتعمل في محل لشركة باطا للأحذية، إلى أن تلتقي بمحمّد الذي انتشلها في ربيع 1951 من تحت أنقاض مبنى تدمّر جزئياً بفعل تفجير استهدف فندق كونتاننتال بَلاس؛ حيث ينزل السياح الأجانب والضباط الفرنسيون. لقد وقعت قوتشين في حبّ أصغر من طموحها، غير أن حبيبها محمد أُسِرَ من قبل الفيت مين، واختفت أخباره زمناً، ثم عاد؛ ليسافر مع قوتشين إلى المغرب عن طريق فرنسا عام 1957، وتبقى فيه حتى 2001، ثم تغادره إلى الصين، وتأخذ من قريبتها آن آن جرّة رماد جين مي، وتحتضنها «أخيراً حضنت أختي جين مي»، ص222، وتعود إلى المغرب، في خريف 2001، حيث يفتح العالم شدقيه لحرب جديدة بعد أحداث شتنبر.
لم تجد قوتشين ذكرياتها حين عادت إلى الصين، فعادت إلى المغرب غريبة عن نفسها ؛ لتتابع حياتها أرملةَ زوج عربي كان يخبّئ جسدها «في جلباب العفّة»، ص135، لذلك تقول: «مت في الثالثة والثلاثين من العمر. عملياً انتهت حياتي حين وطئت قدماي درج الباخرة المتجهة إلى المغرب»، ص159.
وإذا كان السرد يتساءل عن سبب انتحار قوتشين في الرابعة والتسعين من عمرها؛ فإنّ الإجابة تحيل إلى غربتها عن المكان وعن الأشخاص الذين تعيش بين ظهرانيهم: «هناك أمكنة لا ننتمي إليها، حتى لو سكنّاها عقوداً. فلكيمياء الجسد دخل في الموضوع. كما أنّ هناك أشخاصاً لا نعرفهم حتى لو تساكنّا معهم سنوات»، ص176.
على أنّ هذا السرد التعاقبي للحكاية ليس إلا عرضاً اجتهادياً منّا، لمحاولة تركيب موضوع لعبة السرد التي تداخلت فيها الأزمنة والأمكنة بشكل مثير، لا لتروي حكاية جين مي وقوتشين فحسب، بل لتروي حكايات أخرى عن الحب والحرب وشبق الجسد، وشهوة الدم، حكايات لا تشكّل عبئاً على الحكاية العامة، بل تتداخل معها؛ لتسهم في إضاءة جوانب أخرى من ظلام الحروب التي جلّت الرواية بعض آثارها.
تحكي جين مي حكاية غريبة انتشرت بين الناس في قرية فرغت من الذكور الذين التحقوا بالحرب؛ حيث سقط طيار ياباني بين الأحراش، فقيّدته امرأة حتّى يعود الرجال. وبمرور الوقت استأنست المرأة بالرجل وأحبته، وحين علمت أن المقاتلين يبحثون عنه، وأن الموت هو مصير حبيبها المحتوم، قرّرت أن تخفف من بشاعة موته. لقد خشيت أن يقطعوا «رأس الياباني الوسيم، بشعره الأسود الكثيف، ولونه القمحي وعينيه السوداوين، فوضعت له الزرنيخ في حساء العشاء. في الصباح قبّلته، ثم دفنته في حوش البيت»، ص33.
وثمة حكاية أخرى رأتها قوتشين مكتوبة تحت صورة في متحف ذاكرة الحرب في نانجينغ، في أثناء عودتها القصيرة إلى الصين عام 2001، وهي تحكي عن طبيب ياباني رأى في يوم ثلجي جسدين ملقيين على التراب، يبدو أنهما تقاتلا حتى أُنهكا، فحاول هو أن ينقذ الاثنين، غير أنّ الياباني الذي يحتضر همس للطبيب: «أخي، إنه صيني فاقتله»، ص248، ولكن الطبيب أراد أن يعالجهما معاً غير أنهما لم يكونا بحاجة لعلاج أو قتل. فقد توفيا معاً. بعد ذلك جمع الطبيب من الجنة البنفسجية التي تحيط بهما كثيراً من الأزهار، من أجل أن يحفظ البذور ويحملها إلى اليابان رمزاً للسلام، وقرر أن يسميها «أوركيديا فبراير»، وهو «اسم الدلع» الذي كان يطلق على جين مي شبيهةِ تلك الزهرة البنفسجية في طفولتها وصباها.
ثانياً: في فضاء الحرب:
في الفضاء الروائي تبدي الكاتبة اهتماماً بالفضاء الطباعي والجغرافي والدلالي، وتؤثث أمكنتها، وتؤسس لعلاقات دالة بين الزمن والمكان؛ ففي الفضاء الطباعي تطالعنا الكاتبة بعنوان مثير للخيال، يحتاج إلى قراءة للرواية، فالحياة ها هنا تعرض في جزء منها بعد وفاة جين مي، وتصفها المرأة المتوفاة، من خلال رماد جرّتها الذي أضحى سارداً، على نحو ما نرى في السرد التالي لجين مي بعد عشر سنوات من وفاتها: «أتابع الحياة من دوني، من خلال كلامهم، ومن خلال صمتهم أيضاً»، ص20.
ويمكننا أن نلاحظ أن هذا العنوان يحيل إلى الشخصية الأقل حضوراً بين الشخصيتين، وربما كان من الأفضل أن يحيل العنوان إلى قوتشين بشكل ما، ليقابل وزن الشخصية في الحكاية؛ وإن كنا لا ننكر ما لهذا العنوان من طاقة دلالية ضافية.
وتحتلّ الغلافَ لوحةٌ ذات أبعاد حقيقية، في موضوع لا يحتاج إلى الرمز كثيراً، فاللوحة التي تتضمن صورة فوتوغرافية لفتاتين صينيتين تحتلان المشهد، بخلفية من مدينة مهدمة بفعل الحرب، تشير إلى محتوى الرواية العام دون مواربة؛ لتأتي، بعد ذلك، العتبات النصية التي تُفتَتَح بها الرواية من أجل تخصيص المحتوى ؛ ليشير إلى أننا مقبلون على قراءة رواية تفرد لمعاناة الأنثى في الحروب دوراًكبيرا؛ فقد جاء الإهداء «إلى ضحايا اغتصاب الحروب»، ص5.
ثم جاءت ثلاث عتبات أًخر لأدباء فرنسيين وأمريكيين، جاء فيها:
• «من فظائع الحرب أننا ننسى تحييد جسد المرأة»، ص7.
• «أحلم باليوم الذي يأتي فيه طفل، ويسأل أمه: كيف كانت الحرب؟»، ص7.
• « كل الحروب هي حروب أهلية؛ لأنّ البشر إخوة»، ص7.
أمّا في ما يتعلّق بالفضاء الجغرافي فقد جاء مناسباً للشخصيات، معبّراً عن مواقفها، فمدينة نانجينغ مثلاً لم تعجب قوتشين لأنها بلا بحر، بينما تبهرها مدينة سايغون، وتحيي في ذاكرتها حلم باريس. لنتأملْ السياقين التاليين، لكل من نانجينغ وسايغون من وجهة نظر هذه الشخصية المتمردة:
• «لم ترق لي مدينةُ نانجينغ، فبالإضافة إلى مخلفات الحرب كانت مدينة بلا بحر. والمدينة بلا بحر هي مدينة بلا أبواب»، ص70.
• «البيوت المزخرفة بالجص، وسقوف القرميد الأحمر، الشرفات المزيّنة بالتماثيل الرخامية، الفنادق الفاخرة، السيارات المكشوفة، الرجال بالسراويل القصيرة، والنساء بالفساتين الأنيقة»، ص94.
وقد ركّزت الكاتبة تركيزاً كبيراً على تقاطبية المكان، وعلى أثر الزمان في تغيير صفاته، فقد سعت أكثر من مرة إلى إبراز التعارض بين قطبي الغنى والفقر من خلال المكان الجغرافي؛ فثمة تقاطب مكاني بين قرية جسر تشولانغ ومدينة نانجينغ يجعل الأم « تتوه بمجرّد أن تخطو خارج البيت. امرأة تعوّدت على قرية صغيرة، وعائلات معروفة، وأزقّة ككف اليد.. ضاعت وسط مدينة كبيرة»، ص71. وثمة تقاطب مكاني آخر نجده في وصف مدينة سايغون التي يرد فيها وصفانمن قبل قوتشين، وصف باريسي مرّ معنا سابقاً، مدعوم بوصف آخر لموقع ممتاز على النهر، ووصف يثير الحزن في النفوس:
• «فُتنتُ بموقع المدينة على ضفّتي نهر سايغون، أنا مائية الهوى، أينما كان الماءُ أكون [كذا في الأصل]، قضيت صباي على ضفاف نهر اليانغستي وشربت من مائه. جسدي يشبه نبتة الأرز كلما ازدادت كثافة الماء ازددتُ نضجاً وجمالاً»، ص95.
• «اكتشفت حياة أخرى، حيث الفقر والموت بالتقسيط. أطفال يتامى شبه عراة وحفاة يجوبون الشوارع بحثاً عن فضلات أو صدقة، يبيعون الدمى الخزفية والفواكه الجافة كتسوّل مقنّع»، أو يجولون ببالونات إشهار مقابل بضعة نقود، لأطعمة لن يأكلوها، لمواد تنظيف لن يستعملوها، وعلامت ألبسة لن يلبسوها»، ص102.
أمّا أثر الزمن فيتبدى على الأماكن من خلال صور متعددة، فالساردة الخارجية تصف سوق درب عمر ـ وهو مركّب (مجمّع) تجاري يتوسط مدينة الدار البيضاء، بات يسمّى سوق الشينوا ـ بعد ثلاثين عاماً من انقطاعها عنه، فتقول: «دهشتي كانت كبيرة، البنايات والشوارع والمحلات لم تتغير، لكنّ الباعة تغيّروا تماماً، كما البضاعة. أصحاب المحلات كلهم صينيون وصينيات، باستثناء بعض مساعديهم من المغاربة الوسطاء أو الحمالين»، ص11.
وقوتشين التي تترك الصين تعود إليها بعد أربعة وأربعين عاماً؛ لتبرز في سردها هذا التعارض الكبير بين قطبي الحرب والسلم؛ حيث تم التنقل بينهما بفعل الزمن، فتقول عند وصولها إلى مطار بكين: «لم أتصور التقدّم الحضاري الذي وصل إليه بلدي، إلا وأنا أنزل في مطار بكين. كان المطار ضخماً ومتطوراً»، ص211. وعندما تصل لاحقاً إلى مطار نانجينغ تقول: «وصلتُ، أنا وآن آن، إلى مطار نانجينغ في الثامنة ليلاً. رجفة في القلب تلتها تنهيدة عميقة. لا أثر للجروح. شعب آخر استيقظ من موته وأخذ طريق الحياة»، ص217؛ لذلك تبدو عاجزة عن الربط بين صورتي الماضي والحاضر في كثير من الأحيان: «صورتان عجز عقلي عن الربط بينهما، صورة النهر وحيداً، ظلمة الأزقة، رائحة البارود والجثث المتعفنة؛ وصورة الأنوار الزاهية، الموسيقى والرقصات الطائرة..» ص225.
مثل هذا التقاطب المكاني يتجسد في الزمان أيضاً؛ فالمسافة «التي استغرقت منا في زمن الحرب، أنا وعائلتي سنة كاملة بين قرية جسر تشو لانغ ومدينة نانجينغ، قطعتها الحافلة في ساعتين»، ص233. ومثل هذا الأمر كان كافياً ليهزّ الشخصية من الداخل، حتى إن التسميات الجديدة كان تزلزل أعماقها: «وقفت بنا الحافلة أمام المدخل. من النصب الحجري الرمادي الذي كُتب عليه بالأحمر «تشو لانغ تشاو سْوِن» عرفت أنها لم تعد قريتي»، ص134؛ لذلك كان طبيعياً أن تعود إلى المغرب مرة أخرى، فقد أضاعت وطنها مرتين.
ثالثاً:شهرزادان لحكاية واحدة:
في هذه الرّواية ثمة ثلاث ساردات، تجترحهنّ عائشة البصري في ثوب حبكوي رائق: ساردة خارجية تشتغل على كتاب حول مقابر العالم، وتهتم بمصير الإنسان بعد الموت، وتبحث عن الطرق الغريبة في دفن الجثث وإحراقها وتعليقها على أغصان الأشجار، ويغريها شراء صندوق قديم من محلّ صينيّ في الدار البيضاء، فتجد فيه مقصاً وإبراً ومشغولات يدوية، وأشياء أخر. على أنّ أهم ما يلفت نظرها «كتيب» بعنوان «قوتشين معزوفة حرب منسية»، و»جرّة خزفية»، كانت ضمن معروضات المحلّ، وهذا الخيار التمهيدي اللافت أتاح للكاتبة أن تلعب لعبتها الفنية الباهرة، فتسلم قياد السرد إلى ساردتين داخليتين: الساردة الأولى صاحبة رماد الجرّة: جين مي التي عاشت ويلات الحرب اليابانية الصينية، وكان أهلها يدلعونها باسم (أوركيديا فبراير)، والساردة الثانية أختها قوتشين التي حكت ذكرياتٍ حررتها صحفيّة اسمها «كاترين لي» في الكتيب المذكور، وتحدثت فيها عن رحلتها من الصين إلى فيتنام، ثم إلى المغرب، مروراً بفرنسا.
براعة الكاتبة هنا تكمن في أنها لم تكتفِ باستخدام المخطوط سارداً، على نحو ما رأينا عند أمبرتو إيكو في «اسم الوردة»، ومُقَلِّده يوسف زيدان في «عزازيل»، بل أضافت سارداً آخر هو «ساكنة الجرة»؛ لتنشئ سرداً آخر يتوازى مع الأوّل حيناً، ويتقاطع حيناً آخر، ويبني حكاية متكاملة، وغير متعاقبة زمنياً، عن الويلات التي تعاني منها المرأة في حروب تتحدث عن أعداد القتلى والجرحى، وتهمل أعداد المغتصبات اللواتي يحملن عارهن الذي «ارتكبنه» تحت حدّ السيف. وقد أفادت الكاتبة من تجارب فوكنر وكنفاني وأفنان القاسم وغيرهم في اعتماد التشكيل الطباعي للتمييز بين الشخصيات، حيث جعلت الخط المستخدم في سرد جين مي مائلاً لتمييزه عن سرد قوتشين.
وها هي ذي الساردة الخارجية تمهّد لسيدة الجرة من أجل أن تبدأ بسرد الفصل الأول من حياتها عام 1996، قبل أن ترتد في فصول أخرى إلى عقود سابقة:
• «لمّعْتُ الجَرّةَ بمنديل ناعم تحاشياً للخدوش قبل أن أضعها على المصطبة الرّخامية لمدفأة الصالون. ولأتأكّد من أنّ الصّفقة كانت رابحة فقد نقرتُ عليها بأصابعي لأختبر الرّنين، وهي تقنية تعلّمتها من والدتي؛ لأقيس مدى رهافتها وجودتها، ومدى نقاء الطّين الذي صُنعت منه، فأعادت إليّ النقرات صدى صوت امرأة»، ص18. «
• «نانجينغ.. صيف 1996
أنا الآن في جرّة من الخزف الصيني الرفيع»، ص19.
وعلى الرغم من أنّ الأختين مولودتان تحت برج واحد (هو برج النمر)، فهما تختلفان بطبائعهما كثيراً؛ إذ لم تستطع أبراج السماء أن ترافقهما؛ لأنّ السماء ذاتها كانت مشغولة بضجيج الطائرات.
تنطلق جين مي في تعاملها مع المجتمع المحيط بها من كونها البنت الأصغر التي تحتاج الحماية؛ ذلك أنّ قوتشين أكبر منها: «سبقتني إلى العالم بدقيقتين»، ص67، وقد ترتّبت بناء على ذلك الإحساس مجموعة من السلوكيات التي تمنع الصغرى من محاسبة الكبرى، أو من ملاحقتها جهراً، أو من الاعتراض على تصرفاتها. بل تجعلها تطلب الحماية منها: «كنت أهرب من فراشي ليلاً، وأندسُّ بجوار أختي؛ لأحتمي بجسدها النحيل. لم تكن أمّي هي المثال بالنسبة لي كباقي الطفلات، قوتشين كانت أمي بشكل من الأشكال»، ص67.
مثل هذا الضعف الذي تبدّى في شخصيتها، تجسّد طيبةً تبلغ حد السذاجة، وعجزاً عن مواجهة الظروف، وإذعاناً لاغتصاب مفاجئ، وإيماناً بمقدّسات أسلاف، بحثاً عن جدار فكري عقيدي تستند إليه؛ لذلك تعترف أختُها بأنها دخلت من مدخل ضعفها لتحقيق مآربها الصغيرة: «أعترف بأنني استغللت شخصيتها الضعيفة والخائفة لأجل تحقيق أهدافي الصغيرة. كانت تصدّقني بعماء، لا تناقشني، ولا ترتاب في نواياي إلا نادراً»، ص37.
وللسبب نفسه نالت رضى أمّها التي تتفق معها على الانصياع للسائد الاجتماعي والديني؛ لذلك تباركها أمّها: «تمتمت أمي بوهن وهي تهلوس: أنت الوحيدة في هذه العائلة التي نفخ فيك بوذا بعضاً من طيبته وحكمته، ووهب روحك السكينة»، ص75.
وتستمرّ جين مي على هذه الصفات حتى وفاتها التي شعرت بها أختها، وقدّمتها من خلال سرد بديع، يعيد إلى التوأمين حبل اتصالهما السري. تصف قوتشين إحساسها بوفاة أختها، في يوم من أيام صيف 1986، بقولها: «أصبحتْ لا تغادر أحلامي. في آخر حلم رأيتُها تلملم أقمشة الحرير في حقيبة اللاعودة (…) بينما كانت روحها تصعد أدراج السماء كانت روحي تسحبها إلى أسفل. بعد شدّ وجذب صعدت جين مي إلى الأعلى، بينما تدحرج قلبي إلى حضني باكياً»، ص184.
غير أنّ جين مي بعد الوفاة أصبحت أكثر جرأة بقليل، فصارت تنتفض داخل جرّتها، وصار بإمكانها ألا تحزن على وفاة زوجها، لأن جرح الخيانة كان طريا، وأصبحت قادرة على مواجهة وي جو ، لا يمنعها من ذلك إلا وفاتها: «لو كنتُ على قيد الحياة لواجهتُ وي جو بالحقيقة التي لم يعرفها زوجي، ولا أفراد العائلتين»، ص186.
ومثل هذا السرد وغيره يغري القارئ، ويحيل على جمال لغوي وتخيّلي؛ ذلك أنّ الرماد الذي يسرد يتيح للروائية أن تقدّم لغة لم يعتد عليها القارئ، تقول جين مي بعد عشر سنوات من وفاتها: «متّ منذ أزيد من عشر سنوات، وما زلت حاضرة بين عائلتي، أحيا أفراحهم وأحزانهم، وأحلّ ـ بشكل من الأشكال ـ حتى مشاكلهم التي لا تنتهي. يحدث أن يشير زوجي للجرّة في أحاديثه: قالت جين مي، وفعلت جين مي»، ص20.
وفي مقابل جين مي المستسلمة الساذجة البسيطة تنهض قوتشين المتمرّدة التي تريد أن تختار قدرها. ها هي ذي تعرّف عن نفسها بقولها: «اسمي قوتشين، امرأة من شرق الصين، عشتُ حربين، وبقدرة الحب أخطأتني حرب ثالثة»، ص27.
لقد أحبّت قوتشين اسمها كثيراً؛ فقد اختارته لها خالتها التي «كانت مغرمة بالرقص والغناء»، ص27، وهو «اسم آلة موسيقية عريقة وراقية لا يعزف عليها سوى عليّة القوم من الأدباء والشعراء والنبلاء. لا يمسّها العازف إلا بعد الاستحمام وإشعال البخور»، ص27. لذلك كان طبيعياً أن تواجه تغيير اسمها في البيئة المغربية، وأن تصرّ على استخدامه من قبل زوجها، بوصف هذا الاسم ملاذها الأخير الذي تهرب إليه من حاضر غربتها: «استبدلوا اسمي بزهرة. وهو ما لم أقبله بتاتاً، فاسمي هو ما تبقّى لي من حياتي السابقة. غضبتُ. تعلل محمد بصعوبة نطق قوتشين بالنسبة لوالديه. لكنني حرّمتُ عليه، هو بالذات، أن يناديني باسم غير اسمي»، ص162.
هذا التحدّي كان لازمة من لوازم شخصيتها، تدفعها إليه كثافة سيكولوجية تمرّدية تملأ كيانها، وتقودها نحو مغامرات متهورة، حتى قبل أن تبلغ العشرين، وتحصل على الهدايا الصغيرة مقابل نزهة صغيرة أو قبلة، وعلى كثير من الشكوكولاتة من جندي ياباني كانت تخطط لقتله مع عشيقها الثائر: «فجأة تسلل شبح من وراء البرج، قفز مباغتاً العسكري، ونحره في رمشة عين، ثم قفز إلى النهر. كل شيء مرّ بصمت، لولا حشرجة خافتة صدرت من القتيل. وبهدوء ولا مبالاة ارتدت قوتشين فستانها، جمعت شعرها بالمشبك العاجي على شكل ذيل حصان، أخذت علبة كاملة من الشوكولاتة من جيب الجثة، ونزلت من أعلى البرج بهدوء»، ص88.
وبسبب تعدد مغامراتها، فقد توقعت أختها أنّ رأسها يفكّر بمغامرة جديدة في أكثر الظروف حلكة وصعوبة، من مثل رحلة الهرب من قرية جسر تشو لانغ إلى نانجينغ: «في تلك اللحظة تمنّيت أن أدخل إلى رأس أختي قوتشين؛ لأعرف ما تفكّر فيه. أكيد أنها بدأت في التخطيط لمشاريعها الجهنمية. لم تكن حزينة ولا خائفة من خطورة الرحلة، كانت عيناها تلمعان في عتمة القعر ببريق المغامرة والإثارة»، ص31.
وإذا كانت قوتشين قد صرّحت في سايغون «جسدي أصبح وطني وعائلتي وديني»، ص107، فإنّ كلمة (أصبح) لا تعبّر تماماً عما آل عليه الحال؛ فقد احتلّ الجسد أهميّة بالغة في حياتها المبكرة؛ إذ إن جين مي تقول عن جسد أختها، قبل أن تخرجا من قرية جسر تشو لانغ : «جسد أختي التوأم قوتشين كان يسكنه شيطان صغير، ظلّ ينمو ويكبر معها»، ص65. وقد أهّلتْ هذا الجسدَ مجموعةٌ من الصفات؛ ليكون كذلك، فهي تختلف عن أختها وأمها وجدّتها، كما يتضح في السياقات التالية:
• «أنا وأختي جين مي تقاسمنا نفس الماء ونفس الأحلام [كذا في الأصل] في الرحم، لكنّني كنت الأقوى من الولادة، ببنية ضعيفة، لكن روح فائضة وطموحة»، ص36.
• «والدتي كانت أكثر سخاء في العطايا وحرقاً للبخور، وأصدقنا صلاة وابتهالاً؛ فقد اعتادت الحج إلى هذا المعبد مرة كلّ ربيع؛ لتصلي من أجل الإنجاب. حين أنجبت توأماً أنثى واظبت على العودة من أجل إنجاب ذكر»، ص32.
• «أنا لم أكن أذهب إلى المعبد إلا مضطرة. كنت أفضّل جولاتي على النهر؛ لأني أدركت منذ وقت مبكّر أنّ الآلهة من اختراع جدّتي»، ص40.
يذكر هنا أن الحُلم بمستقبل أفضل يشكّل تَكُؤة مهمة استندت إليها قوتشين في محاولة تغيير حياتها؛ وهي تذكرنا على نحو كبير بشخصية (حميدة) في رواية «زقاق المدق» لنجيب محفوظ، من حيث سعيها إلى الانفتاح على الخارج، فالداخل هو العدو والكبت وفقدان الأمل، أمّا الخارج فهو الفرصة المنتظرة التي لا تملّ انتظارها. وقد عبّرت قوتشين عن حلمها هذا عبر التأكيد على ثيمة الرحيل التي تعدّ واحدة من أهم الثيمات التي تقترحها الشخصية لمستقبلها؛ ويمكن أن نلاحظ ذلك في عدة سياقات سردية، نختار منها السياقين التاليين:
• «ربّيتُ طموحات صغيرة، كبرتْ وتحوّلتْ إلى أحلام مرتبطة بالواقع، منها الحلم برجل يقع في حبّي، ويأخذني إلى بلاد بعيدة أكثر دفئاً بلا حروب أو اقتتال»، ص70.
• «حلم البحر والسفينة الذي كنتُ أحدّث به أختي في ليالي الأرق، داخل غرفة ضيقة بلا نافذة، في نانجينغ، ظلّ قائماً في داخلي»، ص126.
ولم تكتف هذه الشخصية بالانكفاء على حلمها، بل نقلته إلى غيرها، وسعت إلى تحقيقه، وها هي ذي جين مي تصرّح برغبة أختها في الرحيل عن طريق الإشارة إلى شغفها بالسفن الراحلة التي تعني مجهولاً مثيراً: «في إحدى هلوساتها الليلية أخبرتني بأنها تحلم ببيت أو حتى غرفة بشرفة تطلّ على ميناء؛ فهي تعشق السّفن الرّاحلة. السفينة القادمة ـ شرحت لي ـ لا إثارة فيها، فالمسافر يصل إلى نهاية الرّحلة كما يصل إلى نهاية الحياة»، ص110.
وإذا كان حلمها قد أخفق في المرة الأولى، بعد هرب تاجر السلاح الفرنسي من الفيتنام، فقد تحقق على يد محمد الشاب المغربي الذي وصل الفيتنام جندياً من الفوج الرابع للمشاة المغاربة في الجيش الفرنسي.
رابعاً ـ لغة الحرب: الأسلاف في مواجهة الموت والاغتصاب
تحفل لغة رواية «الحياة من دوني» بإيقاعات الحرب والموت والاغتصاب، وتحاول أن تحتمي بالماضي والمقدّس في مواجهة آثارها المأساوية. ويستطيع القارئ أن يلمس ذلك الفزع إلى العادات والطقوس، والشخصيات التي تمثلها من مثل الأم والجدة؛ فالجدات في الحرب يخضن حرب الكلام لطرد الخوف من قلوب الصغار: «في الليل تتسلّم الجدّاتُ قيادة حروب أخرى.. الكلام الشفوي ليس كالكلام الموثّق. لهذا تجد الحكايةُ دائماً سارداتٍ أخريات يختلفن فقط في بعض التفاصيل الصغيرة. الجدّات ذاكرة الحروب السابقة يتقنّ الحكي في ليالي الرعب الطويلة»، ص59. والأمهات يلذن بالصلاة، على نحو ما فعلت والدة التوأمين بعد وفاة الأب، تقول جين مي: «لاذت والدتي بالبيت لا تغادره، وأكثرت من الصلاة. أسمعها تطلب الرحمة من السماء: يا الله لقد دُمّر عالمك الجميل، فاصنع لنا عالماً آخر، فقط من أجل الأطفال الأبرياء»، ص118، وقد توافقت هذه الرؤية التي تحكم المجتمع عامة مع رؤية جين مي، بعكس قوتشين التي لم ترَ في الآلهة والطقوس ما يغريها، حتى إنها لم تكن تشارك في «احتفالية أولامبانا، اليوم الذي تفتح فيه أبواب العالم الآخر؛ ليزور الموتى أقرباءهم الأحياء»، ص81.
أمّا محمد الشاب المغربي الهارب من ذاكرة الحرب فإنه يفزع إلى طقوس بلاده وقوانينها وعاداتها؛ إذ يريد أن يودّع الحرب بالاستناد إلى سلام تحققه رؤيته/ ورؤية مجتمعه الإسلامي للعالم. من أجل ذلك يوضح لقوتشين في الطريق من فرنسا إلى طنجة أنهما ذاهبان إلى بلاد لا خمرة فيها، للناس كما يقول القرآن الكريم، وللنساء كما يقول المجتمع: «ملأ كأسي، وبلهجة لم أعهدها فيه أخبرني: هذا هو خمرك الأخير. هناك، وأشار في اتجاه الجنوب، ممنوع على المرأة أن تشرب الخمر»، ص151
وتصبح الأسطورة في مجتمع مثل المجتمع الصيني الذي تطحنه رحى الحرب ملاذاً آخر، يبحث الناس عن بطل إيجابي، على نحو ما نرى في الأسطورة التي تحكيها الجدة عن عشر شموس كانت تحيط بالأرض وتحرق المحاصيل، إلى أن جاء رامٍ ماهر اسمه هاوْ وي، فأسقط تسع شموس وترك واحدة،؛ لتضيئ نهار الكون، وتدفّئ الناس، فقرر الملك مكافأته بتزويجه ابنته تشانغ، وإهداء حبتي الخلود له، ولتشانغ في رأس السنة الجديدة حتى يقضيا حياة خالدة. وفي رأس السنة هجم أحد تلاميذ هاو وي على زوجة معلمه، وأجبرها على ابتلاع الحبتين، فلم تتمكن من البقاء بين الناس، ولا أن تصعد إلى مرتبة الخلود، وبقيت بين السماء والأرض معلقة، واختارت القمر كي تسكن فيه، بينما بقي حبيبها هاو وي يتطلع نحو القمر. ص ص 45ـ46.
ولكن هل كانت هذه الحكايات والطقوس والأساطير قادرة على مواجهة الإيقاعات المأساوية التي فرضها الغزو؟
الخيار الفني الذي تقدّمه عائشة البصري لا يتيح لتلك الأوابد المحكية أن تنتصر على الحرب؛ وأنّى لها ان تفعل ذلك، والحرب تطحن العظم واللحم، والغاية من هذا السرد أن يلفت الأنظار إلى الويلات التي ينبغي تظهيرها، وفي المقدمة منها: الويلات التي عانت منها النساء.
وتمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة إيقاعات أساسية قرّعت آذان القارئ بلا هوادة، كان أقواها إيقاع الاغتصاب الذي طغى على إيقاع الحرب ذاته، بالإضافة إلى إيقاع الموت الذي كان أقلّ حضوراً؛ لأنّ الاغتصاب وفق رؤية الرواية أصعب من الموت، فهو موت من نوع آخر، وهو يجعل الموت أفضل منه في كثير من الأحيان؛ لذلك كانت الفتيات يعملن على إخفاء أنوثتهن، ورغم ذلك لا يسلمن من الاغتصاب:
• «كان التدريب قاسياً على إخفاء أنوثتنا، لدرجة أننا فقدانها نهائياً بعد الحرب»، ص112»
• «الخوف من الاغتصاب كان أكثر من الخوف من الموت الاغتصاب موت بطيء للمرأة، حينذاك يُدفن الجسد في مقبرة النسيان والإهمال. من سيتزوج امرأة مغتصبة مهما كانت وطنيته؟ ومن ستكون لها الشجاعة لتتزوج وتحبل وتلد بعدما تعرضت له من وحشية»، ص112
من هنا يبدو منطقياً أن تُقْدِم المرأة المسملة (عائشة) على الانتحار، بعد أن تتعرض للاغتصاب على الرغم من أن الانتحار أمر يحرّمه الإسلام، ذلك أن اغتصابها أمام زوجها لن يجعلهما قادرين على النظر إلى بعضهما أبداً:
«كانت الجارة عائشة امرأة جميلة جداً، أنجبت ثلاث بنات آية في الجمال. فكنّ، هي والبنات، من أوائل ضحايا الاغتصاب حين دخل الجيش الياباني إلى القرية. اغتُصبت أمام زوجها، فألقت بجسدها المدنّس في النهر. واختفت البنات الثلاث وسط فوضى الحرب»، ص43.
لقد اغتُصبت جين مي (ليلة مقتل العسكري الياباني على يد عشيق قوتشين)؛ إذ وجدتها فاقدة الوعي، ممزقة الثياب، وكانت تدرك تماماً أن اغتصاب الأرض والعرض أمران متلازمان؛ فالغزاة كما تقول «غزوا الوطن وأجسادنا نحن النساء، بالمعنى الديني، دنّسوا الأرض، ودنّسوا الجسد. اعتبروا أجسادنا غنيمة حرب، فعانينا من احتلال مزدوج»، ص52.
ويمكن أيضاً أن نشير إلى حكاية أخرى من حكايات الاغتصاب المؤلمة التي عانتها صديقة من صديقات جين مي وقوتشين، وهي حكاية تسردها جين مي؛ إذ تتعرض هذه الصديقة للاغتصاب دون أن تقاوم، وتبقى عيناها مفتوحتين من الفزع، وتكون النتيجة أن تُغتصب بشراسة، وأن تقتل أمها التي تصرخ، وقطها الذي يموء استنكاراً:
«نظرات القط كشاهد على الجريمة، ومواؤه المسعور، أزعج العسكري. بعصبية قام عن جسدي وأفرغ مسدسه في جسد القط، قبل أن يستانف اغتصابه. في تلك اللحظة بالذات سمعتُ طلقة رصاص في الغرفة الأخرى. قتلُوا أمي، وقُتل القطّ نيابة عنّي»، ص115
وثمة فتاة اسمها وي جو تعرضت لحادثة اغتصاب أكثر ألماً، لأنّ الخديعة كانت عنصراً فاعلاً فيها، ولأنّ المستقبل (الطفل) كان ضائعاً ضياع وي جو ذاتها:
• «كانت وي جو صبية جميلة تلفت الأنظار. تودد لها جندي أمريكي، استدرجها إلى العنبر، لتجد شخصين آخرين في الانتظار، فرنسي وإنجليزي يسكران بالساكي، فكانت عملية اغتصاب جماعي»، ص186.
• «لا تعرف وي جو إن كانت الدماء التي تجري في عروق ابنها أمريكية أو فرنسية أو إنجليزية». ص186
شغل إيقاع الموت حيّزاً لا بأس به من الإيقاع الروائي، وميزة هذا الإيقاع ولعه بالجانبين المادي والفلسفي، وتوزعه بين الساردات الثلاث. وعلى الرغم من أن الساردة الخارجية لم تشغل فضاءً طباعياً معتبراً، فإن تكرارها للفكرة جعل منها مشاركاً فعالاً في هذا الإيقاع.
تلك الساردة التي انشغلت بفكرة مصير الإنسان بعد الموت إلى درجة جعلت أقرباءها يتطيرون منها، ويلقبونها بالخفاش تقلق على مصير الجثث، وتقارن بين تعامل الحضارات المختلفة مع الجثث من الدفن إلى الحرق إلى تعليقها على أغصان الأشجار…إلخ، وتتخيل للمستقبل «سيناريوهات مرعبة، كأن يستيقظ شخص ما، ويجد أن والدته قد فارقت الحياة، يقبّلها على الجبين، ويرمي الجثة في حاوية الأزبال في ناصية الشارع، أو يحتفظ بها في مجمّد البيت ريثما يأتي دورها في الدفن»، ص10.
وإنّ عدم موت الساردتين الأساسيتين بسبب الحرب كان خياراً فنياً صائباً، لتكونا شاهدة عليها، فقد حاصرهما الموت من كل جانب؛ وتركهما تسردان ويلاته؛ لتموتا من ثمّ كلٌ بطريقة مختلفة: جين مي تموت بسرطان الرئة، بينما تضع قوتشين حداً لحياتها بعد أن ملّت العيش. تتساءل جين مي في قرية جسر تشو لانغ: «من أين سيأتي الموت هذه المرة؟ هل سيصعد من الأرض؟ هل سيهطل صبيباً من السماء؟ الهواء خانق والطائرات لم تترك حتى فسحة لطائر الكركي؛ ليمدّ جناحيه. المخابئ أصبحت خائفة على خائفيها»، ص ص 58. 59
أما قوتشين فتتحدث عن المفارقات التي عاشتها في ما يتعلّق بالموت والحياة، بعد أن شهدت حربين، وكادت أن تشهد حرباً ثالثة:
• «عشت عمراً طويلاً، أكثر مما أردتُ، عمراً كافياً لدفن كلّ أحبتي وأصدقائي. فمن مفارقات حياتي أن الموت الذي كان يحوم حولي كثيراً في صباي وشبابي لم يقترب مني ولا مرة بعد الثلاثين»، ص28.
• «لن يكون موتي بقصور من جسدي. ستلفظني الحياة فقط لأنني أطلت الإقامة فيها. أتمنى ألا يرتبط تاريخ موتي، كما ولادتي، بحرب عالمية أخرى»، ص28.
وقبل الخوض في إيقاعات الحرب التي تغص بها الرواية لا بد لنا من التأكيد على مقولة جين مي؛ إذ «لا أحد يظلّ سوياً في الحرب»، ص118؛ إذ تتغير النظرة إلى الأشخاص والأشياء والعادات، وربما يألف الناسُ الحربَ، «كما يألف الجسم السقم [على رأي الكواكبي في طبائع الاستبداد] فلا تلذّ له العافية». تتساءل قوتشين بعد وصولها إلى المغرب: «هل سئمتُ من اللاحرب؟ من تكبيرات السلام المتدفقة من المآذن في سكون الليل؟»، ص166. وأما جين مي فتتساءل عما يمكن أن يفعله المرء في حالة اللاحرب: «بعد طرد العدوّ الياباني طُرِح السؤال: ماذا سنفعل بلا حرب، بلا طائرات وقنابل؟ «، ص201.
لقد غيّرت الحرب كلّ شيء، حولت الملاكين الكبار والصغار إلى فقراء، ولم تفعل العكس، كما حوّلت تجارها إلى أثرياء، يتاجرون بالسلاح والأعضاء والآلام. تحكي جين مي عن أسرتها في قرية جسر تشولانغ: «لم نكن فقراء، كنا من الملاكين الصغار، يملك والدي قطعة من الأرض ورثها عن أجداده، ووالدتي تخبّئ في صندوقها ثلاث قطع من الحرير الفاخر، مخازننا مملوءة، ونار مطبخنا تشعل كلّ يوم قبل أن تأتي الحرب وتساوي بين الجميع»، ص44.
وفي الحرب تتغير النظرة إلى البيت؛ فالبيت الذي كان لم يعد متاحاً، والحرب تحول الناس إلى فلاسفة. سألت جين مي أباها في اثناء الرحيل عن جسر تشو لانغ «أبي متى سنعود إلى البيت؟» فأجابها: «البيت هو نحن مجتمعين. حيثما تكون العائلة يكون البيت (كذا في الأصل)»، ص30.
الحرب تغيّر المشاعر أيضاً، وفيها تنمو الغرائز وتزداد الوحشية؛ فيونغ شقيق الأختين، من امرأة المدينة التي عرفها أباهما، كان في طفولته يصطاد عصافير الدوري ويعلقها من عنقها بخيط الحرير، ويراقبها وهي تصارع الموت، «تلك الرغبة في القتل التي ستعمّقها الحرب فيما بعد؛ ليصبح أكثر شراسة وأكثر تعطشاً للدم، كبعض شباب القرية الذين تحولوا إلى قتَلة بذريعة الحرب»، ص75.
أما الأم والأب وجين مي وقوتشين وكثيرون فقد فقدوا القدرة على البكاء، ولم يعد منظر الدم والدمار والأعضاء المبتورة والبديلة يثير رعبهم؛ فقد عملت جين مي، وهي في الرابعة والعشرين، في محل بيع الأعضاء البديلة، وجرّبتها على الزبائن بلا رعب. ولكن هذا بحد ذاته شيء مرعب: «شيء مرعب ولا إنساني تسرّب إلى دواخلنا وقتل مشاعر الخوف والتقزّز»، ص130. ويبدو هذا طبيعياً في الرؤية الشاملة للحرب التي شلّت مقدرة المجتمع على مزيد من الحزن: «لم نبكِ الفقيد، فقدنا الرغبة في البكاء. لم يعد أي حدث، مهما كان كارثياً، قادراً على إثارة دموعنا التي كنا في أمسّ الحاجة إليها حتى لا نفقد عقولنا»، ص118.
وفي الحرب تختلف النظرة إلى العدو، ويبتدل، فقد يحدث في أوجها «أن تعشق عدوّك. تكفي نظرة واحدة إلى عينيه؛ ليولد تآلف إنساني، ورغبة في الحب، حب خارج السياق، في لحظة وجيزة بين عدوّين»، ص33. ويمكن أيضاً أن تقاتل أخاك، عندما لا تجد من تقاتله، على طريقة الشاعر العربي: «وأحياناً على بكرٍ أخينا.. إذا ما لم نجد إلا أخانا»، فحين تنتهي حرب الأعداء تبدأ حرب الإخوة شوقاً إلى العراك أو لهفةً إلى شهوة الدم أو تسابقاً إلى نفوذ أو غنيمة:
• «في مطلع عام 1946 كانت حرب الأعداء قد أشرفت على نهايتها لتبدأ حرب الإخوة»، ص93.
• «في الكثير من الأحيان تندلع معارك شرسة بالسلاح الأبيض بين الصينيين أنفسهم، يشارك فيها مقاتلون لا يعرفون لماذا ولصالح من يقاتلون «ص61 .كما تتزعزع اليقينيات، وتختلف المواقف من الأشخاص، ويمكن للحرب أن تغير نظرة المجتمع إلى المجرمين، وتمنحهم صفات البطولة، فعلى الرغم من أن يونغ كان قاسياً وفظّاً وقاتلاً، إلا أنه يتحوّل بفعل الحرب، وفقاً لما يقوله أحد الرهبان جندياً: «لقد كنتم قطّاع طرق، والآن أصبحتم جنوداً. بدماء الغزاة غسلتم دماء أبرياء لطّخت أيديكم، فاذهبوا بسلام»، ص51.
أما اليقينيات فتتحول إلى عكسها، بفعل الغضب، إذ يصل المرء تحت وابل القصف إلى مواقف مليئة بالتحدي، لا يجرؤ على إعلانها أيام السلم: «لا أحد في السماء، وتأكّد لي ذلك خلال الحرب. لو كان هناك إله يحرسنا في السماء لمنع تساقط القنابل على بيوتنا وأجسادنا الضعيفة»، ص40.
لقد أثرت الحرب تأثيراً بالغاً على الجميع، وكان الجندي المغربي (محمد) أحد ضحاياها الذين يعد موتهم صرخة مدوية ضدها. لقد مات بعد أن عاني كثيراً من الهلوسات: «كنا من جميع المستعمرات بيضاً وسوداً لم نكن نختلف عن خيول مسرجة. ألبسونا بذلة عسكرية، وأعطونا بندقية ريمغتون وحزاماً من الرصاص. ووضعونا في مواجهة العدو»، ص152.
عاش محمد التجربة الأكثر مرارة، فالصينيون والفيتناميون يحاربون دفاعاً عن وطنهم، واليابانيون والفرنسيون والإنكليز يغزون؛ ليوسعوا نفوذ دولهم، أما محمد فقد كان يقاتل من أجل لا شيء، يقاتل نيابة عن الآخرين؛ ليحقق أحلام الآخرين، ليكون، ذاتَ مصادفتين، في مواجهة جنديين مغربيين، التحقا بالفيت مين ليقاتلا الفرنسيين، يتذكرهما فيجهش بالبكاء؛ حيث تردد في قتل الأول، ولكنه أطلق النار عليه حين ظهر قائد الكتيبة الفرنسي، والثاني كان بإمكانه أن يقتل محمداً، لكنه أطلق النار على ساقه وأخذه أسيراً. وهناك قصة ثالثة تعبّر عن تعاطف أحد المغاربة من الفيت مين معه؛ إذ ساعده على الفرار من الأسر. أي أن تجربته في مواجهة إخوانه لأجل الآخرين كانت قاتلة لنفسه؛ لأنه نال عطف إخوته، على الرغم من أنه أسهم في قتلهم، خلال معارك ليس للمغاربة فيها ناقة ولا جمل.
وعلى الرغم من أن رائحة الحرب والدم أزكمت أنوفنا؛ فإن آخر مقطع في الرواية لقوتشين (قبل المقطع الختامي للساردة الخارجية) يحيل إلى احتمال حرب جديدة، ففي المطار الفرنسي، بينما تتجه عائدة إلى طنجة، تقع أحداث 11 سبتمبر 2001، فتقول:
«أيها السادة المشاهدون، صباحكم حرب.
مانهاتن مشتعلة.. ارتباك وحالة طوارئ في المطار الفرنسي.
سبب آخر لإشعال حروب أخرى في العالم»، ص257.
هي حرب جديدة إذن، أو حروب جديدة، بينما تواظب الساردة الخارجية في السرد النهائي، على حرق البخور كل يوم جمعة، بجانب جرة جين مي، لأنها تدرك أن «الأموات ليسوا أمواتاً تماماً»، ص258، وتنتظر منها أن تسرد، ربما، حكاية حرب جديدة وحياة جديدة من دونها.
* ناقد وأديب فلسطيني
بجامعة الإمارات

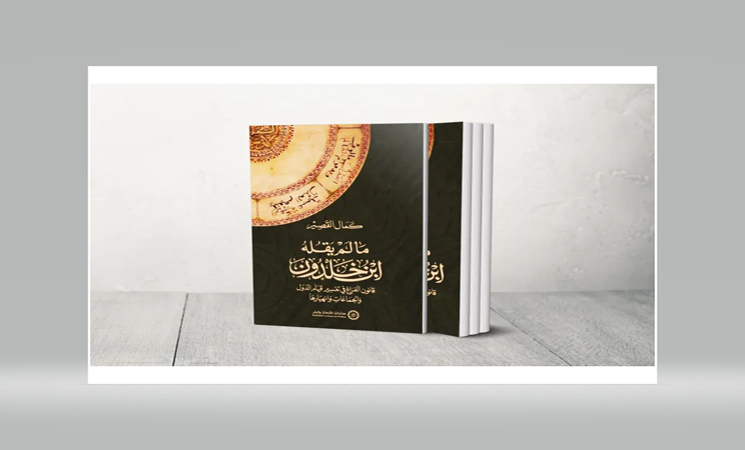





اترك تعليقاً