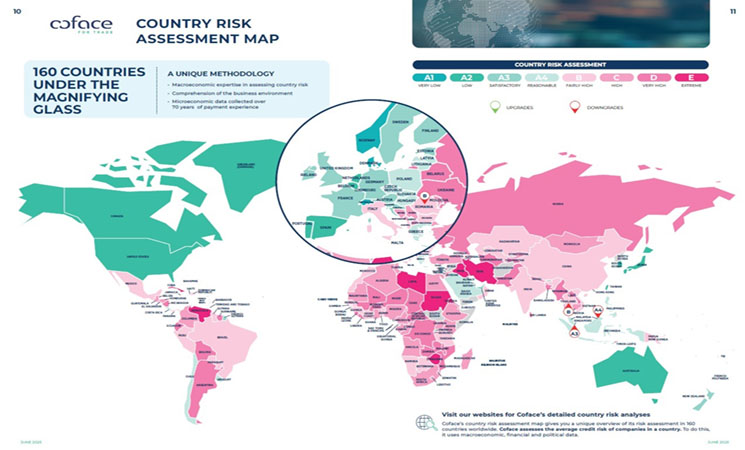تطالعنا بين الفينة والأخرى أخبار عن حوادث متعددة، تختلف درجات خطورتها، تتطلب تدخلا من أمنيين، عناصر للوقاية المدنية، مسعفين، من أجل نقل مصابين في حادثة سير، ضحايا خروج قطار عن سكته، انهيار منزل، ورش بناء، حريق في مصنع، كما هو الحال بالنسبة لحريق «روزامور»، أو في محل سكني، حالة انتحار ومحاولة الانتحار، غرق، نقل رضيع متخلى عنه في حاوية للقمامة أو على قارعة الطريق …
مهنيون يكونون في الصف الأول في علاقتهم بضحايا هذه الحوادث، وآخرون يأتون في مرحلة أخرى، سواء تعلق الأمر بالممرضين أو الأطباء الجراحين أو الشرعيين، في حال تعلّق الأمر بحالات عنف أو بجثث.
جميع هؤلاء يتعاملون يوميا، ليل نهار، مع الأجساد، دافئة كانت أو باردة، ومع الأشلاء، نعاين كيف يتدخلون أمامنا، ينتشلون، ينقلون الضحايا، يلجون المركبّات الجراحية لشق بطن، قفص صدري، رأس، ثم رتقه فيما بعد، لكن القليل منا يطرح أسئلة، عن طبيعة هذا العمل، إن كان بإمكان أي كان القيام به؟ إن أصبح خطوة آلية وميكانيكية، لا تترك أثرها وفعلها في نفسية هؤلاء المهنيين؟ أم أن وقعها موجود، باختلاف مستوياته، صغيرا كان أو كبيرا، لكن دون أن يثير الانتباه ودون أن يحسّ به المتضرر نفسه أو من يحيطون به؟
«الاتحاد الاشتراكي» التقت وحاورت عددا من المهنيين، من مختلف المواقع، واستقت ارتساماتهم وشهاداتهم، لتقدمها لقرائها على لسانهم، وتطلعهم على الوجه الخفي للممارسة المهنية في ارتباط بقطاع الصحة وبالإنسان، وتطرح أسئلة المواكبة النفسية والدعم المادي والمعنوي، وسؤال التعويض عن الضرر.
أشلاء على الطريق
لا أستطيع أن أجرد أو أحصي عدد الحوادث التي وجدت نفسي في خضمها ووسطها، ولا أعرف كيف يمكنني التمييز بينها، وبناء على أي معيار، فهي بأجمعها بطعم الألم والقسوة وبشاعة المشهد. لكن من بين كل تلك الحوادث المتعددة ومختلفة الضحايا، هناك حادثة راسخة تفاصيلها في ذاكرتي، خاصة ذلك المشهد المؤلم، مشهد شباب انقلبت بهم السيارة التي كانوا على متنها بالقرب من قرية الصيد «تشيكا» جنوب مدينة الداخلة، وكلما صادفت حادث سير إلا وعادت تفاصيل تلك الواقعة لتؤلمني.
أتذكر كيف أن أشلاء الضحايا اختلطت ببعضها البعض، ولم نستطع التمييز بينها، بالإضافة إلى امتزاجها بالصباغة التي كانت على متن السيارة التي كانت تقلّهم، وما زالت أتذكر حين اقتربت من أحدهم ولما أمسكت به كيف سقطت فروة الرأس أرضا.
يعجز لساني عن وصف المشهد الدرامي، لحظتها دبت القشعريرة في جسمي، تسارعت نبضات قلبي، وارتعدت كل فرائصي، من هول المشهد الذي لازمني أياما وأياما، بل أنني كنت أستفيق مذعورا ليلا، وبعد كل هذه المدة، ما زلت غير مصدّق أنني عشت تلك اللحظة الأليمة والتجربة الصادمة، وكنت دائما أتمنى أن يكون الأمر مجرد كابوس عابر، لكن للأسف كان كابوسا واقعيا وفعليا.
أتذكر أنني لم أستطع العودة إلى العمل، ومواصلة مهمتي، فتم منحي عطلة لمدة شهر، التي مرت خاطفة، دون أن تحقق ما كان مرجوا منها، أو تسهم في التخفيف عني من وقع ما جرى، وللأمانة فأنا لم أتمكن من ممارسة أنشطة حياتي اليومية بشكل طبيعي، وكنت أميل خلال تلك الأيام إلى العزلة والإنزواء، وكان الخوف لا يفارقني، أما الشهية للطعام فقد فقدتها لمدة طويلة.
وضع قد يكون أقلّ وقعا اليوم، لكن ومع ذلك، فتلك الحادثة متجذرة في ذهني وتفاصيلها لم تتمكن الأيام من محوها، وتبعاتها ما تزال تسكنني.
أطباء بجراح نفسية
الألم .. آلام، في كل يوم وليلة، وعند التعامل مع كل حالة تلج المستشفى طلبا للعلاج، خاصة أولئك الذين يتم نقلهم على متن سيارات الإسعاف بسبب تعرضهم لحوادث متعددة، عدد منها يشوّه ملامح الجسم ويتلف الأعضاء، لنكون أمام امتحان آخر، من أجل إنقاذ حياة المصاب، الذي يكون اللقاء الأولي به، من أصعب اللحظات وأنت تتبين وتكتشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها وحجمها، ومدى تأثيرها، لتدخل بعدها في مرحلة تحدّ للقيام بما يجب القيام به، وأنت تحت تأثير اللحظة وهول الصدمة لمصير عدد من الحالات.
تواجدنا في المستشفى هو استمرار للألم، الذي يكون بسبب وضعية مريض، وحتى بسبب حالة طبيب في حالات معينة، وهنا أستحضر حجم الصدمة وعظم المأساة التي عشناها كطاقم طبي وتمريضي، قبل سنوات بمستشفى دار بوعزة. خلال ذلك اليوم ودّعنا زميل لنا بعد انتهاء فترة عمله بابتسامته المعهودة وبقفشاته التي ألفناها منه، فقد كان إلى جانب خبرته وكفاءته وإنسانيته في التعامل مع المرضى، رجل نكتة ودعابة، يحاول جهد إمكانه أن يخفف علينا من وقع التعب والعناء الذي نتكبده جميعا داخل المستشفى العمومي، في ظل الطلب المرتفع والوسائل المحدودة، بشريا ولوجستيكيا.
غادر الطبيب الشاب الذي كان حديث الزواج المستشفى على متن سيارته، واتجه صوب منزله عبر الطريق السيار، وهناك استرعى انتباهه وقوع حادثة سير في الاتجاه المعاكس، فما كان منه إلا أن أوقف سيارته وغادرها محاولا استطلاع الأمر لربّما يمكنه تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، وبالفعل لما وقف على طبيعة الحالة عاد إلى السيارة وحمل حقيبته الخاصة من الصندوق الخلفي لها، وهمّ بالتوجه مرة أخرى صوب مكان الحادث لتقديم الإسعافات للمصابين إلى حين وصول سيارة الإسعاف، فالرجل/الإنسان، يلازمه شخص الطبيب أينما حلّ وارتحل. عبر الطريق في الاتجاه الآخر، لكنه فوجئ بشاب على متن سيارة رباعية الدفع، قادما من أقصى الطريق بسرعة لم يتمكن معها من التحكم فيها أو توقفها فراملها، فصدمه وطوّح به عاليا قبل أن يسقط أرضا مضرجا في دمائه.
كنا في مستعجلات المستشفى حين وصلت سيارة الإسعاف وهي تنقل ضحية حادثة سير، لم نكن على علم بمن يكون الضحية، إلى أن تم إدخاله فبدأ الخبر يتناقل، سارعنا إلى المكان الذي كانت الجثة ممدّدة عليه، فكانت الصدمة عظيمة بالنسبة لنا، فالضحية ليس سوى زميلنا الذي غادرنا قبل «لحظات»، مبتسما، ضاحكا، مداعبا. بدأت الدموع تنهمر على الخدود، واحتبست الكلمات في الحناجر لا تقدر على مغادرتها، كثير منا لم يصدّق الأمر، بل أن منا من قال أن زميلنا هو مستلق وسيقوم في أية لحظة من اللحظات، لكنها كانت مجرد متمنيات عاكسها الواقع لأن الفراق قد وقع بالفعل.
أتذكر كيف أنني عشت مرحلة من أصعب مراحل حياتي على المستوى النفسي، فلمدة شهر لم أتمكن من تجاوز الصدمة والألم، كما أستحضر كيف أن أرملته الشابة هي الأخرى ظلت واجمة، لا تتكلم وحتى الدموع تحجرت في مقلتيها. وضع عصيب عشناه جميعا أنا وزملائي وزميلاتي في المستشفى، إذ في كل لحظة كانت صورة زميلنا، رحمه الله، تراودنا، وكانت كلماته تتناهى إلى مسامعنا، وكنا نخال انه سيدخل إلى قاعة الفحص في كل لحظة وحين، لكن هيهات أن يتغير القدر.
إن إحدى الحالات المأساوية التي عشناها، والتي نعيشها يوميا في المستشفيات، كأطباء خصوصا، وكمهنيين للصحة عموما، تقاسمتها معكم، باعتباري طبيبة، لأؤكد من خلالها أننا نعاني من أعطاب نفسية كبيرة، نحملها في داخلنا، لها تأثير كبير على حياتنا، ومع ذلك نواصل مهمتنا ورسالتنا، ونحاول القيام بواجبنا المهني على أحسن وجه، وأن نبتسم ونلبي الحاجيات الصحية للمرضى، وإن كنا نحن في أمسّ الحاجة إلى من يستمع إلينا ومن يسعفنا، ولا نجده؟
عجلات تحصد الأرواح
عدد الحوادث لا يعدّ ولايحصى، في النهار كما في الليل، تختلف تفاصيلها ومآلاتها، كما يختلف وقعها، على من تعرضوا لها، وعلينا نحن كذلك الذين نكون في الواجهة للتعامل معها، قبل أي كان.
من بين الحوادث الكثيرة التي صادفتها خلال فترات عملي والتي ظلت عالقة في ذهني، لا تفارقني آثارها السلبية إلى يومنا هذا، حادثة مؤلمة التفاصيل. أتذكر ذلك اليوم حين تمت المناداة علينا صباحا لكي ننتقل إلى مكان حادثة سير خطيرة بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان بالدارالبيضاء، وبالفعل لبينا النداء وحين وصولنا إلى هناك وقعت عيناي على منظر مفزع ومرعب جدا، إذ لم أعتد على رؤية ذلك المشهد إلا في الأفلام والحروب عبر الشاشة، فقد كان الأمر يتعلق بضحية يبلغ من العمر 21 سنة، كان ممددا على الأرض ورأسه تحت عجلات شاحنة كبيرة محمّلة بالقمح، والدماء تنزف وتتدفق منه بقوة، أمام مخّه فقد تناثر على الإسفلت.
لم أقو على متابعة الوضع، ولم أحس بدموعي وهي تنهمر من مقلتاي عنوة دون أن استطيع التحكم فيها، فلم أجد بدا من مسحها خلسة حتى لا ينتبه إليها غيري، والرعشة تدب في جسمي وبين أضلعي. لا أخفيكم أنني لم أستطع النوم خلال تلك الليلة، ولن أغالي إن صارحتكم بأن ذلك المشهد لم يفارقني، فكلما تذكرته فقدت الرغبة في الأكل، وتسمّرت مكاني ودبت القشعريرة في جسدي.
لقد مرت أكثر من 6 سنوات عن هذا الحادث، لكن الآثار النفسية لتلك الحادثة لا تزال تخيّم علي، تؤثر على نفسيتي، بل أنني كلما مررت بالقرب من مكان الحادث أو عند اقتراب شاحنة كبيرة الحجم مني، أستحضر تلك الحادثة، ويغمرني شعور غريب، هو مزيج من الخوف والقلق والحذر.
إنه قدرنا في هذه المهنة، وهذه آلامنا التي تسكننا والتي لا يعرفها الغير.
طريق الموت
كانت الساعة تشير إلى الثانية من صباح أحد الأيام، في جو قارس بارد، يغري بعدم ترك الفراش، توصلت بنداء لكي أقوم بنقل طفلة مريضة صوب مستشفى آخر يبعد عنا بحوالي ساعتين من الزمن، الذي يمكن لمصالحه التعامل مع الوضع الصحي للطفلة التي لم يكن يتجاوز عمرها 8 سنوات.
تسلمت الطفلة المريضة التي كانت برفقة والدتها، التي لفّتها في بطانية وتحملها بين يديها، لم أكن أعرف طبيعة مرض الطفلة، لكني كنت أعرف أن مهمتي أساسية وعليّ أن أنقلها بسرعة لكي تتلقى العلاجات الضرورية. صعدت الأم وهي تحمل ابنتها إلى سيارة الإسعاف، في غياب مرافق صحي نظرا للخصاص في الموارد البشرية، وربما لان الطبيب الذي أشار بتحويل وجهتها رأى أنه ليس هناك من داع صحي يفرض تواجد مرافق أو مرافقة من الأطر التمريضية، وهذا موضوع وإشكال آخر، لنا كسائقين لسيارات الإسعاف، وكذلك بالنسبة لهذه الفئة من مهنيي الصحة التي تعيش جملة من الإكراهات والصعوبات المرتبطة بالنقل الصحي.
وصلنا إلى وجهتنا في وقت ممتاز، خاصة وأن الطرقات الشوارع والطرقات كانت خالية من أية حركة، فتحت الباب الخلفي لسيارة الإسعاف في وجه السيدة التي غادرتها وهي ما تزال تحمل فلذة كبدها، ورافقتها إلى غاية مصلحة المستعجلات حيث قامت بوضعها برفق على سرير طبي، وما هي إلا لحظات حتى جاء الطبيب الذي قام بفحصها، قبل أن يلتفت صوبي ووجهه ينطق بعلامات استفهام كثيرة، وخاطبني قائلا «هذه الطفلة ميّتة»؟
سؤال .. خبر .. معطى .. كان صادما بالنسبة لي، وكيف لي أن أعرف أنها توفيت، فقد غادرنا المستشفى وهي حيّة في حضن والدتها، وفي الطريق وأنا أقود السيارة، لم تخبرني والدتها بأي شيء، لم تتساءل، لم تتكلم، وحتى حين غادرت سيارة الإسعاف كانت ما تزال تحضن صغيرتها، فوجدت نفسي في دوامة من الأسئلة، المرتبطة بما هو قانوني وإداري، وبينهما كانت الصورة الملائكية لا تفارقني مما زاد من حجم ألمي، الذي تعاظم حين انهارت الأم مكلومة أمامي.
أنا اليوم تقاعدت عن العمل منذ سنوات، لكني أؤكد أن تلك الصورة ما تزال حاضرة في ذهني حتى هذه اللحظة، وأتذكر تقاسيم ذلك الوجه الطفولي، الذي ظل راسخا في مخيلتي، والذي تسبب لي في ألم كبير لازمني لأسابيع ليست بالهيّنة، لأن المساهمة في إنقاذ حياة مريض، قد يكون أمرا عابرا مهما كان حجمه وقيمته، لكن وفاة مريض، خاصة حين يتعلّق الأمر بطفل صغير، يكون وقعه كبيرا وأثره بليغا، وأنا خلال مسيرتي المهنية تعرضت لمثل هذا الموقف مرات ومرات، إذ سبق أن فارق الحياة مريض أمام ممرضة في التخدير والإنعاش كانت ترافقني من أجل نقله إلى مؤسسة صحية أخرى، وذلك على بعد حوالي 10 كيلومترات من المستشفى الذي أعمل به في اتجاه الوجهة الصحية الثانية، مما اضطرني للتوقف والاتصال بمصالح الدرك لإخطارها بالواقعة، قبل أن تصل دورية إلى مكان توقفنا وترافقنا بعدها صوب المستشفى من أجل القيام بالإجراءات الإدارية.
حياتنا المهنية كانت ترخي بظلالها على حياتنا الخاصة، وكنا نعود إلى منازلنا وإلى أسرنا ونحن نحمل معنا تلك التفاصيل الأليمة التي نعيشها ونحن نقوم بواجبنا، تفاصيل نظل أسرى لها، تؤثر في سلوكنا، في مواقفنا وفي ردود أفعالنا، وهو ما كان المقربين منا يؤدون ثمنا باهظا له مرارا وتكرارا، وكنا نظلمهم معنا بسلوكاتنا، وهو ما أفسد علينا غير مرّة جلسات ولحظات، كان من المفروض أن تكون عائلية وأن تتوفر فيها طقوس السعادة، لكن عوض ذلك كان يحضر فيها الحزن والألم.
في قلب كل الحوادث
أن تكون مسعفا، أن تعمل في مجال النقل الصحي، أن تتدخل على متن سيارة للوقاية المدنية من أجل نقل مصاب في حادثة أو جثة إنسان، صغيرا او كبيرا، امرأة أو رجلا، فردا واحدا أو مجموعة أشخاص، فهذا يعني أنك تعيش حالات متعددة على مدار الساعة لا حالة واحدة.
نحن لا نعيش قصة واحدة في اليوم، وإنما مجموعة قصص وأحداث، وداخل كل قصة هناك تعدد للمشاهد أو لنقل القصص، خاصة وأننا نحن من نكون أول متّصل بالمريض عموما والمصاب خصوصا، الذي نعمل على نقله، حيا أو ميتا، بغض النظر عن حالته الصحية والوضعية التي يكون عليها، مما قد يعرضنا لإمكانية الإصابة بعدوى ما، وأمراض مختلفة، هذا في الوضع الذي يمكننا وصفه بـ «الطبيعي»، فبالأحرى في الحالات غير «العادية» التي يكون خلالها الوقع النفسي كبيرا.
طيلة مساري كنت مطالبا بالتدخل في الكثير من الحالات، وبالتالي فالمشاهد المروّعة هي كثيرة وكثيرة، لا يمكن الوقوف عندها كلّها، لأنها كلها مؤلمة، ومن بينها أول مشهد عشته حين توجهنا إلى حي السدري بالدارالبيضاء ذات يوم لنقل جثة رجل فارق الحياة على إثر سكتة قلبية، وبما أنه كان يعيش بمفرده فلا أحد انتبه إلى وفاته، لولا الروائح التي نفذت إلى أنوف جيرانه والتي كان مصدرها مسكنه، وبالفعل وجدنا جثة الرجل منتفخة والرائحة كانت قوية، لا أخفيكم بأنها ظلت في حلقي لمدة طويلة، فقدت معها القدرة على الأكل.
مشهد آخر عشته، حين انتقلنا إلى منطقة اسباتة على إثر الانهيار الذي شهدته المنطقة، وكنا نعاين أطراف ضحايا وهي مرمية هنا وهناك تحت الأنقاض، وكنا جنبا إلى جنب مع المصابين، مع الألم، والدموع ومع الدماء.
إنها مشاهد صعبة التجرع، مشاهد ترافقنا إلى منازلنا وتؤثر في علاقتنا بأسرنا، فنجد أنفسنا أحيانا في وضعية غضب وصراخ لأبسط الأسباب، ويكون رد فعلنا غير طبيعي، تحت تأثير تلك الوقائع والحوادث، التي نستحضرها أحيانا في الليل، وتراودنا أحيانا أثناء السياقة، مما يخلق رهبة ورعشة، مخافة التعرض لحادثة سير، ويكون المآل في نهاية المطاف مشابها لبعض تلك الحالات التي تعاملنا معها ونقلناها إلى المستشفى إما بأعضاء مبتورة، أو في وضعية مؤلمة أو عبارة عن أجساد فارقتها الروح، فتنهال الأسئلة علينا، كيف سيكون وضعنا؟ من سيتكفل بالأبناء وأي مستقبل لهم؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي تعكس حجم الضرر النفسي الذي نكون عرضة له، والذي يكون له أثره الكبير في حياتنا، وينخر أجسامنا يوما عن يوم.