تتقاسم الإنسانية في هذه الظرفية الحرجة هواجس الذعر والفزع والهلع جراء انتشار وتفشي وباء كورونا (كوفيد 19) على نطاق واسع في هذه القرية الكونية، حيث تجاوز عدد الإصابات المليونين وعدد الوفيات بمئات الآلاف مما أفرز وضعية نفسية مضطربة .. تميزها السوداوية بسبب الخوف من المجهول الذي بات يستبد بالجميع، فالكل مستلب بالبحث عن الخبر عبر وسائل التواصل … والموت المختبئ في الأجساد المتحركة يتجول أمامك ولا تدري أين هو ؟ والآخر أصبح عدوا مفترضا .. إنه زمن صحي كارثي باعتبار الحادث عاما – خارق للعادة – وفريدا يشمل عموم المكان والزمان … لضراوة الوباء وسرعة انتشاره جعلت منه ظاهرة – عدوى لا تفرق بين الهويات أو الثقافات أو الأديان أو الشمال والجنوب.
اتخذت الدول – للسيطرة على الوباء – إجراءات احترازية واقية كإغلاق الحدود وتسريع الفحص المخبري وإفراغ الشوارع، وعزل المدن وتوفير خطوط ساخنة ومحاربة الإشاعة، وتوعية المواطن بالتزام الحجر الصحي … واعتماد الدراسة عن بعد .. والتباعد الاجتماعي.
وفي غمرة هذا الذعر الجماعي الرهيب الذي يخيم على عزلتنا المفروضة لتجنب العدوى… يبقى الحدث يعرض نفسه كعلامة من علامات المساءلة .. مصدر هذا الوباء وهل هي النهاية ؟ أم هي بداية بزوغ عصر جديد وبصيغة أخرى: هل ينتمي هذا الحادث لحركة التاريخ أم أنه حادث عابر كباقي حوادث الأوبئة التي عاشتها الإنسانية عبر التاريخ ؟
بالعودة إلى الأصل اللغوي للفيروس باليونانية القديمة يعني « السم « وأول استعمال له يعود للشاعر فرجيل (الإلياذة) واكتشاف الفيروس بالمعنى الحديث تم سنة 1892 حيث ظهر علم الفيروسات بعد الاكتشافات التالية :
الميكروبيولوجيا: حيث بدأت دراسة الفيروسات والخلية والباكتيريا والميكروبات.
التكنولوجيا : الهاتف، التلغراف وسرعة الضوء، والطيران والإشعاعات …
في خضم هذا الزخم من الاكتشافات العلمية والتقنية دخلت الإنسانية، تاريخا جديدا وانقلابا في السياسة الوبائية الكبرى للحداثة، فتغير مفهوم الكائن الحي، كسيرورة وبائية من الأمراض التقليدية إلى عصر الفيروسات، إنه مخاض الانتقال من الثورة الصناعية ق 19 التي أحدثت تغييرا عاما في تاريخ البشرية، والثورة التكنولوجية المعلوماتية التي أصبحت تتجرأ لأول مرة الدخول في علاقة مع اللامرئي يقول « هيدغر في هذا السياق : « .. الطبيعة تعود اليوم إلى مركز اللعبة وعلينا جميعا أن نتعلم كيف نقتسم سكنى العالم «.
فلا غرابة إذا استضأنا بما قاله ميشيل فوكو في كتابه «تاريخ وباء الطاعون»، بوصفه ورشة بيوسياسية لدراسة نشأة العلاقة بين المعرفة والسلطة «التي مثلت الوجه الخفي لواقعة الحداثة، أن الصلة التاريخية بين الحداثة والأوبئة ليست عرضية، بل هي جزء أصيل من هويتها الأخلاقية «.
بات العالم يعيش تسارع المنجزات العلمية والتقنية في مختلف المجالات، بفعل تكنولوجيا المعلومات التي غيرت إدراك البشر للزمن قابله تنظير مبني على مضمون فلسفي يسعى إلى نقد الحداثة كمشروع غير مكتمل بالمفهوم الهيغيلي : « إن نقد الحداثة لذاتها تستمده من ضماناتها الخاصة»، بمعنى أن نقد الحداثة يتم من داخل الحداثة نفسها.
ومن هذا المنطلق سار يورغن هابرماس في إطار نظريته النقدية « الخطاب الفلسفي للحداثة» يقدم علاجا لأمراض الحداثة اختزله في مفهوم «العقل التواصلي» أو «الفعل التواصلي» الذي ينفتح فيه على مختلف ثقافات بلدان العالم، وفي مقابلة له مع صحيفة لوموند سئل هابرماس عن النتائج والآثار الأخلاقية والسياسية لأزمة كورونا على الصحة العالمية قال : « علينا أن نكافح من أجل إلغاء النيوليبرالية … وأن تقييد عدد كبير من حقوق الحريات المهمة يجب أن يظل محدودا جدا … ولكنه إجراء مطلوب كأولوية للوصول للحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية وإن كان البعض يستغله لأغراض سياسية «.
أما إدغار موران فهو يحمل المسؤولية مباشرة إلى العولمة التي يرى « أنها وحدت العالم على المستوى التقني والاقتصادي لكنها لم تآخ بين الشعوب وذهبت إلى إبادة الخصوصيات الثقافية … العولمة قربت المسافات وجعلت الأزمنة متواقتة .»
بقي أمر استيعاب المخاطر الملازمة للتقدم التقني عصيا على السؤال الفلسفي، حيث اعتبرت حنا أرنت أن التقدم والكارثة وجهان لعملة واحدة.
حسب فرضية غايا GAYA أن أي نشاط بشري يؤثر في البيئة في أي مكان من الكرة الأرضية، يولد ردة فعل تلقائية ومعاكسة في المنظومة البيئية تهدف إلى إعادة توازن الناجم عن التغيرات المناخية أو التلوث بمختلف أشكاله جراء إفراط الإنسان في أنشطته الصناعية والتكنولوجية.
إلا أن هذه الفرضية ضعيفة التحقق، ذلك وبصرف النظر عن أصل هذه الجائحة الفيروسية إن كانت ظاهرة طبيعية انتشرت عبر طفرات متتالية في بداية القرن الحالي وبقيت تتطور إلى أن وصلت إلى الوضعية الحالية، أم أنها منتوج بشري تطور نتيجة تدخل الإنسان في الجينات الوراثية للفيروس في سياق الحرب البيوليوجية. ليبقى السؤال الذي يطرحه المهتمون، كيف طور هذا الفيروس أسلحته الهجومية عبر وسائل وطرق دفاعية أخرى لاحتواء جهاز المناعة الإنساني بعد أن حصل هذا التطور خارج جسم الإنسان بسرعة خيالية في أقل من عشرين سنة ؟
هذا الاستفهام في بعده العلمي ناتج حتما عن حالة الظهور والاختفاء للفيروس طيلة القرن الماضي بعد اكتشاف قارة اللامرئي الحيوي : الإنفلونزا الإسبانية 1918 -1919، والإنفلونزا الأسيوية والحمى القلاعية والكوليرا وأنفلونزا الطيور وجنون البقر والسيدا وإيبولا.
في زمن كورونا أصبح هذا الفيروس عدوا مفترضا يختبئ وراء المرض ليتحول إلى مساحة فيروسية مفتوحة، فالإنسان ينفق كالحيوان دون جنازة ولا مرافقة أثناء المرض ولا توديع … تغيرت إذن تخوم الجسد وغير مفهوم المرض من دلالته وأصبح مجرد اختراع أخلاقي خاص بنا نحن البشر، فالفيروس كحادث أعاد ترتيب العلاقة التكنولوجية مع المحسوس اللامرئي بعد أن نسف الحواجز الثقافية والأخلاقية التي بناها الإنسان عبر العصور لفصل نفسه عن بقية الكائنات باعتباره مركز العالم، هذه المركزية التي تفككت دون عودة، لأنه لأول مرة في تاريخ الأوبئة، سار الجسم البشري هدرا عضويا أمام كل أنواع الهجمات الفيروسية التي اصطدمت بها الأزمنة الحديثة.
كان بيل غيتس مؤسس شركة ميكروسوفت قد حذر في مؤتمر ميونخ (2015) وفي مناسبة أخرى (2017) من انتشار الوباء، ودعا الأسرة الدولية إلى الاستعداد كما لو كانت تستعد لحرب نووية. والسؤال لماذا توقع بيل غيتس وقوع هذا الحدث ؟
وكرد فعل فوري على الوباء نجد الاستعارة التي استعملها كل من ماكرون وميركل حول الحادث، فالأول قال « إننا في حرب «في حين قالت ميركل : السيطرة على وباء كورونا هي السيطرة على الوقت»، وهي نفس الاستعارة التي استعملها بيل غيتس حين حذر من وقوع حرب بيولوجية.
والمتأمل في هذه التصريحات يجد أن القاسم المشترك فيها هو الحرب والسرعة، وبالتعبير الفيريليوي « إن السرعة هي جوهر الحرب .. وأن من يتحرك بسرعة أكثر يهيمن على من يتحرك بسرعة أقل «، وفي هذا السياق يحضر طيف هيراقليطس حيث قال « إن الحرب أم كل الأشياء «
استطاع بول فيريليو استيعاب المخاطر الملازمة للتقدم التقني التي بقيت عصية على المعالجة الفلسفية، أن يؤسس حقلا معرفيا جديدا سماه « درومولوجيا « يهتم بعلاقة الإنسان كوعي بجوهر السرعة حيث صارت هذه الأخيرة مقياس القيمة الأول، لم يعد أي شيء محصن تجاهها فلم يخترع الإنسان عبر التاريخ آلة لكبح السرعة.
فالسرعة مع التقنية هي عصب الحرب وقد استطاع فيريليو نحث مفاهيم جديدة كعلم بيئة الزمن وعلم السباق أو علم السرعة.
فيريليو : هذا القادم من العمران إلى الفلسفة بعد أن كان رساما رفقة ماتيس ثم مهندسا معماريا، وسار على خطى مارتن هايدغر الذي تصدى لجوهر التقنية وعلاقتها بالزمن وواصل مشروعه الفلسفي المبني على التأمل في إطار نقد ما بعد الحداثة بفعل الطفرة التكنولوجيا الهائلة وأثرها على البيئة والإنسان، حذر بدوره من مخاطر الإفراط في السرعة التي تشوه من تمثلنا للعالم الذي صار صغيرا بفعل سرعة البث، فأفسح الوقت الزمني أمام الوقت الحقيقي temps réel le من خلال شاشة الكومبيوتر، والتلفزيون، والهاتف، حيث يظهر كل شيء على الفور ويلغي بالتالي البعد المادي، فلم تعد الغابات والبحار مهددة بالتلوث بل أضحى الزمن مهددا بالفناء، الشيء الذي يجعل من الحادث هو الوجه الخفي للتقدم، والمقابل السلبي للسرعة هو الحادث أو الكارثة (كورونا). وفيريليو مقتنع بأن السرعة هي المسؤولة عن معظم الكوارث الإلكترونية فالحوادث لا تقع بمحض الصدفة بل هي الثمن لهذا التقدم الإنساني.وهدف الدرومولوجيا أن تجعل الإنسان على وعي تام بنصيب الخطر الموجود ضمنيا في قلب السرعة.
ونتيجة ذلك يقول فيريليو إن سكان الأرض انقسموا إلى قسمين :
شعوب الأمل التي من حقها أن تحلم بالمستقبل لتوفرها على السرعة التي تفتح لها باب الممكنات بفعل آيبوك آيفون وآيباد وآخر الصيحات الإلكترونية G5.
شعوب اليأس مشلولة الحركة بفعل فقرها التقني وتكتفي فقط بالإقامة في عالم متناه.
ونحن ننتمي حسب تصنيف فيريليو إلى الفئة الثانية من الشعوب، وعسى أن يحرك جحيم كورونا هذه المياه الآسنة والراكدة في ثقافتنا الجاهزة.
كان المفكر الفذ المهدي المنجرة قد توقع في بداية الثمانينات مستقبل الإنسانية بمناسبة استضافته في أحد البرامج الإعلامية وهو مصحوب بحاسوب صغير يعلن لمقدم البرنامج : « إن هذا الحاسوب هو من سيحدد مصير ومستقبل الإنسانية، وعلى الدول النامية أن تكون في مستوى الحدث لمقاومة العولمة المتوحشة «
وقتئذ لم يلتقط الوعي المجتمعي الدلالات البعيدة لهذا التوقع و التحذير، فبقينا متأخرين عن الحاضر العالمي.
جحيم كورونا وسؤال السرعة
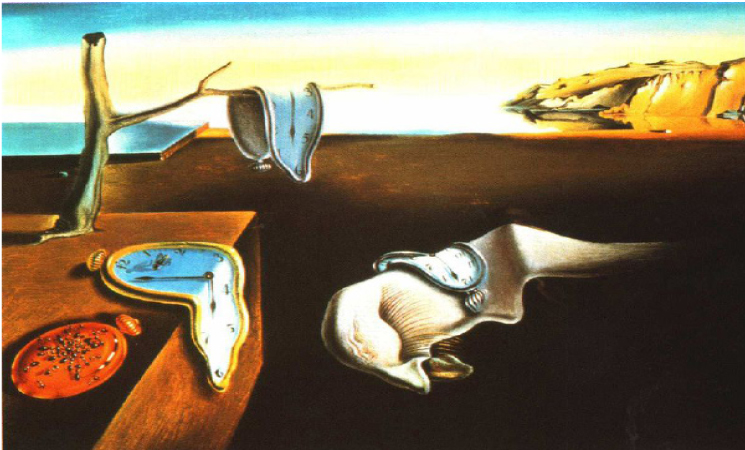
الكاتب : ذ.سلام بكوري
بتاريخ : 26/06/2020






اترك تعليقاً