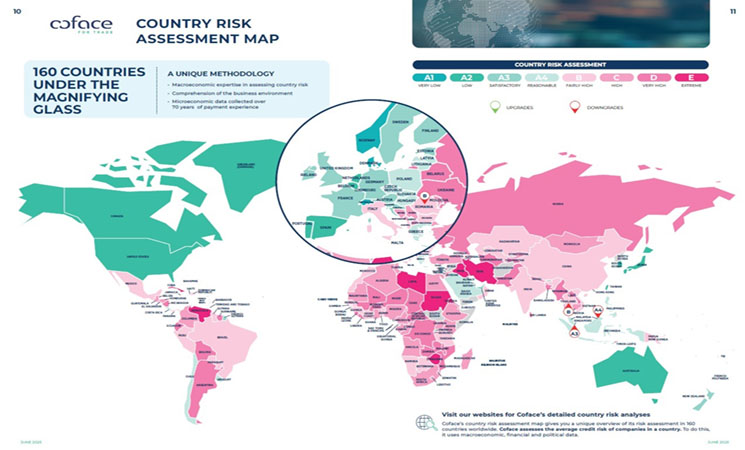لعل ما يجعل من أزمة وباء كورونا المستجد، جائحة لم يسبق للعالم ان عاش مثلها، هي حدة الطبيعة التاريخية للفيروس التاجي، والتي يأتي الجزء الأكبر منها، من التزامن الثلاثي فوري التأثير لها، وعواقب إنتشارها و إتساع رقعتها عالميا، وأخيرا بديهية طبيعتها التحويلية. لعل ما يميز أزمة جائحة كورونا المستجد، توخي السرعة و اليقين في العلاقات الدولية، سمتان لا تجتمعان إلا نادرا فيما يشبه هذه الأزمات، وما أظهرته من توافق واضح في الآراء داخل المجتمعات الدولية، بيد ان كل شيء بدا في التغير و سيستمر على هذا المنوال.
لازال يعطينا التاريخ كما إعتاد، دروسا في التركيز على المستجد من الاحداث، مع وضع كل جديد في منظوره الصحيح، خاصة عندما نكون في وسط العاصفة، وأن سوابق الأزمات العالمية بإختلافها، تحديدا الناتجة عن الفيروسات و الاوبئة، التي تصبح عند إنتهائها نسيا تاريخيا ليست سوى، أوسمة تاريخية يجب الإعتبار منها. تختلف الازمة العالمية الحالية بالإنطباع الذي تبديه، حول قواعد الأمن الدولية و ملامح العالم الجديد، مؤكدة على الإتجاه الناشئ القادم، بيد ان غياب القدرة على التنبؤ، سمة تميز الهيكل التطوري للأمن العالمي.
قبل بضعة سنوات من الآن، كان مفهوم «عدم اليقين» مرسخا بقوة، إلا ان هذا التقلب ظل مجردا للغاية، وعلى إرتباط دائم بقضايا الأمن الإلكتروني، اي عدم سيطرتنا على التكنولوجيات الجديدة، إلى جانب إيماننا المطلق وثقتنا العمياء، في قدرتنا على حل مشاكلها. ينضاف إلى ما سبق الأزمات السياسية، مع أسئلة دائمة حول بؤرة «التوتر العالمي» التالية، مستندين في توقعاتنا إلى الآراء و التوجيهات المختلفة. إن اضطرابات فيروس كورونا، تعطي الآن شكلا و مضمونا ثابتا، لهذا المفهوم بطريقة جديدة و مبتكرة، لما يوفره لها من عقبات حقيقية، سواء كانت فكرية أو عملية، في مواجهة تجسيد حميمي لمفهوم «غير المتوقع».
نفس الشيء، ينطبق على «ما بعد أزمة كورونا المستجد»، الذي قد تنهي ما يشبه «يوم 11 شتنبر» الطويل على العالم، والذي غرق فيه العالم لما يقرب من عقدين كاملين، سنوات من نطاقات عالمية لعدم الأمن وترقب «الحدث المطلق»، الذي إفتتح القرن الجديد بشكل مأساوي، فلا حرب العراق في 2003 و الربيع العربي في 2011، ولا الحرب على سوريا في العام ذاته، ولا بروز تنظيم داعش ما بين 2013 إلى 2017، ولا ضم شبه جزيرة القرم في 2014، أو إنتخاب دونالد ترامب في 2016، لم تتمكن من إزاحة حدث «يوم 11 شتنبر»، من مكانته بالنسبة للعالم.
مهما تعددت أسماء أو صفات هذه التطورات، إلا ان الجميع يجمع على ان وقت ظهورها، يأتي في أعقاب تاريخ «11 من شتنبر»، واحداثه المزعزعة للاستقرار. يمكننا القول الآن، بان المخاوف السابقة من الفيروس الإلكتروني «Y2K» في 1999، لم تكتمل إلا بإلتحاق فيروس كورونا المستجد في 2020، وأن ما بعد تاريخ «11 من شتنبر»ـ قد أختتم في عشية الذكرى العشرين لهذا الحدث، حتى وإن كانت هذه الفترة قد تركت أثرا لا يمحى، في مجال الأمن المعلوماتي المتقدم للحقبة الموالية.
بعيدا عن الجوانب الطبية، يطرح السؤال حول الأشكال الجيوسياسية، لهذه اللحظة المحورية الجديدة التي تولد أمامنا؟. من السابق لأوانه معرفة إجابة واضحة، خاصة إن كان لابد لنا من تجنب الحتمية التاريخية، وإن وجب علينا الإصرار على الطبيعة التطورية لهذه العملية، فإن أربعة أبعاد كبيرة بدأت ترسم معالمها بالفعل، وهي «تعزيز الدولة ذات الميل السلطوي الملحوظ»، «تعميق عسكرة العلم» و «توحيد معايير المراقبة» و «تدفق موجة من العولمة المضادة».
يشهد في جميع أنحاء العالم، على تأكيد الدولة بوضوح لسلطتها خلال الازمة الحالية، مستعينة بدعم كل من الشرطة و الجيش، ولتلعب دور المنقذ و صانع القرار الخارق، أو محكم القانون بشكل صارم، كما رأينا في عدة بلدان كالهند و كينيا و فرنسا و الولايات المتحدة. يشهد للدولة أيضا، إستثمار حالة الطوارئ، و انظمتها و حالات الحصار المبدئية، بنمط ذكي و حماس مبطن، من خلال حكومات إستغلت ثغرات، في مطالب العدالة التي تواجهها دائما بإنتظام.
بعيدا عن البيروقراطيات الهائجة و صناع القرار السائدين، فإن الوضع الاستثنائي أعطى قدرا اعظم من التحرك، للدول المنخرطة بالفعل في ما يعرف ب»الإنجراف الإستبدادي»، كحال «هنغاريا لفيكتور اوربان» و «الفلبين لرودريغو دوتيرتي» و «البرازيل لجير بولسونارو»، وان «الإستبداد الحداثي» ليس إلا وسيلة في الواقع للعثور على وجهات إجتماعية جديدة. إن ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية المشرفة على نهايتها، من تجاوزات و تكبر على سيادة القانون في الولايات المتحدة، أمكنه ان يعلن في 13 من ابريل الماضي، أن سلطته السياسية أصبحت «كاملة» الآن.
من الممكن القول، بان دينامية إعادة التموقع الموجهة، التي بدأت قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعزيزها خلال الفترة الحالية سوف تستمر في النمو، وستسعى لذلك اكثر اليوم بسبب ترشيدها تقريبا في كل مكان، نتيجة لمطالب الحماية الشعبية. وخوفا من ذلك، سينقص إهتمام المجتمعات، بالأسس الموضوعية لهذه التدابير و مقبوليتها الديمقراطية، وسيبدأ التعامل مع المواطن كالطفل الصغير. اليوم، يوبخ هؤلاء المواطنون من قبل ضباط الشرطة، يعيدون توجيههم في الاحياء الراقية، و ضربهم بالعصي في الاحياء الفقيرة.
وعليه، فإذا كانت نزعة التدخل، في سنوات 1990 و حروب ما بعد 11 من شتنبر، قد عززت من إنتشار منطق الدفاع عن النفس ضد الوباء الحالي، فبطبيعة الحال سيستمر تعميق اثر هذا النمط من أوامر الطاعة، إذ دخلت الإستجابة لمواجهة كوفيد-19، منطقيا في هذا السياق العسكري، بيد ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر مسبقا من ان بلاده تعيش «حالة حرب»، وذلك لان الديناميات الدولية كانت تعمل بهذه الطريقة، منذ ما يقرب من ثلاثين سنة مضت، كما يمكن ملاحظة جميع الأزمات الحالية، من هذا «المنظور الإختزالي» أو «الصارم» للحرب، في الحقيقة هي كذلك بالفعل بعد إتخاذ الخطاب الحربي، موقفا عالميا من الدبلوماسية. إن هذا الوجود المطلق للدولة و هذه العرفية، التي لا تشكك في الليبرالية الجديدة، لغالبية هذه الدول ولكنها ترفضها، قد تصاحبها أو حتى تفوقها، مراقبة واسعة للمواطنين المتموقعين في عدة مناطق جغرافية. إن تثبيت هذا المعيار المتناقض، على الصعيد الدولي قد يضيف بعدا من «الضرورة»، إلى حجة المنفعة الإجتماعية المتقدمة مسبقا، نفس الشيء قد ينطبق على أرجحية الأداء الإملائي.
سيكون من الصعب، بوتيرة متزايدة وضع بصمة، و الإشراف على متابعة هذه الممارسات التي إنغمست في العنف، دون استعجال أو مشاورة البرلمان، كما وقع بالصين و إسرائيل و روسيا و كوريا الجنوبية، عبر تتبع حركات المواطنين، و رقمنة القيود المفروضة على الحركة، والحق في تطبيق تقنية التعرف على الوجوه، وغيرها من التقنيات مرارا و تكرارا بإسم «الأمن المقدس». يمكن للمرء ان يتصور، ان الغموض الدستوري في بعض الحالات، وعدم الوضوح في حالات أخرى، سيسمحان بإجراءات الحجر الصحي لأسباب غير طبية. وبما ان هذه التدابير، ستنفذ عبر تكنولوجيات شبه معصومة من الخطأ و قابلة للمسائلة، فإن المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، على إثرها قد ترتفع بشكل ملحوظ. ومن هنا علينا التساؤل، هل تم تخيل المستقبل دائما كعالم ديستوبي خلال القرن الماضي؟، كما تخيله كل من «ريني بارجافيل» و صولا إلى «مارغريت آتوود»، مرورا بكل من « ألدوس هوكسلي» و «فيليب كي ديك» و «بيير بوول» و أخيرا «إبرا ليفين»؟.
يبرز حاليا على مستوى العالم، احد أهم الأسئلة وهو «هل نتوجه نحو عولمة مضادة؟». تكمن الإجابة عليه بضرورة التخفيف، من ما قد يؤدي بنا إلى عولمة مضادة، مع طرح أسئلة من قبيل «هل من آثار مفيدة لهذه المشاركة من قبل الدول؟»، و «هل ستحمي حقا النسيج الإجتماعي؟»، و «هل تلعب الدولة حقا دورها جيدا؟»، و أخيرا «ألا تجعل التكنولوجيا حياتنا أسهل؟». من الواضح، ان التدابير الرامية لدعم المواطنين، تتلقى دعما واضحا و ترحيبا كبيرا في كل مكان، ولاسيما للحد من زيادة عدم الإستقرار. و بالمثل، فإن إعادة تنظيم مساحات التفاعل و حسن تسييرها، عاملان ضروريان بلا شك للنظام الإجتماعي. ومع ذلك، ينبغي ان لا نغطي أعيننا، على أن هذه الفترة التاريخية الحالية، تتسم بإتساع الفجوة ما بين الدول المنهكة و بين المؤسسات، في الشمال كما في الجنوب، في خضم تعالي أصوات الخطابات الممارسة للوصاية، الآن باردة و رقمية و عنصرية.
اليوم، لا تفوز الدول بسهولة، بعضوية دولية إلا بحالة الإستسلام. ولذلك فإن أزمة فيروس كورونا، يمكن ان تؤدي في نهاية المطاف، وعلى الأرجح إلى موجة من العولمة المضادة. هذه الموجة لن تكون بالضرورة إيديولوجية ومناهضة للعولمة، التي تنشط منذ مدة ليست بالقصيرة، بل ربما كانت نتيجة للحظة جديدة من القدرية المشتركة -من مفارقات العولمة- حيث تولد حدود للترابط و الشعور، سرعان ما تنهيها الممارسات. يمكن لهذه الظاهرة، ان تخلق أوجه ضعف وجودية، وليس فقط إقتصادية داخل المجتمعات.
إن الإعتقاد المتزايد، بأن «التبادل الشامل ليس جيدا بالضرورة»، يؤدي إلى تعزيز منطق الإنقسام الدولي والحمائية الوطنية. وعلى غرار الدولة الإستبدادية الموحدة، فإن إنغلاق العالم سيكون جزءا من المنطق القائم من قبل، على مبدأ الحصون التي ستتم حمايتها في أوروبا، والجدران التي ستبنى في أمريكا، وأيضا لأنظمة مطوقة ومؤمنة في روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة. إن الحاجة الملحة إلى الحماية، حماية «امتنا» من التهديدات الخارجية، ستكون من المواضيع السياسية المتكررة في كل مكان، مما سيعوق التعاون الدولي إلى حد كبير.
إن عالم ما بعد كورونا، سيحدد خصائصه بطريقته الخاصة، تحديدا حيث يكمن «الجديد» بشكله الأساسي، بطريقة ستمكنه من البقاء وفيا لمنطق «عدم الإتساق». ولذلك، لا يمكن التنبؤ بصحة هذه الفرضيات، بل ينبغي ان تكون هذه الإمكانية غير محددة، بما يشبه السقطة الشهيرة، للكاتب بول فاليري في 1960، حيث قال «إن النمط غير المتوقع، يسعى بنفسه نحو التغيير، وان الحديث غير المتوقع، لا حدود له تقريبا».
سيجعل هذا التوجه المجهول، من الجيوسياسية لمرحلة ما بعد الازمة الوبائية اكثر إجتماعية من السياسة. إن العبور الهجين، ليس إلا شكلا لمختبر الحكامة الهرمية المعاصرة، الذي يربط بين التجارب العسكرية «البعيدة»، و الإختبارات الإجتماعية «القريبة». الأمر أشبه بشخصيات رواية الكاتب «خوسيه ساراماغوا إنسايو في «الأعمى، 1997»، الذين تحولوا إلى فاقدين للبصر بسبب مرض غير معروف، أغرقهم في جو مشحون بالتوترات، الشك و العداء، الحقد و الأنانية، في وضع قد تعيشه دول العالم على الساحة العالمية، في حالة الترسيخ للإستقطاب الملتف.
ينطبق القول المأثور «رب ضارة نافعة»، على الفترة الحالية التي علينا ان نراهن فيها، على العيش وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، في ظل عدم الإستقرار و المستقبل شبه المجهول. قد نشهد فيه أيضا ولادة فهم افضل لعلاقاتنا بالعالم، فضلا عن التواضع و الكرم في تبادل ما تفتقر إليه دول العالم من معونات أساسية، في ساحة دولية تكاد تخلو من العدالة و البصيرة. لكن و في الوقت الحاضر، لا يسعنا تجاهل العلامات المعززة لحضور للفيروس، ببعض من الأورويلية (نسبة لجورج اورويل) الجيوسياسية الحساسة جدا.