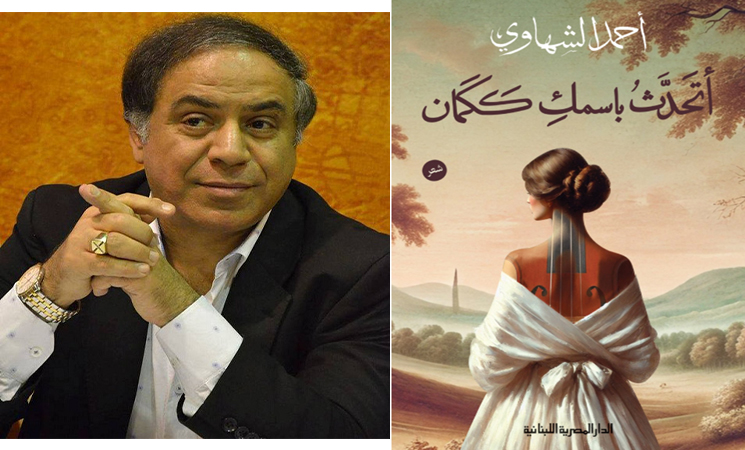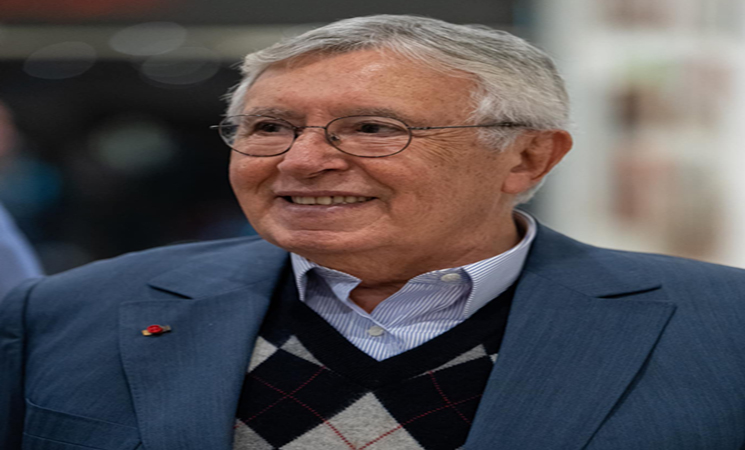كتب جورج أورويل مقالته الرائعة «مراكش» سنة 1939 خلال إقامته الاستشفائية التي استغرقت زهاء ستة أشهر بهذه المدينة. وقد أسالت هذه المقالة حبرا كثيرا خصوصا بين النقاد والدارسين المهتمين بالنقد الثقافي لدرجة أنها تعتبر اليوم متنا دراسيا في هذا الحقل مثلها مثل الكثير من النصوص الشبيهة كـ»قلب الظلام» لجوزيف كونراد، و»موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح، و»أصوات مراكش» لإلياس كانيتي، وغيرها من النصوص.
عندما عبرت الجثة طار الذباب في شكل غيمة عن طاولة المطعم واندفع وراءها، لكنه عاد أدراجه ً بعد بضع دقائق.
انسلت جماعة المشيعين الصغيرة – جميعهم رجال وأولاد، ما من نساء – وسط السوق بين أكوام الرمان وسيارات الأجرة والجِمال، مرددين ترتيلة نحيب قصيرة. ما يجتذب الذباب هنا فعلا هو كون الناس لا يضعون الجثث أبدا داخل توابيت، بل يلفونها في خرقة ويحملونها على نعش خشبي خشن فوق أكتاف أربعة أصدقاء. وحين يصل هؤلاء الى مكان الدفن يحفرون حفرة مستطيلة يتراوح عمقها بين الثلاثين والستين سنتيمترا ويرمون بالجثة داخلها، ثم يهيلون فوقها بعض التراب الجاف المتكتل الشبيه بطوب مكسور. لا وجود لشاهدة قبرأو اسم أو أية علامة من أي شكل. مكان الدفن عبارة فقط عن تلة يباب هائلة شبيهة بموقع بناء مهجور. ثم بعد انصرام شهر أو شهرين يتعذر على المرء التعرف بيقين على المكان الذي دفن فيه قريبه.
عندما تتمشى وسط بلدة مثل هذه – بها مائتا ألف نسمة، عشرون ألف منهم على الأقل لا يملكون بحق سوى تلك الخرق التي تسترهم – عندما ترى كيف يعيشون، بل أكثر من ذلك كيف بسهولة يموتون، يصعب عليك مرارا التصديق بأنك تتمشى بين كائنات بشرية. جميع الإمبراطوريات الاستعمارية تأسست في الواقع على هذه الحقيقة. الناس هنا ذوو وجوه بنية – إضافة إلى كثرة أعدادهم! هل هم حقاً من نفس لحمك ودمك؟ هل لهم أسماء؟ أم هم مجرد نوع من الكائنات البنية التي يصعب التمييز بينها، تماما كما النحل أو حشرات الشعاب المرجانية؟ هم يخرجون من الأرض، يعرقون ويعانون الجوع ومرة أخرى ينحدرون إلى قاع قبور لا أسماء تميزها، وما من أحد بعد ذلك يلاحظ غيابهم. حتى القبور سريعا ما تتلاشى في التراب. أحيانا وأنت تتمشى في الخارج سالكا طريقا يخترق أشجار التين الشوكي، تلاحظ كثرة الحفر والنتوءات تحت قدميك، ووحده شيء من التناسق في تلك النتوءات يجعلك تدرك أنك إنما تتمشى فوق هياكل عظمية.
كنت مرة أطعم أحد غزلان الحدائق العامة.
فالغزلان هي الحيوانات الوحيدة التي تثير شهية الأكل وهي بعد حية، والحق أنه لا يمكن للمرء أن ينظر إلى أطرافها الخلفية دون أن تساوره صلصة النعناع. يبدو أن الغزال الذي كنت اُطعمه أدرك ما كنت أفكر فيه لأنني حتما لم أرُق له رغم أنه تناول قطعة الخبز التي مددتها له. طفق الغزال يقضم الخبز بسرعة، ثم أحنى رأسه وحاول أن ينطحني، ثم قضم قضمةً أخرى ونطح من جديد. ربما كان يفكر أنه إن تمكن من إبعادي، فسيظل الخبز عالقا بشكل ما في الهواء.
وضع حفار عربي يشتغل في ممر قريب معوله الثقيل وانحرف نحونا. جال بنظره من الغزال إلى الخبز ومن الخبز الي الغزال بنوع من الدهشة الهادئة، وكأنه لم يشهد حدوث أمر مثل ذلك من قبل. أخيراً قال في خجل باللغة الفرنسية:
«بإمكاني… أكْل بعض ذلك الخبز»
قطعت له بعضا من الخبز فخبأه بامتنان في مكان سري تحت خرقته. هذا الرجل هو مستخدم تابع للبلدية.
عندما تعبر حارات الملّاح اليهودي، تأخذ فكرة عما كانت عليه غالبا حارات اليهود في القرون الوسطى. فالحكام المغاربة لم يكونوا يسمحون لليهود بامتلاك الأرض في مناطق محدودة، ثم بعد مرور قرون من نظير هذه المعاملة لم يعد اليهود يعبأون لأمر التزاحم. العديد من الأزقة عرضها أقل من مترين بكثير، كما أن المنازل منعدمة النوافذ تماما، والأطفال الرُّمْد يحتشدون بأعداد لا تصدق في كل مكان كما غيومٍ من ذباب. وهناك غالبا ساقية بول صغيرة تجري وسط الزقاق.
في سوق الملّاح، ترى أعدادا هائلة من العائلات اليهودية، يرتدي أفرادها جميعا أردية طويلة سوداء وطواقي صغيرة سوداء. يشتغلون داخل دكاكين مظلمة يكتسحها الذباب وتبدو مثل كهوف.هناك نجار يجلس متربعا أمام مخرطة من عصر ما قبل التاريخ وهو يدير بسرعة البرق أرجل الكراسي في تلك المخرطة. تشاهده يُشَغّل المخرطة بواسطة قوس في يده اليمني بينما قدمه اليسرى تتحكم في الإزميل. ولأنه قضى كل العمر جالسا في نفس الوضع اعوجت ساقه اليسرى. بجانبه حفيده البالغ ست سنوات مشتغلا منذ تلك السن على أعمال بسيطة.
كنت ماراً فقط بدكاكين النحاسين عندما رمقني أحدهم أشعل سيجارةً. وعلى الفور فوجئت باندفاع مسعور لليهود من كل تلك الحفر المظلمة حولي. كان العديد منهم أجدادا مسنين بلحى رمادية طويلة، يصرخون كلهم طالبين سيجارة. بل إن أحد العميان سمع في مكان ما خلف أحد الدكاكين شائعة السيجارة فجاء يزحف نحوي متحسسا بيده الهواء. هكذا في حوالي دقيقة نفذت علبة السجائر. أظن أن لا أحد منهم يشتغل أقل من إثنتي عشرة ساعة في اليوم، لذلك كانوا يرون في مجرد سيجارة ضربا من الرفاهية المستحيلة.
ولأن اليهود يعيشون في مجتمعات مغلقة، فإنهم يشتغلون بنفس أنواع التجارة مثل العرب، باستثناء الزراعة. باعة الفاكهة، الخزافون، الصاغة، الحدادون، الجزارون،عمال الجلد، الخياطون، السقاؤون، الحمالون – حيثما نظرت لا ترى سوى اليهود . هناك في الواقع ثلاثة عشر ألف منهم، يعيشون جميعا في حيز لا يتعدى بضعة هكتارات. لحسن الحظ أن هتلر لا يعيش هنا . هو ربما، مع ذلك، في طريقه. كما تسمع الشائعات الخسيسة المألوفة عن اليهود، صادرة ليس عن العرب فقط، بل أيضاً عن الأوروبيين الأكثر فقرا.
« أجل يا صاحبي، لقد أخذوا مني عملي وأعطوه ليهودي. اليهود! إنهم حكام هذا البلد الحقيقيون، هل تعرف ذلك. يملكون المال كله، ويتحكمون في البنوك، المالية – كل شيء»
«لكن» قلت «أليس حقيقة أن اليهودي العادي هو مجرد عامل يشتغل ساعة من الزمن مقابل سنت واحد؟ «
« أوه، ليس هذا سوى تمثيل! هم في الواقع مرابون، ماكرون اليهود»
بنفس المنطق، وقبل مئتي سنة، كانت نساء مسنات فقيرات تحرقن بتهمة ممارسة السحر، هن اللواتي لم يكن يسعفهن السحر بشكل كاف للحصول على وجبة طعام كاملة.
جميع الذين يشتغلون بأعمال يدوية لا تراهم العين بشكل كاف، وكلما زادت أهمية العمل الذي يقومون به كانوا أقل بروزا للعيان. مع ذلك تلاحظ العينُ صاحب البشرة البيضاء بوضوح تام. فإذا حدث في شمال أوروبا وصادفت فلاحا يحرث الأرض، فأنت تعاود النظر إليه في الغالب مرة ثانية. أما في البلدان ذات الطقس الحار، في أيما جهة جنوب جبل طارق أو شرقي السويس فاحتمال رؤيته ضعيف جدا. لاحظت هذا الأمر مرات متعددة. ففي المشهد الاستوائي ترى العين كل شيء إلا الإنسان. ترى التربة الجافة، شجر التين الشوكي، النخيل، والجبل البعيد، لكنها دائماً تخطئ الفلاح وهو يعزق حقله. هو بنفس لون الأرض، لكنه أقل إثارة للاهتمام بكثير.
لهذا السبب فقط أصبح هناك إقبال على البلدان الفقيرة في آسيا و إفريقيا كوجهة سياحية. لن يفكر أحد قط في تنظيم رحلات رخيصة الي الأماكن المنكوبة. لكن حيثما وُجِد البشر ذوو البشرة البنية، ففقرهم ببساطة لا يُلاحظ. ماذا يعني المغرب للرجل الفرنسي؟ بستان برتقال ووظيفة في خدمة الحكومة. أو ماذا يعني للرجل الانجليزي ؟ جِمال، قصور، نخيل، فيالق أجنبية، صواني نحاسية، قطاع طرق. قد تعيش أعواما في هذا البلد دون أن تلاحظ أن حقيقة الحياة بالنسبة لتسعة أعشار الناس هنا هي صراع مرير بلا نهاية لانتزاع قليل من القوت من تربة عصفت بها التعرية.
معظم أراضي المغرب جرداء جدا لدرجة أن حيوانا بريا أكبر من حجم الأرنب لا يستطيع العيش عليها. مساحات شاسعة جدا كانت تغطيها الغابات أصبحت يبابا لا شجر فيها، فيما التربة شبيهة تماما بقطع طوب مكسور. مع ذلك هناك نسبة كبيرة من الأراضي الفلاحية يبذل أصحابها جهدا مرعبا في زرعها. كل الشغل هنا يدوي. طوابير طويلة من النساء المعقوفات الجسم كالحرف اللاتيني L في شكله الكبير مقلوبا، يشققن طريقهن ببطء عبر الحقول، وهن ينتزعن بأيديهن الأعشاب الشائكة، بينما الفلاحون يجمعون البرسيم علفا للماشية مقتلعين إياه ساقا ساقا عوض حصده كاملا ليقتصدوا بضعة سنتيمات في كل ساق. المحراث عبارة عن شيء خشبي بئيس، خفيف الوزن جداً حتى ليسهل على المرء حمله على الكتف، مزود في أسفله بقطعة حديد خشنة تقلب التربة موغلة إلى عمق عشرة سنتيمرات تقريبا. إنه يناسب قدرة الحيوانات هنا. فعادة يتم الحرث اعتمادا على حمار وبقرة مقيدين إلى بعضهما البعض. حماران اثنان ليس لديهما ما يكفي من القوة. أما استخدام بقرتين فيكلف علفا أكثر. كما لا يملك الفلاحون مسالف حديدية، هم فقط يحرثون الأرض مرات عديدة في اتجاهات مختلفة تاركين عليها أخاديد غير مستوية، ثم بعدها يستخدمون المعاول لتسوية كامل الحقل على شكل رقع صغيرة مستطيلة بغرض الحفاظ على الماء، إذ ليس هناك ماء كاف غالبا باستثناء يوم أو يومين من المطر إثر عاصفة مطرية نادرة. وبهدف الوصول إلى مجاري المياه الهزيلة في باطن الأرض تُحفر قنوات بعمق10 او 13 مترا على طول حواف الحقول.
بعد كل ظهيرة تمر مجموعة من النساء المسنات جداً على الطريق المحاذي لبيتي،على عاتق كل واحدة منهن حمل من الحطب. أجسادهن محنطة بفعل السن والشمس، ويَبدين صغيرات الحجم. يظهر أن المرأة بشكل عام في المجتمعات البدائية تتقلص إلى حجم طفل عندما تبلغ سنا معينا. ففي أحد الأيام مر من أمامي كائن مسن ضعيف لا يتجاوز طوله متر و20 سنتيما وهو يرزح تحت حمل هائل من الحطب. كان الكائن امرأة أوقفتها ودسست في يدها قطعة من فئة 5 فرنكات (أكثر قليلا من ربع بنس). ردت علي بأنة حادة، بدت تقريبا مثل صرخة، تنم عن بعض امتنان وكثير من الدهشة. أظن أن اهتمامي بها بدا من زاوية نظرها انتهاكا تقريبا لقانون من قوانين الطبيعة. لقد قبِلَتْ وضعها كامرأة مسنة، أو بعبارة أخرى كبهيمةً أثقال. فعندما تكون أسرة ما في الطريق مسافرة، تشاهد في غالب الأحيان الأب وابنه الراشد ممتطيين حمارين في المقدمة، بينما امرأة مسنة تتبعهما على الأقدام حاملة المتاع.
الغريب لدى هؤلاء الناس أن العين لا تراهم. فلعدة أسابيع، ودائما في نفس الوقت كل يوم، تمر مجموعة النساء المسنات بمحاذاة بيتي حاملات الحطب. ورغم أن صورتهن انطبعت في بؤبؤ عيني، لا أستطيع الجزم حقا أنني رأيتهن فعلاً. كوم من الحطب فقط كانت تمر أمامي – هكذا كنت أرى المشهد. حدث مرة أن وجدت نفسي ماشيا وراءهن، وقد أثارت حركة حمولة الحطب في صعودها وهبوطها الغريب انتباهي إلى الإنسان الرازح تحتها. ولأول مرة لاحظت الأجساد الضعيفة الملونة بلون الأرض، أجساد اُختزلت إلى عظام وجلود، أجساد حادة الانحناء تحت ثقل الحمولة. حين كنت وطئت أرض المغرب لم تكد تمر خمس دقائق على ما أظن حتى لاحظت على الفور الحمولة الزائدة على ظهور الحمير، وقد أغاضني ذلك الأمر. ما من شك أن الحمير تُعامل بفظاعة. فالحمار المغربي لا يتعدى حجمه بالكاد كلبا من فصيلة سانت برنارد، لكنه يحمل أثقالا تعتبر من منظور الجيش البريطاني ثقيلة جداً حتى على بغل ارتفاعه متر ونصف، كما تظل البردعة في غالب الوقت على ظهره لأسابيع عديدة. وما يثير الشفقة بشكل خاص هو أن الحمار أكثر الكائنات على الأرض طاعة، فهو يتبع سيده مثل كلب دونما حاجة إلى رسن أو قيد، ثم عندما بعد سنين عديدة من الإخلاص في العمل يسقط فجأة ميتاً، يرمي به صاحبه في خندق ما لتنهش كلاب القرية أحشاءه قبل أن تبرد.
مثل هذا الأمر يجعل الدم يغلي في عروقك، في حين أن معاناة البشر بشكل عام لا تسبب ذلك. أنا لست بصدد كتابة تعليق، بل أثير الانتباه فقط إلى حقيقة ما. الأشخاص ذوو البشرة البنية لا تراهم العين تقريبا. يمكن لأي شخص أن يشعر بالأسف لأجل الحمار ذي الظهر المقشور، لكن يتطلب الأمر حادثا ما حتى يتمكن نفس الشخص من ملاحظة المرأة المسنة الرازحة تحت حمولة العيدان.
كانت اللقالق تحلق شمالا، بينما الزنوج متجهون جنوبا – عمود غبار طويل، فرقة مشاة، بطاريات مدفعية جبلية، ثم المزيد من المشاة، أربعة أو خمسة آلاف رجل إجمالا، يسيرون على وقع الأحذية الثقيلة، وجلجلة العجلات الحديدية.
كانوا سنغاليين، أشد الزنوج سمرة في القارة الإفريقية، لدرجة يصعب معها أحيانا التعرف على مبتدأ شعر الرأس لديهم على مستوى الرقبة من شدة سمرتهم. كانت أجسادهم البهية متوارية تحت بدلة « الكاكي» الطويلة، بينما أقدامهم المضغوطة داخل الأحذية الثقيلة تبدو ككتل من الخشب، وكانت كل خوذة معدن يرتدونها تبدو أصغر على رؤوسهم. كان الجو حاراً جداً والرجال وقد قطعوا مسافة طويلة يرزحون تحت ثقل حُزَم العدة، فيما وجوههم السمراء الحساسة بشكل غريب تلمع عرقا.
لدى مرورهم أمامي استدار نحوي شاب زنجي طويل ملفتا نظري. لكن النظرة التي ألقاها إلي لم تكن البتة النظرة التي قد يتوقعها المرء. لم تكن نظرة عدوانية، أو مزدرية، أو عابسة، أو حتى مستطلعة. كانت نظرةً زنجية خجولة وفاغرة، نظرة احترام عميق في الواقع. وقد رأيت ما كانت تعنيه. هذا الشاب البئيس، الذي هو مواطن فرنسي، والذي بسبب ذلك تم سحبه من الغابة لينظف الأرضيات و يُصاب بعدوى الزهري في الحاميات العسكرية، يشعر في الواقع بمشاعر الإجلال تجاه ذوي البشرة البيضاء . لقد لقنوه أن البيض أسياده، وهو لم يتوقف يوما عن تصديق ذلك.
لكن هنالك فكرة واحدة تخطر في بال كل رجل أبيض عندما يرى كتيبة سمراء تمر أمامه ( ولا يهم بتاتا بهذا الخصوص إن كان يعتبر نفسه اشتراكياً) «إلى متى يمكننا الاستمرار في الضحك على ذقون هؤلاء الناس؟ كم يلزم من الوقت قبل أن يوجهوا بنادقهم الوجهة الأخرى؟ «
الأمر غريب حقاً. كانت هذه الفكرة تقبع في مكان ما من عقل كل رجل أبيض. كانت تقبع في عقلي، وعقول كل الناظرين من بعيد إلى المشهد، وعقول الضباط الممتطين صهوات خيولهم المتعرقة، وضباط الصف البيض الماشين بين الصفوف. كان الأمر شبيها بسر نعرفه جميعا، وكنا أذكى من أن نفشيه . فقط الزنوج لم يكونوا يعرفونه. كان مشهد العمود الطويل من الزنوج شبيها تقريبا بقطيع ماشية، مسافة ميل أو ميلين من الرجال المسلحين، صاعدين الطريق في سكينة، فيما الطيور البيضاء الكبيرة تحلق فوقهم في الاتجاه المعاكس ملتمعة مثل قصاصات ورق.
عن العدد الأخير (39) من مجلة «الثقافة المغربية»