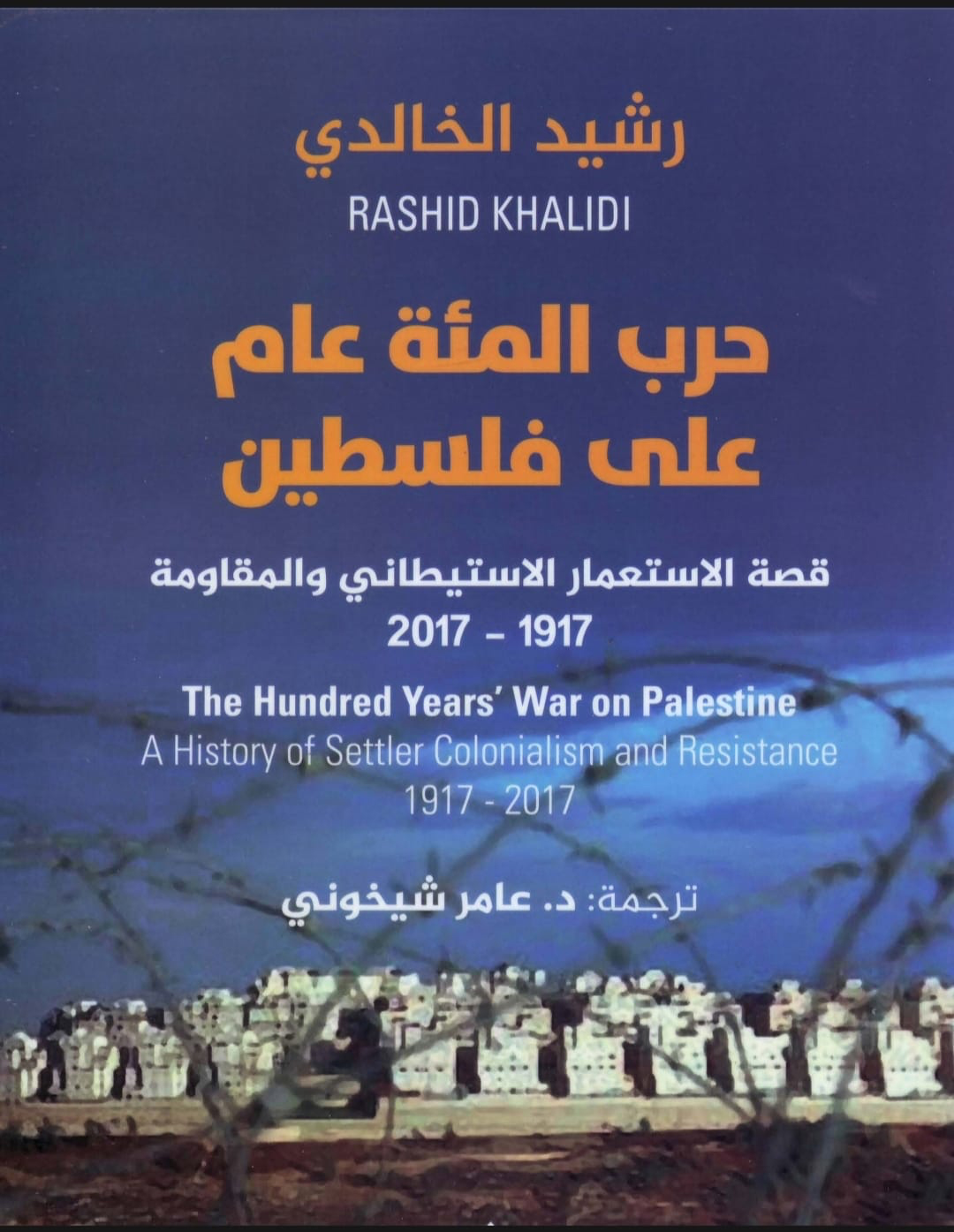هذه الحكاية، حكايتي، أصبحت أيضا حكاية جماعية، عامة ديموقراطية، جمهورية وسياسية، حكاية فرنسية لأنني وزيرة في الجمهورية، وأنني حملت كلمة بلادي، وفي بعض الأحيان تتمثل هذه البلاد في وجهي، لا هي حكاية جميلة ولا سيئة، فقط هي حكاية حقيقية.
بالنسبة لي قبل 39 سنة، الحياة رحلة بدأت في بني شيكر بالمغرب، ولا أعرف تماما كيف هو مسارها، أو بالأحرى أحاول ألا أعرف … بالمقابل، أعرف جيدا لصالح من أعمل كل صباح، كل مساء، في كل مرة أركب الطائرة، أغيب عن عائلتي، أعتذر عن حضور احتفال بنهاية السنة، أو عندما تتصل بي والدتي لتقول لي إنها لم تعد تراني، مؤاخذات حنونة، إنه شيء فظيع.
واليوم لا أعتقد أنه بإمكاني أن أتوقف هنا، أن أقول بأنني كنت ناطقة باسم الحكومة، وزيرة لحقوق النساء، وزيرة للمدينة، للشباب والرياضة، ووزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، بأنني وضعت قوانين ووقعت مراسيم، تلقيت ضربات، تكلمت في البرلمان.. ضحكت من صوري من هفواتي، وبالأخص استمتعت وسط هذا الصخب، وأيضا كوني كنت محبوبة، ولي أصدقاء في كل الظروف، كل هذا صحيح ومثير وقاس، لكن هذه ليست فكرة هذا الكتاب. الفكرة هي أن أتحدث عن فرنسا، عن فرنسا بلدي، فرنسا بلدنا…
عدت إلى البيت نصف صامتة و نصف بطلة، باريسية بعض الشيء بالنسبة لإخوتي وأخواتي الأصغر مني، ثم عادت الحياة إلى طبيعتها، وذات يوم وجدت في صندوق الرسائل ظرفا من ورق جميل بشعار مدرسة بشارع سان غيوم، فتحت الظرف ببطء ثم صرخت، فأسرع الجميع نحوي، لم يعد هناك مجال لشمال أميان، كان الأمر يتعلق بالشانزيليزي ولاكونكورد، لقد نجحت! كانت الورقة ترتعش بين يدي، لا أعتقد أنني عشت لحظات فرح أقوى من تلك اللحظة، لقد تذكرت دائما ذلك الظرف، خصوصا عندما قبلت سنة 2010 العودة إلى مدرسة العلوم السياسية لإلقاء محاضرة افتتاحية مخصصة للاكتشاف السياسي، عندما دخلت الكرسي المركزي في بهو المدخل نظرت للطلبة المتنوعين والمختلفين بعض الشيء عما كان في السابق، نظرت إليهم بحنان، فأي شيء أجمل من أن تستعيد أحد أمكنة طفولتك؟ كان يبدو لي أنني عشت سنوات حزينة بعض الشيء، بعد ذلك توجهت صوب المكتبة حيث كنت أقرأ وأشتغل وأحلم كثيرا، فالمحاربون القدامى لا عمر لهم….
بعد ذلك الصباح خرجت لأتجول في هذا الحي الغني المنضبط الجميل جدا لكي تعيش فيه يوميا، أحببته كثيرا وتذكرت إقامتي الطلابية بشارع سيتو، كما تذكرت أميان وحافلتنا /المكتبة – لا أستطيع تذكر اسم الكتبيين رغم أننا تحدثنا كثيرا…- تذكرت أركاي ووالدي وهو يدخن في المقهى، صعدت شارع سان جيرمان الذي يحتفظ دائما بمفاجئات، لم أكن أتصور أبدا نفسي هنا، فكما تقول أمي دائما:” الحياة أذكى منك ابنتي !”
بالفعل، كان الخيال ضروريا للتفكير بأنه سيكون هناك ذات يوم قانون فالو بلقاسم باسم وزيرة حقوق النساء، (قانون 4 غشت 2014)، فمثل هذا التاريخ لا يبتكر هكذا، ولست بريئة في ذلك، لا أتحدث عن ليلة رهيبة لا، بل عن امتيازات يتعين إسقاطها، نعم، فالتاريخان مرتبطان في نفسي بشكل وثيق، وأقول ذلك بدون عجرفة، لكن بافتخار، ثم أفكر في أمي وفي جداتي و في الفتيات الصغيرات اللواتي كنت ألعب معهن في سن 3 سنوات، واللواتي أتساءل دائما عن مصيرهن، فأي حرية وأي فرصة منحت لهن، أي أفق أعطي لهن ومن طرف من ؟ من طرف الرجال.
إن هذا القانون يحاول دائما ضمان مساواة أكثر بين النساء والرجال، ولاسيما المساواة في الشغل، خاصة من خلال تقاسم عطلة الأبوة لتفادي عرقلة أو تقليص المسار المهني للنساء تلقائيا، ثم أيضا، وبما أن الأطفال هم كذلك قضية الرجال- وهم كثر- فقد فهموا ذلك وتبنوه كحق، وذلك بإلزام المقاولات المرشحة للصفقات العمومية بإقرار مخططها للمساواة المهنية أولا، أي المساواة في الأجور كما في المسار المهني، ليس ذلك كشرط إضافي، بل كاستثمار، ومن خلال تطوير أو فرض المناصفة كلما كان ذلك ضروريا، أما في السياسة بطبيعة الحال، فقد تجلى ذلك بمضاعفة الذعائر المفروضة على الأحزاب التي لا تحترم القاعدة، و كذلك في مجالس الإدارة، وغرف التجارة والسلطات والهيئات الاستشارية والجامعات الرياضية، وفي كل الأحوال، في المجال العمومي ككل ، الرهين بنا وبالتزامنا.
كل هذه القوانين ناقصة، والقانون المكتمل لا وجود له لحسن الحظ، فهل سيكون هذا القانون إنسانيا؟ أو قانونا دكتاتوريا بامتياز؟ إن القانون المكتمل هو الذي يكون واضحا، شاملا، ويصاحب تحولات المجتمع، وفي بعض الأحيان يسرِّع هذه التحولات، وفي مجال المساواة بين الرجل والمرأة بطبيعة الحال، لابد من قوانين أخرى، وفي كل الأحوال فإنك إذا لم تتقدم في هذا المجال فإنك سوف تتراجع، أما بخصوص التطور الهائل للعقليات، صدقوني فهي قناعة امرأة، مدافعة عن حقوق النساء، وابنة وأم، وهي قناعة سياسية أيضا، ومن عاش الزوبعة الإعلامية حول قانون إلغاء الدعارة يعرف ذلك جيدا، ففي بادئ الأمر كانت تلك الافتتاحية التي ألهبت الكل في صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” في يونيو 2012، بخصوص استجواب يتعلق بشيء آخر مغاير تماما، والذي ذكرت فيه بأن اختفاء الدعارة هو السبيل الوحيد الممكن لاحترام حقوق النساء ضحايا هذه الآفة، و كان هذا الانفجار سيؤثر على الآتي.
فمن خلال صورتي المصاحبة للاستجواب بشكل لا أخلاقي، كان فخذاي يظهران فوق حدود اللياقة المقبولة، وكان ذلك بمثابة لكمة قوية في البطن، وانطلاقا من تلك اللحظة بدأ الطوفان، لكن كان لابد من الاستمرار في السير، وبسرعة، كان هناك ذلك الصراخ والحقد والاعتداءات بأكياس دم رماها متظاهرون، وكانت هناك تلك الكلمات الجارحة مثل كلمة: ” putophobe ” معادية للمومسات.
ثم كانت هناك تلك المحاكمات التافهة، وعودة الأخلاقوية البورجوازية أو الدينية، ونداء” salauds 343″ الذي أجج الانقسامات بما فيها الانقسامات داخل حكومة تتلكأ في مساندتي، لم أكن أريد أن أبقى في حدود الكلمات أو المواقع، فبالأحرى التراجع، كان لابد من قانون سيكون مقترح قانون بتواطؤ عدد قليل من البرلمانيين، لقد كان الطريق طويلا وشاقا وكان مآله غير مضمون، لكون الخطوط والتقاطبات اخترقت كل العائلات السياسية، وكانوا يتنبأون لي بأول فشل سياسي كبير، لكن في النهاية حل اليوم الكبير، يوم 4 دجنبر 2013، عندما تمت المصادقة على القانون في الجمعية الوطنية، لكن كان يتعين انتظار سنتين ونصف أخرى ليتم تثبيته نهائيا من طرف البرلمان، وقد كانت مهلة كافية لإقامة محاكمات جديدة: قانون غير فعال،لا يمكن تطبيقه، ساذج، غير واقعي.. لكنه اليوم يعتبر قانونا للجمهورية، ولم يعد يقتصر فقط على تحويل النظر بشكل محتشم عن المأساة، لكنه يعاقب الزبناء الذين وُضعوا أخيرا أمام مسؤولياتهم.. ويصاحب الضحايا في مسلسل الخروج من الدعارة، نعم إنها السياسة، تلك السياسة التي تتوجه لجذور نظام إجرامي يدر 40 مليار دولار سنويا في العالم من خلال المتاجرة في أجساد النساء.