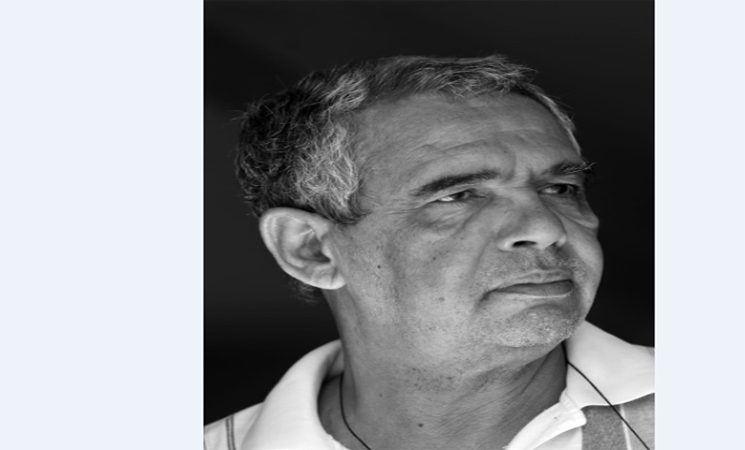«بؤس التعليم يؤدي إلى بؤس الحياة»
العدمية تدرس وعظمة الروح تدرس، ومادام ان العالم العربي من المحيط إلى الخليج يحتقر الفكر، فإنه يمجد الانحطاط ، ولذلك لا وجود لمؤسسات من أجل الثقافة، بل توجد مؤسسات مهنية عبارة عن ملجأ تختفي فيه ثقافة التطرف والانحراف، تزيح بكل حقد المعرفة الفرحة وتحطم نشوة الروح، لأن هدفها إنتاج العدمية باعتبارها شعارا للمرحلة .
من الحكمة أن نعترف بأن العدمية تبدأ حين يجتهد زعماء الأمة بإضفاء على كل ما يحدث معنى ليس منه في شيء، أي مغاير له بالحد والوجود، ولا يمكن للغاية من وراء ذلك أن تتحد مع فقدان الشجاعة وانحطاط الإرادة، ففقدان الإرادة يؤدي حتما إلى ضعف قوة الروح، حيث تصبح كالباب يتحكم فيه الداخل والخارج .
هكذا تصبح العدمية «هي الألم المعنوي الذي تسببه «دون جدوى « هذه هي اللايقين، قلة الفرص المتاحة لاستعادة القوة بأي شكل كان .للإطمئنان على أي شيء كان، هي خجل المرء من نفسه «. وبهذا المعنى يكون نيتشيه قد حدد ماهية العدمية بأنها خدع الإنسان لنفسه على امتداد الزمن «فسبب العدمية هي خيبة الأمل في وجود هدف، ذلك أن فقدان الهدف يجعل الإنسان الضعيف في متناول الكهنة والمشعوذين إلى درجة أنه يظهر بمظهر العبد الخاضع لإرادة السيد، لكن مع ذلك نتساءل، هل للعدمية نهاية ؟ هل يمكن علاجها بدون تربية وتعليم وثقافة ؟ ألا تكون الفلسفة هي الدواء الأعظم لشفاء الروح من العدمية ؟
إذا كانت العدمية، ما نشاهده عندنا في الواقع هي دفع الإنسان إلى الاعتقاد بفقدان قيمته، مما يجعله يحتقر نفسه، ويصاب بفساد ذوقه للحياة ،ولذلك يلتجئ إلى تلك الطقوس والشطحات الصوفية والمبالغة في العبادات من خلال التدين الشعبي الذي يتحكم فيه الجهال، وزيارة الأضرحة والتماس بركة الأولياء ومغازلة الحجر، وعشق اليأس، فإن مرض الذهان ينتشر بسرعة في الأوساط الشعبية كبداية للعدمية .
لم يعد الإنسان المريض بالعدمية يتحمل العيش في هذا العالم، بل يريد نفيه بكلمة «ما جدوى «وأن كل شيء مزيف، هكذا يقوم بسجن الكينونة في مفهوم اللاقيمة، ويسعى إلى تقديس الموت من خلال الاحتفال بالموتى وشراء أفخر الأثواب ووضعها على قبور الأولياء «كسوة مولاي إدريس مثلا « وقد شاهدت هذا في فاس، هكذا يزدهر مهرجان الثقافة الصوفية الذي يروج للعدمية، وقد يكون زعيم هذا التوجه متورط في العدمية ولذلك يدافع عنها .
من المستحيل انتشار التنوير في هذا الفضاء المعتم والذي يسوده الظلام، مما يصعب استعادة الحق في الوجود لمقولات العقل ومنحها الحرية لكي تواجه مقولات العدمية، ولعل هذا التفكير في كينونة العدمية وإقحامها في براديغم القرون الوسطى الذي يحل كا أزماته بالتراث، ولعل هذا ما قاد الروح إلى الابتعاد عن تلك المناطق المضيئة في المعرفة، وجعلها عمياء، لا ترى الفكر العلمي والفلسفي، هكذا حرمت من عقل الأنوار، وستتوج بوسام العدمية، ويصبح الرجوع إلى الوراء شعارها .
مهما يكن من أمر، فإن العدمية قامت بعزل الإسلام عن التاريخ العام للأديان والثقافات والحضارات، مما عجل بالإعلان عن أفول الإنسان، وبأفوله تموت الأمة، وهذا ما يريده زعماء اللاهوت الذين حولوا الدين إلى سياسة عدمية للاسترزاق هدفها الحرب المقدسة حتى نهاية العالم، ولكم مثال الراهن هنا وهناك .
والأمل الوحيد « لا ينبغي الهروب من الفلسفة وإنما الهجوم حتى لا تصيبنا اللعنة، إذ على الإنسان الإنساني أن يتعلم كثيرا من أجل أن يعيش بدلا من أن يصارع محبة في البقاء ….فإقصاء الفلسفة يؤدي إلى حرمان الروح من لذة الحقيقة والسؤال والفكر العلمي والنظري، أي حرمانها من الحضارة والسعادة . لأن الحكم الجاهز الذي يردده العامة يقول بأن الفلسفة لا قيمة لها قد ورثوه عن النمطيين مرضى الأنفس بالشهوات الحسية .
«بؤس الفكر يؤدي إلى بؤس الحياة»
«ينبغي على الروح أن تعود إلى نفسها،لأن الفكر هو مبدؤها «هيجل
بإمكان الوعي الذاتي أن يمتد في العقل من أجل تحريك الروح نحو تحقيق كمالها في الفكر . وبما أن الفكر هو غاية الوجود، فإن الإنسان يشكل ذلك الرباط الذي يربطهما، لأنه في حقيقته هو ما يجعل من الفكر والوجود نفس الشيء، هكذا تبدأ الحقيقة في اللمعان، وتبدأ الروح في الدهشة، الحقيقة والدهشة طريقان يقودان نحو الفلسفة. فمن خلال الدهشة يستطيع هذا العصر أن يحرك الروح بدلا من الذوبان في الأجساد، الآن الروح تمنح للنفس عظمتها. وبما أن الفلسفة هي عطر الروح فبواسطته تستيقظ من سباتها الدوغمائي، وتتساءل من أكون ؟ وإلى أين أتجه ؟ ولماذا كل هذا الألم ؟ ألا يكون الجهل هو الشر والعلم هو الخير ؟ وهل الألم هو حقيقة الوجود؟
لا يمكن لمعلم الحقيقة أن يعلمها وهو نفسه «يجهلها» ذلك أن العلاقة مع الحقيقة عندما تنهار لا يمكن ترميمها. ويفقدانها يشعر الإنسان وكأن أيامه الجميلة قد سلبت منه، ويصبح قربانا للأوهام، يسير نحو الشهرة الزائفة والمتع الجسدية المؤلمة. بل إنه يقتحم عالم الحمق والطيش « والأحمق هو الذي يريد، ولكنه يريد بخمول وكسل وإرادته تتغير، يرغب في أشياء كثيرة في الوقت نفسه …ولذلك لن ينعم بحياة هادئة ومبتهجة «.
والحال أن بلوغ الحقيقة هو ذاته فن الابتهاج بكمال الروح، حين تنطلق من مبدأ «اعرف نفسك « لأن هذه المعرفة هي الإحساس بذلك الانتقال الانطولوجي الذي لن يتمتع به إلا من خاض تجربة الفرح بالكينونة .
فالحقيقة غذاء للروح، تنمو بواسطتها إلى أن تصير مقاما للمعرفة، باعتبارها تفكيرا مستمرا في الحقيقة، لأن التساؤل عن معنى المعرفة يتحول إلى سؤال عن الطريق المؤدي إلى الحقيقة، وبعبارة أخرى كيف يستطيع الفكر بلوغ شاطئ الحقيقة ؟
هل عندما ينطلق من تلك الروح التي تعرف نفسها ؟ أم بمجرد ما يرغب في تعلم الحقيقة ؟
وبأي ثمن يمكن لهذه الروح التي تجهل ماهيتها بلوغ الحقيقة والتعرف عليها ؟
من أجل معرفة الحقيقة لابد من معرفة ماهية الروح، ومن خلال اعرف نفسك، تتم العودة إلى منبع الفكر، لأن الذي يجهل نفسه يظل محروما من الفكر، ولذلك فإن العلاقة بيت الذات والحقيقة تراهن على الاهتمام بالنفس. «انني فخور جدا بالحياة التي عشتها، يصرخ سقراط في وجه القضاة، حتى اذا ما حصلت على البراءة لن اتغير .. فلن اتوقف على التفلسف»؟1افلاطون، محاكمة سقراط، الأعمال الكاملة بالفرنسية.
فمعرفة الذات هي المدخل إلى الوعي. بل ومبدأ الحقيقة، ذلك أن الذات لكي تقترب من الحقيقة لا بد أن تؤدي الثمن، أي أن تصبح شيئا مغايرا لذاتها يخترقها التحول في كينونتها، من خلال المعرفة والزهد والتأمل، ومن أجل بناء الذات لذاتها « أعتقد أن الحب والزهد هما الشكلان الكبيران اللذان بواسطتهما تتحول الذات، بحيث تصبح قادرة على بلوغ الحقيقة «2فوكو،تأويل الذات ، دار الطليعة . فالحقيقة هي ما يعطي الذات غبطتها وينير كينونتها. لكن من الحكمة أن نتساءل، ما هي الحقيقة التي تريدها الفلسفة باي ثمن ؟هل هي الرؤية في أبعد معاني الرؤية ؟ أم هي الموجود حين ينكشف في ضوء الوجود؟ بل أكثر من ذلك، من أي مدخل إذن إن لم يكن من مدخل الفلسفة ينبغي لنا أن نفكر في جوهر الحقيقة ؟
يعترف هايدغربصعوبة الإجابة عن هذا التساؤل، وبخاصة وأن الفلسفة لم تحسم في هذا الالتباس بين الحقيقة واللاحقيقة.
«مادام أن ميدان الحقيقة الأصلي لم يتم الكشف عنه إلى حد الآن، بمعنى الخفاء الذي تنتمي إليه «1هايدغر، أصل العمل الفني ، دار الجمل ،ص 127،ولذلك فإن الحقيقة اختارت الإقامة في التضاد الموجود بين «البقعة المضاءة والإخفاء المضاعف «، بل لقد أصبح جوهرها هو النزاع القائم بين الضوء والعتمة مما حرمها من الوجود في الكشف، وبما أن كشف الموجود ينتمي إلى الوجود نفسه، فإنه في جوهره يتم الانفتاح على تلك البقعة المضاءة بداخله، ههنا تختبئ الحقيقة، ولذلك يتعين على الفيلسوف يبحث عن معنى هذا الجدل بين البقعة المضاءة والعتمة، لكي يضع نفسه بالقرب من الحقيقة. وهكذا ستقوم الحقيقة بإنجاز مشروع إقامتها في الموجود الذي سيتحول إلى جوهرها .
مهما يكن من أمر هذا الغموض الذي أضحى يخيم على هذا المدخل، فإن طبيعة البحث عن الحقيقة تحدد ماهية المعرفة، والفيلسوف هو القادر على هذه المعرفة، لا لأنه مؤسس الفلسفة فقط، بل لأن إقامته الشاعرية لا تكون سوى في جدل الفكر والعقل، إنه المفكر والحكيم والفاضل، وكلها شروط تقود الذات إلى معرفة الحقيقة إذ «لا يجب أن تكون مجنونا حتى تعرف الحقيقة «حسب ديكارت، بل ينبغي أن تكون عاقلا تدرس وتتعلم المعرفة، لأن الحقيقة هي مكافأة المعرفة على العمل العميق الذي تقوم به الذات، لأنها تسعى إلى الكمال، ولن تجد سوى الحقيقة من أجل إنقاذ ذاتها .
وبما أن فيلسوف الأعماق هو المنقب الجيد عن الحقيقة، فإن قدره قد يكون حزينا حين يختطفه ليل الجنون ويسكنه عتماته ثم يبحث عن نفسه في شفق الأصيل مرددا « مجنون بيدي، عارف نفسي، ما أحسست أبدا بالأمان الحلو أقرب إلي ولا بنظرة الشمس أدفأ عندي، ها هو قاربي يسبح بعيدا «1نيتشيه،كتابات ما بعد الوفاة، مدرسة الحكمة .فمن يكون هذا المجنون التائه ؟وهل سيمنحه ديكارت الحق في الحقيقة؟ وهل إن عظمة نيتشه تكمن في جنونه ؟ وما علاقة الجنون بالعباقرة ؟
بمجرد ما يتعرف الفيلسوف على عبقريته ويبتهج بروحه الناعمة، بمجرد ما يجد نفسه محاصرا بحراس العدمية، حين يحس برعشة جنون العباقرة عندما تطرق أقدامه أرضا جاهلة»آه ياإخواتي إن من يكون عبقريا يكون هو الضحية دائما «1نيتشه ، المصدر نفسه ،ص 208وبخاصة وأن عاشق الحقيقة لايكون مولعا بالأقنعة، لأنه يتكلم على لسان الحكمة، والحكمة تعلم الحقيقة، وإرادة القوة والشوق العظيم، وكل هذه المفاهيم الميتافيزيقية لا يعرفها إلا من يكابدها. ذلك أن الشوق يتجرد عن المحسوسات ولا يعتمد العين أو اليد، بل إنه يسعى إلى معانقة الحنين «آه يانفسي لقد علمتك أن تقولي اليوم كما علمتك أن تقولي قديما وفي عهد مضى وأن ترقصي فوق كل ما هو هنا وهناك»1هكذا تكلم زارادشت.
بما أن هذه الحرية المطلقة لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها سوى الفيلسوف، باعتباره مؤسسا للفلسفة ومكتشفا للحقيقة ومبدعا للفرح بالكينونة، فإنه أصبح يحتقر أخلاق العبيد الذين فقدوا ملكة العقل، ونعمة النسيان وعظمت في أرواحهم الرغبة في الانتقام والحقد والكراهية، ولذلك يجتمع شوق الفيلسوف كله في شوق عظيم يسعى من خلاله إلى تخليص نفسه من الطاعة العمياء والخضوع «آه يانفسي لقد خلصتك من كل خضوع وركوع وقول ياسيدي، لقد سميتك تحول الضرورة والقدر».
ثمة حكمة قديمة تقول إن أجراس السماء لن يسمعها إلا الحكماء الذين اختاروا إقامتهم الشعرية على الأرض والسكن في الحقيقة، أما أولئك العبيد الذين أرادوا تطويق الحقيقة ووضعها موضع سؤال ضد الحقيقة فلن يسمعوا نداءها، بل إنهم يرثون الحقيقة جاهزة .هكذا تكون أرواحهم مثقلة بشوق الانتقال إلى العالم الآخر، لأن العبودية حطمت فيهم إرادة الحياة .ولم تعد أعينهم ترى لمعان نور الحقيقة في الغسق، لكن أين يشع ضوء الحقيقة ؟ومن أين يمكن استحضار حميميتها ؟ ولماذا لم يسمع العقل العربي نداءها إلى حد الآن ؟ وبأي معنى يصبح الفيلسوف هو الناطق الرسمي باسم الحقيقة ؟ أفليس من العار أن لا تسمع هذه الأمة نداء الحقيقة مع العلم أن كل الأمم التي لبت نداءها حققت عظمتها في الثورات العلمية؟
والحال أن الإنسان بدون ملكة العقل لن يستطيع أن يسمع نداء الحقيقة، ولذلك سيظل غريبا في هذا العالم .وبما أن الغريب يكون بطبيعته مزعجا ولا أحد يرغب في الاقتراب منه، فإنه سيصبح مجرد لاجئ مضطهد، لايسمح له بالدخول إلى أرض الحقيقة، مادام أنه يؤمن بالنزعة العدمية، ويسعى إلى نشرها ولو كان بالإرهاب، فالعدمية سجن للروح، لا تتركها تغادر عتمات اللاوجود، لأنها تخشى الوجود، وتكره الفرح بالكينونة والابتهاج بالحياة.
إذا كانت الحقيقة هي هدف الفلسفة، فإن الفيلسوف لا هدف له غير هذا الهدف، بل لم يعد يسمع سوى هذا النداء الذي يناديه منذ أمد بعيد، وبواسطته ستصبح كينونته شاعرية بالماهية، مما يجعلها تترك للقرب الجوهري للأشياء يهاجمها، ذلك أن الكينونة هي هبة الوجود للحقيقة، وبلغة الشاعر هولدرلين الذي يقول « وقديما كنت أطير نشوة بسبب حقيقة جديدة أو رؤية أفضل لما هو فوقنا ومن حولنا «،لكن نور الحقيقة الباهر حين زاد عن حده اأقى بالشاعر في الظلام وليل الجنون، فهل هناك نعمة أخطر من نعمة الحقيقة؟ومن يستطيع أن يتحمل دهشتها غير الفيلسوف ؟ومتى يتم الرحيل إلى شاطئ الحقيقة، وعلى أي مركب ستتم هذه الرحلة الاستكشافية إذا كان مركب العقل محطما ؟
قد يكون قدر هذا الكتاب هو التيه بين لحظة الحقيقة ولحظة الزيف، وبإمكان التيه أن يقضي على كل هدف يتناقض مع مشيئته، ذلك أن التيه يستهلك وجود الفيلسوف أكثر مما فعلته هذه الأمة، ويحكم عليه بفقدان إرادة الارادة ، وبخاصة وأن إرادة القوة تسيطر على مأساة الوجود بواسطة نشوة الفرح بالحقيقة ،وبهجة الجمال ،ففقدان الحقيقة ينتج عن عدم الإحساس بدهشة الوجود، يقول نيتشيه.
«فاليوناني كان يعرف ويشعر بمأساة الوجود، ومن أجل أن يتعايش معها ،كان لا بد أن يواجهها بتلك الأحلام اللذيذة لديونيزوس»فشاعرية الوجود بإمكانها رسم ألوان جديدة لحياة الموجود، والإنسان هو أعظم الموجودات ، ولذلك لاينبغي للمأساة أن تتحول إلى حقيقته، لكن ماذا يعني ترميم حقيقة الوجود المأساوية بتلك الأحلام اللذيذة ؟ ألا يكون اللعب بالحقيقة خطرا على ماهيتها ؟ ألم يكن العقل العربي المكبل بالسلاسل ضحية هذا الخطر؟
ومع ذلك ينبغي أن نقول في طريق التيه نتعلم صناعة الفكر، لأن التيه حسب هايدغر هو ماهية الفكر، حيث يتساءل قائلا»من أين نستمد ملكة الفكر، بل كيف استطاع أفلاطون أن يجد حقيقة الفكر في الوجود والوجود في المثل ؟وكيف استطاع كانط أن يجعل من المتعالي ماهية العقل الخالص؟»وبعبارة أخرى أنه إذا كان العقل لا يجد حقيقته إلا في الفكر فإن الفكر لايعثر على حقيقته إلا في الوجود، وبما أن هذه الامة قد ألغت الوجود بمرسوم حكومي فإنها تخلت عن العقل المفكر بإرادتها.
هكذا فقدت ملكة الفكر عندما أصبحت تلعب بورقة الحقيقة منذ الغزالي الذي ضحى بالأمة من أجل متعته الذاتية . لم يعد الفكر يتمتع بالحرية لكي يختار إقامته في الوجود . مادام أن التيار العدمي فرض عليه إقامة إجبارية خارج الوجود.ومن العبث أن يحرم الفكر من الحرية وبخاصة وأن العقل يموت بحرمانه من الفكر، لأنه في قلب جدل العقل والوجود يشرع الفكر في التفكير في الوجود»فالوجود ينتج الفكر «بلغة هيجل،وكلما أبعد عنه يتوقف ويتحول من ملكة إلى انعدام الملكة.
ثمة برهان على أن تطور الفكر الفلسفي قد بدأ مع ظهور التنظير البرهاني للوجود عندما دشنه بارميند في اللحظة التي اختار طريق الوجود وابتعد عن طريق اللاوجود .والفكر العربي فعل العكس حين اختار طريق اللاوجود ،مما حكم عليه بفقدان أداة الإنتاج وأجبر الفكر على الإقامة الأبدية في سجن العدم .وإلا ما معنى هذا الاعتزاز بالإقامة الناعمة في العدم ؟ولماذا اللاوجود بدلا من الوجود ؟بل أكثر من ذلك ،إلى متى سيظل الفكر العربي مسجونا في سجن العدم ومحروما من البحث في الوجود باسم التدين الشعبي؟وكيف يمكن بناء نهضة فكرية بعقل غير ناهض؟
ينبغي على الفلسفة أن تحقق ذاتها في الإنسان الممزق الكينونة، وتعمل على تأزيمه من أجل أن يتحرك نحو كماله، الذي يوجد في تحرير العقل من أوهامه، فالهدف الذي ننشد هو هدف انطولوجي و معرفي، لأننا نسعى إلى ربط العقل بالفكر والفكر بالوجود ، ولذلك كنا نبدأ من مقدمات ثم نستخلص منها بعض النتائج التي تساعدنا على النظر إلى العقل في تجلياته السياسية والمعرفية والمجتمعية، وبما أن جدل العقل والتنوير لم يتوقف عند حدود محاكمة العقل العربي على عصيانه المدني وتحريضه على مقاومة التنوير، بل تجاوزنا ذلك إلى تفكيك بنية هذا العقل ، والتعرف على هويته ، ولذلك تساءلنا عما إذا كانت ولادته مجهضة، أم أن تربيته التيولوجية قد حكمت عليه بالضياع في الأوهام والخرافات المقدسة، وبعبارة أخرى، لماذا تأخر العقل العربي وتقدم العقل الغربي ؟ هل لأنه أدار ظهره للفلسفة والعلم ؟ أم لأنه سقط في هوة التراث ولم يستطع الخروج منها ؟ وما الذي حكم عليه بالسبات الدوغمائي؟ وهل يستطيع أن يتعرف على نفسه خارج أوهامه ؟ وكيف انتقل من أوهام واقعية إلى أوهام وهمية؟
(*) أستاذ الفلسفة و الفكر المعاصر بجامعة الرباط