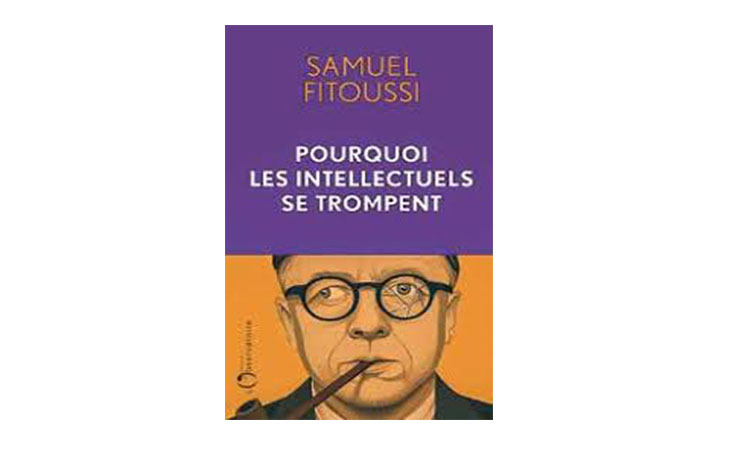للثلاثي المخدوش «الأدب/الفكر والحب والجنون» أصله في تاريخ البشرية منذ البدايات الأولى لفعل الكتابة والتعبير بها عن المشاعر الإنسانية. وهو ثلاثي مخدوش في نظرنا، لأن فعل الاحتكاك بين العناصر المكونة له يولِّد هذا الخدش، الذي يبقى بصمة في تاريخ من كان من حظه الدوران حول فلكه إلى حد الجنون في بعض الأحيان. وإذا كانت الأمثلة كثيرة ومتنوعة في هذا الإطار، فإننا سنقتصر على عينة خاصة تاريخيا (العصر الحديث) وجغرافيا (ضفتي المتوسط).
يقدم لنا تاريخ الأدب الغربي الحديث نماذج كثيرة، لربما أبرزها وأشهرها قصة إيلينا ديماكونوفا التي كانت تتهيأ للاقتران بالإسباني سلفادور دالي لتهيم في حب الشاعر الفرنسي إيلوار، الذي تزوج أخرى. وانتهى الأمر بها بقبولها الزواج من دالي، على الرغم من بقاء إيلوار حبها الحقيقي، على الرغم من إن دالي كان يكن لها حبا تغنى به في لوحاته، بل هناك البعض منها وقعها باسميهما معا.
احتفظت ذاكرة التاريخ الفلسفي والأدبي الغربي بوجه آخر أشعل النار وأطلق البارود والكبريت على أكثر من مفكر وشاعر، ويتعلق الأمر بـ «الجنية» اندريس لو سالومي التي «دوخت» على الأقل ثلاثة عمالقة هم على التوالي نيتشه والشاعر ماريا ريلكه وفرويد. لكنها بدورها تركتهم لتتزوج بالموسيقي ريتشارد فاغنر. ولربما كان هذا ما وتر علاقة هذا الأخير بنيتشه، الذي كتب بحسرة وحزن وهو مجروح ملكوم++++: «دخل طائر سماء غرامي واختطف الكائن الذي أحببت. لكن ذلك الطائر المدعو فاغنر، لم يكن نسراً … وفي هذا عزائي». نفس الشيء حدث للويس أراغون وإلزا، تماما كما «قنبل» الوجود العاطفي لهيدجر وهانا أرينت.
كما نعثر في الأدب العربي المعاصر على أمثلة لا تقل أهمية عن نظيرتها في أوروبا. فقد نشرت غادة السمان في تسعينيات القرن الماضي رسائل الحب التي تلقتها من غسان كنفاني، ولم تنشر، لحاجة في نفس يعقوب، الرسائل التي بعثت له بها. والظاهر أن حبا جما ربطهما، أو على الأقل هذا ما نفهمه عندما يخاطبها كنفاني: «إنني على عتبة جنون، ولكني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودك معي جنون آخر له طعم اللذة».
تبقى مي زيادة قصة قائمة بذاتها في ميدان الثلاثي المخدوش، فالصالون الأدبي الذي كانت تُديره وتدعو له من أثرتهم على باقي الأدباء، كان أيضا ورشة «لاقتناء» أو تدجين أو اختبار المحبين، ممن «تهافتوا» عليها: أحمد لطفي السيد، ولي الدين أحد، مصطفى صادق الرافعي، وجبران خليل جبران، حتى وإن لم يكن من زوار الصالون لتواجده في أمريكا.
غرضنا هنا ليس هو الاستفاضة في حكاية هذه الغراميات، ولربما التمتع برومانسيتها، على الرغم من التراجيديا التي تلفها، بل محاولة فهم بعض أسئلة نيتشه المتعلقة بالموضوع: «ما مصدر العواطف المفاجئة، الجياشة، الحميمية، التي يبديها رجل لامرأة؟ إن الشبقية وحدها لا تشكل منها سوى السبب الأدنى، ولكن حين يجد الرجل الضعف، الحاجة إلى المساعدة، والزهو مجتمعة في امرأة واحدة فإن شيئًا يجري في كيانه وكأن روحه تكاد تطفح: يجد نفسه مذهولًا ومهانًا في ذات اللحظة، عندما ينبثق نبع الحب الكبير» (نيتشه، «إنسان مفرط في إنسانيته»). غرضنا أيضا ليس هو التأصيل لمفهوم الحب ومحاولة سبر أغواره، بل محاولة فهم سبب أو أسباب هذه التبعية «الأزلية» للرجل في علاقته مع المرأة، بمجرد ما تدخل هذه «المتغيرة/الحب» بينهما.
للإشارة، فإن كل الأمثلة التي سقناها أعلاه تمشي في نفس الطريق المستقيم: أي أن الرجال «يسقطون» في غرام نساء «تقفن» في الوجود والحياة على أرجلهن، في حين يدفع هذا الشعور «المهبول» الرجال إلى الهذيان والارتماء لتقبيل أرجل النساء، وفي حالات معينة إلى الجنون. ألا تَحُولنا مثل هذه العلاقات إلى العلاقة الأصلية في قصة الخلق للديانات السماوية الثلاثة؟ ألا ينطبق ما قاله نيتشه في النص السابق على آدم كذلك؟ كان آدم سيد الجنة، رمز الحياة الأزلية دون شجون ولا مشاكل؛ لكن بمجرد ظهور حواء أصبح ما هو عليه إلى اليوم. ألم يجد آدم نفسه «مذهولا ومُهانا» في نفس الوقت عندما أُمر من طرف حواء بالأكل من الشجرة؟ ألا تنقلب علاقة السيطرة بين الرجل والمرأة، بمجرد ما تصل سهام حبها لقلبه؟ ولماذا يحدث هذا القَلبُ في العلاقة، حتى مع من يعتقد المرء أنهم كانوا أسياد عقولهم وأرواحهم (فرويد، هيدجر) مثلا؟ هل هناك شيء يُفهم في مثل هذه الأمور، خارجا عن نطاق الفهم المُعتاد؟
إذا تهنا في مادة موضوعنا وتعمقنا أكثر، لربما لن تنقطع الأسئلة، لأنها تتناسل بسرعة فائقة تفوق حتى ما يمكن للعقل التكهن به. ومع ذلك يبقى سؤال معين مهما: بأية «نية مبيتة» يحب الرجل والمرأة؟ لا نبحث هنا عن الجذور النفسية الانفعالية لهذا الأمر، بقدر ما نُحاول «خدش» علاقة أصيلة أخرى بينهما: مصيدة الصياد والطريدة. ألا تعطينا الأمثلة السابقة انطباعا على أن المرأة، وهي تشعر بدورها كطريدة، سرعان ما «تُتْلِف» خيوط اللعبة، ليصبح الرجل طريدة، في الوقت الذي يحتفظ فيه بوهم كونه الصياد؟ ألا تعتبر هذه العلاقة نموذج العلاقة الأصيلة بينهما؟
خاطب هيدجر هانا أرينت في أول رسالة له: «لن أستطيع امتلاكك أبدا، لكنّك ستنتمين منذ الآن إلى حياتي» (رسائل حنة ارندت ومارتن هيدغر 1925-1975). لربما هذا هو عمق العلاقة الغرامية بين الرجل والمرأة، ذلك أن كلمات هيدجر توحي بأنه كان على وعي، قليل أو كبير، بطبيعة الرجل الامتلاكية. وهذا بالضبط ما يقلب لعبة الصياد والطريدة بينهما لصالح المرأة، لأنها «تعرف» بأن رغبة الرجل تفوق «الجنس»، لأنه يريدها أن تكون ملكا له؛ ومن ثم نوبات الغيرة المفرطة والهذيان أو لربما أيضا إظهار العضلات والعنف عند الكثير من الرجال. والعلاقة الحقيقية بينهما، هي علاقة هوية وانتماء لبعضهما البعض، أي تجاوز صريح لمبدأ الامتلاك: «لماذا يكون الحبّ فوق طاقة كل الإمكانيات الإنسانية الأخرى ويكون ثقلاً حلواً بالنسبة إلى المحبّ؟ لأنّنا نتحوّل إلى ما نحبّه، لكننا نبقى نحن أنفسنا. ذلك أنّنا نريد أن نشكر من نحب، لكن لا نجد أي شيء كاف لهذا الشكر» (هيدجر، نفس الإحالة السابقة). هذه هي قمة علاقة حب إنسانية متوازنة بين الطرفين. ولكلمة الشكر هنا معناها وأهميتها، فالحب بهذا المعنى هو نوع من الشكر، شكر الآخر على قبول «الدعوة»، بل جعلها هوية مشتركة، لشخصين حرين في قراراتهما. والدعوة هي «حضور»، فيزيقي أو رمزي للآخر: «ذلك إنّ حضور الآخر الذي يدخل حياتنا هو أمر لا يمكن لأيّة روح السيطرة عليه. فالقدر الإنساني يعطي قدراً إنسانياً، ومسؤولية الحب الحقيقي هي السهر على يقظة هذا ووهْبُ الذات كما كان في اليوم الأول» (هيدجر، نفس الإحالة). والحضور هنا ليس حضورا فيزيقيا مرتبطا بمكان ما، بل هو حضور زمانيا. ويفترض الحضور الغياب، وفي هذا الغياب حضور، لأننا حررنا هذا الأخير من شرط المكان. وإذا لم يكن الاثنان حاضرين في الغياب، فإن الهوية المشتركة والاستقلال المتبادل سيُنهكان.
ما يحمي الحب هو ما يحمي الفلسفة أيضا، أي جرعة كافية من الوحدة، ولا تؤثر هذه الأخيرة في الحضور السالف الذكر للآخر. والوحدة ليست سلبية، لأنها في الفلسفة، كما في الحب، تكون نشيطة في عالم تأملاتها وتحضيرها للتساؤلات الكبرى. ولهذا كله علاقة بالحرية. تزدهر الفلسفة في أوقات الحرية، وينمو الحب فقط عندما يشعر الإنسان بحرية حقيقية: حرية الحضور في الغياب وعدم الغياب في الحضور. ويتشخص أسمى حضور في الغياب الفيزيقي للآخر في المناجاة، التي تعتبر كلاما يشبه إلى حد ما الصلاة. ففي هذه الأخيرة يكون المُخَاطَب غائبا جسديا، لكنه حاضر «روحيا». من هنا فإن فعل المناجاة هو فعل صلاة، قد يُفضي لإبداع حقيقي في لوحات تشكيلية أو أبيات شعرية، وقد يقود إلى «الجنون»، كأقوى لحظة لحضور الآخر في غيابه.
من الأسئلة التي تشغل دائما المحبين هي لماذا بالضبط هذا الشخص وليس غيره؟ وحتى وإن لم يكن السؤال غير ذي معنى، فإنه يؤكد على أن الحب يظهر في غالب الأحيان عرضيا، يأتي من حيث لا ندري في وقت لا نقرره وفي مكان غالبا لا نحدده. يحدث فجأة، أو هكذا يتهيأ لنا. نلصقه على حائط «القدر» ونعزي سببه إلى قوى غيبية. وعندما يكون هذا الفهم هو الغالب على الحب، تتفشى في المجتمع حيث يُعتقد في هذا مظاهر بدائية، بل «وحشية» متخلفة.
يزعم المرء أنه بالإمكان استحضار الأرواح التي تؤثر سلبا أو إيجابا في جعل شخص يحب أو يكره شخص آخر. والشعوذة من حيث هي ممارسة بدائية في غياب أجوبة شافية على ظاهرة ما، هي ملجأ من لم يفهم بأن الحب هو هدية. و»الشعوذة» في حد ذاتها هي محاولة لتدجين ما لا يُدجَّن، بالرغبة في «تحيينه» وجعله حاضرا. لكن بما أن الحب سيد نفسه، بحريته المطلقة، فإنه إما أن يكون هدية ودعوة يُشكر عليهما أو لا يكون. وإذا كان الحب صدفة، فإنه صدفة ذاته.
يقود الحب «للجنون» عندما لا يُحترم في كنهه الحقيقي ويُعاش كنزعة امتلاكية محضة. ويحدث الجنون الفعلي عندما تختلط الخيوط على المحب «المسيطر» ولا يعرف أهو الصياد أو الطريدة. فالصيد هو محاولة حرمان الآخر من حريته، بل من حياته. وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث في الحب ذي النزعة الامتلاكية. أما الحب الهدية، فإنه -عندما يعاش هكذا- يهدم تمثل العلاقة الغرامية كعلاقة صياد وطريدة، بل يرفضها ليبنيها على الشكر والامتنان لحضور الآخر، حتى في غيابه.
الثلاثي المخدوش

الكاتب : د. حميد لشهب (النمسا)
بتاريخ : 31/01/2020