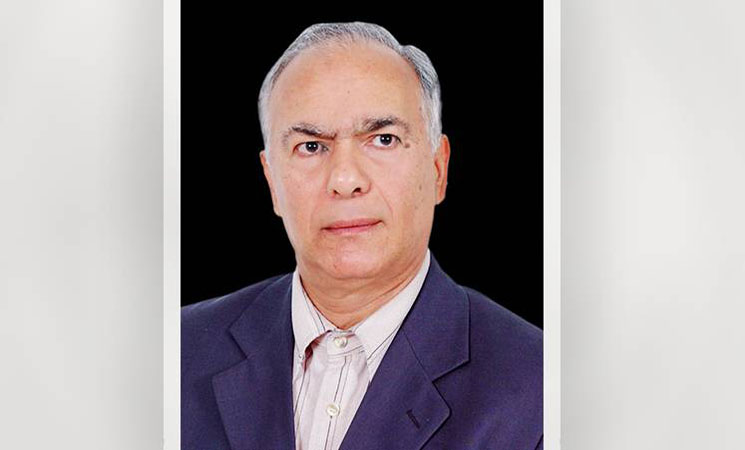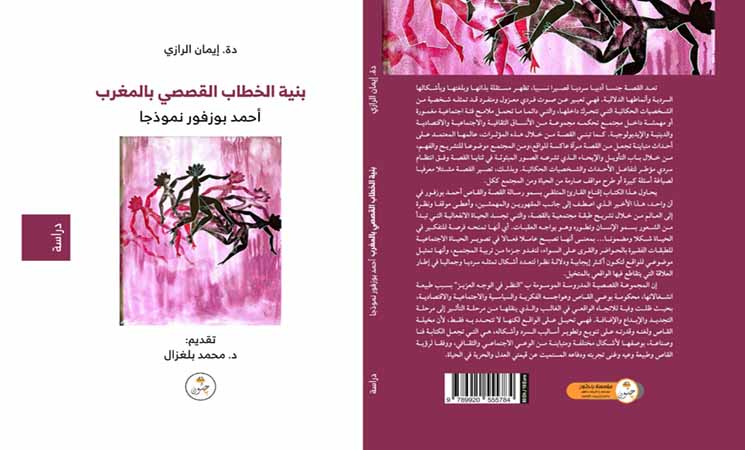تندرج قوانين الكتابة الشعرية، شأنها شان أية ممارس إبداعية، ضمن القوانين الطبيعية لعملية التحويل، التي تخضع لها العناصر على امتداد صيرورتها التفاعلية ، سواء مع أشباهها أو أضدادها، من خلال انزياحاتها المتتالية عن هيئاتها المتعارف عليها، وتقمصها لهيئات جديدة، تكون وسيلتَنا لاكتشاف المضمر فيها وهي على هيئتها الأولى . بمعنى أن عملية التحويل ،لا تنحصر فقط في شِقها التجميلي للعالم، بل تتجاوزه إلى مستوى أعلى، يضعنا في قلب المكونات الأساسية لهوية الشيء، والتي تكون عادة محتجبة عن أنظارنا، وغائبة عن اهتماماتنا، قُبَيْل اندماجها في عمليات تحويلية ، تتحقق بموجبها مهامُ تظْهير ما احتجب منها. وهي مهامٌّ تساهم في بلورة تأويل جديد للكتابة الشعرية، باعتبار أن التظهير هو الوجه الآخر لعملية التعرف والفهم، اللذين نتفاعل بواسطتهما مع العالم ، وليس مجرد بَلْوَرة دلالية لانفعال ظرفي، تجاه مؤثر ما ،من المؤثرات الداخلية أو الخارجية، بمعنى أن التظهير هو ترجمةٌ عمليةٌ لمعرفتنا بخصوصية الشيء، ضمن ما ينسجه من علاقات تفاعلية مع باقي العناصر المجاورة والمحايثة له ودور الشعر ،هو التأكيد على أن تقييمنا و حكمنا على ظاهرة معطاةٍ من ظواهر الكون ، يظل مقترنا بسياق ما، بوضعيةٍ، و بشرط معين من الشروط الفكرية و الحياتية ،التي توجد عليها الذات، خاصة و أن الشيء يظل باستمرار في حاجة إلى المساءلة، وإلى الفهم والتفسير، بمختلف أنماط القول ، وخاصة منها القول المجازي المتميز باشتغاله في قلب تلك الهوامش المؤجلة ،فما نتوهم أننا أدركناه بشكل تام وكامل ،ليس في الواقع سوى النزر القليل من دلالةٍ كُلِّية وشمولية ، تظل نسبةٌ كبيرةٌ منها غائبة عن إدراكنا ، وبحاجة مستمرة إلى عمليات تحويلية على المستوى المجازي ،كي تبوح بما هو مضمر في تضاعيفها ،خاصة وأن مكونات الشيء، لا تتوقف عن تجديد دلالاتها وأبعادها ،انسجاما مع تجدد وتعدد سياقاتها ،لذلك فإن الشعر لا يفتأ يذكرنا بأن حدود فهم الشيء تظل غير ثابتة ، وغير نهائية ، باعتبار أن الالتباس هو الخاصية الأصلية للكون، والذي قد يرتفع في حالة ما إذا تحقق وعيٌ فكريٌّ وجماليٌّ ،قوامه انزياحاتُ دلاليةٌ موجَّهةٌ من قِبل اللغة الشعرية، وهي لغة تتيح للقراءة إمكانية اكتشاف بنيات نظمية جديدة ،تساهم في إنتاج دلالات مغايرة، انسجاما مع الدور المنوط بالكائن، والمجسد في واجب ومتعةِ تجْلِيَتِه لما يكتنف الظاهر من غموضٍ والتباس، في أفق توافر شرط تعَرُّفٍ يتيح له إمكانية رسْم مسارات آمنة، في مجاهل أسفاره الجسدية و الروحية ،ربما كَرَدِّ فعلٍ منه على الحضور الجارفِ والعنيف لسطوة النهايات، التي تترصده في خضم استسلامه لغوايات وإكراهات اليومي . ثم إن رد الفعل هذا، لا يتحقق إلا من خلال فهم ما يحدث ،أو ما يمكن أن يحدث ،أي من خلال رفْع الغموض المستبد بعنف وهشاشة العناصر، ومهما تعددت مسارات الكشف والاستغوار والتأويل، فإنها لن تستغني عن الآفاق المستشرفَة من قبل الكتابة الشعرية، المتميزة بخصوصيةٍ لا يمكن تعميمها على غيرها من الأنواع الإبداعية والفنية، بما يعني أن وظيفة الشعر، ومن خلال ما يقدمه من إضاءات تحويلية للغامض والملتبس، تتمثل في توسيع دائرة السؤال، المفضية بدورها إلى توسيع دائرة الواضح، وهو ما يُفسح المجال لاشتغال رمزيةِ إيقاعاتٍ مجازيةٍ، متميزة بمُسحتها الجمالية وعمقها الإنساني، فالمسالك العملية التي تفتحها التقنية الحديثة المعززة بالعلم التجريبي، تظل في أمس الحاجة إلى حضور الروح الإنسانية، المعرضة دوما إلى التهميش، بفعل تفاقم العنف التقني وشراسة نوايا التجريب العلمي، المؤديين لا محالة إلى استشراء حضور كائنات آلية لا روح في أجسادها. وهي الكائنات التي تشتغل بوحشية عقلٍ تجريبيٍّ وافتراضي، تتمثل خصائصه في اختراقه العنيد لكل الحدود التي لا تكف الاستحالة عن وضعها في طريقه. وفي هذا السياق، يمكن إثارة إشكالِ الاستراتيجية المتشعبة الأبعاد، الموظفة في حركية الكتابة، مع التذكير بأننا هنا غيرمعنيين بتاتا بتلك الكتابة الساذجة، المنجزة في صيغةِ استجابةٍ عاطفيةٍ وانفعاليةٍ ،لِحدَثٍ شخصي أو جماعي، أو بتلك الكتابة المُدَّعِيَّة، الناتجة عن رغبة مجانية في الانتماء إلى الشعر.و ما نعنيه بالاستراتيجية المتشعبة ،هي مجموع ما توظفه الكتابة من خبرات تقنية وجمالية، بقوة ما تمتلكه من كفايات نظرية وفكرية، وأدوات تعبيرية ،تكون دليلََها إلى القول الشعري، فضلا عن تمثُّل الحالة الجديرة بالانتقاءـ وبالتأطير الشعري . ضمن هذا الاختيار، تكون الذات الشاعرة في وضعية استنفار، قد يطول أمده ،أو يقصر، بفعل اقترانه بمحفزات معينة، ذات طبيعة جسدية، انفعالية أو فكرية، يكون لها دورها المباشر في إطلاق شرارة الكتابة، وفي إنضاج شروط القول، حيث يتضح بجلاء، تأثير شرط اللحظة، أو بتعبير آخر، شرط الصدفة، المشوب بحالة مزمنة من التربص والترقب ،تحسُّبا من احتمال غياب هسيس القصيدة، إما بفعل جفاف مباغت في منابع الرغبة، وخلل لا متوقع في الرؤية، أو تيَبُّسٍ قاسٍ في حنجرة القول. وهي بعض عوامل اقتران تجارب إبداعية كبيرة، بطقوس المنشطات، على خلفية هاجس التخفيف من ضراوة ارتطامها بحاجز العيِّ ،و حرقة الحبسة.
عموما، و ضمن هذا الإطار، تبدو الكتابة وهي تتلمس طريقها إلى مجهولها ،شبه عاجزة عن تمثُّل تفاصيل المشهد، لأن هذه التفاصيل تبدو غائمة أمام أنظارها، بعيدة، و نائية عن مضاربها، و متمنعة عن أي اجتراح جمالي أو نظري، حيث تغدو الكتابة هنا، شبيهة بكائن غريب يَحُلُّ بأرض غريبة، وحيث يكون المرئي بعيدا عن متناول رؤيتها المتلصصة التي لا تختلف في شيء، عن رؤية طائر جارح، يتحين فرصته المواتية للانقضاض على ظل الفريسة، فيما الكائنات المتواجدة على أرضية الواقع ،تجوب فضاءاته جيئة وذهابا على سَجيَّتها ،حيث ما مِن أحد يدري أن ثمة عينا جارحة اسمها الكتابة، تتربص بالمحتجب خلف خمائل الوقت. وكلما تضاعفت شساعة العالم،وتعددت شراسته،إلا و تقلصت مؤقتا سلطة هذه العين ،كي تأخذَ شكلَ مُجَسَّم ثابت، لا علم لأحد بنواياه، في أفق مبادرتها، بخطوة تمهيدية لفعل الظهور.و هي خطوة تتمثل في استدراجها البصري للجزء ،كي يغادر منازل الكُلِّ التي يستمد منها تناغمه وانسجامه ،لأن مغادرته لها ،هي من بين الأسباب الأساسية المؤدية إلى انفراط حبات عقده، الناتج عن جُماع بنيات دلالية متكاملة في انتظامها و تلاحمها حيث سيكون بوسع نار الرؤية، أن تستفرد بكل جزء على حدة، كي تشل حركية الكل، فتجعله جاهزا للمجاهرة بأسراره، فمن خلال هذه المنهجية، تضاعفٌ الكتابة سلطتها ،فيرتقي إلمامها بتفاصيل المعيش إلى مستوى تماهيها معه ، وتملكها له، حيث تتحول هي أيضا إلى واقع قائم الذات، من خلال ضبطها لديناميته، وإخضاعه لسلطتها. إنها بهذا المعنى تجرد الواقع من شساعته اللامحدودة، أيضا من عماه، ومن طبيعته الأصلية، الموسومة بحركيتها الجارفة، التي تحُولُ دون دمجه ضمن توصيف محدد، وواضح المعالم ،وهو ما يعمق لدينا الوعي بانصراف العالم إلى معالجة أحواله وأنساقه الخاصة به، هناك، أي في ما وراء الهاوية .وهي اللحظة التي تصبح فيها الكتابة صرخةً جارحةً في مسامع العالم، عساه يتلفت قليلا حيث هي ،متقدما باتجاه عتباتها ،و فضاءاتها. كما هي اللحظة التي يتحول فيها العالم ذاته إلى معدن خام ،مهيأٍ لأن يوجد من جديد، بصيغة أخرى ،أي كما تشاء الكتابة، لا كما يشاء هو.