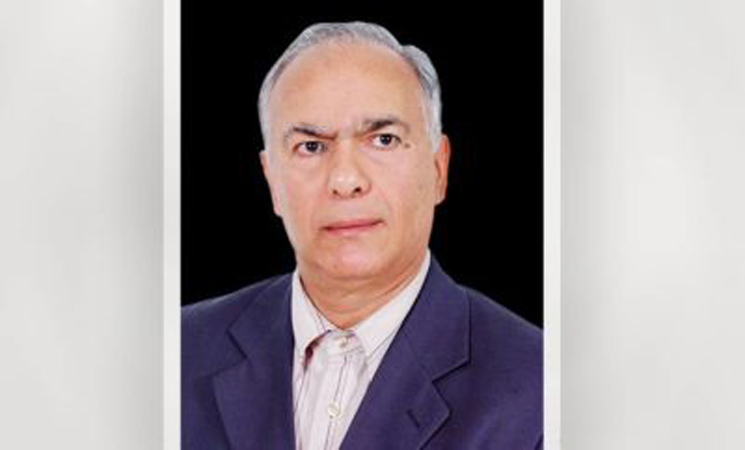إذا كانت مسارات»الآخر» ، هي نتاج تفاعل كافة الأنواع الفنية والأدبية المتواجدة في المشهد الثقافي، والمؤطرةعادة بمنظوماتها الفكرية والنظرية، إلى جانب كونها مدعمة ببنياتها المؤسساتية، التي تستقطب اهتمام الفضاءات العامة والخاصة، فإن المسارات المحلية وعلى النقيض من ذلك، تتخبط في أجواء اجتماعية وثقافية ، مصابة بقحط معرفي ،لا مجال معه لظهور أية بارقة أمل فنية كانت، أو جمالية، يمكن اعتمادها بوصفها روافد حقيقية للإبداع الحداثي.
كلما استحضرنا سؤال الحداثة العربية، إلا وطالعنا إشكال أكثر طرافة، له علاقة بالاشتغال المتكامل لثنائية الوهم والحقيقة، وقد تنصلت من أي إحساس محتمل، بما يحتدم بين طرفيها من تناقضات صارخة ،حيث يلاحظ وبشكل جلي أن الحقيقة في ربوعنا، غالبا ما تلجأ إلى انتداب توأمها «الوهم»، كي يقوم مقامها في تدبير حياتنا الثقافية والسياسية، بشقيها الخاص والعام، نظرا لانصرافها إلى إنجاز مهام أخرى، أكثر ملحاحية «هناك»، في معسكراتها المركزية، التي لا يجوز للوهم أن يتواجد بها إلا ضمن دائرة ضيقة ومغلقة، تحول بينه وبين إعاقته لحركيتها. ولعل السبب الموضوعي في تفضل السيدة «الحقيقة» بإخلاء مكانها «للوهم» هنا والآن، هو اقتناعها بعجزها التام عن مواكبة ديناميته التفاعلية، ومهاراته الاستثنائية في التعامل مع كافة الإشكاليات التي يضيق بها واقعنا العربي، والذي يعتبره الوهم مجاله المثالي لممارسة كامل سلطاته التنفيذية والتشريعية، وإذا نحن تقيدنا بالسياق المعرفي ، فسنجده- الوهم – قد اكتشف فيه ضالته المنشودة، التي تتيح له إمكانية تفجير نزواته العجائبية، عبر فبركته المتطورة لحقائق لا تخضع للضوابط المعتمدة عادة، سواء تعلق الأمر بقطاع الفنون السمعية البصرية، أو بحقول الفكر والإبداع، حيث تتحول الأشرطة السينمائية- على سبيل المثال لا الحصر – بموجب سلطته، الموسومة بغثاثتها الفاضحة، وشعبويتها البئيسة، إلى منجزات»فنية» مؤهلة لـ »منافسة» أرقى وأهم التجارب السينمائية العالمية، و الشيء ذاته ينسحب على المسرح، الذي يتم إذلال خشبته، بإكراهها على تحمل أحط وأفظع السخافات، بتزكية سذاجة جماهيرية لا حدود لسخائها، كما أن النقيق الموسيقي، يتحول بنفس المنهجية، إلى إيقاعات موسيقية، «تطرب» لسماعها ملائكة السماء قبل الأرض، ودون استثناء الهلوسات الشعرية الملحة على انتزاع «شرعيتها» من أكذوبة انتمائها إلى سلالة رامبو، بودلير، أو مالارميه، أو التلفيقات السردية الحريصة على إقناعنا بانتسابها إلى شجرة مارسيل بروست، جويس أو كافكا، واللائحة طويلة، علما بأن المنطق ذاته ، ينسحب على باقي الخطابات الفلسفية، حيث لا مناص من استحضار نتشه، وهايدجر، هابرماس، فوكو ودريدا إلخ، أملا في ملء بياضاتها بما تيسر من السند المرجعي.
هكذا إذن، وبما يكفي من الفقر المعرفي، أضحت لعبة استحضار مرجعيات الحداثة وملحقاتها، في تأطير ما يدبج من أوهام، أمرا جد مشاع ومتداولا إلى أقصى حدود الابتذال، بما يجرد تساؤلنا من براءته، ويجعله معنيا بتجاوز الجانب الضحل والجزئي من الظاهرة ،كي يتناولها في شموليتها، خاصة وأنها أمست بقوة تكريسها، من بين أكثر الطابوهات تعاليا عن أية مراجعة نقدية، من شأنها تسليط الضوء على ادعاءات هذا التعالي،ولو في حدوده االدنيا. ومصدر تنصل تساؤلنا من براءته، يعود إلى اقتناعه بكون المقياس الوحيد لضبط حدود المصداقية، التي تتمتع بها المنجزات الإبداعية والفنية، يتمثل أساسا في شرط امتلاكها لقوانين كفيلة بإنتاج أعمال جديرة بأسمائها ، وهو شرط يتعذر بدونه تحقق مطلب التفاعل الخلاق، القائم عادة بين الذات وبين ما تنصهر فيه من تجارب معرفية وجمالية، دون أن تكون بالضرورة ملزمة بتقديم ولائها لأي توجه نظري جاهز ومسكوك، باعتبار أن المقياس المعتمد في اختبار عمق التجربة الإبداعية وقوتها، يكمن أساسا في تفردها واستثنائيتها، اللذين نستدل بهما على حضور أفق جمالي ومعرفي جديد، متميز بخصوصيته المتفردة .ثم لو حدث أن قيض لمالارميه، بروست، أو كافكا، وغيرهم من مؤسسي الحداثة الأدبية، أن يخبروا بأنهم قد أصبحوا وضدا عليهم، آباء رمزيين لزوابع لا تحصى ولا تعد من الكتابات الرديئة، لتنكروا جملة وتفصيلا لإبداعاتهم ،التي لا يجادل أحد في كونها المقابل الموضوعي لحياة رمزية، كابدوا جاهدين، من أجل رسم ما أمكن من ملامحها،علما بأننا لا نلغي أهمية حضور تجاربهم كمرجعيات في ذاكرة الكتابة، بل على العكس من ذلك، نعتبر استحضارها وتمثلها ، أحد المطالب الأساسية لتحقيق متعة المواكبة المعرفية والإبداعية، وأيضا لتمثل مختلف ما تستشرفه الذات الكونية من آفاق، لكن ليس على أساس واجب تماهينا الأعمى معها، بمختلف الصيغ الهجينة والتحريفية، المؤدية إلى تمييعها والعبث بقوانينها وأسسها. وفي هذا السياق تحديدا، نثير موضوع تلك المفارقة التي هي مدار هذه الورقة، والمتعلقة بدلالة الإصرار اليائس»لأولئك» على تقمص الخطابات المحلية لمسارات «الآخر« كما لو أنها مكتسب كوني قد وضع بشكل سائب ومجاني رهن إشارة المفسدين، دون مراعاة الفرق الفادح الذي لا تحده السماوات ولا الأرض، بينها وبين الخصوصية المحلية، المشروطة بشوائبها المميزة لها.
فإذا كانت مسارات «الآخر»، هي نتاج تفاعل كافة الأنواع الفنية والأدبية المتواجدة في المشهد الثقافي، والمؤطرةعادة بمنظوماتها الفكرية والنظرية، إلى جانب كونها مدعمة ببنياتها المؤسساتية ،التي تستقطب اهتمام الفضاءات العامة والخاصة، فإن المسارات المحلية وعلى النقيض من ذلك، تتخبط في أجواء اجتماعية وثقافية، مصابة بقحط معرفي، لا مجال معه لظهور أية بارقة أمل فنية كانت، أو جمالية، يمكن اعتمادها بوصفها روافد حقيقية للإبداع الحداثي، الذي تعاني نماذجه الناجحة بفعل هذا المناخ المأزوم، من أهوال غربة مدمرة، جراء انعدام شروط تفاعلها مع غيرها من الأجناس الإبداعية، بما يجهض إمكانية الإقامة في سكن متعدد المداخل والعتبات، تنتشي فيه الذات باستضافة مختلف الأنواع الفنية والإبداعية، من موسيقى وتشكيل وسينما، وحوارات فكرية ،وهو إجهاض لا يبقي سوى على زوابع متتالية من التهريج المتألق كالعادة في احتفائه الكرنفالي برموزه ومسوخه، داخل أجواء مضادة جذريا للتوجه المعرفي ، كما هي مضادة لأي حضور ولو محتشم،لأدنى تجليات الحداثة، المتعارف عليها في فضاءاتها الطبيعية، خاصة وأن هاجس إنتاج عمل مستوف لشروطه، لا يتبلور إلا ضمن قوانين تفاعلية مشتركة بينه وبين باقي الأنواع الأدبية والفنية، حيث يستمد كل منها خصوصيته، من قوة تواصله، مع غيره من الأنواع المتواجدة في نفس المشهد الثقافي والحضاري، بحثا عن إمكانية إنتاج فضاءات جمالية مشتركة، تأخذ شكل عالم فسيفسائي الهوى، يساهم كل منها بطريقته الخاصة في هندسة أرجائه، دون أن يفقد بالضرورة خصوصيته، بل وفضلا عن ذلك يمكن القول إن حضور شرط التفاعل المشترك والخلاق بين الأنواع، هو ما يساهم في تخصيب وإغناء هذه الخصوصية، حيث يمكن مقاربة العمل الإبداعي أو الفني، من خلال ضبط آلية تقاطع بنياته الجمالية مع مختلف بنيات الأنواع والأجناس الأدبية والفنية المجاورة له في المشهد الثقافي العام. وبالنظر إلى غياب هذا الأفق في الواقع العربي، فسيكون من باب التطاول، القول بحضور حداثة إبداعية ما، خاصة في ظل افتقار المشهد إلى شروطه التفاعلية، نتيجة الغياب الملموس للسؤال الثقافي والمعرفي، الذي يعتبر بحق، مكونا مجتمعيا وحضاريا، يمارس دوره الحاسم في إغناء تصوراتنا عن هوية حداثة فكرية أو إبداعية، تخص ثقافة وحضارة شعب ما، ذلك أن ما يرتقي بالعمل إلى منازل الحداثة، هو تفاعله مع أنواع فنية وإبداعية محايثة له، ومتمتعة بنفس الأفق ونفس المسار، داخل مناخ اجتماعي، وثقافي منخرط بشكل تنويري وعقلاني، في مشروع التحديث. لكن في حالة بقاء التجارب ككل، خارج هذا الإطار المندمج، فإنها حتما ستقع فريسة يتم سوداوي، يستبد بالنصوص استبداده بمؤلفيها، وفي اعتقادنا، أن مصدر مقولة اليتم المتداولة في منهجية التأطير النظري لهذه الوضعية الدرامية، يتجسد أساسا في تفاقم الإحساس بحالة الإحباط الكبير لدى المبدعين الحداثيين في المجتمعات العربية، نظرا لكون إنتاجاتهم تظل مراوحة مكانها، ومحرومة من حظوة إحداث أي تفاعل مشترك، سواء مع غيرها من الأنواع الأدبية والفنية، أو مع المتلقين المحتملين المتواجدين في مختلف الفضاءات الحية، الناطقة باسم الحضور الإنساني. وهو في الواقع يتم، يتجاوز حده الإبداعي والفكري، كي يتخذ بعدا وجوديا، قاسيا وتراجيديا، أيضا هو ذات اليتم الذي تحاول بعض التوهمات التنظيرية، إضفاء هالة فلسفية وحضارية عليه، فيما هو ليس سوى ترجمة ضمنية، لمأساوية الطرد الممارس بغير قليل من الاحتقار على المؤلف الإقليمي، من قبل قوانين الحداثة المركزية، المعنية فقط، بمن هم منتمون بالقوة والفعل إلى مداراتها. وبالتالي، فإن خطابات الحداثة في العالم العربي، تظل محكومة بنسقها الأحادي البعد، علما بأن كل منجز من هذا القبيل، يظل أبدا، خارج فضائها ، مهما أفلح في تطوير اعتداده باستيهاماته، وبحجج وبراهين تخيلاته.