لا يمكن لمراكش الفيحاء أن تصدأ عن معين تاريخي أتيل، قد تستعر فيها من حين لآخر مَدنية الرجل الأبيض وزيف الحداثة السائلة، وهما يهيمان بتفتيت الوجدان والعمران، غير أن هناك روحا لا تشيخ في مملكة الأولياء السبعة، هي جزء من شخصيتها العميقة، التي تُذكر بعبق التاريخ، بمخزون ذاكرة جماعية سادرة نحو الضياع. فهل كُتب لمراكش أن تتحمل أوزار كل ذلك الالتباس؟ أن تحمل في ذاتها تمفصلات على درجة عميقة من التشابك، في مدينة يتساكن فيها الجلال بالدناءة، الزهد بالنتانة.

رواية «طيور السعد» للروائي المغربي عبد العزيز أيت بنصالح، الصادرة سنة 2016، عن المركز الثقافي العربي، في حوالي 221 صفحة من الحجم المتوسط، احتفاء بالزمن وبالتاريخ، بما هو زمن مُحايث من حيث الدلالة والمعنى، وزمن فاصل بين منعطفين مبنى ومعنى. هل يجوز بلغة مختصي الزمن أن نقول بولوج المغرب حقبة التاريخ الحديث مع تجربة أحمد المنصور السعدي؟ أميجب أن ننتصر لرؤية الزمن الوسيط الممتد؟
ما معنى أن نعود بسردية الحكي نحو ماضي مراكش السعدي؟ أَهُو هروب من أتون الحاضر المستلب؟ أم نوستالجيا مخصوصة لاستعادة أمجاد الأجداد وهُمْ على وشك الدخول إلى عتبة الزمن التاريخي والانسياب في تجاويفه؟
من دون شك يظل القرن السادس عشر نصبا للافتخار في عالم متجاذب القوى والنفوذ، قرن امتزج فيه الأمل بالألم، الانعتاق بالانسداد، لعل شيئا منه لا يزال يتسربل ضمن حاضرنا بشكل أو بآخر، أوَ لا يوحي صراع مراكش وفاس الأزلي حول الرياسة إلى تعثر مشروعنا المجتمعي وانحسار أفقنا الحضاري وتصحر وعينا الجمعي؟ لماذا لم نستطع تاريخيا أن نؤسس لقاعدة التوافق السياسي والمجتمعي وفضلنا الانقسام؟ حتى صرنا كائنات انقسامية بامتياز بتوصيف الانتروبولوجيين، نُمني النفس بأماني دونما هدف مرسوم، نجر وراءنا فاتورة الماضي.
هل يجوز أن نقرأ التاريخ بصيغة التمني؟ أن نستعير صيغة «ماذا لو» لفهم مجريات القرن السادس عشر، ماذا لو نحن المغاربة سايرنا جيراننا الشماليين، شاركناهم ثوراتهم، اكتشافاتهم واختراعاتهم، هل كان الأمر سيكون ما هو عليه الآن؟( ص 112)، علينا أن نقر بأن الوعي بإشكالية التفاوت مدخل لأي استنهاض وجداني، مَعبر لإعادة بناء الذات المنكسرة، مُنطلق لإعادة قراءة هذه الذات الحضارية المتضخمة التي صرفتنا خارج مراكب الزمن والتاريخ.
لربما كان القرن السادس عشر للميلاد، قرن فرصة ذهبية أفلتت من أيدي أجدادنا، القرن الأغلى من التاريخ، القرن الوحيد في سياق القرون الأخرى، الذي مَرَّ صدفة بفرص مواتية للتغيير بمحاذاة أجدادنا، وأمام أعينهم (ص 112)، اللغز المحير في بلدنا، لغز كان المغاربة حين التأم وجدانهم في مراكش وفي غيرها بعد الانتصار في معركة وادي المخازن 1578م قاب قوسين من أن يقتحموا زمن التاريخ ويستوطنوا مساحاته.
رواية «طيور السعد» تستوقف القارئ لإعادة تشكيل خرائط الذاكرة، حيث مغرب المتصوفة بتعبير المؤرخ التونسي لطفي عيسى يتناغم مع مغرب السوقة والأغفال، لحظة كانت فيها الأرض المغربية تنجب الإصلاح كما تنجب الأرض البقول.
تصوير بديع لمورفولوجية المدينة الحمراء بأسوارها وأبوابها، قصورها وحدائقها، حوماتها وسقاياتها، ألعابها الجماعية وعالمها المخملي، إنها في ذلك محاولة إبداعية تتوسم بالتاريخ من أجل ترميم الذاكرة التاريخية من شوائب الحاضر، ومن متعهدي السرد المتعالي عن حقيقة الزمان والمكان، في مدار تخييلي يراهن على توضيب الحكاية الفردية والجماعية من أجل صياغة ما يسميه موريس هالفاكس بالضابط الاجتماعي/ الريكيلاتور الذي يضمن لأي أمة البقاء بين الأمم، فأين نحن من ذلك الوجدان الضائع؟ ذاك هو السؤال المركزي لهذه الرواية.
تبتغي الرواية ضبط مقياس المسافة بين كتابة التاريخ وتوضيب الذاكرة، التاريخ كإستوغرافيا ومنهج، والذاكرة كانتماء وإحساس، لربما تلك علاقة خاض ويخوض فيها فلاسفة ومؤرخون منذ فترة ليست بالقصيرة، على الأقل منذ سبعينيات القرن الماضي، مع عرَّابي الذاكرة التاريخية بول ريكور وبيير نورا وآخرين.
بلغة الاختصاص الذاكرة ليست هي التاريخ، يُحيل مفهوم الذاكرة إلى آليات تمثل الماضي واستحضاره، بما هو تمثل استرجاعي لنسق الذهنيات والتصورات الرمزية التي ينشئها الناس عن الماضي، كإنتاج اجتماعي وسياسي وثقافي. الذاكرة بتوصيف المؤرخ الفرنسي بيير نورا صاحب مبحث «أماكن الذاكرة «ضمن الكتاب الضخم الذي أشرف عليه جاك لوغوف «التاريخ الجديد»، «تمثل ما تبقى من الماضي في أذهان الناس، أو ما يتصورونه بخصوص هذا الماضي»، الذاكرة بالتعريف موروث ذهني تختزل مسيرة من الذكريات الفردية والجماعية التي تغذي التمثلات الاجتماعية. إنها مجرد صورة عن ماضي وقع استحضاره، اختزاله، تضخيمه، تقزيمه… وفق حاجيات اللحظة وتشابكات الراهن بين الفرقاء، غالبا ما تغلب عليها القدسية والرمزية كصورة بعض الشخصيات السياسية والدينية في المخيال الاجتماعي، صورة قد تمتزج فيها الحقيقة بالخيال، من شأنها أن تقود نحو اختفاء الواقع بتعبير الفيلسوف جون بودريار وظهور ما فوق الواقع، الواقع المتخيل الذي لا يحيل بالضرورة إلى الماضي.
بالمقابل التاريخ اشتغال مفاهيمي وموضوعاتي وإشكالي، يقوم على المعالجة المنهجية، على ترتيب الماضي بعبارة لوسيان فيفر، على عملية بناء وإعادة بناء، كتابة وإعادة كتابة، صياغة وإعادة صياغة، تعليق على تعليق، في مدار متداخل من العمليات المنهجية التي تشتغل بالتحليل والتأويل والنقد.
تقترن الذاكرة التاريخية بتعبير ببير نورا بإعادة بناء المخيال وخروج المكبوت، فالذاكرة تحكمها الغائية، وتشتغل من منظور الواجب تحت شعار «حتى لا يتكرر هذا»، وغالبا ما تخضع لتوجهات سياسية وأخلاقية.
نسوق هنا مثالا عن مبحث ذاكرة التاريخ الحديث المغربي، مع حدث معركة الملوك الثلاثة، أدرجته المؤرخة الفرنسية لوسيت فالنسي في كتابها المرجعي أساطير الذاكرة، وقفت فيه عند تحليل مستويات وأنساق الذاكرة، من منظور مخلفاتها الذهنية والرمزية والانفعالية عبر ثلاثة مستويات:
1- مضمون الذكريات من زاوية الفائز والخاسر/ الذاكرة المغربية والذاكرة البرتغالية
2- حول وسائل إنتاج الذكرى/ التخليد والنسيان
3- حول ما ظل خارج هذه الوسائل/ التمثلات والأوهام.
الذاكرة التي توصلت إليها فالنسي هي بناء ذهني وقع تخليده في الذاكرة المغربية، ونسيانه في الذهنية البرتغالية، توثيقه في التأليف المغربي وبتره في الكتابة البرتغالية.
ضمن فجوة التاريخ والذاكرة، تحضر شخصية زهراء بنت الكوش في رواية «طيور السعد»، امرأة عفيفة وزاهدة، ولكأن التاريخ لا يكتبه إلا الأخيار، شخصية مؤتمنة على سرد الحكاية وتمحيصها من هفوات الاخباريين، على إعادة صياغة الأحداث بربط سابقها بلاحقها، فهل ارتكبت أم الأخطاء حينما عزت للماضي ما عاشته بين المُنصتات إليها ؟(ص 13)، وهل يظل المؤرخ صاحب إزعاج دائم حينما يذكر بسرديات الماضي؟ ولا يقبل منه إلا ما يتوافق مع شواهد العمران. أوَ ليس هذا التعامل مع الذاكرة يظل انتقائيا لدينا؟
سبق للشاعر الفلسطيني محمود درويش ذات مرة أن قال «من يملك الحكاية يملك أرض الحكاية»، الحكاية ههنا تتزيا بعباءة السلطة وترتدي وشاح المشروعية، الحكاية صانعة للرموز، ناقلة الأشخاص من مرتبة العاديين إلى مرتبة العمالقة، أو العكس،الحكايات جُند من جنود الله، يُثبت بها قلوب العارفين.نحن من نصنع رموزنا حينما لا نشيع ثقافة التمحيص والنقد، ونجعلها ثقافة انسيابية في وعينا الجمعي.
ينبش عبد العزيز أيت بنصالح في تفاصيل دقيقة من تاريخ العصر الوسيط، تاريخ الألق المغربي من عصر الملثمين إلى عهد السعديين، وهو يستعيد خرائط الذاكرة الوسيطية من خلال إعادة استنطاق المصادر الاخبارية، تظهر زهراء بمظهر المؤرخ المؤتمن على صحة شواهد الماضي، صوت الحكمة الذي يتعالى عن الدهماء، ويَخبر الأشياء،زهراء قارئة فطنة لروايات الإخباريين، باحثة عن الحقيقة الضائعة وسط الأقلام، أو التي أريد لها أن تضيع، برؤية استرجاعية للزمن، تخترق الفضاءات والأمكنة جيئة وذهابا.
اهتمام زهراء بالزمن ناتج من زهوها بما لا رجاء فيه، تنتقي لب وقائعه، ثم تتمثلها، فستحضرها طازجة، برغم بُعد المسافة بينها وبين ما كانت تحكي عنه (ص 74)، أوَ ليست زهراء مثل المتسكعة التي تحدث عنها مشيل دوسرتو الباحثة في المزابل عما تبقى من الأثار والأشياء، من أجل أن تلتقط الهوامش التي ترتق ثقوب السرد، وهي تحكي عن تبدل الزمان والمكان، وتستشعر بداية الاختلال بين ضفتي المتوسط، حينما حسمت الكرافييلا البرتقيزية صراعها مع الجمل الاسلامي، حينما غامرت أوربا بركوب البحر، وبقينا نحن حضارة مستغلقة على نفسها في تجارة القوافل والصحراء.
تنضح رواية طيور السعد بإشارات عميقة إلى ميكرواستوريا الهامش والمهمش، وهي تفتح ورشا مازالت نوافذه موصدة في خارطة الاشتغال التاريخي، تتكلم عن ظاهرة الغِلمان والشواذ وقلة الحياء، تفصح عن جانب معتم من الحديقة السرية لسيدة مدن المغرب، حيث يتساكن الصلاح بالعهر في مدينة كثيرة الألغاز، كما ترسم الرواية جانبا من تاريخ العقليات والذهنيات بمراكش، حيث أبناء حاضرة مراكش يعرضون عن الكتاتيب القرآنية، ينصرفون إلى اللهو والتحطيم والصراخ في وجوه أمهاتهم (ص 143).
تتوقف الرواية كثيرا عند الغيرة التاريخية بين حاضرة فاس ومراكش، وتجاذبهما حول زعامة المغرب، علميا وسياسيا. فاس دار علم ومستقر رياسة، أشاحت بطانة فاس إلى المنصور أن موضع معمل السكر بإشيشاون مستوحش ومقفر، حيث الأرض جُزر صلعاء إلا من نبات الغسول الصامد على الدوام، والشوك والحنظل والحرمل والحجارة المفتتة (ص 42)، وهي ترمي إلى ثني السلطان عن بناء معمل السكر، أوَ ليس البناء في أساسه سوى معاندة لبطانة فاس ونكاية فيهم؟ ألا يوحي بأن أهل مراكش قادرون على تحويل الأحلام إلى وقائع؟ إلى انتصار الإنسان على الطبيعة؟ هل كان لزاما على أي سلطان مغربي يعتلي كرسي العرش أن يقع بين فسطاطين، بطانة أهل فاس وبطانة أهل مراكش؟
هل صارت مراكش مجرد حكاية؟ حين كانت وصيفة زيدان بن المنصور على دين النصرانية في قصر البديع؟ أين نحن من ذاك التعايش الديني الذي رسمه الأجداد؟ لربما الغِربان لا يعنيها التاريخ في شيء، إلا إذا أطلعها على أوقات حروبه وأوبئته، تترصد الأحداث الدامية حتى تتبين ميدان الضحايا، وتحوم من حول الجثث ما أن تنفق، تم تحط تباعا لتلتهم ديدانها، تلم مأدبتها التي تربط شرهها بالتاريخ (ص 215 )، عكس اللقائق تلك المخلوقات الرومانسية الحالمة، تقتفي أدق التفاصيل، تراقب من فوق، تهتم بالتفاصيل لأنها آمنة، باحثة عن السلام. حياتنا موزعة بين غِربان تنتشي بالدمار ولقائق تنشد الحب والسلام.
قدر المغرب التاريخي كما ترمي إلى ذلك مقاطع الرواية أن يعيش حالة الانقسام والتشرذم، وكأن الدولة التي أسس بنيانها المنصور قصر من ورق، دولة الفرد لا دولة المؤسسات، أزمة الاستخلاف بنيوية في هيكل الدولة، من يقرأ التاريخ يشعر بذلك، قدره كذلك أن لا تتوحد جبهته الداخلية لحظة الاستقرار، هو ما يوحي إليه العروي غير ما مرة في منجزه الفكري»نعيش استقرارا في ظل انحطاط». زمن الفرص الضائعة ومغرب الأماني الذي تبخر على أيدي أبنائه لا أعدائه، عن طريق الدسائس والوشاية والكيد.
تبدو اللقائق في رواية «طيور السعد» حاملة لبشائر الخير، عفيفة مثل أهل الزهد والصلاح، مُطلعة على أحوال البشر، مُقايِسة بين عالمين آخذين نحو الانفصال، عالم بلاد الروم السائر في ركاب التقدم، وبلاد المغرب المستغرقة في الدسائس والمؤامرات، تشوفت ملكة انجلترا إلى الغرب حيث عالم واقع خلف بحر الظلمات، فيما تشوف المنصور إلى الجنوب حيث الرمال وما تحتويه من مناجم الملح، ومن بعدها أكياس التبر ( ص 77)،ولكأن اللقائق شاهدة على عصر التحول والانعطاف، كان المنصور قاب قوسين من أن يفك اللغز، لكن للفوضى كلمة فصل(ص 69)، كاد وجدان المغاربة أن يلتئم لولا هذا الانجذاب الغريزي نحو نقطة البدء، فأين هم من ذلك؟
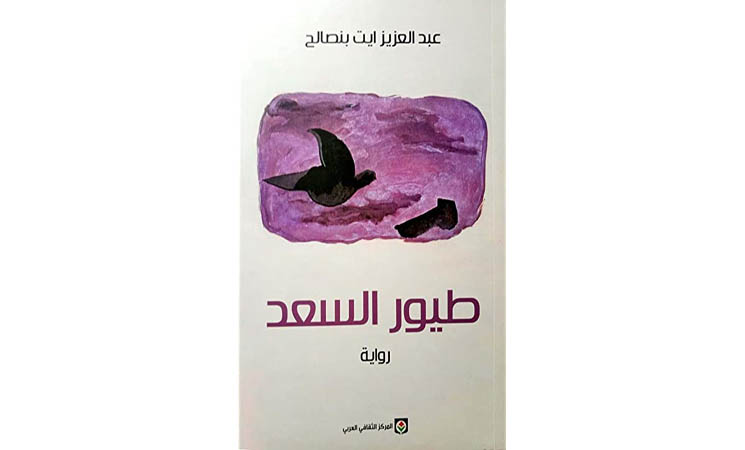
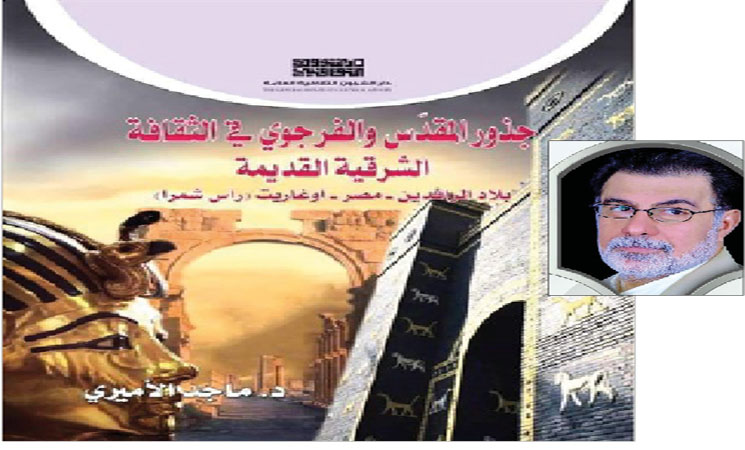

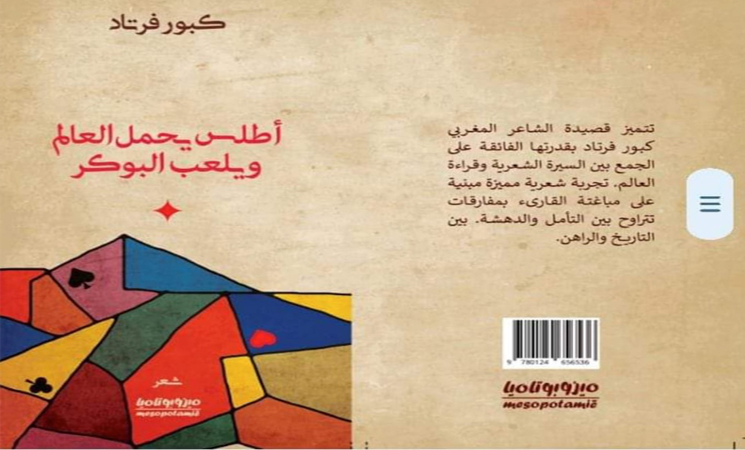



اترك تعليقاً