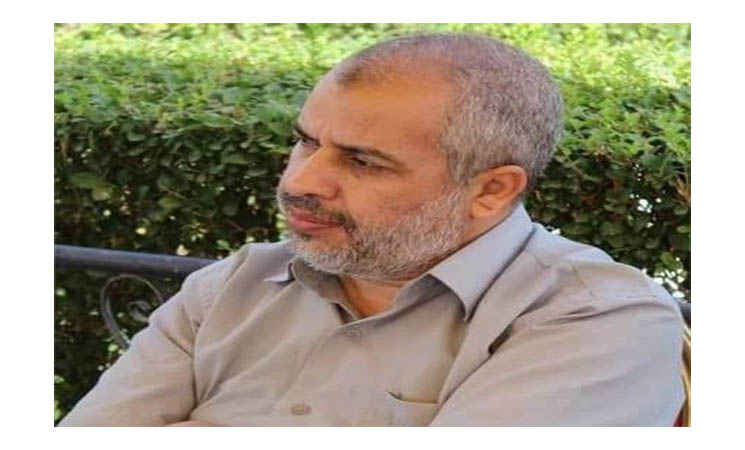كثيرا ما يصلنا كلام طائرٌ، كلام لا أساس له، ولا متكأ يعتمده وهو يصاول ويطاول بأفواهه العديدة، وأبواقه الصدئة، وَأَلْسُنِه المتشققة المنفلتة، آداب وفنون وعلوم أمم أخرى، لغات أخرى، وعبقريات أخرى. إذْ يذهب به التعصب إلى حد التَّشَرْنُقِ على ذاته، والاعتصام ببَجْدَتِهِ، منتصراً لمنتوجاته وإفرازاته حتى ولو كانت إفرازاتٍ محدودةً موقوتةُ لا شِفاءَ يُرْجَى من ورائها، ولا تَرْياقَ يُنْتَظَرُ من مائها وزبدها. يذهب به إلى الدعوة إلى قطع الجسور الواصلة مع الأغيار، وبخاصة إذا كانوا من ديانات أخرى، وأعراق وإثنيات مختلفة، ومعتقدات وضعية أرضية أو «لاَأَدْرية» بالتمام والكمال. ربما يرجع هذا تاريخيا إلى اعتداد العرب بلغتهم، وبآدابهم، وعلى رأسها الشعر بوصفه ديوان العرب، وقاعهم التاريخي وجذرهم ومدهم وجزرهم، وبوصفه هوية مميزة تكاد لا تتخطى العربية كلغة عبقرية، مكتفية بذاتها، محتضنة مكانها وكنوزها وذخائرها لليوم الموعود وشاهِدٍ ومَشْهود، للآمرين الناطقين بها، الكاتبين المُعْتَدّين باستجابتها لدقائق الفكر، وجوهر التصور، وعمق الرأي، وأسرار الخيال والكشوف، والماورائي، والمحجوب المستتر.
وإذا كان هذا الكلام صحيحا من بعض الوجوه، وصدى واعيا لشروط، وظروف، وسياقات تاريخية معينة، فهو لم يعد كذلك اليوم بالمطلق، لأن اللغات والآداب والعلوم والفنون تتضايف وتتثاقف وتتسالف، وتتلاحم، ولا يصمد منها، ويتسنم الصدارة والوجاهة والطليعية، وينتشر في الجهات إلا تلك التي وراءها مجتمع ناهض عامل عالم فعال، خلاق، نَهَّازٌ للفرص، مُبادِرٌ إلى التخييل والتصوير والتبديع والاجتهاد، والشك في الأول والأخير.
ومن ثَمَّ، يصبح السعي إلى معرفة الآخر المختلف عبر لغته المختلفة المكتنزة بالمغاير الذي من شأنه الإغناء والإثراء والتخصيب، يصبح ركنا معرفيا لا مناص منه، وفرضا موجبا لا فرض عين، فرضاً يطوق حياة ووجود وكينونة البعض، ويسقط عن البعض الآخر. ما يعني أنه يتصل مندغما بالقلة، النخبة، الانتلجنسيا..القادة الربابنة الذين يقودون القاطرات، والسفن، والمكوكيات، نحو البر الآمن حيث التلاقي والتواد والتحاب، كل ذلك مشمولا بالقيم والمُثُل والمباديء والتساند من أجل – إن لم يكن الرغد والرَّفاه، العيش الكريم في أقل مطلب ومبتغى.
معرفة الآخر ومبادلته الرأي والاختلاف والمحبة والتساكن، رأس الحضارة، وسنام الثقافة بما هي ـ في مفهومها اللغوي الـتأصيلي ــ جَبْرٌ للكسر الأنطولوجي، وتقويم للاعوجاج، وترتيب منظم لمساكن الإنسان وسكناه بالمعنى الحقيقي والرمزي والمجازي.
وهذه المعرفة المطلوبة تمتد – فوق العلائق العادية-، والمصالح البينية، والمعاشات اليومية، والجوارالدافيء الرؤوم- إلى الشعر والموسيقى والمسرح، والقصة، والحكايات الشعبية، والرقص، والفن التشكيلي بما هي مشخصات لروح الآخرين، لروح الأغيار، ولمسعاهم الحثيث المكمل، لإيجاد نقطة ثابتة غير رجراجة، يقف عليها الجميع، تحت سماء صافية لاَ زَوَرْدية غير مكدرة ولا مكفهرة، ولا منذرة بوابل الويل والثبور.
فإذا عدنا – مثلا- إلى الشعرية العربية في فترة ما قبل الإسلام حتى لا نقول «الجاهلية»، ألفينا موضوعة الفقد والترحال، مهيمنة، فضلا عما يحف بها من بكاء وضياع ميتافيزيقي لصيق بشسوع ومتاه الصحراء، وضآلة الإنسان فيها.
وقس على ذلك الأعصر الشعرية التي توالت منوعة على اللحن إياه، ومضيفة إلى اللحن هذا، آلات موسيقية جديدة وميلوديات، اقتضاها منطق التطور الاجتماعي، وواقع الترجمة العظيمة، واختلاط دماء شعوب وقبائل أسلمت مرغمة أو عن طيب خاطر.
من هنا، وبناء عليه، تتقدم آداب الأمم الأخرى محمولة على عبقرية لغاتها، عارضة اجتهادات وابتداعات أبنائها في مضمار الفنون والعلوم والآداب، مصبوبة في تلك الأجناس والأنواع المختلفة بوساطة موضوعات وثيمات مرتبطة بأنساق ثقافاتها، وإبستيمولوجيات معطيات أزمانها وأفضيتها. فإذا نحن بإزاء اشتغال مرهف وسحري على عناصر ومكونات الطبيعة والأفلاك، وعلى ما وراء الطبيعة، وما ينأى عن الناسوت والملكوت، بفضل مسبار الخيال الخلاق الذي يشبه في آفاقه وأبعاده اللاَّتُحَدُّ، واللاَّتنتهي، الثقبَ الأسود العظيم الذي دوَّخَ العلم والعلماء ولا يزال.
لنقترب من الحسي أكثر، القمين بوضعنا في صورة تلك الخيالات البديعة المهولة الرهيبة المجنحة بما لا يُحْصى من أجنحة وريش. ولنأخذ كمثال موضوعتين تتلاقيان في العمق، وتختلفان في الظاهر البادي. إنهما موضوعتا البرق والليل.
فالبرق: L’éclair، بما هو عنصر كهربائي نوراني، وفلكي كوسمولوجي وأسطوري. وبما هو روح ووحي وإلهام، وانبثاق يعقبه احتدام. شكل – كما هو معروف !- موضوعة أثيرة، ومحورا رئيسا، وركنا ركينا في شعر الهائل هولدرلينْ، العابر للأزمنة والأمكنة، بجنون العقل، وجنون الرائي الذي افترسته رؤياه، كيوحَنّا الذي افترست الخطايا السبع التي تطوق العالم، رؤياه.
إنه إشراق ظلمات الفجر في أضواء ليل العالم، واختراق للأشياء، والسحب، والسماوات، والكون والإنسان.
وإذا كان البرق – كما رأينا- مكونا مركزيا في شعر هولدرلين، فإن مواطنه ومعاصره «الغريب»، المستهام الشاعر «نوفاليس» الذي اختطفته يد المنون ولما يُكْمِلْ عقده الثالث، جعل من الليل موضوع شعره الأثير. الليل بما هو برق آخر، ساكن وملموم، ورؤيا غاية في الغوص، تفضح الأشياء فيما هي تحاول جاهدة أن تسترها أو تمحوها. رؤيا غواصة، بما لا يقاس، تكمن وتستكن في نسيج سديم الكون، وتاريخ الإنسان الباحث عن ضياعه، وعن تلك «اليد» التي قذفته في الوجود، ورمته عاريا من كل سر، مُكِبّاً على وجهه، أعمى، ويدَّعي الإبصار.
فَهولْدَرْلينْ : (1770-1843)، ونوفاليسْ : (1772-1801)، مؤسس قصيدة النثر في اللغة الألمانية، كلاهما نبيّ، استبقا ما سيحدث في زمنيات آتية ميتافيزيقيا وأنطولوجيا، وكينونيا، وكَيْنَنَةً.
وبذلك، فإن تاريخ الشعريات في شتى الجغرافيات، يدين لهما بالفتح الشعري وباجتراح ما لم يكن مفكرا فيه، وكان طيَّ الغيب، وتلك، لعمري، غاية الشعر والموسيقى والفنون الرفيعة، وبالابتداع المهيب والصاعق الذي ما انفك يتحقق حثيثا وعميقا، ويعاود التَّنَطُّفَ والتَّخَلُّقَ الدائم المتجدد وَفْقَ أقدارٍ ومقاديرَ وموازينَ وتلقياتٍ ونبوءاتٍ، ومصادفاتٍ تنوس بين العبقرية والفذاذة والجنون، والحكمة، والنبوغ، و»الحمق الخلاق».
وَإذاً، فلا مندوحة لنا من عناقهما ومصاحبتهما، مثلما لا مندوحة لنا ولا مفر من عناق ومصاحبة شعراء هائلين آخرين، إن نحن شئنا نفخ الروح الكونية المرفرفة منذ أزمان وعصور، في جسد شعرنا وآدابنا وفنوننا.
وفي هذا ما يفسر –ضمنا- مصاحبة الفيلسوف الشامخ هيدجر للشعراء الهائلين: هولدرينْ، وريلكهْ، وتْراكْلْ تمثيلاً. ومصاحبة ومؤانسة فلاسفة آخرين للعابر بنعالٍ من مجد وريح: نوفاليسْ الذي غادر الوجود متعجلا مُرْتَعِبا من إطالة الإقامة فيه، شأنه شأن رامبو وتْرَاكْلْ، ولوتْرَيامونْ، ولاَفورغْ، وجبرانْ، والشّابّي، وهو يرثي بمزمار شعره الميثي الملتاع، هشاشة ورخاوة الكائن والموجود، وخطأ الكون.
أصداء أصوات غافية : كيف نتَخَطّى أوْهاماً، كيف نَخْطو أمَاماً؟

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 03/02/2023