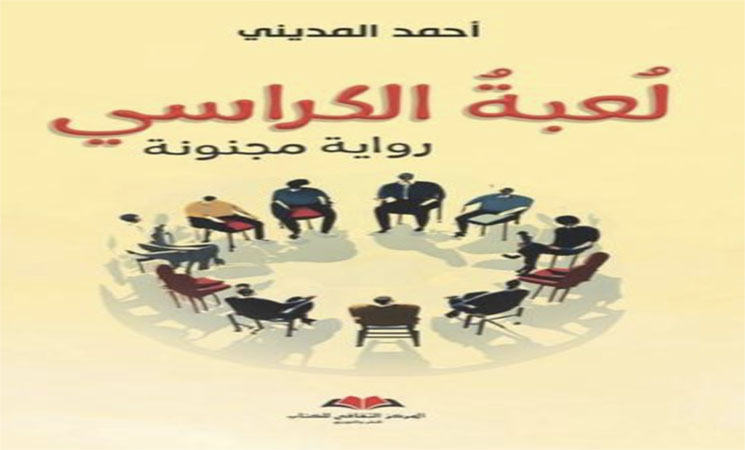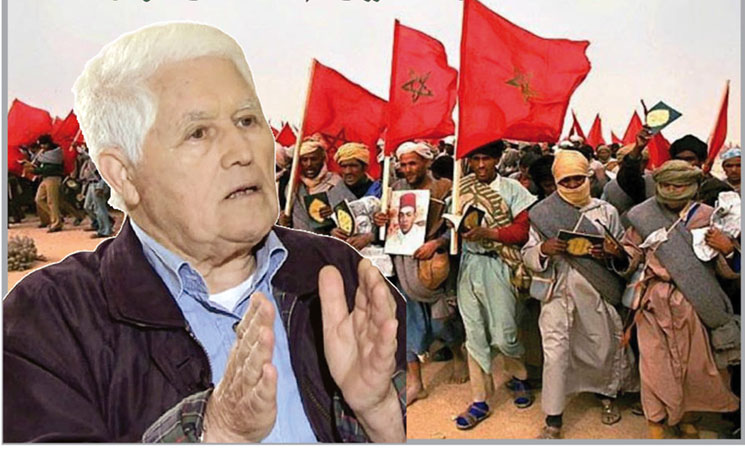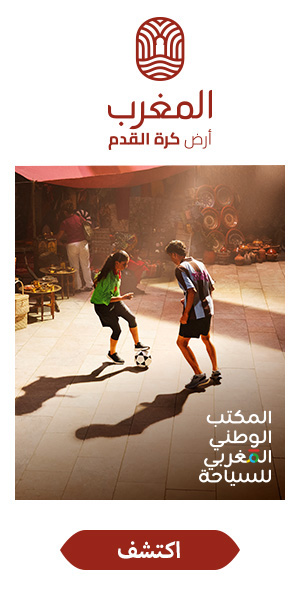هناك مقولة شهيرة في تاريخ الأدب الروسي، تنسب إلى الروائي الكبير دوستويفسكي، مؤداها : «كلنا خرجنا من معطف غوغول». ما يعني استمرار وانتشار وحضور الأثر الأدبي الغوغولي، في ثنيات وطوايا، وشرايين النصوص القصصية، والروائية الروسية التي أتت بعده. وما يعني – ثانية- أن الأدباء الروس الكبار، عيال عليه، جلسوا إلى مائدته، واغتذوا من خُبْزه وإدَامِه. ذلك أن الرسالة الفنية والاجتماعية العميقة التي حملها «المعطف» الأسطوري، وأسلمها إلى لابسيه الذين تعاقبوا على ارتدائه، و»التوشح» به، تَبَطَّنَتْ قيم الفترة، وانشغالات المناخ الاجتماعي والآدمي آنئذ، ونجحت في استيعاب، وبلورة روح العصر الروسي على مستوى الكتابة الواقعية، والكتابة السحرية الفنتازية العجائبية، والفنطاستيك الغرائبي.
فالموظف البسيط العادي الرتيب النمطي الذي نصادفه إلى اليوم، هنا وهناك، وفي وضعيتنا الاجتماعية المغربية، والذي جعل منه غوغول بطلا مهزوما، وهازما، بمعالجة حكائية فاتنة، جارحة وموجعة، حكائية زواجت بين القص المَقْبُول الذي يمتح من تفاهة اليومي المكرور، وبرودة المكاتب، وصمم الوظيفة الإدارية المرذولة، والقص المَهُول الذي يخرج فيه «أكاكي أكاكيفتش»، ليلا –وهو الميت- وعلى مدار أَمَاسٍ في صقيع روسيا القاتل، ليقتص من معذبيه وقاتليه، أولئك الذين سخروا من بساطته وسذاجته، وتندروا بمعطفه الرث طول الوقت، والذين سرقوا منه المعطف الجديد الذي أفنى سويعات، وأياما مترعات بالألم والكد والتوحد والبرد، من أجل اقتنائه.
فالخـروج من هذا «المعطـف» العظيم، على حد قول دوستويفسكي، أو ارتداؤه –بالحَرِي- من لدن أدباء : أبناء وأحفاد غوغول الروحيين، ينبغي أن يقرأ ويفهم في بعده الرمزي بما هو تراث وازن متحدر، وإنجاز أدبي روسي كبير.
وإذا كان الأدباء الروس، خرجوا من «معطف» نيكولاي غوغول، ومن «صدرية» بُوشْكِينْ، فمن أيّ معطف خرجنا نحن؟ بل من أي جلباب؟ توخيا للدقة، والخصوصية الثقافية الأنتروبولوجية؟.
وبتعبير أوضح: من أبونا أو آباؤنا الأدباء الكبار الذين فرشوا لنا الأرض، ومهدوا لنا السبل لنستلم المشعل أو الجمر، ونواصل المسير؟
وكيف تستقيم هذه الأسئلة، والحال أن لفيفا من الشعراء والكتاب ينفون –جملة وتفصيلا- أثر الأسلاف فيهم وعليهم. بل ويعلنون، ببساطة ووثوقية، أغبطهم عليهما، أنهم قتلوا الأب الأدبي، وأنهم عيال على أنفسهم وحسب، يبدؤون من الصفر، من عري بدائي، لا متكأ ولا متوكأ لهم، ولا حائط يسندهم، ولا مَنْسَاة تُرَكِّزُهم.
لكن، ماذا نفعل بقولة الشاعر الألمـاني «هولـدرلين» الـذائعة : «… وحَرِيٌّ بنا نحن –معشر الشعراء- أن نبقى واقفين، عاريي الرؤوس، وأن نمسك بأيدينا شعاع الأب اللامع، وأن نهدي الشعب هذه الهبة السماوية محتجبة في الشعر؟»؟.
ماذا تعطينا حين مجابهتها بما يقوله ناكرو التأثر، وجاحدو فضل الآباء على أبنائهم؟ هذا إذا فهمنا أن «شعاع الأب اللامع»، لا يخرج عن معنيين، وهما : رب السماء..رب الأعالي، أو أدباء وشعراء العصور السالفات الخوالي، الذين بصموا أرواح عصورهم المتعاقبات، وَجَوْهَرُوا الأزمنة المتتاليات كلها.
نعم، قد نعزو الأمر إلى الصراع بين متكافئين نظيرين، في حال نبوغ الأبناء –بين الأب وابنه، و»كنقيضين عنيدين بين «أوديب» و»ليوس»، على مفترق الطريق، على رغم أن بعض الآباء هم حتما «شخصيات مركبة». عِلْماً أن الشاعر «إيليوتْ» يعترف بهذا التأثير الأسلافي، وإن كان يمتدح صنيع الأحفاد: «إذا كان الشعراء الموتى، هم المسؤولين*** عن تقدم المعرفة لدى الأحفاد، فإن هذه المعرفة ستظل من صنيع هؤلاء الأحفاد، أنتجها أحياء لتلبية حاجات الأحياء».
في الأمر ما يحمل على القول بأن الشعراء والأدباء، أيا كانت لغاتهم أو جنسياتهم، أو جغرافياتهم، مسكونون بأصوات علوية، أصوات قادمة من عصور، وأزمنة متداخلة، منشبكة، ومتعددة من جهة، وآتية من تلك الآفاق البعيدة والغامضة، من المجهول واللانهائي، من جهة أخرى.
وعليه، فإذا كان أدباء روسيا الكبار، قد خرجوا من معطف غوغول، ومن شخص «أكاكي أكاكيفتش»، العادي والإشكالي في نفس الآن، وخرج أدباء وشعراء الانكليز من «مِلْتونْ»، والألمان من «غُوتْه»، والفرنسيون من شعراء «الثريا» = La pléade، وفكتور هوغو، وخرج الإيطاليون من «دانْتي»، على ما تفيد كثير من الأقاويل النقدية، والاعترافات بهذا الخصوص، فنحن –المَغارِبةَ- من أية عباءة، بل من أي جلباب خرجنا؟.
الظاهر أنه لا يمكن الحسم برأي هنا، إذ تتعدد وتتشعب الأصوات القديمة، ويتنوع الأسلاف الكبار المؤسسون، والتنقيحيون المشارقة على وجه الخصوص، والغربيون المواربون بكل تأكيد. فحين يعانق الشاعر سلفا معينا، أو أسلافا «ضبابيين»، فإنه يعانقهم ككلية، ككلتة غير مُصْمَتَةٍ، بل عديدة الزوايا والسطوح والأضلاع، يعانق فيهم كل «رومانس العائلة» الذي ينتمي إليه، بتعبير «فرويد» Freud.
ذلك أن الرقعة العربية، ومكونات أخرى هوياتية ثقافية ولغوية متعددة، شاسعة ورَحيبة، تندرج ضمنها شعوب وقبائل، وأقطار، وأمصار، وتنضوي تحتها خصوصيات على رغم انصهارها في هوية لغوية – ثقافية واحدة موحدة، لكنها الوحدة التي تؤكد التنوع القائم، والغنى الرافد.
فليس الأمر، من وجهة النظر هذه، شبيها بما حصل ويحصل في أوروبا حيث الهويات تخومية، خطوطية وبَيِّنَة، والألسن مختلفة، والثقافات متقاربة – متباعدة، مع الإقرار بالمرجعية «الاغريقو-لاتينية» لها ثقافيا، والمرجعية «اليهودية – المسيحية» دينيا.
إشـارات :
1-في التأثر والتأثير الأسلافي، تَرِدُ سَلاَهِيمُ وجلابيب، وعِمامَات ولِحَى، وسُبْحات. كما تَرِدُ قبعات، و»َدْجيناتْ»، وأقمصة زَهْرية فاقعة زعفرانية، وطحلبية، وَغُرَابية، وسيجارات كوبية، وَسْمُوكِينَاتْ، وعورات، وكحول وحشيش وضياع، وبقايا وجودية متسولة، ورُقَع وِلْسُونِية عدمية مضحكة، وأرصفة عليها كعوب عالية لأنوثة حَشْرَجَها السهر والدخان، والنبيذ الرخيص، وورود بلاستيكية شائهة تماما. السلف هنا بالمعنى الجينالوجي، وبالمعنى التغريبي المستلب.
2-»السوريالية» وهي مذهب مجانين راسخين في الشعر والأدب، والتشكيل، والكتابة بعامة، أحرقت ماضي الأناقة الصالونية الباريسية، وهشمت بناية الأدب الكلاسيكية، ومِشَدّات طوابق عماراتها الشامخة. فهل برماد حريقهم، و»أباريقهم المهشمة»، ندفن ماضينا، ونبتعث أصواتنا الأمشاج المنكرة، أصواتنا المستلفة؟ ألسنا نبيع الوهم وسلال القصب الخاوية، ليس قصب بْلِيزْ باسكالْ على كل حال.؟
فَمَا لَمْ تحفظ لتمحي، فيما أوصى به أبو تمام وابن عربي وغيرهما، ستظل نائسا، عاجزا، متأرجحا، رجلاك معلقتان، عَجيزتُك في الريح، ورأسك إلى أسفل، والعالم من حواليك مقلوب، فتنتج – من دون وعي ومن دون مسؤولية ولا أناة- هذيانا فيما تكتب، وكلاما مُنْبَتًّا، وطلسما يعوم في صور المعاول الهدامة، ومشاهد الإيروتيكا في محاولة بائسة لإنعاظ الكتابة والمكتوب ! ظَنّاً أنها دَادَائيّة أو تكعيبية أو سوريالية، وربما «سِرْوَالِية»، أو ما شئت، إِنْ في الشعر أو التشكيل. بينما لا تشكيل ولا شعر ولا موسيقا إلا بموضعة الذات في العالم، محاصرةً بالأسئلة والألم، وَمُسَيَّجةً بالموت بوصفه محواً وحياة.
4- مَا مِنْ كائن يتوكأ على نفسه إلا الخنثى والحلزون. أما الذكر فمحتاج إلى قَسيمه: الأنثى. والأنثى محتاجة إلى قسيمها : الذكر. وفي ذلك هتاف مرايا، وصهيل دائرة وقوس. فاعتبروا يا أولي الألباب !.