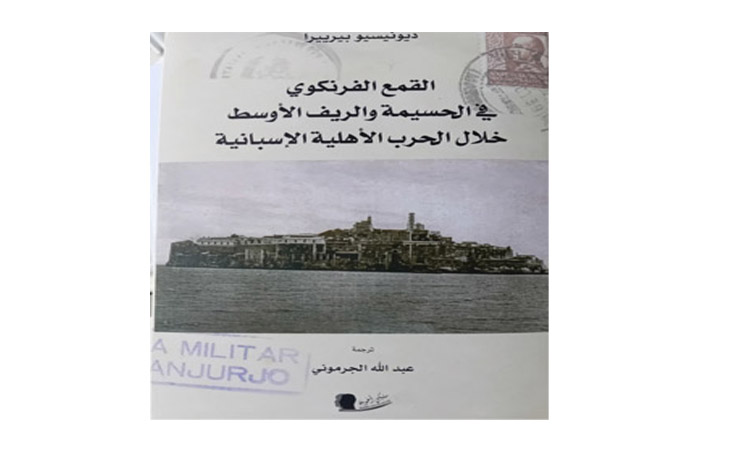لا يشيرعنوان المقال إلى، ولا يحيل على المدونة الفقهية التي سعت إلى « فرض الحجاب» الذي أشبعته رأياً وفُتْيا، معتبرةً إياه أحد مطالب الإسلام الرئيسة لأنه عنوان التقوى والعفة والأخلاق الكريمة. علماً أن نبشها في قضايا الحجاب / الغطاء الذي يحض النساء على حجب وإخفاء مفاتنهن من شعر ليلي أخاذ أو أشقر وقّاد، ومن أذرع بضة ونحور فضية مَضَّة، وأسْتُرٍ لباقي نوافذ الجسد الذي يلتهب شهوة وإغواءً وإغراءً في ملتهم واعتقادهم المريض، كأن المفاتن الإلهية عورة، ونداء ملحاح إلى الغارات التترية. نبشهم ذاك، ومرماهم وخوضهم الدّعي، لا يستوقفنا بل نُلْقِهِ وراء ظهرنا غير عابئين بتهافته واختراعه من قِبَلِ طائفة من « الفقهاء « الذين هالتهم الأنوثة، فراحوا يحتالون على سور وآي الكتاب المبين، وما صَحَّ أو ضَعُفَ من أحاديثَ منسوبة إلى الرسول الأكرم، بالتأويل والتغريض، مرماهم أن ينجحوا في لجم « الغرائز»، وعقل الاندفاع، وكبح الفتنة والسحر، والجمال النسائي الذي يرمي ب « شَرَر «، فيصيب أكباد الرجال، كما يصيب « أكباد الإبل «.
ما نتوخاه هنا، هو أن نتحدث عن فضيلة الثقافي الذي يصحح ويغلف الطبيعي، والأنتربولوجي الذي يعطي لفيض الدلالات والأعراف والمواضعات الاجتماعية والثقافية، دلالة حافة وترنسدنتالية في آن. ذلك أن العري طبيعةٌ وأصالة خام، وبدءٌ صلصالي وحمإ مسنون، فيما الغطاء أو اللباس أو الحجاب أو الرداء، ثقافة اقتضتها وأملتها التحولات والتطورات والتغيرات التي مست الدماغ البشري، وطالت التجربة الإنسانية.
ولئن كان الطبيعيُّ حقيقةً أنطولوجية ووجوديةً، فإن الثقافيَّ مظهر واقعيٌّ حققته الإرادة البشرية في مسعاها إلى تجاوز شرطها، وبلوغ جوهرها، أَيْ بما وَصَمَها بالتعالي، ونبذ الحيوانية والبهيمية التي ظلت « وفيَّةً « لقدرها.. وفيةً لعريها الأوّلي الأزلي والأبدي، لطبيعتها المركوزة لِ» تصلُّب « دماغها، وبقائه حبيس « نُوروناتِه « التي لم تتجدد بما يكفي، ولم تتطور كما ينبغي، لتصل إلى القدرة على الفهم والتمييز، والاستطاعة على وعي الزمان والمكان، وعي الماضي والحاضر والآتي. لذلك، نجدها كما هي: صوفا ووبَراً وشعَراً ولحما وعظما. نجدها تنام حيثما اتفق، وتأكل العلف من دون تنقية ولا تصفية ما لم يفعل ذلك سيدها وسائسها. ونُلْفيها تتسافدُ أنّى كانت وحيثما وُجِدَتْ لا شيءَ يَرْدَعُها ولا عقلا يقمعها، بينما يستحي الإنسان الذي « كرَّمَهُ « الله، أن يفعل ذلك على المكشوف أَيْ قبالةَ الخاص والعام، وإلاَّ عُدَّ فعلُه مروقاً عن الأخلاق، وخَدْشاً للحياء العام، وخلخلةً للناموس، وخروجاً عن المواضعات الاجتماعية، وفُحْشاً كبيراً ينهى عنه الدين والمجتمع والدولة. فما اتخاذ الإنسان بيوتا يسكن إليها، ومنازلَ يأوي فيها، وغرفا يمارس فيها ما شاء من « خروقات « و « انتهاكات «، سوى استجابةٍ تلقائيةٍ، لكن راسبة وراسخة في وجدانه وتربيته وعقله وتقاليده وأعرافه، اتِّقاءً للقيل والقال، ودَرْءاً للشناعة والوضاعة، والصَّغار، والنبذ والاضطهاد.
وإذاً، لِنَقُلْ إن الإنسان حيوانٌ مكسوٌّ، محجوب ومُحَجَّبٌ ومحتجِبٌ، وَفْقاً للضرورة والسياق والمجتمع والدين، والأخلاق والآداب العامة. إننا نخفي سوءاتنا باللباس التقليدي أو العصري، كما أخفى آدمُ وحوّاءُ سوءَتَهما بورق التين العريض الذي خَصَفاه عليها. ونُخْفيها بالألوان التي نختار وننتخب ونصطفي تَبْعاً لأذواقنا وثقافتنا، نثير من نصادف ومن ينظر إلينا إعجاباً أو استحسانا أو راحة ورِضا في أقل الأحوال. وبالعطور المختلفة، نحجب إِنْ لم نطردْ روائحنا الكريهةَ، فنسموَ بعلائقنا مع الأحباب والأصحاب والأغيار، ثم نستطيبُ كُنْهَ وجودنا، ونُسْتَطابُ، ونستسيغُ معيشنا ونُسْتَسَاغُ. الألبسة والألوان والعطور والألسنة الفصيحة، والعقول النبيهة، والأفئدة القوية رابطة الجأش والنُّهى، هي سبيلنا الذهبية إلى إشاعة المحبة والتوادد والصحبة مع الناس، وطريقنا اللاَّحِبُ إلى إبعاد الضجر والملل والاكتئاب، أو التقليل منه في الأدنى. نقول ذلك وفي البال بيتُ زُهَيْرٍ الشهيرُ:
لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُهُ ///// فلمْ يَبْقَ إلاَّ صورةُ اللحم والدمِ
لذلك أشرنا إلى الألسنة والأفئدة فوقه، علماً أن زهيراً بْنَ أبي سُلْمى، إنما يرى أن شخصية الفتى / الإنسان، تتحدد في فصاحته وبلاغته ونباهته، وقوة شخصه، ورَباطة جأشه وشجاعته وسداد رأيه. ونزيد على ذلك من جانبنا بالقول: هندامه وأناقته وذوقه وثقافته، واختياراته في الحياة، وأكله وشرابه؛ مدركين معنى الفروسية وسياقها الزَّمكاني في بيت زهير المفتلذ من معلقته الذائعة:
سئمتُ تكاليفَ الحياة ومن يعشْ //// ثمانينَ حوْلاً لاَ أبا لكَ يَسْأَمِ
إذْ كان الظرف يومئذٍ ظرف كرٍّ وفرٍّ، وشعر وخطابة مُفَوَّهَة ونبوغ. في حين أن منطق زماننا، وروح عصرنا، ومتغيرات أحوالنا، تؤكد بالحتم، إيلاء الثقافة بمعناها الشامل، المكانةَ الراسخةَ، والتصريفَ المطلوبَ والمستحق. ثقافة تطولُ اللباس، والعلائقَ مع الناس، والأكل والشرب والسفر والاجتهاد والابتكار لتحقيق مآربنا، والمأمول من وجودنا، وبقائنا وموتنا، واستمرار الحياة معنا ومعهم، بنا وبدوننا. ومن ثَمَّ، فالحجاب والتحجيب بما يعني التستر والتكتم، وإخفاء عيوبنا ونقائصنا، ومَهانتنا وهَوانِنا، ونزقنا، و» معاصينا «، وإظهار عنفواننا ـ في المقابل ـ وصدقنا ووفائنا، و» لباسنا « الثقافي العام، وإنسانيتنا في البدء والختام، من دون رياء أو نفاق، إنما هو فضيلة من الفضائل، وشيمة من الشيم، وخَلَّةٌ من الخِلال، وموردٌ غَدِقٌ من موارد بقائنا وصيرورتنا، ونُسْغٌ لا يَني يَسْري أبداً في شريان وجودنا وَوَتين حضورنا واستمرارنا.
ختاماً أقول: قيل» لباسك يرفعك قبل جلوسك، وكلامك ( علمك ) يرفعك بعد جلوسك. وفي المثل ما فيه من أن المرءَ بأَصْغَرَيْه: قلبِه ولسانه. وإذا كان المثل إياه ينطوي على نسبة معتبرة من الحقيقة، فإنك وأنت تتكلم إنما تكون مستورا محتجبا ما يعني مرتديا لباسا. ستقول: هذا تحصيل حاصل. نعم، غير أن اللباس في الحالين لا يرتفع متكلما كنت أو منصتا، ما لم يقصد بالمثل: الطاووسية، والخيلاء. ويقول المثل الفرنسي المعروف: ( اللباس لا يصنع الراهب )، وإنْ كان يصنعه ـ في ظننا ـ لأنه يميزه، أما السريرة والطوية فلا يعلمهما إلا لله.
أصداء أصوات غافية.. من فضائل الحجابِ والاِحتجاب..

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 14/06/2024