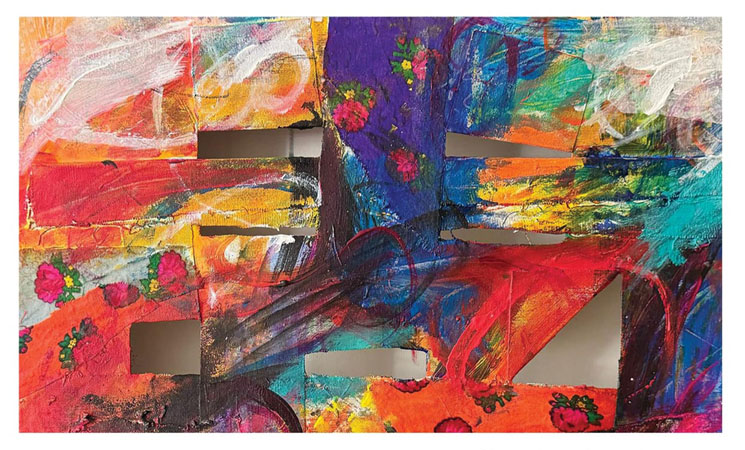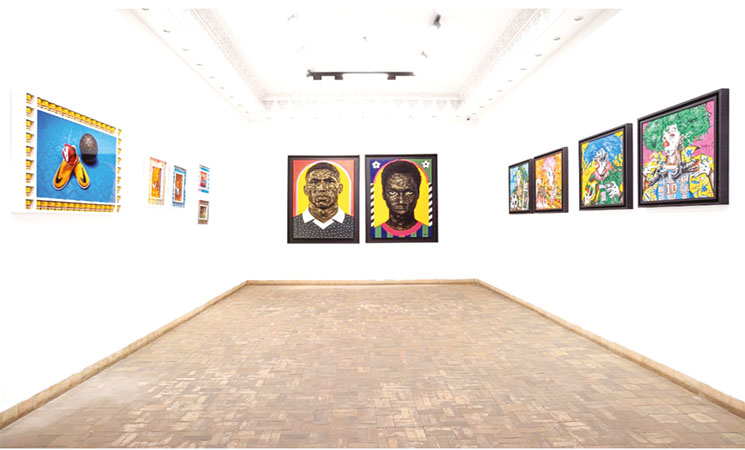في كل دورة من دورات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، يُثار نقاش حاد حول مستوى الأفلام المعروضة في المسابقات الرسمية، وعن التنظيم، وطبيعة المدعويين، وطريقة انتقاء الأفلام، وعن معايير اختيار لجان التحكيم ومنح الجوائز، وعن الندوات والمكرمين إلى غيرها من الأمور. وكما هي الحال دائما، تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض، وبين منتقد ومتحفظ. غير أن هذه الدورة، بما لها وما عليها، ستبقى علامة فارقة في تاريخ السينما المغربية. لقد كشفت المستور، وصار من المستحيل غض الطرف عما حصل، لأن الأمر أصبح يفرض تدخلا عاجلا لإنقاذ السينما: «فإما أن نكون أو لانكون». لن أدخل هنا في تفاصيل ما حدث، فالداني والقاصي أصبح على علم بذلك. ولكن أريد أن أقف عند بعض مكامن الخلل التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد الذي أصبح لا يطاق. وفي نظرنا، فإن هذا الخلل الحاصل في منظومتنا السينمائية لم يحدث صدفة، بل هو نتيجة للخلل الحاصل في المنظومة الفنية والثقافية والتعليمية والسياسية والاقتصادية ككل. فلا يمكن اختزال هذا الخلل في سلوكات بعض الأفراد، أوتضارب في المصالح الضيقة بين بعض اللوبيات الصغيرة، بل إن الخلل عضوي وبنيوي بامتياز. وهذا الخلل هو من أنتج أمثال هؤلاء المفسدين ومن يسير على منوالهم في كل القطاعات، وبالتالي عطل عجلة التقدم. وهو من أنتج كذلك هذه الأفلام الرديئة والباهتة التي لا تمثلنا. وهو من فرخ لنا أشباه منتجين ومخرجين وممثليين ونقاد، وهو من ساهم في هذه الوضعية غير المستقرة للمركز السينمائي المغربي الذي يسير بالنيابة منذ سنوات.
سنحاول في هذا المقال أن نتطرق قدر الإمكان لبعض أسباب هذا الخلل الذي يعوق تقدم السينما المغربية، دون أن ندعي أن مقاربتنا ستكون شاملة جامعة، بل إن ما نطرحه لا يعدو أن يكون مجرد أفكار ومقترحات، قابلة في النهاية للنقاش وللنقد وللرد أيضا. لذا سنوجز أهم الأفكار فيما يلي:
I ـ مشكل الكتابة:
نقصد هنا الكتابة بأبعادها الثلاثة: السيناريو، الإخراج، والمونتاج. فكل مرحلة تتطلب مؤهلات فنية وتقنية عالية، كما تتطلب وقتا كافيا لإنجازها. غير أن هذه العناصر لوحدها غير كافية. فالمخرج لوحده لا يمكن أن يصنع فيلما، فالإنتاج عنصر ضروري ومكون أساسي أيضا في هذه العملية. وأي خلل في أحد هذه العناصر سيؤثر بالضرورة سلبا على العمل الفني. لذا، يجب أخذ هذه المعطيات كلها بعين الاعتبار حين نتحدث عن عمل سينمائي ما.
يجب الاعتراف، بأن مشكل السينما المغربية يكمن أساسا في غياب رؤية، وفي فقر المخيال والخيال أكثر منه شيئا آخر. ويعود هذا الفقر أساسا، سواء لدى كاتب السيناريو أو المخرج أو حتى المنتج، إلى غياب خلفية فكرية وثقافية وفنية عموما، وغياب المعرفة بالفن السينمائي على وجه الخصوص.. فلا يمكن أن ننجز فيلما يرقى إلى المستوى المطلوب دون توفر الحد الأدنى في تقارب الرؤى بين هؤلاء الفاعلين الثلاثة. فهذه الخلفية الفكرية هي التي تؤطر رؤية المخرج (قائد الأوركسترا)، ونواياه، وحساسيته، ونظرته للأشياء وللعالم وللإنسان. فالمخرج يكتسب أسلوبه من خلال نهجه الفني الذي يبنيه طوال مساره الفني. وهذا هو الذي يمكننا من فهم وإدراك صيرورته الإبداعية، ومساره وأهداف إبداعه وإنتاجه. إن هذه العناصر كلها هي التي تشكل بوصلة المخرج، وتنعكس على مشروعه السينمائي، وتثبت أصالته وتفرده وتميزه عن الآخرين. إن جلاء الصور من جلاء الأفكار، كما يقول جان لوك جودار. فحين تتضح الرؤية، يتضح المشروع، ويصبح للمخرج هامش حرية أكثر في الارتجال والتجريب، والمخاطرة (Prise de risque)، والتمرد على اللغة السينمائية، وعلى الأجناس…
صحيح أن السيناريو هو مجرد خطاطة أو خريطة طريق يلجأ إليها المخرج لإنجاز فيلمه. لكن ليس كل المخرجين لهم القدرة والكفاءة للاشتغال بهذه الطريقة. وحده من يملك رؤية هو القادر على الاشتعال بهذه الطريقة، وقليلون من نجحوا في ذلك، وشكلوا استثناءً في تاريخ السينما المغربية. في حين أن البقية العظمى من مخرجينا ما زالوا في حاجة إلى سيناريو متماسك، ومحبوك بشكل جيد، وإلى معالجة درامية دقيقة، وإلى نحت الشخصيات، وتحديد سيماتها ومعالمها بدقة، وإلى حوار يكشف عن أبعاد الشخصيات ودواخلها…
II ـ هجرة مخرجي التلفزيون
إلى السينما
هذا مشكل انضاف مؤخرا إلى مشهدنا السينمائي ليزيد طينه بلة، ويدخله في نفق مظلم لا ندري إلى أين سيوصلنا. فجل من أنتجوا «الكوارث التلفزيونية» التي تبث كل سنة في شهر رمضان، هم من زحفوا اليوم كالجراد على مشهدنا السينمائي وأغرقوه بتفاهات، ماهي بأفلام سينمائية ولا هي بأفلام تلفزيونية، إن هي إلا أفلام ممسوخة وبدون هوية. طبعا هذا ليس حكم عام، فالدراما التلفزيونية في الغرب وآسيا تجاوزت قيمتها الفنية والجمالية السينما أحيانا. ولا أحد يجادل اليوم بأن الحدود بين السينما والتلفزيون بدأت تتلاشى تدريجيا بحكم أنهما يستعملان نفس آليات التصوير والمونطاج، وأحيانا نفس الفرق التقنية والفنية. هناك أفلام تلفزيونية ترقى إلى مستوى العمل السينمائي، لكن يبقى الفارق البارز هو على مستوى العرض. فالقاعة السينمائية لها طقوسها الخاصة وسحرها الخاص الذي لا يقاوم. أما عرض سينمائي في التلفزيون فغالبا ما يفقده الكثير من فنياته وجماليته، بل يفقده أحيانا معناه، ويقدمه مشوها حين يتدخل مقص الرقابة لبترعدة أجزاء يرى أنها تخدش حياء المتفرج. فالرقابة على الفن والإبداع التي يمارسها التلفزيون، سواء الرقابة القبلية (قبل التصوير) أو البعدية (أثناء العرض)، تنعكس سلبا على الأعمال السنمائية. وهذا الوضع أفرز لنا فصيلة من المخرجين والمنتجين، وجلهم قادم إلى عالم السينما من التلفزيون، يعرفون حدود الممكن واللاممكن بين هاذين الوسيطين. أصبح هم هؤلاء هو الاستفادة من دعم السينما والتلفزيون في آن واحد. لذلك يستحضرون هذا المعطى أثناء الكتابة والإنتاج والإخراج والمونطاج، وبالتالي يرفعون سقف المراقبة الذاتية على حساب العمل الإبداعي.
III ـ أفلام الصحراء:
تلكم قصة أخرى. فقد أحدث مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، صندوقا خاصا بدعم الفيلم الوثائقي الخاص بالتراث الصحراوي الحساني. وكان الهدف من إنشائه، هو التعريف بالتراث المادي واللامادي الصحراوي من جهة، والتعريف بالقضية الوطنية والترافع عنها سينمائيا من جهة أخرى. غير أن هذا الخلط بين الفعل الإبداعي والفعل السياسي أو «المسيس» سيكون له أثر سلبي ما شهد الزمان السينمائي نظيره. فقد فرخ لنا هذا الصندوق «مخرجين» ودور إنتاج مثل الفطريات، انتشرت في كل ربوع المملكة. وكانت الحصيلة هزيلة مقارنة مع الميزانية المرصودة. فجل هولاء، لا هم أنجزوا أفلاما وثائقية، ولا هم ترافعوا عن القضية الوطنية، ولا هم عرفوا بالتراث الحساني. جل ما أنجزوه هو «شبه روبورتاجات» فارغة، شكلا ومضمونا. فعوض أن يساهم هذا الصندوق في خلق مشاريع سينمائية حقيقية، يكون فيها الجمال والفن هو المعيار أولا وأخيرا، تحول هذا الصندوق بقدرة قادر إلى ما يشبه الريع، إلى درجة أن البعض اعتبره حقا مشروعا. طبعا فهذا الدعم، يستفيد منه كل المخرجين المغاربة بدون استثناء. لكن الغريب في الأمر، أن هناك مخرجين أنجزوا أفلاما عن الصحراء وهم لا يعرفون عنها شيئا، بل ولم يزوروها إلا بمناسبة التصوير. أما بالنسبة للمخرجين الصحراويين، فهم لا يخرجون عن هذه القاعدة. فرغم معرفتهم بمجالهم إلا أن جل ما أنتجوه لا يخرج عن خانات الروبورتاجات التلفزيونية أو حتى أقل منها. ولحسن الحظ هناك دائما استثناءات، رغم أنها تعد على رؤوس الأصابع. وهنا يجب التنويه ببعض المخرجين الشباب من أقاليمنا الجنوبية الذين أنجزوا أفلام جد محترمة مثل، عبد الله محمدي، وسالم بلال، أحمد بايدو، جواد بابيلي، توفيق بابا، إضافة إلى آخرين أنجزوا مجموعة من الأشرطة القصيرة الجميلة التي أنتجت في إطار مختبر الصحراء.
IV ـ بطاقة المخرج
في المغرب، لا يمكن لشخص ما الاستفادة من دعم المشاريع السينمائية، سواء التسبيق على المداخيل أودعم ما بعد الإنتاج، إلا بعد التوفر على بطاقة المخرج. وللحصول على صفة مخرج لا بد من إنجاز فيلم روائي أو وثائقي مطول أو ثلاثة أشرطة قصيرة، ووضع طلب مصحوب بمجموعة من الوثائق. تعرض هذه الأفلام على لجنة يعينها المركز السينمائي للبت في من يستحق هذه البطاقة من عدمها. يعتبر هذا الإجراء حسب السلطة الوصية على القطاع، إجراء إداريا يهدف إلى تقنين هذه الحرفة. كنا سنقبل هذا المعيار، لو أن اللجن كانت صارمة ومنصفة في اختياراتها، لكن للأسف الشديد، فإن الأمور لا تسير دائما بالشكل السليم. وما منح هذا الكم الهائل من البطاقات سنويا إلا دليل على عدم الوضوح في تسليمها. فعلى سبيل المثال، تم توزيع 346 بطاقة مخرج مابين 2017 و2021، حسب الحصيلة السينمائية بالمغرب لسنة 2021. فإذا افترضنا أن كل مخرج وضع ثلاثة أشرطة قصيرة، معناه حسابيا 346x 3 = 1038 شريطا قصيرا. فهل كل هذا العدد الهائل من الأشرطة التي قدمها أصحابها توفرت فيها الجودة الفنية والجمالية المطلوبة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتم دعم هؤلاء الشباب المخرجين، إن كانوا مبدعين حقا؟
لا ندري من هي الجهة التي أقحمت تعسفا هذا البند الذي أصبح شرطا أساسيا للحصول على الدعم. الكل يعرف أن البطاقة لا تصنع لا مخرجا ولا فنانا. فالكثيرون يحملون مشاريع مهمة، لكنهم لا يتوفرون على هذه «البطاقة السحرية». لقد حان الوقت لإلغاء هذه البطاقة، وأن يتم الاحتكام، أولا وأخيرا، إلى المشروع الجيد، عوض الاستمرار في توزيع البطائق بهذا الشكل السخي الذي لم ينتج لنا سوى «الخردة». قلناها ونعيدها مرارا «لا يمكن الرهان على الكم من أجل الكيف».
IV ـ الدعم والإنتاج
«قالو باك طاح، قالو من الخيمة خرج مايل» مثل مغربي يضرب للشخص الذي يفتقد للأهلية الصحية والكفاءة اللازمة للمشي بالشكل السليم، لذلك فسقوطه متوقع ما دام خروجه من المنزل كان متعثرا.
لعل الساهرين على الشأن السينمائي ببلادنا لم يستوعبوا بعد كنه هذا المثل المغربي العميق. والحال أن ما نشكوه من ضعف في جل أفلامنا المغربية، في كل دورة من دورات المهرجان، راجع بالأساس إلى تعثر في المنطلق. فالتعثر يبدأ من الكتابة والإعداد، وصولا إلى التصوير والمونطاج، ثم إلى التوزيع. ولا بد من الإشارة هنا أن لجان الدعم تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فيما وصلت إليه السينما المغربية من تعثر، إلى درجة أن أحد المخرجين قال حين شاهد مجموعة من الأفلام في طنجة: « يبدو لي أن الناس أصبحت تفعل ما تشاء». فكيف يسمح أعضاء هذه اللجن بمرور مشاريع ضعيفة وتافهة لا تتوفر فيها أدنى الشروط التي يمكنها أن تتوفر في عمل سينمائي بسيط، فبالأحرى محترم؟ وماهي المعايير «إن كانت موجودة أصلا» التي تستند إليها اللجنة في تقييمها للمشاريع قبل منحها الدعم؟ هل المعيار هو السيناريو، أم المخرج أم المنتج؟ أم تأخذ هذه العناصر كلها بعين الاعتبار؟ ثم ما طبيعة تركيبة هذه اللجن أصلا، وعلى أي أساس ومعيار يتم اختيارها؟
أسئلة عديدة تطرح في كل مرة، وتثير نقاشا ساخنا، وأحيانا سخطا عارما في وسائل التواصل الاجتماعي. لكنها سرعان ما تخمد وتذهب أدراج الرياح ما دام لم يفتح نقاش عمومي صريح بين كل الفاعلين السينمائيين. ولعل ما يعطل هذا النوع من النقاش الصريح هو تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. فمعظم الفاعلين السينمائيين، سواء كتاب سيناريو، أو مخرجين أو منتجين أو غرف مهنية، يبحثون عن الدعم بكل السبل.
يجب الجزم مسبقا أنه ليس لدينا منتجين حقيقيين بقدر ما لدينا منتجين منفذين. فإذا ما استثنينا بعض الأشخاص الذين يؤمنون بالسينما ويستثمرون فيها، وهم قلة قليلة، يعدون على رؤوس الأصابع، فإن البقية تعول على الدعم. ولعل هذا ما جعل الجشع يتكاثر ومعه عدد المنتفعين. فالمركز السينمائي وزع 434 بطاقة منتج مابين 2017 و2021. وهذه أرقام ضخمة إذا ما قارناها بعدد الإنتاجات سنويا، سواء تلفزيونيا أو سينمائيا.
وإذا كانت هذه القلة، وسط هذا الكم الهائل، هي من ينتج بين الفينة والأخرى أفلاما من مالها الخاص، رغم أنها تطمح في دعم ما بعد الإنتاج، فإن الغالبية العظمى تطمع كليا في التسبيق على المداخيل لإنتاج الأفلام. طبعا فالتسبيق على المداخيل يشكل ثلثي ميزانية الفيلم، ويفترض في المنتج أن يبحث عن الباقي. غير أن المفارقة الكبرى، هي أن المنتج غالبا ما ينجز الفيلم بجزء من هذا التسبيق على المداخيل ويحتفظ لنفسه بهامش ربح كبير. لم أسمع بحسب علمي المتواضع أن منتجا أعاد المال إلى المركز السينمائي المغربي. طبعا هذا الوضع أفرز لنا صندوق دعم أشبه بصندوق ريع أو بقرة حلوب، لدرجة أن مخرجين بعينهم استفادوا منه عشرات المرات، دون أن يتركوا الفرصة للأعمال السينمائية الأولى والثانية، ولبعض المخرجين الشباب، أن يظهروا للوجود. ولهذا السبب أجزم بأنه لن يكون لدينا منتجون مستقلون أبدا، ولن يتطور الإنتاح في المغرب ما دام الكل يراهن على صندوق التسبيق على المداخيل.
يدور حاليا نقاش بين الفاعلين السينمائيين حول عزم الوزارة الوصية على القطاع السينمائي إعادة النظر في سياسة الدعم. إذ تقترح هذه وزارة، حسب بعض المصادر، إلغاء التسبيق على المداخيل، والاحتفاظ فقط بمنحة الدعم ما بعد الإنتاج مع الزيادة في الميزانية المخصصة لها. ويأمل هذا القرار أن يرغم المنتجين على الاستثمار في السينما، وإنتاج الأفلام بشكل مستقل سواء من مالهم الخاص أو عن طريق الإنتاج المشترك. وبعد إنتاج الفيلم يعرض على لجنة «دعم ما بعد الانتاج» لمشاهدته وتقييمه فنيا وجماليا، وتحديد كلفته الإجمالية قبل البت في المنحة المستحقة.
نظريا، يعتبرهذا القرار قرارا صائبا وسليما، لعدة أسباب: أولا، سيبعد بعض المتطفلين عن هذا القطاع، وسيعيد المنتجين الحقيقيين إلى الواجهة. ثانيا، سيجبر المنتجين على احترام الحد الأدنى للعمل الإبداعي. فلا يمكن الاستمرار في دعم مخرجين يفتقرون إلى الخيال والمخيال، وإلى خلفية فكرية ورؤية فنية وجمالية، وإلى منتجين يفكرون في قضم ميزانية التسبيق على المداخيل على حساب الإبداع. ثالثا، سيمكن هذا القرار من إبعاد المتطفلين، لأن المنتج سيضرب ألف حساب قبل الإقدام على أية مغامرة مع أي مخرج كان. رابعا، سيعطي الفرصة للمبدعين الحقيقيين الذين يؤمنون بأن السينما بالنسبة إليهم هي مسألة وجود وليست مسألة استرزاق. طبعا يبقى هناك تخوف البعض من هيمنة «مول الشكارة» وإفراغ السينما من مضمونها الحقيقي ومهمتها النبيلة، وتحويلها إلى مجرد سلعة تباع وتشترى كباقي السلع. وهو تخوف مشروع، خصوصا حين ترى بعض الأفلام التي أنتجها بعض الخواص مؤخرا تغزو السوق على حساب أفلام أخرى.
لكن يبقى نجاح هذا المشروع رهين بتفعيل قوانين وضوابط واضحة وشفافة، وبإحداث لجان تتوفر فيها الشفافية والنزاهة والكفاءة. ورهين أيضا بوجود منتجين لهم تجربة ورؤية ومشروع سينمائي يدافعون عنه. كل هذه المعايير ستبعد صيادي المنح و»مول الشكارة» الذين يسعون، أولا وأخيرا، للربح، دون إعارة الحد الأدنى للإبداع السينمائي.
وفي حالة فشل تمرير هذا القرار إن وجد أصلا، رغم أن الغرف المهنية تعارضه بشدة على مابيدو من خلال النقاش الدائر في الكواليس، فإن الاحتفاظ بالتسبيق على المداخيل، بالصيغة الحالية، لم يعد ممكنا، ووجب إعادة النظر فيه كليا.
هناك اقتراح غريب يروج له بعض المخرجين، وهو اقتراح أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه عبثي وساذج، وينم عن عقلية انتهازية وانتفاعية بامتياز. يفيد هذا الاقتراح تخصيص صندوق خاص بالمخرجين القدامى، وعدم إقحامهم مع باقي المخرجين، خصوصا أصحاب الأعمال الأولى والثانية. وبهذا المعنى، يصبح عامل السن والأقدمية في الحرفة، حسب هؤلاء، محددا أساسيا في الاستفادة من الدعم، أما الإبداع وجودة المشروع، فتأتي في الدرجة الثانية. كل صناديق الدعم في العالم تدعم المشاريع حسب أهميتها وجودتها وأصالتها، وليس حسب أقدمية المخرجين وتقدمهم في السن. المفارقة الكبرى هي أن ما يسمى بجيل الرواد الذي أنتج أعمالا سينمائية محترمة، لم ينتج مؤخرا سوى أفلام باهتة، تراوحت قيمتها «الفنية والجمالية» بين الضعيفة والمتوسطة.
مقترحات لتطوير الدعم
لقد اقترحت منذ مدة ليست بالقصيرة بعض الأفكار حول الدعم، نشرت في جريدة الاتحاد الاشتراكي، وفي «عين على السينما» التي يشرف عليها الناقد والكاتب المصري أمير العمري. وأعيد نشرها هنا مع تحيينها على ضوء المستجدات الحالية، مساهمة مني في النقاش الدائر حاليا حول سياسة الدعم.
من ضمن هذه المقترحات:
ـ إعادة النظر في سياسة «الكم من أجل الكيف» التي أثبتت بالملموس عدم نجاعتها. فما معنى أن ننتج سنويا، كما من الأفلام يربو عن العشرين فيلما مطولا والعديد من الأفلام القصيرة والوثائقية، يفتقر معظمها إلى الحد الأدنى من الإبداع؟ إن البلدان التي اعتمدت سياسة الكم، هي بلدان متقدمة اقتصاديا ويلعب فيها المنتجون الخواص، من أشخاص و شركات وقنوات تلفزيونية، دورا أساسيا في الاستثمار في الصناعة السينمائية. أما أن ينتظر «منتجونا» التسبيق على المداخيل لإنتاج الأفلام، فهذا لن يطور السينما وصناعتها على الإطلاق. والحالة هذه، لا بد من الرهان على الكيف، وذلك بعقلنة الانتاج ووضع لجن دعم ذات كفاءة وتجربة وخبرة لضمان جودة الأفلام، والحد من نهب المال العام.
ـ إحداث ثلاث لجن مستقلة للدعم يتم اختيارها وفق معايير محددة، على أن تعقد اجتماعاتها في دورتين في السنة بدل ثلاثة، وذلك لإعطائها الوقت الكافي لقراءة وتقييم المشاريع المقترحة فنيا وجماليا وماليا أيضا، كل حسب اختصاصاته.
1ـ لجنة الانتقاء الأولي:
تشرف على هذا الانتقاء الأولي لجنة قراءة مكونة من فاعلين ثقافيين وفنيين، شريطة أن يكونوا سنيفيليين. تتكلف هذ اللجنة بقراءة كل السيناريوهات المقترحة للدعم، قراءة متأنية والبت فيها وفق معايير محددة مسبقا. وبعد الانتهاء من القراءة تسلم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن المشاريع المنتقاة وتسليمها للجنة الفنية، على ألا يتجاوز عددها العشرة في كل دورة. هذا الإجراء سيعفي اللجنة الفنية من قراءة عشرات المشاريع عديمة الجدوى، وسيربحها وقتا ثمينا يمكن أن تستثمره في قراءة المشاريع المنتقاة بأريحية، عوض الاشتغال تحت الضغط كما هو الحال في كل دورة.
2 ـ اللجنة الفنية:
تتحدد مهمة هذه اللجنة الفنية في قراءة السيناريوهات المنتقاة من طرف لجنة الانتقاء الأولي، قراءة دقيقة ومتأنية، وتقييمها مع أخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة في صناعة الفيلم (السيناريو والإخراج والإنتاج). فالسيناريو وحده ليس المعيار الوحيد لمنح الدعم، بل يجب أخذ بعين الاعتبار المخرج وأعماله السابقة، وكذلك منتج الفيلم وإنتاجاته السابقة، مع استحضار مساريهما وسمعتهما أيضا.
أما بخصوص الأعمال الأولى والثانية، فيجب مشاهدة الأعمال السابقة، لمعرفة نهج المخرج، وطريقة إخراجه للعمل. وبعد التقييم تستدعي اللجنة كل مخرج على حدة، باعتباره المسؤول الأول عن الفيلم وموقعه، وتناقش معه تفاصيل الفيلم، قبل البت في اللائحة النهائية للمشاريع التي تستحق الدعم. كما تحدد هذه اللجنة لائحة كتاب السيناريو المستفيدين من منح إعادة الكتابة، على أن تصرف له مباشرة في حسابه الخاص.
وبعد انتهاء هذه اللجنة من أشغالها، تسلم تقريرا مفصلا إلى اللجنة التقنية. غير أنه لا يحق للجنة الفنية أن تحدد أو تتدخل في قيمة الدعم المالي للمشاريع المنتقاة، بل ينحصر دورها في تقييمها فنيا وجماليا. كما تسلم للمخرج، في حالة اختياره، تقريرا مفصلا عن مشروعه يتضمن كل مكامن القوة والضعف. بدل الاكتفاء بملاحظات عامة وفضفاضة ومقتضبة، التي لا تفيد العمل في شيء. ونفس الشيء في حالة حصول المشروع على منحة إعادة الكتابة (وإن كنت أفضل أن يتم تخصيص جزء من هذا المبلغ المالي لـ (Script Doctors) متخصصين في قراءة السيناريو وتطويره، كما هو معمول به في محترفات الأطلس التي ينظمها مهرجان الفيلم بمراكش.
تتكون هذه اللجنة من رجال الفكر والثقافة والفن (كاتب، وروائي، وناقد فني، وناقد سينمائي، وفنان تشكيلي، ومخرج سينمائي، وسيناريست، وأستاذ جامعي وغيرهم…)، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا سنيفليين، ويجب أن يكون هذا الشرط أساسيا وحاسما في اختيارهم، لأن قراءة السيناريو تحتاج لمعرفة دقيقة بآليات كتابته، ومعرفة باللغة السينمائية، وبالسرد والدراماتورجيا، ولهم ثقافة ومرجعيات سينمائية. كما يشترط أيضا أن لا يتم إقحام أي ممثل عن القطاعات الوزارية والمهنية في هذه اللجنة حفاظا على استقلاليتها. كما يُستحب أن تولي هذه اللجنة عناية خاصة لسينما المؤلف والسينما التجريبية، شريطة أن تتوفر فيها الجودة المطلوبة. وذلك لعدة أسباب: أولا، لأن سينما المؤلف عادة ما تخرج عن المألوف، وتجد صعوبة في إيجاد قنوات التمويل والتوزيع. ثانيا، لأن جل المنتجين لا يغامرون في إنتاج هذه الأفلام لأنها لا تذر عليهم أرباحا كبيرة. وثالثا، لأن هذه السينما بأبعادها الثقافية والفنية والجمالية هي التي سترفع من مستوى السينما ببلادنا، وهي من سيمثلنا في كل المهرجانات العالمية.
كما يجب أيضا إعطاء الأولية للعملين الأول والثاني، شريطة أن يكون معيار الجودة هو المحدد في هذه الاختيارت كلها.
3 ـ اللجنة التقنية والمالية:
تتكلف اللجنة التقنية والمالية بدراسة وفحص وتقييم كل التفاصيل التقنية للسيناريوهات المنتقاة، لتحديد ميزانية الفيلم وفقا لمعايير موضوعية وعقلانية، وذلك بعد مناقشتها مع منتج فيلم. ويعهد إلى هذه اللجنة كذلك، مراقبة مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، للتأكد من أن الميزانية المرصودة قد صرفت فعلا على الفيلم وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات. ويمكن أن تتألف هذه اللجن من ممثلين عن الغرف المهنية والقطاعات الوزارية.
وترشيدا للنفقات، يجب عدم السماح للمخرجين بجمع صفات متعددة داخل الفيلم الواحد، إذ غالبا ما نجد أن مخرج الفيلم هو نفسه المنتج أو المنتج المنفذ، وكاتب السيناريو، وصاحب الحوار، والموظب، والممثل الخ. فإذا ما استثنينا الجمع بين الاخراج وكتابة السيناريو التي تبدو أحيانا منطقية، فإن الجمع بين كل الصفات الأخرى في فيلم واحد لا ينم في غالب الأحيان عن عبقرية المخرج، وقدرته الهائلة على ممارسة كل هذه المهام، بقدر ما هي وسيلة للسطو على ميزانية الفيلم. طبعا مثل هذه الممارسات تقلل من فرص الشغل بالنسبة للتقنيين والفنيين.
يجب أيضا، أن يتم تحديد عدد المرات التي يستفيد منها المخرج من الدعم. فلا يعقل أن يمنح بعض المخرجين الدعم كل سنة رغم أن بعض أفلامهم تكون أحيانا جد متوسطة، في الوقت الذي يستثنى فيه آخرون يحملون مشاريع محترمة، خصوصا من المخرجين الشباب.
إن فصل هذه اللجن الثلاثة واختيارها وفقا لمعياري الكفاءة والنزاهة، وضمان كل الشروط المناسبة لعملها سيعزز بكل تأكيد من استقلاليتها، ويضمن بالتالي جودة الفيلم السينمائي بعيدا عن منطق الكم الذي راهنا عليه كثيرا دون جدوى. كما سيغلق الباب على بعض السماسرة الذين عاتوا فسادا، ويتدخلون في عمل اللجن والضغط عليها أحيانا. طبعا يبقى تحقيق كل هذا رهينا بتغيير بعض القوانين المنظمة للقطاع وبتوفر إرادة سياسية حقيقية في تطوير السينما.
IV ـ القاعات السينمائية:
لا يمكن تطوير السينما وخلق سوق داخلية دون الاستثمار في القاعات السينمائية. لقد تم منذ سنوات الإجهاز على مجموعة من القاعات السينمائية بالمغرب. فمن 256 قاعة سينمائية وصلنا إلى حوالى ثلاثين قاعة بما فيها المركبات السينمائية، أي ما مجموعه 56 شاشة في عموم المملكة. وهذا رقم مخيف وهزيل إذا ما قارناه مع فرنسا التي نتباهى دائما بمقارنة أنفسنا معها. ففرنسا تتوفر على 5241 قاعة سينمائية، استقطبت هذه السنة إلى حدود شهر شتنبر 2022، 104,97 ميلون متفرج، علما أن هذا العدد سجل تراجعا بنسبة 30٫3-ـ مقارنة مع سنة 2019. والمفارقة الكبرى أنه خلال شهر واحد فقط، أي شتنبر الماضي 2022 بلغ عدد التذاكر التي بيعت فرنسا حوالي 7٫38 تذكرة، متجاوزة عدد التذاكر التي بيعت في المغرب طيلة خمس سنوات (من 1017 إلى 2021)، والتي سجلت في حدود 6.294.172 تذكرة فقط. أما بخصوص المداخيل فقد بلغت في فرنسا أكثر من 672 مليون يورو سنة 2021، فيما بلغت المداخيل في المغرب طيلة الخمس سنوات الأخيرة حوالي 28 مليون يورو. هذه الفوارق الضخمة تؤكد بالملموس أننا بعيدون كل البعد عن الصناعة السينمائية.
لقد وعد الوزير الحالي المشرف على قطاع السينما بفتح 150 قاعة سينمائية خلال متم السنة الحالية (2022)، وهو مشروع سينعش القطاع السينمائي لا محالة إن أنجز. كما سيساهم في الترويج للأفلام، خصوصا الوطنية منها. ولكن لحدود الساعة، وبينما ما زالت تفصلنا عن متم السنة أقل من ثلاثة أشهر، لا ندري أين وصل هذا المشروع. على أي نبقى متفائلين ونتمنى أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره. والخلاصة، أن القاعة السينمائية جزء من الصناعة السينمائية، ويمكنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إذا استثمر فيها الخواص بشكل كبير،لأن الدولة لا يمكنها أن تستثمر لوحدها في القاعات
.
باحث في الصورة