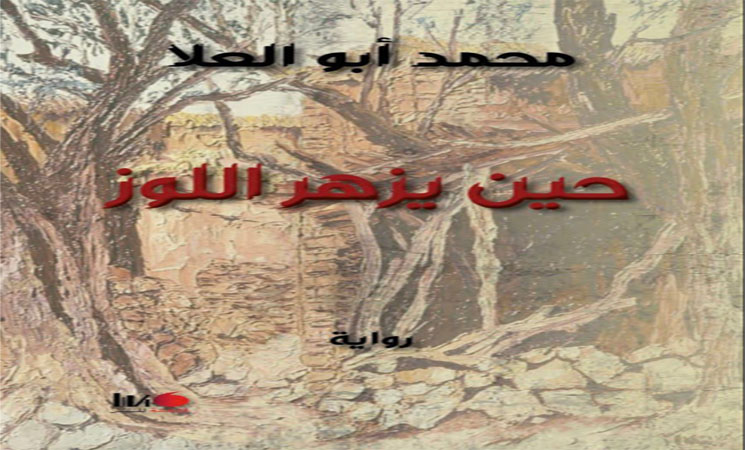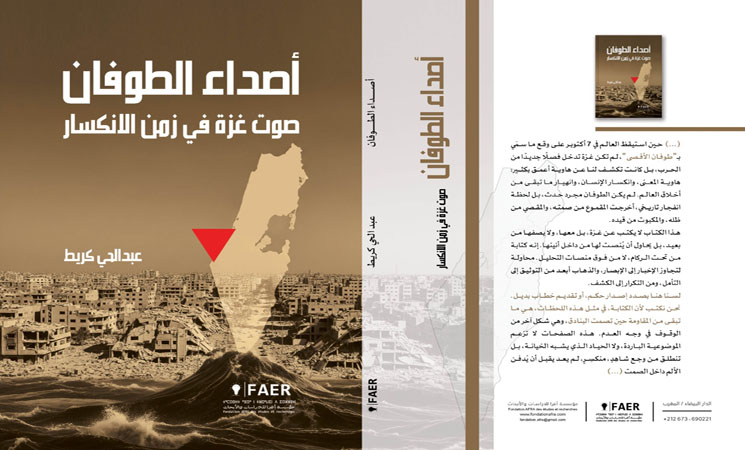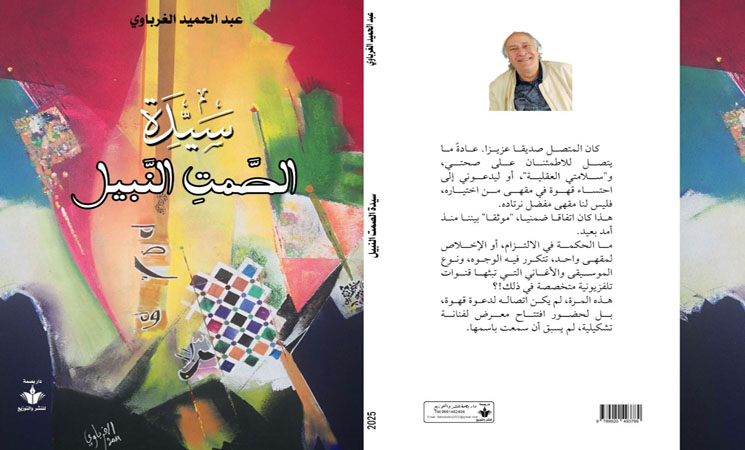يذكر ابن خلدون في الفصل السادس من مقدمته أن «العرب أمة وحشية”، ويتهمهم بعدم «الانقياد للسياسة”، وهو يعرف بأن السياسة مرتبطة بالحضارة والمدنية منذ أرسطو، ويقول (ابن خلدون) بأن طبيعتهم «منافية للعمران مناقضة له”…
طبعا تلقف الكثير من الكتاب الغربيين هذا الرأي السلبي لابن خلدون عن “العرب”، واعتبروه شهادة واضحة من عالِم ينتمي الى الثقافة العربية الإسلامية، حتى أن گوتيي مثلا يتساءل: «هل هبت رياح النهضة الغربية عبر الأندلس حتى نزلت على روح ابن خلدون؟»، ونسي گوتيي وأمثاله أن النهضة الغربية لم تبدأ الإ بعد وفاة ابن خلدون بحوالي مائةعام!
وقد حاول جرمان عياش حل هذا الإشكال الذي طرحه ابن خلدون في مقدمته عن «العرب”و سلوكهم الدنيء، متسائلا: كيف يمكن لنا أن نقبل وصف ابن خلدون للعرب بالوحشية وهم من أسسوا حضارة مشهود بعظمتها وقوتها في التاريخ البشري، وذلك رغم كل ما يمكن أن يقال من أنها حضارة غير عربية في عمقها، و أن السريان المسيحيين والفرس هم من صنعوا تلك الحضارة المنسوبة للعرب وأعطوها كل قوتها وزخمها. وحتى لو أقررنا بذلك، وهو أمر محقق بالفعل، وأشار إليه ابن خلدون نفسه، فإن ذلك لا يمنع من أن جهاز الحكم العربي هو من شجع العلوم وهو من عمل على ترجمة الفلسفة والمعارف القديمة، وهو من شجع الإنتاج المعرفي والعلمي والفلسفي، ورصد لذلك الأموال الطائلة، مما يجعلنا نقول بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية في العصر العباسي كانت بقرار من الدولة وبإيعاز منها.
إن الحضارة العربية الإسلامية أمر محقق تاريخيا، سواء بوجهها المادي المتمثل في العمارة والتشييد والبناء والصناعات الحربية، أو بوجهها اللامادي المتمثل بالعلوم والمعارف وازدهار اللغة العربية وآدابها…
وبالعودة الى جرمان عياش، فإنه يعتبر بأن ابن خلدون يقصد بوصفه القدحي ذاك، نوعا معينا من العرب. فقد اعتبر بأن العرب نوعان:عرب البادية الذين يعتمدون على نظام القبيلة كما كان عهدهم في العصر السابق على الإسلام،
والنوع الثاني هم العرب المتحضرون، وهم عرب دولتي بني أمية و بني العباس في الشام والعراق، وكذلك عرب الأندلس في المغرب الإسلامي، يقول جرمان عياش :” فهل يتصور أحد أي تشابه بين قصر الحمراء بغرناطة وبين الخيام التي يتحدث عنها ابن خلدون” (دراسات في تاريخ المغرب،ص:36)، ويضيف أيضا بأن استعمال لفظ العرب للدلالة على الأعراب أمر دارج في عصر ابن خلدون…
لكن رأي جرمان عياش يصطدم باعتراض قوي، فابن خلدون يذكر في موقع آخر من مقدمته كلمة”أعراب”، أي أنه يعرف تماما الفرق في الاستعمال بين الكلمتين، خصوصا وأن استعمال الاولى مكان الثانية لاشك سيخلق الالتباس،
وهو يتحدث في الفصل الرابع من الباب الثاني من مقدمته عن أهل مكة المتحضرين، ويتحدث من جهة ثانية عن «الأعراب”على أنهم أهل البادية، و قد جاء في قوله صراحة: «بادية الأعراب”، وهنا يمكن الرجوع الى التفسير الذي أعطاه محمد عابد الجابري لهذا الإشكال، وذلك في دراسته المعروفة حول ابن خلدون والمعنونة ب»العصبية والدولة في فكرابن خلدون»،إذ أن الجابري يخلص إلى أنه من غير المعقول أن يتحدث ابن خلدون عن العرب كجنس بشري بهذه النزعة العنصرية العنيفة، ونحن لا نجد في سلوكه ولا في سيرته ما يدل على تلك النزعة، والجابري يرجح أن ابن خلدون كان يتحدث عن قبائل بني هلال وبني سليم، والتي عملت على تخريب إفريقية والمغرب الأقصى، في إطار لعبة تصفية حسابات بين الفاطميين وحكام شمال إفريقيا الذين تمردوا على الحكم الفاطمي…
انطلاقا من كل ما سبق، لا يجب إغفال منطق التاريخ وجدليته، فهو يبين لنا بأن التوحش والبداوة والنزوع الى التخريب ورفض الحضارة ليست معطيات ثابتة عند أي مجتمع بشري، إنها مرتبطة بالطور التاريخي الذي يعيشه المجتمع المذكور ومدى نضج الشروط الحضارية من عدمها، وابن خلدون نفسه يورد هذه الملاحظة في مقدمته،عندما يقول: «إن الأعراب كلما نزلوا الأرياف وتفتقوا النعيم… نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم” الباب 2/الفصل 16.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن التوحش والبداوة يحولان الى دعة وتمدن بعد الاستقرار في إطار مجتمع معين، أي أن التوحش مرتبط بمرحلة تاريخية يسود فيها شظف العيش وقساوة الظروف، ويمكن مقارنة هذا الأمر مع القبائل الجرمانية التي تحولت الى الحضارة بعد تغيير الشروط التاريخية.
إننا لا نريد نفي تهمة العنصرية عن ابن خلدون بأي ثمن، ولكن القارئ اليقظ لابن خلدون يخرج بخلاصة محقفة، وهي أن ابن خلدون لا يعتبر التاريخ معطى جوهريا، ورغم أن ابن خلدون محكوم بالمنطق الأرسطي في مجمل منهجه كما بين عبد الله العروي، إلا أنه يعتبر التغير والتطور هو السمة الأساسية للطبيعة والتاريخ، وهو بذلك لا يمكن أن يعتبر بأن العرب كجنس بشري يمتلك طبيعة خاصة به تتمثل في الوحشية وعدم التحضر،أي أنه كمؤسس لعلم الاجتماع و كعارف بقانون التاريخ وتطوره الذي يسميه «علم العمران”، فإنه لا يمكن أن يسقط في هذه النظرة العنصرية.
ابن خلدون، هل كان عنصريا تجاه «العرب»؟

الكاتب : دهراوي عبد الهادي
بتاريخ : 23/11/2019