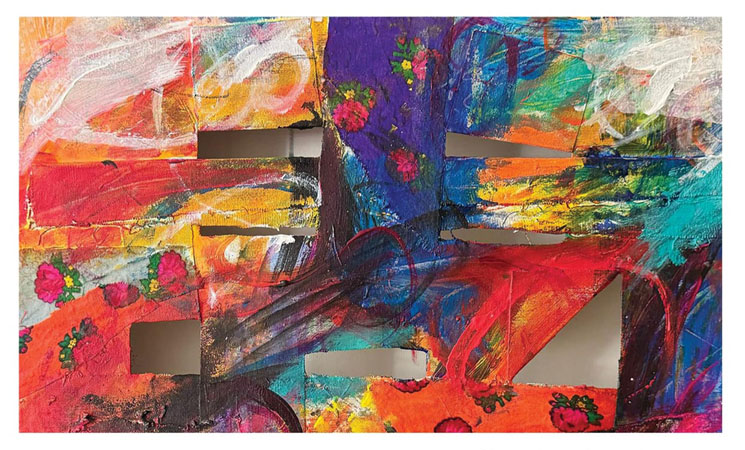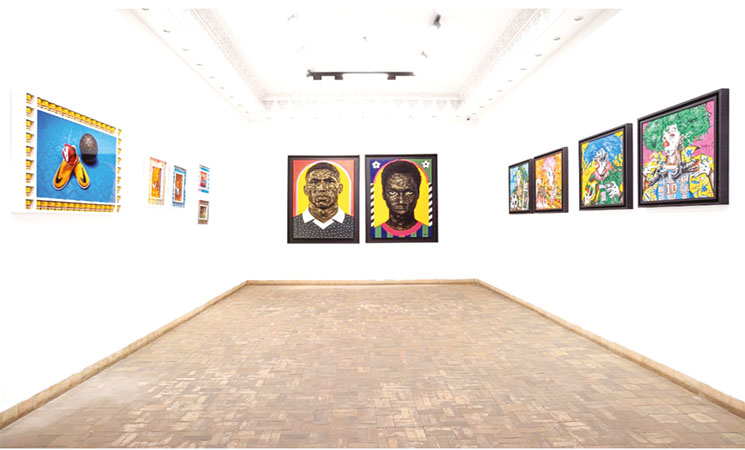نال الصديق القاص والناقد الفني محمد اشويكة شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، بعد مناقشة أطروحته: “التفكير الأنطولوجي في السينما: ستانلي كافل Stanley Cavelle نموذجا”، وذلك بكلية آداب بنمسيك (الدار البيضاء)، شعبة الفلسفة (تكوين: الفسلفة والشأن العام) ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.
الأطروحة التي كانت تحت إشراف د. عبد العلي معزوز، جرت مناقشتها من قبل الأساتذة ( د. محمد مزيان، د. مولاي إدريس الجعايدي، د. عبد اللطيف محفوظ).
في ما يلي نص التقرير الذي تقدم به د. محمد اشويكة:

-1-
بدأ اهتمامنا بالمتن الكاﭬيلي منذ تسعينيات القرن المنصرم، وذلك في سياق الانفتاح على المبحث الإستيطيقي في السينما، وهو ما كان مقرونا برغبة حثيثة في رفد قراءاتنا بِنَفَسٍ جديد، وهي التي كانت منصبة على بعض المتون الفرنسية أو المترجمة منها وإليها وكذا إلى اللغة العربية، وخاصة ما قدمه الألمان والروس وغيرهم سواء كانوا باحثين أم نقادا أم مخرجين.. حينها بَدَأَتْ ترجمة كتب الفيلسوف المتعدد ستانلي كاﭬل (1926 – 2018) إلى اللغة الفرنسية ونقصد هنا كتابه الهام “عرض العَالَم” الذي شكل قفزة نوعية في فلسفة السينما والدراسات السينمائية بشكل عام، وفسح مجال البحث أمام مقاربات فلسفية أنجلوساكسونية جديدة حول السينما.
بعد الانغماس في المجال السينمائي بشكل عاشق داخل الأندية السينمائية، والاشتغال في مجالاته المِهَنِيّة المختلفة، لاحظنا بأن الحقل السينمائي المغربي والعربي في حاجة ماسة إلى رفده بدراسات سينمائية فلسفية وأكاديمية ما دامت الأفلام والممارسة السينمائية قابلة بأن تكون مادة خصبة للدرس والتحليل والتأمل، وهو ما يمكن تحقيقه عبر آليات النقد السينمائي وفن السينما. إن الندرة الملحوظة على مستوى هذا النوع من الأبحاث، شجعتنا على خوض المغامرة، وانتظار سنوات طوال كي يتسنى لنا مناقشة هذه الأطروحة؛ إذ يبدو أن البحث الأكاديمي الفلسفي بالمغرب لم يكن مستعدا للإقدام على الغوص في مثل هذه المسائل.
لم يكن الإقبال على هذا البحث يسيرا، بل اعترضتنا صعوبات كثيرة حاولنا تدليلها بشكل متدرج؛ إذ كان أولها تسجيلُ نوع من الرفض لمثل هذا الأطاريح في الوسط الأكاديمي وقد واجهنا هذا منذ بحثنا في الإجازة لأن مشروعنا البحثي اختط لنفسه استراتيجية طويلة النَّفَس تتغيا الخوض في المجال السمعي البصري عامة، والسينما خاصة، من داخل الفلسفة والعلوم الإنسانية؛ وثانيها عدم تناول المتن الكاﭬيلي باللغة العربية باستثناء بعض المقالات والإشارات والتعريفات والمقالات العامة، وكذا عدم توفر كل مؤلفاته باللغة الفرنسية مما أتاح لنا الفرصة لقراءة ما وصلنا إليه بلغته الأصلية، وهناك من المصادر والمراجع ما قرأناه باللغتين الفرنسية والإنجليزية مما أغنى معارفنا، وزود أطروحتنا بجرعات هائلة من التثاقف والانفتاح والتلاقح، فتزويد المجال الأكاديمي المغربي والعربي بمقاربات فلسفية جديدة يشكل تحديا في حد ذاته، سيما وأننا واجهنا مشكلات جمة على مستوى الترجمة والتعريب وتوطين المصطلحات الفنية والتقنية.. ولعل ما ضاعف حجم الصعوبات أن الفيلسوف ستانلي كاﭬل يكتب نصا فلسفيا يمكن تصنيفه ضمن الفلسفات غير النسقية التي تشكل رِيزُوماً متشابكا ومتواشجا يقود نحو التركيب العميق للقول الفلسفي.
لم تقتصر أطروحتنا على الجمع بين اللغات، وإنما تَعَدَّدَ مفهوم القراءة داخلها؛ إذ لم يكن تناول المتن الكاﭬيلي في شقه الفلسفي السينمائي مفهوما دونما العودة إلى الأفلام التي تناولها بالتأمل والتحليل، وتلكم صعوبة أخرى.. فبعض الكتب والأفلام متوفر، وبعضها حصلنا عليه بصعوبة بالغة، فقد شاهدنا عشرات الأفلام، واطلعنا على عدد من الدراسات التي تناولتها كي نصل إلى فهمها ومقارنة تأويلاتها مع ما ذهب إليه التحليل الكاﭬيلي، وذلك ما أتاح لنا ربطها بمختلف القراءات التي استطعنا التوصل إليها، وهي غزيرة.
ساعدنا التواصل مع الفيلسوف ستانلي كاﭬل قبل وفاته الذهابَ رأسا إلى بعض المصادر والمراجع، فقد زودنا قبل رحيله ببيبليوغرافيا شاملة لكتبه وأهم البحوث والدراسات التي تناولته بالإنجليزية، وكذا بما تمت ترجمته من كتبه وبحوثه إلى الفرنسية، فقد كان سعيدا بأن يَطَّلِعَ الباحثون العرب على منجزه، بل وقد كان متحمسا للقدوم إلى المغرب ضمن سياق أكاديمي معين، لكن المرض حال دون إكمال تواصلنا، فجاءت الموت ولم يتحقق حلمه، ولكنني أحس بروحه تتجول بيننا لأنني أوفيت كل التزاماتي معه مقابل تواضعه وتواصله ودعمه لنا بعد أن بلغ أعلى الدرجات العلمية، وحضي متنه بالانتشار والتأثير العالمي. فضلا عن هذا فتحنا باب التواصل مع أستاذة الفلسفة بجامعة السوربون، الفيلسوفة الفرنسية “ساندرا لوگيي” (Sandra Laugier) التي ترجمت أهم كتب ستانلي كاﭬل إلى الفرنسية، وأنجزت دراسات مرجعية حول فلسفته مما سهل علينا ولوج متنه المتشابك.
طالما ساعد البحث الأكاديمي السينما في مراجعة ذاتها باستمرار، وذلك بغيةَ وضعِ تقييمٍ جمالي من خارج دواليبها، فقد راكم هذا الفن تقليدا خاصا جعل التنظير يرافقها خطوة خطوة، وهو ما بَدَا لنا جليا في المتن الكاﭬيلي الذي فتح السينما على الفلسفة بشكل مغاير؛ إذ يمكن الحديث عن تفلسف مزدوج في هذا الباب:
لم نتناول المتن الكاﭬيلي الخاص بالسينما بمعزل عن روافده الفلسفية فحسب، وإنما حاولنا توظيفه ضمن نظرية السينما (اجتهاداته بخصوص الأنواع السينمائية ككوميديا الزواج الثاني مثلا)، وخاصة في شقها النقدي الذي قام (ولو بشكل ضمني) على أساس جمالي كانت غايته توليد المعايير، وهو الأمر الذي يتجلى بوضوح فيما قام به ستانلي كاﭬل باعتماده في صياغة نظريته السينمائية النقدية على الفكر من جهة، ورؤى المؤلفين السينمائيين من جهة أخرى.
لم يراجع كاﭬل تاريخ السينما، ولكنه عاد لممارسة السؤال الأنطولوجي استنادا على الأفلام الكلاسيكية الهوليودية الأكثر شعبية (فيما بين الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي)، وذلك لجلب جماهيرها العريضة نحو الفلسفة، وهو بذلك يقترح تعريفا مختلفا لإستيطيقا السينما لا يستند بالضرورة على الواقعية التي سعت في عموميتها إلى تحديد وتطبيق فكرة معينة على السينما، بل إن دراساته وتأملاته أحدثت نوعا من التعالق الإبستيمولوجي مع جماليات أخرى تنحدر من الموسيقى (الجاز) وفن الأوبرا والمسرح (شكسبير) والأدب (الرواية).. فضلا عن انفتاحه على حقول العلوم الإنسانية بشكل واسع.
تعكس أطروحتنا النهج المغاير والمتفرد الذي سلكه كاﭬل للتفلسف حول السينما؛ إذ استرجع سنواتِ تَشَبُّعِه بالأفكار التأسيسية التي صاغها الفيلسوفان الأمريكيان البارزان “إمرسون” و”طورو” حول بعض المفاهيم الخاصة من قبيل مفهوم المناقشة و”المحادثة” (Conversation)، وكذا حول العلاقة بين كتابة الفلسفة والكتابة الموسيقية، وعرض خلفياته الذوقية في السينما والمسرح، ونهله من “أوستن” و”ﭬتجنشتاين” ومناقشته لأفكار “راولز” وغيره من الفلاسفة كهايدجر مثلا.. وذلك ما فتح (وجَدَّدَ) باب البحث في قضايا النزعة الكمالية التي طَبَعَهَا بحس من التجاوز الذي اتسم بإعادة تملّك التاريخ داخل الفلسفة وبأهمية جديدة للأخلاق عبر استحضار مفاهيم الخير والسعادة والآخر والاحترام والعيش المشترك ضمن سياقات فيلمية مختلفة.
-2-
فرض علينا تنوع المتن الكاﭬيلي، وكذا امتداده لمجالات علمية أخرى كالدراسات النسائية ودراسات النوع أو الجندر والدراسات السينمائية والتحليل الفيلمي والنقد السينمائي ونظرية السينما والسوسيولوجيا والسيكولوجيا وفلسفة اللغة والسيميولوجيا والدراسات الأدبية وغيرها، حصر إشكاليات أطروحتنا فيما يلي:
بأي معنى تتيح لنا السينما التفكير في الوجود الإنساني؟ وكيف يمكن أن نفكر في الوجود استنادا على ما هو سينمائي؟ ما قيمة العرض السينمائي في مناقشة القضايا الوجودية للإنسان؟ هل يمكن للسينما أن ترقى بنا نحو الأفضل؟ إلى أي حد تستطيع السينما تطوير المفاهيم والإشكالات الفلسفية للوجود الإنساني؟ ما الذي تبتغيه الفلسفة حينما تتناول أسئلة الأخلاق داخل السينما؟ ما الجماليات التي تخلقها السينما وهي تقارب الوجود الإنساني وتحصره داخل منظوماتها الفيلمية؟ كيف يتصور كاڤل العَالَم وهو يوظف مفهوم العرض السينمائي أنطولوجيا؟ ما دور الشاشة السينمائية في كشف الوجود؟ ما تمظهرات النزعة الشكية في صياغة فلسفة السينما الكاڤيلية؟ ما الإضافات الفينومينولوجية التي بلورها هذا الفيلسوف في استعمالاته لبعض المفاهيم من قبيل مفهوم “العادي” (Le quotidien) و”العَالَم اليومي” و”العَالَم العادي” (Le monde ordinaire) داخل السينما؟ إلى أي حد ساهمت المحادثة (La conversation) في تبديد الخوف الأنطولوجي المستشري بين الأزواج في أفلام الزواج الثاني؟ كيف عالج كاڤل مفهومي الخير والسعادة في تحليلاته الفيلمية؟ وما طُرُقُ البحث عن السعادة في السينما؟ إلى أي حد تجعلنا السينما أفضل مما نحن عليه؟ إلى أي حد أسعفت الأفلام ستانلي كاڤل في تطوير مفهوم الكمال الأخلاقي أو النزعة الأخلاقية الكمالية؟
لمعالجة تلك الإشكالات قَسَّمْنَا أطروحتنا إلى أربعة أقسام، احتوت سبعة عشر فصلا، شملت في مجموعها مداخل وخلاصات تركيبية، فضلا عن المقدمة والخاتمة والبيبليوغرافيا.
ضم القسم الأول (الفلسفة والسينما) خمسة فصول تناولت روافد الفكر الكاڤيلي، وموقع السينما في فلسفة كاڤل، ومميزات الفكر السينمائي لديه، فضلا عن تقديم قراءة فلسفية تواجه بين فلاسفة وأفلام: “إمرسون” و”كيكور”، وأنهيناه بقراءة في فيلم “قصة فيلاديلفيا”.
شمل القسم الثاني (أنطولوجيا السينما) ثلاثة فصول قَارَبَت مفهوم العرض السينمائي لدى كاڤل، وتحولات الأشياء على الشاشة من خلال جدلية الحضور/الغياب، واختتمناه بمقاربة للتواصل السينمائي.
تناول القسم الثالث (إيتيقا السينما) ثلاثة فصول اعتنى الأول منها بإشكالية السعادة، مُقْرِناً إياها بقراءة فلسفية تحليلية لفيلمي “نيويورك – ميامي” للمخرج فرانك كابرا و”سيدة الجمعة” للمخرج هوارد هاوكس، واهتم الفصل الأخير من هذا القسم بملامسة إشكالية الخير من خلال استشكال السؤال التالي: هل تجعلنا السينما أفضل؟
احتوى القسم الرابع (سيكولوجيا السينما أو ميلودراما العَالَم) ثلاثة فصول رَكَّزَ الأول منها على الفوارق الحاصلة بين الكوميديا والدراما، وسعى ثانيها إلى البحث في أسئلة الصمت والعزلة استنادا على قراءة فيلم “وسواس” للمخرج “جورج كيكور” بينما ناقش الفصل الأخير علاقة السينما بالتحليل النفسي.
تسعى الرؤية الفلسفية الكاڤلية للسينما إلى البحث فيما يجعل عناصر العَالَم عبارة عن مكوناتٍ تصير للعَالَم أجمع. إن ما يثير اهتمامه هو البعد العالمي (Universel) الكامن وراء الأمثلة الفريدة التي استقاها أثناء تحليلاته للأفلام والشخصيات الفيلمية.
-3-
خلصنا إلى تناغم مجموعة من الأفكار السينمائية الأنطولوجية في الفكر الكاﭬيلي، والتي بلورها بطرق مختلفة أثناء تحليلاته الفيلمية فكانت جسرا إبستيمولوجيا بين الفلسفة والسينما؛ إذ يقر بأن:
الميكانيزم السينمائي يمنح الأشياء والشخوص صيغها الأنطولوجية الممكنة.
يضع ميكانيزم العرض العَالَم في العَالَم ذاته، وذلك ما يجعل وجوده الظاهري والافتراضي ينكشف عبر هذا الغياب الأنطولوجي.
ما يتحرك على الشاشة عبر ميكانيزم العرض السينمائي هو البصمة المقابلة لعرض الوجود كحقيقة أخرى له.
يَنْحَتُ مفهوم الإنسان المنقطع عن العَالَم (L’homme coupé du monde) للإشارة إلى فعل العزل الناتج عن الذهاب إلى قاعة السينما (العزلة الأنطولوجية).
البحثُ عن السعادة تناولٌ فلسفي لكوميديا الزواج الثاني في السينما.
قَادَه تحليل الميلودراما (وخاصة في أفلام المرأة) إلى تطوير النزعة الكمالية.
دفع به تعميق البحث في الجوانب الكوميدية والتراجيدية والغنائية المتعلقة بالعادي (L’ordinaire) إلى فتح باب جديد فيما عُرِفَ في التقليد الفلسفي بالنزعة الشكية، فضلا عن تزويدنا بمقاربة أنطولوجية نوعية من داخل السينما للوجود (العَالَم كوجود).
يمكن أن نخلص في نهاية هذه الأطروحة إلى أن هَمَّ الفيلسوف ستانلي كاﭬل في تناوله الفلسفي للسينما كان مرتبطا بروافد النزعة الشكية والكمالية وأسئلة الفلسفة القارية (Philosophie continentale) التي ارتبطت في تقاليد الفلاسفة الأنجلوساكسونيين بالفلسفة التحليلية، سيما ضمن التقاليد الفلسفية الرائجة في القارة الأوروبية وخاصة ألمانيا وفرنسا.. وهو ما لم يكن مشابها، مثلا، لما قام به الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز الذي لم ينشغل تناوله الإستيتيقي للسينما بتاريخها، ولكنه سعى إلى تقديم تصنيف للصور والعلامات وفقا لظهورها على الشاشة أو وفق مَعْنَاهَا في السينما أو في المجال السمعي البصري بشكل عام؛ إذ اعتمد تحليل جيل دولوز على التمييز بين الحركة السينمائية والحركة المستمرة التي اقترحها هنري برغسون في كتابه “المادة والذاكرة”، وكذلك على تصنيف العلامات التي تناولها الفيلسوف الأمريكي “شارل ساندرس بورس” (Charles Sanders Peirce)، وذلك لتوضيح كيفية انبثاق الفكر عبر آليات المونتاج بين اللحظة والمدة والصورة والصوت، متناولا الكثير من الأعمال السينمائية لمخرجين كبار، غالبا ما ارتبطت منجزاتهم بسينما المؤلف من قبيل: بيرغمان، بريسون، دراير، فورد، گريفيث، كازان، كينج ﭬيدور وغيرهم. عكس ذلك، رَكَّزَ النهج الكاﭬيلي في تناول الأفلام ورَاهَنَ كثيرا على أفلام هوليودية ذات جماهيرية كبيرة لمخرجين مكرسين في الصناعة الهوليودية من أمثال: جورج كيكور، فرانك كابرا، إيرڤينغ رابر، بريستون ستورجس، ليو ماك كاري، ماكس أوفيلس.. وهو بالتالي يعمل على زرع التفلسف لدى جماهير تلك الأفلام.
تاخمت الفلسفة الكاڤيلية السوسيولوجيا لأنها جعلت الشك اليومي أصلا للمشاركة الاجتماعية للغة؛ إذ تتأسس الفائدة الاجتماعية والفلسفية للسينما في توظيفها الفني لأشكال الشك الذي تعبر عنه اللغة اليومية، فنكتشف معها حجم ومعنى الشكوك اليومية التي نعيش بها، ومدى تأثيرها في علاقاتنا الاجتماعية وعلاقتنا بالعَالَم الخارجي.
-4-
يفيدنا الدرس الكاﭬيلي في إثارة الانتباه إلى مبادئ المشاهدة الفيلمية، وكشف بعض الحقائق الدائرة في الأفلاك المركبة لآليات صناعة الأحلام السينمائية، ذلك أن السينما توحي للمتفرج العادي بالاندماج مع الواقع إلا أن رهانها الجوهري يتمثل في خلق الأوهام. يركز كاﭬل على قوة التجربة السينمائية لأنها تقود المشاهد نحو رؤية الواقع بشكل مختلف، وكأن هذا العَالَم “معلق بمجموعة من الحيل” التي يحاول كل فيلم كشفها قصد جعل المتفرج يشعر بأنه حيال مبدأ معين للواقع.
يفيدنا كاﭬل في توضيح أن “حقيقة الصورة تتجلى في التأثير الذي تنتجه”، وذلك عبر فاعلية المضامين في المشاعر التي ينتجها المتفرج أثناء صوغه لما يسميه هذا الفيلسوف بالتجربة الوجودية للمُشَاهِد، ففي “الظلام التجريبي” أو “الليل التجريبي” للعرض السينمائي يكون المشاهد خارج تجربته المعتادة، ذلك أن الفيلم لا يعترف بـ”الوجود الخارجي” للعَالَم، بل يقترح عَالَمَهُ الخاص – يَعْرِضُ ذَاتَهُ – الذي يمر عبر آلياته، ويجبر المشاهدين على الشعور بالعواطف التي تعتمل داخله حيث تتحول الحيلة السينيماتوغرافية إلى مظهر من مظاهر الذكاء. وبالتالي، فإن حقيقة هذا النموذج لا تتوافق مع الشكل المعتاد لأنها تنتج “تأثيرا حول غيريّة العَالَم”.. فلا يقتصر تأثير الآخر على الفيلم فقط، إنه يتحول إلى شكل من أشكال الذكاء التي يمكن للمُشَاهِد أن يمتلكها بعد مغادرة قاعة العرض، أي بعد العودة إلى العَالَم ومواصلة المتلقي لأحلامه السينمائية حيث يبدو “أن جزءا من أنفسنا يتسامى مع تأثيرات المعنى دون أن نكون قادرين على توليد المعنى من خلال لغتنا”، وهنا تكمن إشراقات كاﭬل الفلسفية التحليلية. وبمعنى آخر، فإن السينما تضعنا في موقف حساس ومغاير تجاه العَالَم.
تقدم لنا السينما علاقة وهمية بالعَالَم، لكن الخيال ليس وَهْماً، بل على العكس من ذلك، إنه الرابط الأعمق الذي يجمع المرء بالواقع: “فمن الخاطئ الاعتقاد بأن الخيال عَالَمٌ معزول عن الواقع، إن جوهره ينبني على ذلك الظهور (الواضح) غير الواقعي. الخيال هو ما يمكن الخلط فيما بينه وبين الواقع. إن قناعتنا بقيمة الواقع تقوم على الخيال. التخلي عن تخيلاتنا يعني “التخلي عن اتصالنا بالعالم”. نشير إلى أنه لا يجب فهم الخيال هنا بالمعنى الفرويدي لأنه لا ينتج عن اللاوعي، بل عن تلك الشبكة التي نبنيها من أجل فهم العالم، والإطار الذي نضع فيه أفكارنا وأفعالنا.. أي أن علاقتنا بالعَالَم خيالية من حيث أنها مبنية، منظمة ومهيكلة، من خلالها.
هكذا، نخلص إلى أن التفكير الأنطولوجي في فلسفة كاﭬل السينمائية يستند على إقراره بأن مبدأ الواقع السينمائي يتمثل في أن نضع أنفسنا وجهاً لوجه مع “الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الاقتناع (بواقعية العالم)، وهي مشروطة بمدى تعلمنا تقريب العَالَم مما تشتهيه قلوبنا.. ونحن نقوم بالتقاط الصور”. هكذا، تمنحنا الأفلام وجهات نظر خصبة عن العَالَم من شأنها أن تُحَرِّرَنَا من مسؤولية القبول بكل الإشراطات الأنطولوجية التي نعيش بها وضمنها.
وأخيرا، يجد الباحث في المتن الكاﭬيلي نفسه محاصرا بكم هائل من الإشكالات والمفاهيم المتصادية فيما بينها، غير المكتفية بذاتها، وذلك ما يجعل السينما مجالا يتيح التفلسف بشكل متجدد، ويضمن للسينما أفقا رحبا وفسيحا باعتبارها تقارب، كالفلسفة، وبآلياتها الخاصة قضايا الوجود.. أتمنى أن يكون لهاته الخطوة تبعاتها، وأن تفيد في كل ما من شأنه تطوير البحث الفلسفي والدراسات السينمائية بالمغرب والعَالم العربي سواء على مستوى التنظير أم النقد أم الممارسة المهنية، خصوصا وأن أطروحتنا قد انفتحت من باب الأنطولوجيا على الفلسفة الكاﭬيلية في شقها السينمائي، فكان ولوجنا إليها اقترابا من تلك العلبة الفلسفية التي تتضمن مسالك كثيرة يصعب الإلمام بها دفعة واحدة، سيما وأن ما قمنا به مقطوع السند داخل شعبة الفلسفة ببلدنا، والتي لم يسبق لها – في حدود علمنا المتواضع – أن خَصَّت السينما بأطروحة من هذا القبيل.. فشكرا لكل من ركب معنا سفينة هذه المغامرة التي نتمناها أن تكون مُدَشِّنَة ومُوَطِّدَة للبحث في هذا الباب، فنحن نتحمل أخطاء السبق الذي نعتبره وقود الاجتهاد الفلسفي.
– صدر بالإنجليزية [The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film] في طبعته الأولى سنة 1971، وفي ترجمته الفرنسية [La Projection du monde] سنة 1999.
– بيزلي ليفينجستون وكارل بلاتينيا؛ دليل روتليدج للسينما والفلسفة؛ ترجمة وتقديم: أحمد يوسف؛ المجلس القومي للترجمة؛ رقم 2042؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى 2013.
– Henri Bergson; Matière et mémoire: essai sur la relation du corps à l’esprit; Édition critique dirigée par Frédéric Worms; Préface et notes de Camille Riquier; Collection: HYPERLINK “https://www.puf.com/Collections/Quadrige”Quadrige; Paris; 2012.
– كل الإحالات الواردة بين مزدوجتين مقولات شهيرة للفيلسوف، وجلها متضمن في كتابه:
– Stanley Cavell; La Projection du Monde; Paris; Belin; 1999; P: 214.
– Ibid. ; P: 142.