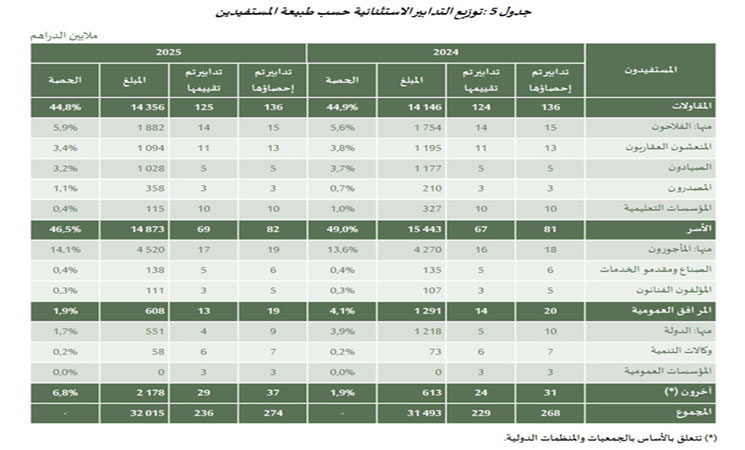بدأ عراب القصيدة الزجلية المغربية أحمد لمسيح شاعرا بالفصيح، ثم انتقل إلى القصيدة الزجلية التي ساهم بشكل كبير في الرقي بها وتطويرها من طبيعتها المعتمدة على الإلقاء والسماع إلى القراءة والتأمل والكتابة. ولا يذكر الزجل في المغرب إلا في ارتباطه بأسماء مضيئة كأحمد الطيب لعلج وعلي الحداني … والشاعر أحمد لمسيح صاحب أول ديوان شعري زجلي مطبوع سنة 1976 في المغرب: رياح التي ستأتي».
عن وزارة الثقافة في المغرب وعن الشعر والصيف والحياة أجرينا مع رائد الزجل في المغرب أحمد لمسيح الحوار التالي:
تم مؤخرا تعيين حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني وضمنها وزير جديد جمع بين حقيبتين «وزارة الثقافة ووزارة الاتصال»… في هذا السياق ما هي انتظاراتك من وزارة الثقافة؟
ليس تشاؤما وليس ابتعادا عن الرد إذا قلت إنني لا أنتظر جديدا من وزارة الثقافة، لكنني أعتبر أن الوزير الناجح هو الذي يتوفر على مشروع وسياسة ومعرفة وليس الوزير الذي يترك كل شيء للإدارة.
ما أتمناه هو أن تعود وزارة الثقافة إلى صفتها كوزارة للثقافة بدلا من أن تكون مجرد إدارة للقطاع الثقافي.
أعلنت منذ سنتين أنك لن تشارك بعد إعلانك في الملتقيات الخاصة بالزجل. ماذا كنت تقصد بالضبط من خلال هذا التصريح ؟
لم أكن أقصد طبعا الاستخفاف بأحد أو هيئة أو جهة منظمة لهذا المهرجان أو ذاك، ولم أكن أقصد أيضا الترفع أو التكبر. لقد كنت مساهما منذ بداية التسعينيات في ظهور عدد من مهرجانات الزجل، وأذكر على سبيل المثال مهرجان مكناس ومهرجان وزارة الثقافة وتجربة مجلة «آفاق» في عددها الخاص عن الزجل، وفي كثير من المرات كنت أعطي «يد الله»، لكن ما يحدث اليوم في مهرجانات الزجل من خليط ينسب نفسه لعالم الشعر في حين أنه لا يتعدى مرحلة «القول» يجعلني أبدو نشازا. لست ضد التنوع بل أعتبره مكسبا ولكنني أعتقد أيضا أنني حر في اختياراتي ومواقفي.
حدثنا عن تجربتك في ديوان «شكون طرز الماء» ؟
تيمة الماء التي اشتغلت عليها في ديوان «شكون طرز الماء» هي بمثابة تطهير للذات من صدى الكتابة الإيديولوجية، واعتبرتها أيضا تجربة للخروج من الصراخ والمباشرة والتحريض وما كان يسمى في وقت ما «بالالتزام» إلى الإنصات للذات وإعطائها فسحة لتكون صوت نفسها وليس مجرد رجع صدى للآخرين، بهذا المعنى انتقلت من المرحلة السابقة «المباشرة» إلى مرحلة «تأمل الذات» بمعنى «الكينونة».
هل لهذه التجربة المليئة بالصمت علاقة بلحظة بسيكولوجية يجتازها الشاعر ؟
نعم، ربما بسبب سني صرت أميل للصمت، ليس فقط صمت الكتابة بل حتى في الحياة اليومية، حيث أتأمل لغة تداولنا اليومي المليئة بالثرثرة كأن يراك أحدهم وأنت مقبل عليه ثم يسألك «جيتي؟»
حدثنا عن انتقالك من التعليم الديني إلى الأدب، وعن طردك من الدراسة بتهمة الشغب والتحريض على الإضراب ؟
«لخبار فراسك» (يضحك)… أرجو أن تضعي تهمة الشغب والتحريض على الإضراب بين قوسين. نعم حدث ذلك بالفعل في بداية الموسم الدراسي (1965 – 1964) حيث كنت قد انتقلت إلى ثانوية «لحلو» في الدار البيضاء وعدت للتعليم الأصلي، هكذا كانوا يسمونه «الديني» أو «الأصلي» وأصبح يسمى فيما بعد «التعليم الأصيل». حصلت على الباكالوريا في يونيو 1969 والتحقت بكلية الآداب في الرباط، وما دفعني لأندمج بسهولة أنا الوافد من المعهد الديني هو أنني درست بضعة سنوات في مدينة البيضاء وكان يدرسنا أساتذة كبار أمثال (عباس الجراري – محمد برادة – أحمد اليابوري – أحمد العلوي – حسن المنيعي – محمد الخمار الكنوني – محمد السرغيني – أمجد الطرابلسي …). لقد أغنتنا هذه الأسماء وأدخلتنا في عوالم الأدب وفتحت شهيتنا للقراءة. وبقدر ما كنت أحفر في كتب الآداب بقدر ما كانت تحصل لي عملية محو لما درسته في التعليم الأصيل من فقه وفرائض وأصول ومنطق وتفسير… لكن بعد حادثة 1973 توقفت مؤقتا عن الدراسة، كانت سنة بيضاء وتعرضت على إثرها للاعتقال بتهمة الشغب والتحريض على الإضراب، ولا زلت إلى حدود الساعة في عداد المحكومين بالسراح المؤقت.
هناك من يصنف الزجل كمكون من مكونات الثقافة الشعبية في المغرب. كيف تنظر إلى هذا الأمر ؟
قد تجدين شعرا مكتوبا على ورق ولكنه في الأصل شعر شفوي، لأنه يراهن على الأذن، وتدوينه على الورق لا يشفع له في الانتساب إلى عالم الكتابة.
أما أولئك الذين ما زالو يعتقدون أن الزجل لا يجوز له أن يخرج عن «الثقافة الشعبية» فالأحرى بهم أن يظلوا أوفياء ومنسجمين مع أنفسهم، ينبغي أن يسجلوا شريطا ويضعوه إلى جانب «نجاة عتابو» و»الكريمي» وغيرهما، لأن التداول لمفهوم «الثقافة الشعبية» يذهب في هذا الاتجاه .
أنت أيضا سجلت أعمالك في أشرطة وذلك حينما كنت إطارا مسؤولا في وزارة الثقافة. وهناك من عاتبك على هذه الخطوة كما لو اعتبرها «استغلالا» لوضعك الاعتباري كمسؤول كبير أنذاك ؟
أود بداية أن أوضح أن ما تم تسجيله لم تتبنني فيه مؤسسة للتوزيع ولا أي جهة رسمية أو غير رسمية، بل سجلت الأشرطة على نفقتي في أستوديو بمواصفات جد بسيطة حيث يمكن لأي شخص أن يقوم به في بيته إن أراد. ونظرا لأن جيبي لم يكن يتسع للذهاب إلى استوديوهات احترافية، التجأت إلى هذا الأستوديو المتواضع وسجلت أشرطتي بمساعدة صديقين ممثلين ووضعتها للتسجيل في إطار الإيداع القانوني في المكتبة الوطنية باسمي الشخصي، فالمسألة تتعلق بمبادرة شخصية. وأفخر أنني لم أستغل منصبي لأي غرض شخصي بل كنت أتحاشى وأبتعد عن حشر اسمي مثلما يفعل الكثيرون في أي تظاهرة، بما فيها التظاهرات التي كنت أشرف عليها سواء داخل الوطن أو خارجه. وإذا كنت حاضرا هنا أو هناك فإنما كمسؤول وليس كمشارك ضمن لائحة الشعراء أو المشاركين في الندوات أو أي شيء من هذا القبيل. كما أنني لم أطبع أي كتاب ضمن منشورات الوزارة. وكل ما تم طبعه هو بعد خروجي من وزارة الثقافة.
لو لم يطرح علي هذا السؤال لما تحدثت في هذا الأمر، لكن لا بأس من بعض التوضيحات، لقد غادرت العمل الإداري ضمن المغادرة الطوعية نهاية 2005 والتسجيلات تمت في نهاية سنة 2007، أما الإيداع القانوني فهو مسجل في بداية سنة 2008 باسم المؤلف وليس باسم أي جهة أخرى. وللناس فيما ينممون مذاهب، وفيهم المحترفون والهواة… ولكن أغلبهم مثل من يتبع «عيساوة» بالنافخ.
هاجمت في حوار سابق الزجالين المغاربة الذين يكتبون تحت الطلب وفق تعبيرك، ويطلبون تملق العامة والمتلقي العادي، وقلت في تصريح انتقده الكثيرون إن الشاعر الذي ينقل كلام العامة إلى قصيدة زجلية يعد سارقا في نظرك ؟
نعم… وسرقته هنا تشبه تلك السرقة الأدبية مع فارق أن السرقة الأدبية تكون من نص أدبي، لكن الآن هناك من يسرق كلام ملايين من الناس وينقل ما يقولونه في الشارع وفي المقاهي وهذا أسميه سارق جماعة. لا أعرف من أين اكتسبوا هذه الشرعية ومن سمح لهم بالتحدث باسم الجماهير، هل انتخبهم الناس؟… إن الجماهيرية مجرد وهم، ولا وجود لها. إذ نادرا ما ينجح الشاعر في أن يكون مرضيا للنخبة ومرضيا للجمهور الواسع، ثم إنني أفضل رأي ناقد صارم ونزيه ولو كان ضد تجربتي على آراء هلامية لأناس لا اطلاع لهم على الشعر والأدب. ودعيني أضيف أخيرا أن دغدغة عواطف هؤلاء الناس هي التي أخرت تطور تجربتي.
بما أننا في فصل الصيف، كيف يقضي الشاعر أحمد لمسيح عطلته الصيفية ؟
في الصيف أتمتع بارتجال الحياة، لا أخضع لنظام معين، هذه عادتي قبل التقاعد، حيث كنت أقضي طيلة السنة في العمل والاجتماعات واللقاءات مع الأصدقاء … أما في الصيف فأتخفف من كل هذه الالتزامات وأرتجل الحياة ببساطة كأن أنام في وقت متأخر أو أستيقظ في الصباح الباكر جدا، لكن هذا العبث لا يلغي أشياء ثابتة مثل القراءة ومتابعة الأخبار وزيارة المواقع الثقافية، والعناية بالحديقة والحيوانات الأليفة. أما عن السفر فأنا أحبذه في شهر شتنبر حيث تكون أماكن الاصطياف غير مكتظة وتسترجع الطبيعة بكارتها، وقد أنجو خلاله من كرة طائشة تهشم رأسي والقصائد العالقة فيه.
استعدادا للموسم الثقافي المقبل، ما هو مشروعك الشعري القادم ؟
غالبا ما أترك مشاريعي الجديدة تختمر في الصيف، أكتبها للمرة الثانية أو الثالثة وأطلقها، ثم أعود إليها لأصدر في نهاية الخريف أو بداية الشتاء ديوانا شعريا ألتزم فيه مع نفسي، وأغامر بشكل جديد وتيمة جديدة رابطة وناظمة للعمل بأكمله.
أما عن مشروعي الحالي الذي عنونته بـ «سطر واحد يكفي»، فقد اخترت أن أكتب عوض الشذرة سطرا واحدا. كان الأمر متعبا، لكنني اخترت هذه الصعوبة في نهاية الأمر وكأنني أقول ما ملخصه «الثرثرة للنثر والصمت للشعر».