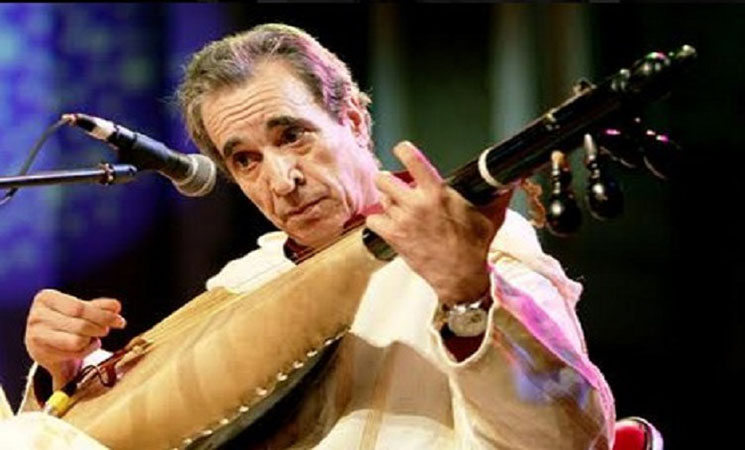بعد أن أرسى حمو باليازيد أسس الغناء بالأطلس المتوسط، ولم تكسف بعده شمس الحركة الغنائية، بل ظلت ساطعة متوهجة بمغنيين وعازفين ملأوا رحاب هذه البقاع الأطلسية أنغاما وألحانا وأسهموا في الدفع بهذا الفن قدما، ومن بين هذه الأسماء الفنان محمد مغني، الذي أعترف أنني شعرت بالعجز، ليس في القلم أو البيان، بل لأن المعني بالأمر أقوى من أن أكتب عنه، لا يكفي أن نقول إنه هو معجزة الغناء في الأطلس المتوسط، إذ شبع مديحا وإطراء وتبجيلا لفنه العظيم طيلة سنوات اربت على خمسين عاما.
وباتت الموضوعية المجردة عن العواطف والعلمية المنزهة عن الهوى تحتم علينا أن نتناول هذا الفنان الشامخ وفنه الباذخ بكثير من الدقة والتفصيل والتأني، لمنح نتائجها المرجوة لجيلنا الجديد الذي لم تسنح له الفرصة التعرف جيدا إلى هذا الهرم الفني ولجيلنا القديم أيضا الذي حكمته العواطف بدرجة كبيرة في التعلق الشديد بمعطياته الباهرة وإبداعاته المتألقة التي لا حد لها ولا نهاية.
رأى محمد مغني النور سنة 1950، بخنيفرة، بقبيلة أيت بوحدو، دوار أمهروق، من والده موحى أومولود الذي تطوع في الجيش الجزائري وألحق بمنطقة” مغنية” إلى حين انتهت مهمته هناك، ليعود إلى مسقط رأسه بأيت بوحدو، فأخذ سكان القبيلة ينادونه ب”اومغنية”، ولما ولج محمد مغني المدرسة الابتدائية ب “تيدار إيزيان” خنيفرة عام 1957 اتخذ من لقب أبيه الاسم العائلي “محمد مغنية”، وبما أن “مغنية” اسم مؤنث تم تحويرها إلى “مغني” فأصبح الاسم العائلي “مغني”، وهو اللقب الذي ليست له علاقة بالغناء كما يزعم البعض.
تربى محمد مغني في أحضان عمته التي كانت أثناء قيامها بعملية طحن الزرع”بالرحى” تصدر آهات مكتومة تتنفس على شكل أشعار حزينة رثاء لأخيها، وليس أدل على هذه الكلمات الحارة من قولها:
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أَسيدْنَا مُحْمَدْ أُورِكْيوطُ رَبِي ذِيمِينُو أَرْمْثَخْ أَلِيكْ أَوِيخْ سِي صْنَّالْ
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أَسِدْنَا مٰحْمْدْ أَيُورْثُو نٓيْلاَّنْ گُوبْرِيدْ أَنْجَذِي دِّدَٰانْ يَاغْ أَمَالُو
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أَيَّاوْمَا أَيَّا گْجيگْ نَاثْنِي ثَوْرْغِي أَبُوقْسْ نَا يْتْوگَانْ إِثْفَلاَ أُومْنَايْ
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
واللَّهْ الْعْظِيمْ مُورْ ذِيگِي أُوولْ إِيلِي ذِيگِي الْحْيَّا
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أُوسَارْ يِٰيخْ أَلْحَّنِّي گْ وَامَانْ غَاسْ أَرْزَّازْ
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
إِزِيلْ وَاضُو نْثْمَازِرْثِينُو مْكْ إِيكَاثْ
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
إِيزِيلْ وَشَالْ نَاگْ إِيلُولْ يُونْ أَرْبِّي
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أَوَا يْذِيا رَبِّي طِيرْ يِّلِّي سْ رِّيشْ
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
أَذِي سَارَا كْ ثْمِيزَارِينُو أُورِي تُوحيل
أَمَارْگْ أَمَارْگْ ذَاخْ إِنْغْ أَمِيسْ نْيُو أُوغَا ثْتْرَارَانْ إِگُوذَارْ وَلاَ ثِيفْلْوِين
إن ما تفصح عنه هذه الأشعار من الإيجاز البلاغي المؤثر والصدق الفني، يقف المرء أمامها مشدوها، إذ هنا تتجسد أمامنا صورة صادقة لواقع المرأة التي تفتقد الصديق والقريب فليس ثمة أحد في هذا العالم يسمع أنينها وشكواها، هذا النوع من الإنشاد يسمى في الأطلس المتوسط ب”أهلل” ومن أهم الخصائص المعنوية التي تتميز بها أشعاره، بالأطلس المتوسط، إنها حزينة فهي تؤكد على طرح الهموم الشخصية ومجمل القضايا الحياتية التي تفكر بها المرأة، الحب، الموت، الفقر الخ.. وتختار المرأة بشكل لا شعوري من أساليب وأوزان الأغنية الشكل المتلائم مع حركة الطاحونة (الرحى اليدوية)، فهي إنسانية هادئة ترتل بهدوء منسجمة انسجاما تاما مع الصوت المنبعث من حركة دورانها حتى لتخاله جزءً من الإيقاع الموسيقي للأغنية، ولذلك فلم تتعدد أساليب (أهلل) فتشمل أشكالا أخرى غير الدرامي والنعي ويتميّز الدرامي بأنه المادة الخام لأغاني”الرحى”.
ينبغي أن نشير إلى حقيقة واضحة في أشعار الطحن على” الرحى” وهي إنها تفتقر إلى الصيحات الإيقاعية والسبب في ذلك يرجع إلى أنها وجدت أصلا لقتل الملل والسأم في نفس المرأة العاملة مؤكدة على العنصر المتغير الذي يطرح جملة الإحباطات الفردية والظروف الخاصة.
و تعلم محمد مغني أبجدية الغناء من عمته و ترسخت في وجدانه هذه الأشعار منذ صغره، و بدأت تظهر بوادر موهبته الغنائية في المدرسة وأخذ شيئا فشيئا يتخلى عن حذره ومخاوفه بل تشجع وبدأ يغني بعد انصراف المعلم، وتجمع حوله التلاميذ مذهولين وكأنما اكتشفوا اكتشافا خطيرا. هذا الطفل النحيل الصامت الذي استهانوا به في أول الأمر يمتلك مثل هذا الصوت الساحر؟.
ومن ذلك اليوم أخذوا يتقربون من الفنان محمد مغني، ويتوددون إليه، وبدأ هو يشعر بأهميته وسط زملائه و أصبح طبيعيا أن يطلبوا منه أن يغني لهم بعد انصراف المعلم مباشرة، و أصبح هو كثير الحركة لا يهدأ، تحسبه يحتبس طاقة تبحث عن منفذ. إن جلس إلى طاولة فإنه لا يهدأ أو يفسح مجالا للهدوء، تسمعه يدندن بصوته، ويدندن، تراه ينقر سطح الطاولة بأصابع يديه بحيوية، التي تظل تتراقص في الهواء، كأنها تنادي الأوتار،. ولَم يعد صوت محمد مغني، الموهوب يتردد فقط بين جدران المدرسة بل أصبح يتردد كثيرا وسط الحي الذي كان يقطنه. وبدأت شهرته تتجاوز حدود الحي.
غادر محمد مغني الدراسة مبكرا، منذ سنة 1963، عندما حصل على الشهادة الابتدائية، ليشتغل بإحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العمومية بخنيفرة لمدة سنتين، إلى غاية سنة 1965، ليغادر عمله نهائيا ويلتحق بأبيه الذي كان يشتغل بإحدى التعاونيات الفلاحية. وفي هذه المرحلة بدأت هوايته للموسيقى والغناء تكبر وتتبلور مع الأيام، كان يختلي فيها بنفسه، صحبة مذياع (راديو) صغير رقم (8)، و ينتظر قدوم الصوت السحري للفنان حمو باليازيد الذي كان يستهويه ويتلقف ما يسمعه من أغاني الرواد وكذلك من أغاني الأفلام الاستعراضية التي كانت تعرضها آنذاك سينما “زيان”، بخنيفرة، إبان الستينيات، لأنه كان شديد الإعجاب بآلة الناي وكان مدمنا على سماع أنغامها التي كانت تتيح له إشباع نهمه الموسيقي، فكان يحفظ كل شيء، دون أن يدرك بأن ما يحفظه من أغان شائعة هي المفاتيح التي ستقوده إلى المجد الذي كان لا يفكر فيه قدر تفكيره في أن يغدو ذات يوم فنان بعاصمة زيان خنيفرة.
فكانت بدايته الفنية بالعزف على آلة الناي التي كان يستخرج منها أنغام تنفذ إلى وجدان المستمع، ولكن كانت تشكل له عائقا، بالعزف والغناء في وقت واحد مما جعله يبحث عن آلة أخرى، وفي عام 1967 سيلتقي بصديق الدراسة المسمى “مولاي أحمد يعيش” ليفكرا معا في صناعة آلة “الوتار” وهو ما تأتى لهما. ولكن فرحتهما لم تدم طويلا لأن محمد مغني ذهب لزيارة الفنانة “إيطو حساين” ليعرض عليها آلته الوترية الجديدة التي قام بصنعها مع رفيقه، لتبدي رأيها في صنعها، ولكن زوج هذه الأخيرة، المسمى علال، دخل على غفلة فوجدها تحتضنها بشغف و تصدر أنغاما من صهيل الأوتار الجامحة وحنين الأخشاب المعتقة، حيث فقد الزوج علال صوابه فكسر الآلة.
ولا بأس أن أتوقف قليلا عند هذه القامة الفنية “ايطو حساين”، فهي من موالد عام 1921 بقرية سيدي احسين كهف النسور بخنيفرة، من والدها محمد أعراب ووالدتها حادة، عاشت بين أحضان عمتها المسماة رابحة نزي مع زوجها المسمى حسن اوشن من أعوان الباشا حمو. وكانت لها عدة تسجيلات بدار الإذاعة الوطنية في بداية الستينيات من القرن الماضي، وكانت الفنانة إيطو حساين شخصية معروفة محليا، وتعزف جيدا على الآلة” لوتار”، كما تحدده الذاكرة الشفهية التي أضفت عليها بعدا أسطوريا وفنيا، و من خلال بعض الحكايات الممزوجة بروح الفكاهة، كتلك التي تقول: إنها تحمل آلتها في حلها وترحالها، وتخرجها من كم قميصها للعزف عليها، كما يروى أيضا أنها كانت تعزف عليها وهي تضعها خلف رأسها، وهي شخصية التي تستحضرها الذاكرة الشفاهية عند الحديث عن سيرة الرواد الذين عرف عنهم أنهم كانوا يعزفون على آلة الوتار بمدينة خنيفرة، وكانت أيضا بجانب محمد رويشة أثناء تسجيل قطعته المشهورة “بيبيوسغوي” التي افتتح بها مساره الفني بدار الإذاعة الوطنية عام 1964.
وفي آخر أيامها، استبد بهذه الفنانة العوز والمرض، وافترسها التجاهل واللامبالاة لتختزل حياتها الحافلة بالعطاء في مساحة جدرانها البئيسة “بثيدار إزيان”، وظلت محاصرة بالوحدة بعد انطفاء أضواء الشهرة، وحين صمتت ميكروفونات كانت تمنحها الحياة في لحظات من الأوقات، إنه واقع يندى له الجبين، واقع مرير لوطن لازال يحن الى فروع شوك السدرة ويتوقف الى تعليقها على قبور من رحل من رواد الفن الأمازيغي بالأطلس المتوسط، بعدما كانوا في حياتهم نسيا منسيا. وقد رحلت عنا الفنانة “إيطو حساين” عام 1987 لتدخل عالم الخلود.
و تعد قضية عزف النساء على آلة الوتار بالأطلس المتوسط من القضايا التي يصعب تناولها، فالنساء لا يعزفن في العلن مطلقا، وهذا لا يعني أن عزف النساء كان غائبا كليا في الأطلس المتوسط وماتزال بعض التسجيلات للفنانات مثل “إيزة وبغوظ” من قرية القصيبة، وبعضها ما يزال محتفظا به بأرشيف الإذاعة الوطنية.
بدأ الفنان محمد مغني يدق على باب الطرب والغناء، وكانت هناك قمم فنية أمثال : حمو باليازيد الذي كان سيد الغناء والعزف، موحا اوموزون، موحا اوبابا، بناصر أوخويا، بالغازي بناصر العريق بفنون الطرب، ابشار البشير، عائشة تغزافت التي تملأ دنيا الناس طربا، ميمون اوتوهان، الروداني الشرقي، مولود أو الباشير، الباز بناصر، بوزكري عمران، مصطفى نعينيعة، أحمد صالح الملقب” بالويسكي”، مولاي بوشتى الخمار، محجوب زعريط، إلى جانب فرسان آخرين. والحق أن محمد مغني كان يحترم أسلافه الكبار، ومن غنى عطاءاتهم ودأب على غناء قطع هؤلاء المشاهير.
وأخذ محمد مغني يتحسس طريقه في خنيفرة المزدحمة والمتخمة بالعازفين والمغنين والمغنيات. وتدفق بدوره إبداعه في كل ضروب الأغنية الأمازيغية، دون أن يخرج على قوالبها الفنية . والتف الناس حوله وتجمعوا ليسمعوا هذه النبرة الجديدة، صحيح كان شارع الغناء مزدحما، ولكن فناننا استوقف الشارع بصوته الحنون ودخل إلى الآذان ممتطيا حصان الرقة والعذوبة، فاشتد شوقهم إليه أكثر حين كانت آذان الناس تتعطش إلى شيء آخر خال من الزفرات، فجاء محمد مغني، ليسكن الوجدان بصوته ويرفع من معنى العشق النبيل!
و لقد ساعده هذا على ذيوع اسمه وانتشاره في الأوساط الفنية وغير الفنية، واشتهر كمغني أكثر من اشتهاره كعازف على آلِة الوتار، وإن علمنا أن الأغاني في تلك الفترة الزمنية كانت تضفي الشهرة والمجد على المغني.
باحث في الفن الأمازيغي الأطلصدر له مؤخرا كتاب “محمد رويشة: المرتجل العبقري”