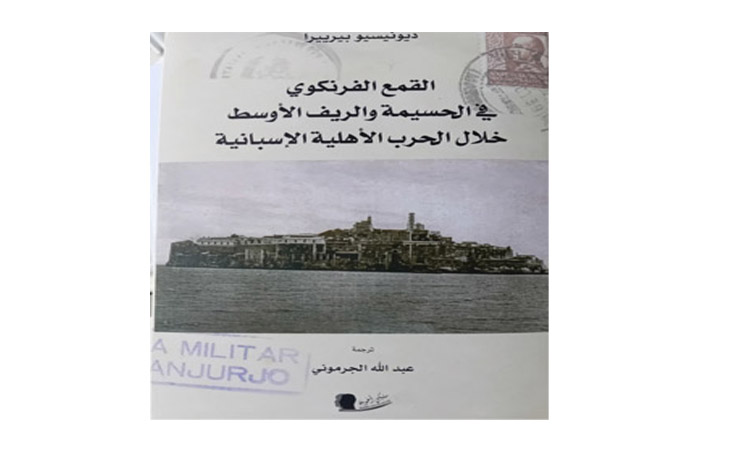الكثير من الكتاب الأدباء يتهربون من كل ما هو شخصي في حياتهم اليومية، ويفهم من ذلك أن حياة الكاتب مختلفة عما يكتب ويتصور، والحقيقة أن هناك حالات فعلا منفصلة كليا عن القيم التي تدافع عنها، وعن معنى الحياة كما تتصورها في رواياتها وقصصها وأفكارها. وربما خوفا من هذه الحقيقة، تجد علاقاتها منحصرة وغير مفتوحة على كل الناس، بل تقتصر على النخبة المثقفة، وإن حدث وتم الاختلاط بالناس، يكون ذلك مبررا سياسيا كالرغبة في المشاركة الانتخابية أو ما شابه هذه الغايات، أو التظاهر الكاذب بالتواضع المعبر هو الآخر عن نزوة التميز عن العامة كما تتصوره النخبة منذ نشأتها. فقد اعتبر أفلاطون الجمهور وحشا، وتنبه الفقهاء المسلمون إلى غوغائية العامة من الناس، وأنهم ينفعلون لما هو حسي، وهم بعيدون عن انشغالات ذوي الفكر والبصيرة، بل منهم من يتعالمون ويحترفون
الفكر فقط لأجل استغلاله في الصراعات العدوانية. وقد أطلق أفلاطون وقبله اسم السوفسطائيين على هذه الفئات التي قيل إن الفلسفة كنبتة زرعت في أرض غير مناسبة لها، فأنجبت الشرور، بحيث صار الفكر في خدمة الجمهور بدل أن يكون مهذبا له وراعيا ومحكما التحكم في غرائز السيطرة فيه، والغلبة التي
تنشدها العامة والجمهور في كل ميولاته وهيجانه الحيواني، وهذا ما يطلق عليه حاليا بالشعبوية في سياق التصنيفات السياسية، أي التظاهر بالإنصات للغة الشعب، والتعبير الصادق عن كل مطالبه حتى تلك التي لا يمكن القبول بها عقليا وفق القياسات العقلية السياسية التي تعترف بضرورة التدرج، وتقسيم الفعل ليكون معبرا بوضوح عن الممكن والمستحيل.
هكذا كان على الكاتب فرض تمايزاته، والحذر من المشترك الجماعي. فالتفكير فعل فردي والجماعة لا يمكنها التفكير، وإن فكرت فهي لا تنتج إلا أسطورة أو خرافة تنشرها وتجيد الدفاع عنها دون أن تفهم أبعادها ومحتوياتها، وهنا غدا الكاتب باحثا عن القلة وموجها لها كل إبداعاته الأدبية والفكرية، بل هناك من الكتاب من يميز في كتاباته بين ما يوجه للنخبة الخاصة، وما يوجه للعامة أو نخبة العامة ممن لا تؤهلهم مدركاتهم لفهم كل ما يعبر عنه الكاتب أو الأديب. وقد عرف عن ديكارت أنه كتب بالفرنسية، ولكن هناك قضايا كتب حولها باللغة اللاتينية، ومعنى هذا أنها خاصة جدا، والمعروف في ذلك الوقت أن اللاتينية لم تكن تفهمها إلا القلة من النخبة، القريبة من مراكز القرار، ولا تزال هذه الممارسات سائدة إلى يومنا هذا، بحيث عندما يريد الكاتب الحديث في قضايا جارحة للجمهور يتحدث بطلاقة، بلغة أخرى لا تفهمها إلا القلة من الناس، لكن هل يفعل ذلك الكاتب العربي؟ ما مظاهر هذا السلوك وما هي أبعاده؟ في الآداب والفكر؟
وظيفة النخبة
هي فكرة سوسيولوجية مفادها أن النخبة تلعب دورا مهما في تطوير القيم داخل المجتمعات البشرية،وبذلك فلها وظيفة تاريخية، ولأنها تتمسك بأكثر القيم تقدما، فإن باقي فئات المجتمع التقليدية لا تتقبل سلوكاتها وتعتبرها شاذة، أو ماسة بالقيم العتيقة للمجتمع وبثقافته وقيم الأجداد، لكن الكاتب العربي يبالغ في تكتماته، ويتهرب من توضيح قيمه الجديدة، وكلما كانت حبيسة
التجمعات الخاصة كان عدد روادها قليلا، وهو بدوره يحافظ على انحسار النخبة، ليضاعف قوته الرمزية واستفادته من ريع الثقافة السياسي والاقتصادي، وهنا أحب أن أذكر بأن الفكر الأسطوري أي فكر ما قبل العقلانية والمعرفة، كان يحرس طقوس الأساطير بسرية تامة، بل إن التفكير اعتبر إيحاءات من الآلهة تحدث في عزلة المفكر، وتجنبه لمشاركة العوام وجودهم ومأكلهم ومشربهم، وحتى حياتهم العامة، وإن حضر فله مكانته الخاصة التي لا يجب أن يقربها إلا ذوي الحظوة والمكانة، وبذلك كانت الأساطير تسمع وعلى المنصتين عدم مقاطعة الحاكي والراوي، وإلا غضبت الآلهة على السائل والمجتمع برمته.
همجية الحضارة
كانت الكتابة أهم إنجاز في تاريخ الوجود البشري، وهي على ما اعتقد سبب ديمقراطية المعرفة وانتشارها، بحيث صار التعلم مفتوحا في وجه الكل، ولم يعد مقتصرا على أبناء النخبة الحاكمة والأعيان، لكن المفارقة أن الكتابة لم يسمح في العالم العربي بتعلمها إلا لمن انتموا للنخبة السياسية أو الغنية من محظوظي المجتمع،وبذلك وجد الاستعمار نفسه يقع في الكثير من المفارقات، فكيف يمكنه ضمان استمراره، إذا لم يعلم الناس لغته، ويدفع في
اتجاه انتشار المعرفة الحديثة والقضاء أو النيل من المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية؟. وقد اندهش عندما لاحظ أن النخبة المتعلمة والدارسة للعلوم الحديثة تنادي بالحفاظ على معرفة الناس وخرافاتهم ومفاهيمهم العتيقة، باعتبارها موروثا ثقافيا ينبغي الحفاظ عليه، وهذا ما دفع المستعمر لأن يستعين بدارسيه لفهم المجتمعات المختلفة عنه ثقافيا وحضاريا، فتعلموا لغة المحليين وتغلغلوا في قيمهم، فأدركوا أن الكتابة سلطة تريد النخبة المتعلمة احتكارها ضمانا لسيطرتها بعد الاستقلال، بل إن الكتابة كانت معيارا لاختيار المسؤولين لشغل الوظائف التي تركها المستوطنون والاستعماريون بعد التحرر من الاحتلال الذي عرفته أغلب
المجتمعات العربية.
سلطة السرية
استفادت النخبة العربية المتعلمة من آليات السلطة، بحيث كلما كان الحاكم غامضا، كلما هابته الجموع وتخوفت منه، وبذلك فإن بعده عنها يزيده هيبة ويكون مجرد النظر إلى وجهه موجبا لغضبه وغضب المحيطين به والمؤسسين لسلطته، وبذلك أدرك الكتاب العرب في لا وعيهم الثقافي أن سرية حياتهم الثقافية بمثابة هيبة رمزية، مفروض عدم التفريط فيها. وأما تلك المواضعات المسماة تواضعا، أي التواجد مع الناس وعدم تجنب التواجد في الأماكن العمومية، فقد رأينا أنها مجرد تكتيكات مرحلية،سياسية أو مجرد حاجة لضمان انتشار المنتوجات الثقافية والأدبية، كمدخل للسيطرة على سوق القراءة الذي يحتاجه الكتاب، ويعتبرونه مقياسا للنجاح والتفوق في مجال الفكر والآداب، وما أن تتحقق هذه الغايات حتى يعود الكاتب إلى سريته المعهودة، مكتفيا بمن يقتربون من مكانته الرمزية وحظوته الثقافية، وبذلك تجد المثقفين العرب جماعات متقاربة، لكنها متمايزة بدوافع إيديولوجية لكن حقيقتها غير ذلك، فهناك تراتبات لم تعد الشهادات الجامعية تؤهل لها لأن سوق الانتشار غدا أكثر واقعية من كل المقاييس الأخرى، اللهم في بعض التجمعات الأكاديمية التي تحاول فرض مقياس، عرف الكثير من الهزات في عالمنا العربي وحتى العديد من الدول الغربية نفسها.
* كاتب روائي