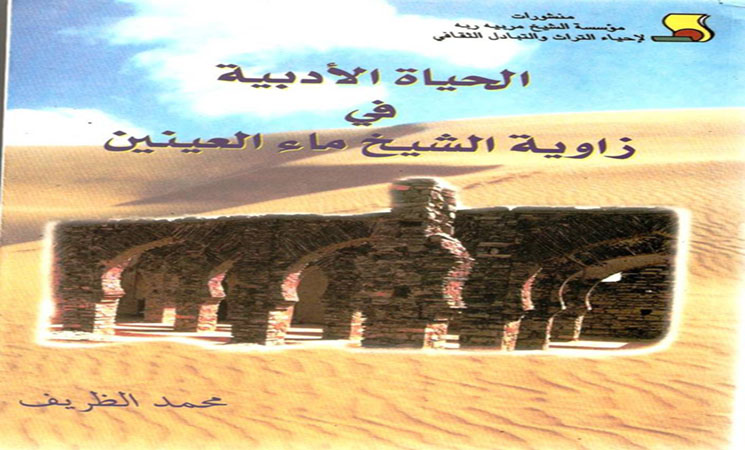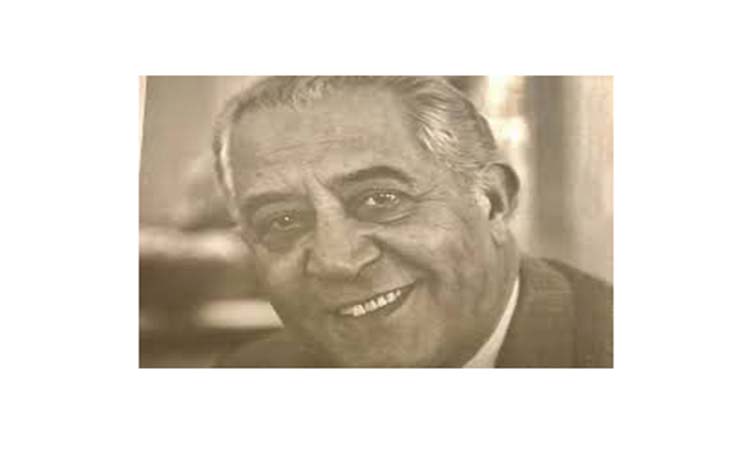ماهي العلاقة بين الكتابة والصحراء؟ وكيف تلازمتا منذ زمن بعيد؟ ألم تكن الكتابة مرتبطة بالصحراء، هل هناك حدود للكتابة في الصحراء أم لا حدود لها مثل كثبان الرمال؟ وأيهما أقرب إلى ثقافة الصحراء: الكتابة أم الشفاهية؟
إنها تساؤلات عميقة تنبعث ونحن نتأمل المتون والمؤلفات التي اتخذت من الصحراء تيمة لها. فلقد شكلت الصحراء دوما فضاء غنيا بامتياز وباعثا على الإبداع والتدوين. بإرثها التاريخي العميق ،وبتنوع تضاريسها، وغنى مواردها الطبيعية التي تجمع البحر والبر في التحام وتناسق جميلين ،كما شكلت ملتقى للحضارات المتعاقبة على المغرب ، لذلك نبغ منها شعراء عديدون ومفكرون كانوا من رموز زمانهم ، ومثقفون ألفوا وأنتجوا كتبا ما يزال بعضها رهين خزانة المخطوطات ينتظر التنقيح وإخراجه من ركام الأتربة ليستفيد منه الأحفاد بعدما أنتجه الأجداد منذ زمن غابر
يعتبر كتاب الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين للدكتور محمد الظريف الصادر سنة 2003 عن منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي من أضخم وأهم الأعمال العلمية الرصينة التي تناولت أدب الزوايا في الصحراء،والكتاب يمتد على 550صفحة وهو في الأصل رسالة دبلوم الدراسات العليا تقدم بها الباحث في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1986
وقد أبرز الكاتب دوافع البحث في الموضوع في مقدمة الكتاب وهي:
1. غياب الاهتمام بأدب الزوايا رغم أن معظم أدباء المغرب وعلمائه ابتداء من العهد السعدي إلى بداية القرن العشرين تخرجوا من هذه المؤسسات الثقافية وتلقوا تعليمهم على يد شيوخها وأساتذتها .
2. تخلف الدراسات العلمية والأدبية عن مواكبة النشاط الأدبي والعلمي الذي عرفته الأقاليم الصحراوية خلال تاريخها الطويل والذي يعود إلى الظروف الاستثنائية في العهد الاستعماري
كما أن اختيار زاوية الشيخ ماء العينين لم يكن اعتباطيا، بل ارتكز على مبررات عدة أهمها أن هذه الزاوية استطاعت استقطاب معظم القبائل الصحراوية، وكونت منها جبهة قوية استطاعت بفضلها أن تحقق مجموعة من المشاريع الاجتماعية والثقافية والسياسية ليصل تأثيرها إلى حدود ليبيا شرقا وإلى مالي جنوبا والى مليلية شمالا. كما أنه على خلاف تخصص بعض الزوايا في مهام محددة فإن زاوية الشيخ ماء العينين كانت تمتلك برنامجا متكاملا يشمل مختلف المجالات انطلاقا من إصلاح ذات البين بين القبائل، وتقوية أواصر المحبة بينها،وتكوين قاعدة اجتماعية متينة وصولا إلى قيادة العمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي في مناطق مختلفة مما أدى إلى عرقلة المؤامرات الاستعمارية لمدة طويلة ،خاصة أنها اعتمدت على أرضية ثقافية صلبة إذ خلف الشيخ ماء العينين وحده (توفي سنة 1910) أزيد من 400 كتاب ناهيك عن أبنائه وتلامذته .
وفي محاولة رصد الحياة الأدبية لهذه الزاوية في مختلف جوانبها،وفي سائر مجالاتها اعتمد الكاتب المفهوم المعيني للأدب انطلاقا من مقولة للشيح ماء العينين :*والأدب كما قرره غير واحد من الأعلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام :الأول ماطبع عليه الإنسان في جبلته وكان في أصل خلقته وفطنته،والثاني ما يكتسبه المرء بالحفظ والتذكار والنظر بالتأمل والاستبصار كاللغة والأشعار والنحو ورقائق الأخبار، والثالث حفظ الحواس ومراعاة النفس.* فلا ينحصر الأدب إذن حسب هذه الإشارات في مجال معين، ولكنه يشمل كل ما يسعى إلى تهذيب الروح والسمو بها سواء عن طريق الكلمة السامية أو الرياضة الروحية من تصوف وشعر وأخبار ورسائل ….
ينقسم الكتاب إلى مدخل وثلاثة أجزاء
في المدخل تطرق الدكتور الظريف إلى تعريف عام للزاوية المعينية حيث حدد المجال الجغرافي لها وهو منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب – مهد الزاوية- من واد نون شمالا إلى إدرار جنوبا مفصلا في بعض تضاريسها والقبائل التي تسكنها والانقلاب الحضاري الذي أحدثه في تاريخها استقرار الشيخ ماء العينين في النصف الثاني من القرن 19 في قلب الصحراء بالسمارة بعيدا عن أخطار المحيط وقريبا من نقط الماء حيث أن مقر الزاوية يتوسط الصحراء ويطل على تندوف، ويراقب عن كثب ما يجري في أدرار وشنقيط فهو موقع استراتيجي بامتياز، والمناخ العام استجابة طبيعية لجو سياسي واجتماعي وثقافي عام مفعم بالتوتر والقلق وفي خضم أحداث جسام كانت تهدد المغرب بالدمار الذي نشأت فيه.
كما حدد الأسس التي قامت عليها الزاوية وهي أربعة : ديني، اجتماعي، سياسي، و ثقافي
وتوقف مطولا عند الأطوار التاريخية للحركة المعينية والتي قسمها إلى ثلاثة أطوار:
1. الطور الذهبي 1857 /1934 ويشمل مرحلتين:
• مرحلة البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي 1857/1910
• مرحلة الجهاد المقدس 1910/1934
2. طور الارتكاس 1934/1956
3. طور الانتعاش 1956/1975
في الباب الأول الذي يتوزع إلى ثلاثة فصول يتطرق د الظريف إلى التأليف في زاوية الشيخ ماء العينين في مجال العلوم من ناحية التصوف والفقه والشروح خاصة لدى الشيخ ماء العينين والشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه والشيخ النعمة والشيخ محمد تقي الله والشيخ شبيهن وابن العتيق واحمد بن الشمس وغيرهم من رواد الحركة المعينية حيث يجرد المؤلف مختلف أسماء الكتب والمخطوطات موضحا لها في الحواشي ومحددا سنة الكتابة .
ففي الفصل الأول يحلل التجربة الصوفية المعينية وأبعادها وقضاياها انطلاقا من ما خلفه علماءها من مخطوطات، بينما يتطرق في الفصل الثاني إلى الفقه مفصلا في مصادر الفقه المعيني وأصوله وقضاياه وخصائص الكتابة الفقهية المعينية وهي ثلاثة :الجمع والشرح المعرفي ،والتبويب والتفريع ،مستحضرا تنوع وتعدد أنواع القول وأشكال التعبير .
في الفصل الثالث يتطرق لمصادر الشروح المعينية وأساليب قراءة النصوص في الشروح المعينية .
الشعر الذي شكل نشاطا متميزا ومجالا واسعا لاهتمام الزاوية المعينية خصص له الكاتب الباب الثاني عبر جرد المسار العام للحركة الشعرية المعينية عبر تقسيمها للحظات ثلاث : لحظة السموق والتحدي وتمتد من 1857 إلى سنة 1934،ولحظة الارتكاس وتمتد من 1934 إلى استقلال الأقاليم الشمالية للمملكة سنة 1956، ولحظة الانتعاش وتمتد من اندلاع حركة المقاومة في الصحراء إلى قيام المسيرة الخضراء . مفصلا في كل لحظة للملامح الأساسية وجرد أبرز خصائصها، ومفهوم الشعر فيها، وأغراضها الشعرية، وخصائصها الفنية ،كما نبه إلى إغفال مؤرخي الشعر العربي والمغربي خاصة التطرق لدواوين شعراء الصحراء رغم الازدهار الذي عرفته الحركة الشعرية في الصحراء .
الباب الثالث خصصه الكاتب لمجال الفنون النثرية الذي يتكون من فنون الرحلات(خارج المغرب وداخله ) والسير(خاصة الشيخ ماء العينين) والرسائل(رسمية،صوفية ،إخوانية ) والخطب والمقالات وغيرها .
في خاتمة الكتاب يجرد الكاتب خلاصات قوية أهمها:
1. إن الصحراء لم تكن تعيش فراغا ثقافيا كما تزعم الدراسات التي أنجزت حول تاريخ الأدب العربي في المغرب،ولكنها كانت تعرف حركة أدبية نشيطة لا تقل في مستواها الكمي والكيفي عن باقي الأقاليم المغربية .
2. إن ما تتميز به الصحراء من خصوصيات طبيعية واجتماعية، وما كانت تعرفه من ظروف سياسية خاصة أدت إلى تقوية الاتجاه الإحيائي الذي سارت فيه النهضة الأدبية الصحراوية في بدايتها.
3. إن تآمر المستعمر على الأقاليم الصحراوية وتشريده لعلمائها وأدبائها ونهبه لذخائرها العلمية وعزله لها عن باقي الأقاليم المغربية لم يتح الفرصة لتقدم الزاوية المعينية ما كان منتظرا منها، حيث تقلص إشعاعها الثقافي وفقدت ريادتها الطليعية في البعث الأدبي ولم تسترجع أنفاسها اللاهثة إلا بعد استقلال أقاليم المغرب الشمالية،حيث نشأت بها نهضة ثقافية ثانية تتسم بالجدة والغْنَى والتنوع حيث ظهرت أشكال أدبية جديدة كالخطبة السياسية والقصيدة الوطنية والقومية والمقالة السياسية والأدبية و الاجتماعية.
4. إن النهضة الأدبية التي تعهدتها الزاوية المعينية في الصحراء لم تكن منفصلة عما كانت تعرفه باقي الأقاليم المغربية من نشاط أدبي وعلمي ولكن كانت ترتبط بها ارتباطا عضويا وتتصل بها اتصالا وثيقا وذلك لما يربط أبناء الصحراء من علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية بباقي الأقاليم المغربية ويشدهم إلى ملوكها من علاقات الوفاء .
5. لم يعرف المغرب في تاريخه الطويل مركزية ثقافية ولكنه كان ولا يزال يعرف حركة ثقافية نشيطة تشمل سائر أقاليمه وتعم مختلف مناطقه، بل يمكن القول أن ماعرفته بواديه وصحاريه من نشاط أدبي يضاعف مئات المرات ماعرفته مراكش وفاس ومكناس وغيرها من حواضره التقليدية مقدما مثالا أن الشيخ ماء العينين وحده خلف أزيد من 400 كتاب عدا ما تركه أبناؤه ومريدوه وأحفاده من مؤلفات .
وفي الأخير فإن الدكتور محمد الظريف و انطلاقا من النشاط الأدبي الذي اضطلعت به الزوايا والربط في صحراء المغرب وبواديه يدعو إلى توسيع دائرة البحث الأدبي في المغرب وإعادة النظر فيما تم إصداره من أحكام نقدية في حق الأدب المغربي خاصة بعد استرجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب وغيرهما من الأقاليم المغربية التي كانت وما تزال تشكل رافدا أساسيا من روافد الأدب المغربي.