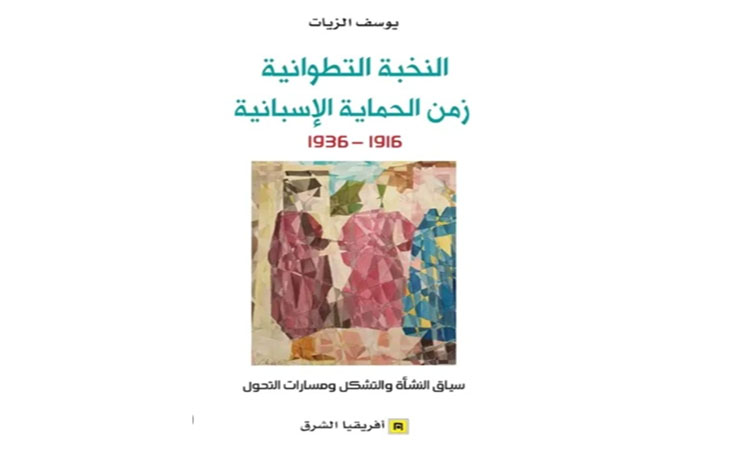النخبة بأي معنى تحدث العودة؟
العودة إلى بناء معنى النخبة يشترط استعادة الشرط التاريخي للتشكل. وقبل تدقيق المعنى، يتوجب الانطلاق من الاستفهام الآتي: متى ولجت مفردة النخبة قاموس الاجتماع المغربي؟ يُلح البعض على أن السؤال في جوهره تاريخي بامتياز قبل أن تنتبه إليه أقلام علماء الاجتماع السياسي، يرتد إلى تقاليد بعيدة من الآن (1)، لعل أقربها يعود إلى أولى لحظات الاصطدام الأوروبي مع دار الاسلام. على مائدة عشاء يوم 11من شهر شتنبر عام 1798 دار حديث بين جنرال فرنسي وشيوخ الأزهر في القاهرة في أعقاب حملة نابليون بونابرت على مصر. خاطب الجنرال الفرنسي شيوخ الأزهر بالقول: «في الماضي زمن الخلفاء، تفوق العرب في الفنون والعلوم، ولكنهم اليوم يرزحون في جهل عميق، ولم يَفْضل لهم شيء من علوم أسلافهم»، أجابه شيخ من الشيوخ: «لقد بقي لهم القرآن الكريم، وهو يجمع بين دفتيه كل المعارف». عندئذ سأل الجنرال: «وهل يعلمكم القرآن طرق صناعة المدافع؟ فأجاب جميع الشيوخ بحماس كبير: نعم. أي موجب لاستحضار هذا المشهد بالذات؟ هناك غايتان أساسيتان: تتصل الأولى بلحظة لقاء النخبة المسلمة مع ورثة الأنوار (2)، والثانية لأنها تُقربنا من فهم منظور الثقافة العالمِة لأزمة التأخر التاريخي في العالم الإسلامي.
بهذا الاستحضار، يحمل سؤال النخب مضمونا وبِنية، دلالة ومعنى. يعتقد بعض المؤرخين أن العودة إلى السؤال هي عودة إلى إعادة اكتشاف مساحات العلاقة بين الذات بالآخر في مستوى عام، وعلاقة المجتمع بالسلطة في مستوى خاص. ويُدقق بعضهم في دلالة كلمة النخبة بالقول: جماعة من الناس يُعبرون عن قضية. لا يكشف التعبير عن تدافعات فكرية حرة ومستقلة، وإنما يتم في إطار استدعاء- إحياء خطاطات أهلية ترتقي إلى مستوى القضية، وأحيانا في إطار افتراض قضية ظرفية تقتضيها المصلحة. في الاجتماع العربي الاسلامي، خضعت النخبة العربية لتفكير النسق خضوعا مطلقا، ولم تتخل عن نَسْغها القبلي ومرجعها الفكري، فكان من الطبيعي ألا يسمح هذا الخضوع بتشكل الفكرة الشقية التي تكسر المألوف التاريخي. (3)
النخبة: جدل التوصيف
كلمة نخبة Elite تفيد في القواميس الانتخاب والاصطفاء الذي تختص به الكفاءات، وقد درج البعض على تعريف النخبة بكونها فئة من الأشخاص يحوزون قدرات خاصة، رمزية أو مادية، وقد أشير لها بالخاصة تمييزا لها عن العامة أو السواد أو السوقة والدهماء…ترافق النخبة مصطلحات موازية من قبيل: الحظوة والألمعية، العبقرية والنباهة والاقتدار…وهي بالتدقيق، فئة اجتماعية تحمل تصورا فكريا أو مذهبيا ينتظم في إطار مشروع سياسي، ومجموعة من الأشخاص يمتلكون قدرة خاصة على التأثير في سير الأحداث وتطور المجتمع. ففي كتابه «البروباغاندا» لإدوارد بيرنيز (1891-1995) الصادر عام 1928م يُشرع لحكم النخبة من أجل الحفاظ على النظام العام وتثبيت الاستقرار، ما يستوجب اتقان فن الدعاية لتشكيل الرأي العام وتجنب الفوضى. بهذا التوصيف، النخبة تمارس فعل الارشاد الأخلاقي والثقافي داخل المجتمع، وتعمل على تغيير الأفكار ومواجهة الذهنيات التقليدية.
انتعش سؤال النخبة كثيرا في حضن علم الاجتماع السياسي في ما بعد (4)، وقُصِدَ به جماعة من الناس يحملون تصورات فكرية ورؤى سياسية مؤيدة أو مناهضة. وبالعودة إلى أصوله، تمَّت صياغة السؤال في لحظة انتقالية، وجِد حساسة من تاريخ المغرب، وارتهنت به قراءات متعددة، اندفاعية أحيانا، ومتفهمة وهادئة أحيانا أخرى. ولربما اليوم العودة إليه تقتضيها مصلحة راهنية. لم يرتفع بعد التوتر بين المجتمع والنخب، لهذا، فالاستدعاء إلى فتح نقاش النخب في تاريخ المغرب لم يشخ بعد، ولا يزال صداه يتردد عند الباحثين في التاريخ وعلم الاجتماع السياسي تحديدا. حقا، تختلف النظرة إلى النقاش باختلاف الحساسيات السياسية والايديولوجية. لكن، في الاستدعاء ما قد يُجلي الرغبة في القبض على لحظات الانعراج التي رافقت مسار تشكل الوعي الوطني تجاه الاستعمار في الفترة المعاصرة؛ من مسار المواجهة المسلحة إلى مسار الحوار والتواصل؛ من مجتمع القبائل إلى «مجتمع التنظيمات» بما تحمله العبارة من دلالة عند السوسيولوجيين.
الحاصل، رغم تقدم الانتاج الإستوغرافي وتراكماته في هذا المستوى يتصدر تاريخ الحركة الوطنية ر واجهة الاهتمامات البحثية (5)، بما يتيحه من مساحات لفهم ما يمكن أن نسميه ب «التحول المعاق» الذي رافق الوعي التحرري في المستعمرات من جهة، وبولادة الدولة الحديثة المستقلة فيما بعد من جهة ثانية.
مداخل إشكالية:
ينطلق المؤرخ في تاريخ المغرب دوما من السؤال الآتي: هل يجوز الحديث عن نخب أم عن مراتب أم عن بيوتات؟ عن صفوة أم عن طبقة…؟ واضح أن المفردات تحمل فيضا من الدلالات والمعاني، لكنها بالنهاية تظل غير مُكثفة للمعنى بدقة. نعتقد أن في الاقتراب اللغوي ما يبدد سوء الفهم الحاصل في تحليل بِنية الخطاب التاريخي.
قبل أن نعرض لبعض قضايا الكتاب، يتوجب طرح بعض الانشغالات التاريخية: هل يعتقد أهل الشمال أن تاريخ النشاط السياسي يكاد يطوى في صفحات تاريخ الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل لهامشية الحضور الإسباني في المغرب من حيث إنجازاته وآثاره دور في عملية الحجب والاخفاء؟ وبالاقتراب أكثر من مضمون الكتاب، كيف ننفذ إلى تاريخ مدينة متوسطية التشكل بالعمل على دراسة نخبها المشرقية التوجه؟ هل يستقيم اختبار فرضيات التحول في مدينة متوسطية بالتفاعل مع ما كان يجري داخل وخارج محيطها القريب والبعيد؟ كيف تشكلت وارتقت النخبة التطوانية إلى الحد الذي صارت ترمز إلى صعود البورجوازيين الجدد لتمثيل الوطنية؟ كيف يتأتى فهم واستعادة مسار تاريخي متشابك لنخبة انتقلت من الظل إلى الضوء؛ من العمل السري إلى العمل السياسي في فترة فاصلة وحاسمة من تاريخ تشكل الدولة الحديثة في المغرب؟ وحين نُجمل هذه الانشغالات في صيغة سؤال مركزي نتساءل: هل ينصرف القصد نحو إظهار تجربة سياسية تحمل خصوصية تاريخية مميزة، أم بتجربة سياسية يمكن أن تنتظم مُجمل تفاصيلها ضمن عموم تطور النسق السياسي في مغرب الحماية (6)؟ من حيث جنس التأليف، هل يمكن الإقرار بأننا أمام بروسبوغرافيا محلية تدخل ضمن قضايا التاريخ المحلي (7)؟
هندسة ومضامين الدراسة:
خرج كتاب «النخبة التطوانية زمن الحماية الإسبانية 1916-1936: سياق النشأة والتشكل ومسارات التحول»* في حوالي 253 صفحة من الحجم المتوسط، مختوما بمسرد بيبليوغرافي اعتمد في توضيبه على مبدأ التصنيف حسب المصادر والمراجع والوثائق والأطاريح والجرائد والمجلات والمقالات…مع إدراج التصنيف اللغوي، وخاصة اللغتين الإسبانية والفرنسية، إضافة إلى وضع فهرس خاص بالأعلام والأماكن والصور والجداول.
من حيث المضمون، تنتظم هيكلة الدراسة في بابين رئيسيين: باب أول يتقفى إشكالية أصول وتكوين النخبة التطوانية 1916- 1930 بالاعتماد على تقنية الانتقاء: «عائلة عبد السلام بنونة، عائلة عبد الخالق الطريس، عائلة التهامي الوزاني، عائلة محمد داوود…وقد تمَّ تقسيم الباب إلى أربعة فصول مهيكلة…وباب ثان يقف عند إشكالية تحول النخبة من العمل الفردي إلى العمل الحزبي 1930- 1936…وقبل البابين، استهلت الدراسة بتمهيد عام يعود بالقارئ إلى اكتشاف اللحظات الأولى لتأسيس المجال التطواني في ارتباطه بالنسيج القبلي وعلاقته بالجوار المتوسطي. وإذا أردنا تجميع هذه الهيكلة، تحاول الدراسة القبض على مفهوم التحول في مسار الوعي الوطني تجاه الاستعمار الإسباني مع بداية العقد الثالث من القرن الماضي. لماذا العِقد الثالث بالذات؟ يعتقد صاحب الكتاب أنه العِقد الذي يسمح بكشف تصور النخبة التطوانية، وببداية تشكل خطاب نقدي مضاد للاستعمار من جهة، وتنظيم سياسي سري انتهى إلى تأسيس حزب سياسي.
المنعطف الاستعماري وخصوصية التجربة التطوانية
لماذا 1916 كنقطة بدء؟ تسمح الوثائق التي استنطقها الباحث بالقول بأنها السنة التي أن تُعبر عن ولادة الفعل التاريخي، عن ظهور أفراد ينتسبون إلى نخبة تطوان. يتعلق الأمر بمسار مُتدرج في البداية، انطلق بعمل أفراد وانتهى إلى الانتظام في عمل الجماعة؛ من نشاط يرتبط بالمجتمع العلمي لتطوان، إلى نشاط يرتبط بالعمل الحزبي، وصولا إلى تأسيس حزب سياسي حمل اسم حزب الإصلاح الوطني سنة 1936م. منذ بدء الحماية على المدينة سنة 1913م، كان العمل السياسي يتعرض للتضييق والحصار في ظل حكم المَلكية الإسبانية.
يجتهد الباحث المغربي يوسف الزيات في إعادة بعث النقاش حول اللحظة الاستعمارية الاسبانية في شمال المغرب، وينتصر لفكرة خصوصية التجربة التطوانية. ومن أجل تنزيل هذه الفكرة، يقترح الزيات وضع عتبات لفهم التحول في الخطاب، من خطاب كان يقبل بفكرة الاصلاح والتحديث إلى خطاب بدأ يناهض الفعل الاستعماري، ويجعله خروجا عن مضمون وثيقة الحماية، وعن الأوفاق الاستعمارية التي ارتبطت بها. في هذا السياق، يعود الزيات بالقارئ إلى أزمنة التشكل؛ تشكل النخبة التطوانية زمن الحماية الاسبانية في فترة تحمل عدة أسئلة حول وجوب الاختيار الزمني 1916-1936م. يقترح في سبيل ذلك إعادة توضيب شريط الأحداث والوقائع التي أسست للتحول في المسار، بالاعتماد على مبدأ التدرج في النضال وفق ما تقتضيه رهانات اللحظة السياسية وحساسيات الفاعلين السياسيين. ومن خلال هذا الاجتهاد، يلمس القارئ رغبة صريحة من طرف المؤلف في تناول إشكالية النخب في تاريخ المغرب تناولا جديدا، بناء لا يلتفت إلى دعاة التمجيد، ولا إلى دعاة التسفيه. يتعلق الأمر، بقراءة هادئة تفتح إمكانات التفكير دون أن تخنق نفسها في متاهات التقييم والحكم. وحتى يتحقق ذلك، يجِدُّ الباحث يوسف الزيات في التعمق في خصوصية التجربة الاستعمارية الإسبانية في تطوان، وفي مقام ثان يتعقب الهزات السياسية التي عرفها مسرح الأحداث بإسبانيا، والتي تردد صداها في أنشطة الحركة الوطنية التطوانية. على العموم، يُشركنا الكاتب في طرح الأسئلة التي تجلي فرضيتي التزامن والتعاقب: كيف نفهم التزامن الذي صاحب تأسيس حزب الإصلاح الوطني مع تمرد فرانكو ضد حكومة الجبهة الشعبية سنة 1936؟ وكيف يستقيم فهم التعاقب الذي انتقل بالنخبة من القبول بالوضعية الاستعمارية إلى العمل ضدها؟
لا نستغرب حينما نصادف بعض الأبحاث التاريخية التي سارت في اتجاه تبني التحليل الذي يقول بأن حزب الإصلاح الوطني يدخل ضمن دائرة صناعة القرار الاستعماري والاستخباري بهدف تقويض مصالح حكومة الجبهة الشعبية، كما لا نستغرب أيضا، من الاتجاهات التاريخية التي أوحت إلى أن توظيف حزب الإصلاح الوطني كان يدخل ضمن استراتيجية تهدئة أوضاع الحرب الأهلية في إسبانيا. القاسم المشترك بين الاتجاهين، وجود مصالح سياسية وامتيازات اقتصادية تمتع بها وطنيو الشمال.
العُدَّة الأرشيفية:
يستهل الباحث يوسف الزيات في تناوله إشكالية النخبة التطوانية زمن الحماية الإسبانية بمدخل إستوغرافي، يعود من خلاله إلى فحص مُجمل الإنتاجات التاريخية التي تناولت هذه القضية، ويُكثف من خلال هذا المدخل عمل النشاط السياسي في شمال المغرب ضمن مقاربات توضيحية: مقاربة إيديولوجية «إبراهيم الخطيب»، مقاربة أرشيفية توثيقية «محمد بن عزوز حكيم»، مقاربة أكاديمية -بحثية « عبد المجيد بنجلون»، مقاربة قانونية- تاريخية « حسن الصفار»، مقاربة بحثية- تاريخية «عبد العزيز السعود»، مقاربة أكاديمية- تاريخية « أنس الفيلالي- يوسف مرون- عاهد زحيمي». واضح أن هذه المداخل تلتقي كلها في الإجابة عن السؤال الآتي: هل كانت تحمل هذه النخبة الإصلاحية مطالب شعب؟ أم مطالب بورجوازية مغربية وجدت نفسها على الهامش في ظل تنامي المصالح الاستعمارية؟ وهل تستقيم القراءة التاريخية التي تسير في اتجاه القول إن الحركة الوطنية ساهمت في تعطيل مسار المقاومة المسلحة (8)؟
المؤكد أن حزب الإصلاح الوطني في الشمال تعبير عن لحظة تحول في الوعي السياسي، لكن يجب أن يُقرأ التحول من زاوية استثمار العواطف الدينية لبناء الشرعية السياسية في مواجهة الاستعمار الإسباني. ظل الحزب يردد في بياناته وخطاباته قضايا الهوية واللغة والدين حتى يستميل النفوس والقلوب، لكن ظل يحمل معه وجع الولادة، لم يتخلص من إرثه القبلي وفكرة الزعيم الواحد ومظاهر الانقسامية من حيث الانصهار والانشطار…من الطبيعي، أن يتعرض تاريخ الحركة الوطنية المغربية إلى انتقادات واسعة حول التصورات والمواقف. «نخبة براغماتية لم ترتقي إلى مستوى التنظيم المطلوب للعمل الحزبي، معزولة عن الجماهير، في المدن والقرى (9) «، أو على الأصح، نخبة ذائبة في إرادة الفرد الذي يحيط به عناصر من نفس القرابة.
مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في إسبانيا في بداية الثلاثينات من القرن الماضي كان سقف التطلعات كبيرا من طرف الوطنيين المغاربة من أجل التعاون، لكن سرعان ما تعرضت الحركة الوطنية لخيبة أمل كبيرة من عدم وفاء الجمهوريين بوعودهم (10). وقتها، بدأت تتشكل القناعة السياسية نحو التنظيم والامتداد في الحواضر الكبرى، لكن بخلفية مصلحية لا تخفى. لم تكن النخبة التطوانية تتردد في التعاون بين الحاميين والمحميين من أجل استغلال كل الفرص الممكنة.
في حقيقة الأمر، فرغم هامشية الحضور الإسباني في مغرب الحماية، إلا أن تأثيره الشعبي كان أقوى من تأثيره السياسي. فقد ساهم اختلاط الفلاحين والجنود البسطاء في المجتمع الريفي في تعزيز حضور اللغة الإسبانية داخله، لكن ليس إلى المستوى الذي يمكن فيه الحديث عن بلترة حقيقية، أو عن مراكز حضرية شيدها الاستعمار الاسباني. تذهب مجمل الأبحاث والدراسات التي اهتمت بهذه الفترة بأن المجتمع الريفي ظل في عمومه قرويا، رغم ميلاد فئة جديدة من المأجورين في تطوان.
عودة إلى مضمون الكتاب، يعرض الكتاب لتصورات النخبة حول المجتمع، ويكثف تحليلاته حول المعضلة الاجتماعية وما يرتبط بها من جهل ومعاش وحرية…لقد وقع الاختيار على فترة قصيرة زمنية، لكنها مُعبرة ودالة ومكثفة لفهم التحول، في الخطاب وفي الممارسة، وفي النَّفس النضالي الذي جادت به مجريات الأحداث ما بعد الحرب الكبرى الثانية. في واقع الأمر، استثمرت الدراسة رصيدا وثائقيا ومصدريا متنوعا، (محلي وأجنبي) يسمح بتشكيل صورة مكتملة عن الموضوع، منها ما يعود إلى وثائق ما قبل تأسيس حزب الإصلاح الوطني، وبالأخص، الوثائق التي تعود ملكيتها إلى مديرية الوثائق الملكية «المجموعة الثالثة، الصادرة سنة 1976، والمجموعة الرابعة الصادرة سنة 1977، والمجموعة الثامنة الصادرة سنة 1992، وهي عبارة عن وثائق مخزنية ومراسلات سلطانية وأيضا مراسلات بين السفراء والأجانب. وقد أغنى الباحث يوسف الزيات المشهد بالانفتاح على وثائق الأرشيف العام للإدارة Archivo general de la administracion الموجود في مدينة ألكالا دي ايناريس Alcalada de Henares بضواحي العاصمة الاسبانية مدريد، فضلا عن ملفات خاصة بالإدارة العامة للمغرب والمستعمرات Direcion de Maruecos y Colonias، بالإضافة إلى وثائق المكتب السري لشؤون الأهالي التابع للمندوبية السامية بتطوان، ناهيك عن استثمار الأرشيف الرقمي بمكتبة مدريد الوطنية Bibliotica National de España، زيادة على مجموعة من التقارير الصحفية والكتب والمؤلفات…
ينتصر الكتاب إلى الفكرة التي تسير بالقارئ بالتدريج حتى يقتنع بأننا أمام نخبتين سياسيتين، موحدتين من حيث الغايات والأهداف، ومتباينتين في أساليب النضال والنشاط الثقافي والسياسي (11). القاسم المشترك بينهما، خلق ثقافة وطنية تُعبر عن احساسات هوياتية ضد الاستعمار الأجنبي. مع دخول الاسبان إلى تطوان سنة 1913، بدأت ملامح التحول تبرز على المدينة، إداريا وسياسيا واقتصاديا، وبما أن لكل تحول انعكاسا، كانت نخبة تطوان ضمن هذا التحول وهي تبحث عن موقع لها ضمن المشهد التاريخي، تسعى إلى تأكيد حضورها الثقافي عبر المبادرات التعليمية.
ومع بداية الثلاثينات، وفي خضم التجاذبات السياسية التي عاشت على إيقاعها إسبانيا، انتقلت النخبة التطوانية من الظل إلى العلن، من العمل السري إلى العمل السياسي، وكانت قد استثمرت الفترة الممتدة من 1913 إلى 1930 في التكوين وإرسال البعثات الطلابية إلى أوروبا، وساهم سقوط المَلكية الاسبانية 1931 في تهييئ المناخ السياسي للمبادرة والفعل وكسب هامش من المناورة والتحرك. انطلاقا من ذلك التاريخ، قدمت نخبة تطوان مطالب الأمة، وتحول موقف عبد السلام بنونة من مرحلة المطالبة بالإصلاح في ظل «الوضعية الاستعمارية» إلى مرحلة المواجهة والنقد تجاه الاستعمار الإسباني، وتعزز هذا المسار، بتطور العمل الصحفي داخل المدينة من خلال «مجلة السلام» 1933 و»جريدة الحياة» 1934. هكذا، وفي إطار الاستمرارية وتطور الوعي السياسي، تُمثل مرحلة عبد الخالق الطريس لحظة حاسمة ومفصلية في قراءة تحول مسار النخبة التطوانية. الطريس منح للفعل السياسي داخل المدينة نفَسا جديدا، ونقله من مرحلة المبادرات الإصلاحية إلى مرحلة العمل السياسي الذي ينتقد الدولة الحامية ويطالبها بوجوب إشراك الأهالي في التدبير السياسي.
خلاصات وامتدادات:
بالنهاية، نكاد نجمل هذه التحولات في مسار جيلين من النضال: مسار أول يمثله عبد السلام بنونة، يبدأ من بداية الحماية الإسبانية على تطوان 1913 إلى غاية 1930، ويمكن وسمه بمسار الإصلاح من داخل «الوضعية الاستعمارية» وتجنب المواجهة والاصطدام، ومسار ثان يمثله عبد الخالق الطريس، يبدأ من الثلاثينات، يتبنى النقد عبر استثمار العمل الصحفي، ويدعو سلطات الاستعمار الاسباني إلى ضرورة احترام مضمون معاهدة الحماية…وبين المسارين، هناك محطات تاريخية حاسمة في الفرز، تأسيس المجمع العلمي المغربي سنة 1916م، والمدرسة الأهلية 1924 اللتين ساهمتا في تخصيب الوعي السياسي لدى نخبة تطوان. لكن، يدعونا الباحث إلى التفكير عميقا في القول الذي يقول بأن المنطقة خضعت لاستعمار غير امبريالي، أو لنقل استعمار صغير، والعبارة في الأصل تعود إلى جمال حمدان، استعمار صغير مرتبط بمَلكية في حالة تفكك وجمهورية محكومة بقبضة من حديد داخليا، ومتساهلة إلى حد ما مع أوضاع الخارج.
إن لفكرة غياب الاستقرار في المتروبول دورا في فهم تحولات النخبة التطوانية زمن الحماية الاسبانية، خاصة من حيث استغلال الفرص واللعب على اللحظات الانتقالية والاستفادة من الممكن والمتاح، والقدرة على التأقلم المستمر مع الطارئ والمستجد، الداخلي والخارجي بالشكل الذي يمنح للنخبة التطوانية حضورا متميزا في النضال من أجل الاستقلال. هناك ملمح آخر لهذه النخبة، طابعها السلمي الذي يكاد يجسد خصوصيتها السياسية، وتجنب العنف والاصطدام في علاقتها بالإدارة الإسبانية. وهكذا، يحملنا الكتاب إلى تقبل الفكرة التي تقول بالتدرج، من الاهتمام بالعمل الثقافي والتربوي إلى المطالبة بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والانتقال إلى المطالبة الصريحة بالاستقلال مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما يجعل الكتاب حلقة ضمن مشروع مفتوح على تحولات النخبة التطوانية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
على العموم، علينا أن نُوسع منظورنا للكتاب، ونطرح القضايا الكبرى التي اعتملت في تشييده. الكتاب بحق، توليف تاريخي يستدمج السياقات التاريخية التي هيأت لولادة الوعي السياسي في شمال المغرب، ويضعها ضمن أفق إمكانها المحلي، دون تعسف على المسار التاريخي أو تحامل عليه. مع تقليب صفحات الكتاب نقتنع بأن النخبة التطوانية لم تعكس تدافعات المجتمع الريفي في الشمال، وظلت في انفصال عن عمقها القبلي، كما أنها لم تمتلك تصورا شموليا لوضع البلاد في ظل «الوضعية الاستعمارية»، ولم تسمح نظيمتها بفرز مساحات حول حرية التفكير السياسي بالشكل الذي يُفيد التدافع والتناوب. بالنهاية، لم ترتق إلى صياغة تصورات تركيبية حول هندسة المشروع المجتمعي في ظل الاستعمار على النحو الذي يخرج البلاد من المألوف إلى المستجد.
من حق الباحث اليوم أن يعود إلى تدقيق بعض جزئيات الصورة المشكلة عن النخبة التطوانية، خاصة تلك القراءات التي خنقت الوطنية المغربية في ترديد شعارات سياسية منفصلة عن الوجود التاريخي، ممهورة بمعطيات إثنوغرافية محلية الصنع في شبه تميز عن الصناعة المشرقية في بعض اللحظات. عموما، ظلت النخبة التطوانية تصطف في موقع رد الفعل، تتحين الفرص المتاحة، وتشتغل بإمكانيات بسيطة على النحو الذي جعلها لا تغادر منطقة «رد الفعل»، بما تفيد هذه العبارة من تناقضات داخلية، وعدم القدرة على الانتقال إلى مرحلة الفعل التاريخي.
*»النخبة التطوانية زمن الحماية الاسبانية 1916-1936، سياق النشأة ومسارات التشكل» افريقيا الشرق، 2024.
الهوامش:
– مشروع نقد النخبة ما كان ليتم عربيا لولا فكر كانط وحفريات فوكو، الأول في «نقد العقل الخالص» في نهاية القرن 18م، والثاني في كتابه «الكلمات والأشياء» في ستينيات القرن العشرين.
2- في كتابه «حرب الذوات» la guerre de subjectivité يطرح المفكر التونسي فتحي بنسلامة فكرة نكران الواقع كعَرض من أعراض الأمراض النفسية عند النخبة العربية، وقد أشار المؤرخ عبد الله العروي إلى ذلك، حينما تحدث عن المثقف التقليداني الذي يفتقد إلى العناصر التي تسمح له بوعي اللحظة التاريخية.
3- هناك استثناء في المشهد، الفقيه أبو الحسن اليوسي الذي ثار ضد سلطة الثقافة، ضد سرديات المشايخ، ضد ثقافة البادية وثقافة الحاضرة. يمكن العودة إلى:
Jacques Berque, Al Youssi, Problème de la culture marocaine ai XVII siècle, éd 2001.
4- يمكن الإحالة هنا على دراسة حديثة صدرت للباحث خالد ياموت حول النخبة والسلطة بالمغرب، أطروحات في الإصلاح السياسي، عن دار معارف المستقبل سنة 2024. تقف الدراسة عند فكرة العطب المعرفي الذي جعل فكرة الاصلاح ترتهن بالمرجعيات الفكرية لحداثة القرن التاسع عشر، وتُقلب في إشكالية الإصلاح وبناء الدولة الحديثة والتحديث السياسي…تظل الفكرة الأهم في الكتاب هي تلك التي تقر بالاستعادة السلفية لبعض الأطروحات الاديولوجية القديمة في مشاريع الإصلاح والتحديث، وهي سلفية مزدوجة، سلفية أنوارية، وسلفية تقليدية.
5- سبق للمؤرخ عبد الأحد السبتي أن أثار قضية العودة إلى دراسة تاريخ الحركة الوطنية في المغرب بالبحث في أصول تشكل الوطنية خلال القرن التاسع عشر. انظر: عبد الأحد السبتي، التاريخ والذاكرة، أوراش في تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، 2012.
– Abdelmadjid Benjellon, Le nord du Maroc, L indépendances avant l’indépendances, Les Editions Toubkal, et L’Harmattan, première éditions, 1996, Rabat.
7- يستشهد الكاتب بمقولة عبد الله العروي: « بدون المبحثة لا يستقيم منطقيا ولا عمليا مشروع التاريخ الشمولي». راجع، عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، الجزء 1، الألفاظ والمذاهب، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1997، ص 190.
8- ساهمت البورجوازية الإصلاحية في عرقلة نمو الحركة الثورية واجهاض الروح الثورية التي امتاز بها أهل الريف. يوسف الزيات، م س، ص 18.
9- ابراهيم الخطيب، ملاحظات في نقد الحركة الإصلاحية وأفقها الاديولوجي، مجلة أنفاس، مطبعة التومي، الرباط، عدد مزدوج، 7-8، دجنبر 1971، يناير 1972، ص ص 77-87.
10- يوسف الزيات، النخبة التطوانية زمن الحماية الاسبانية 1916-1936، سياق النشأة ومسارات التشكل، افريقيا الشرق، 2024، ص 23.
11- نفسه، ص 34.
*أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض