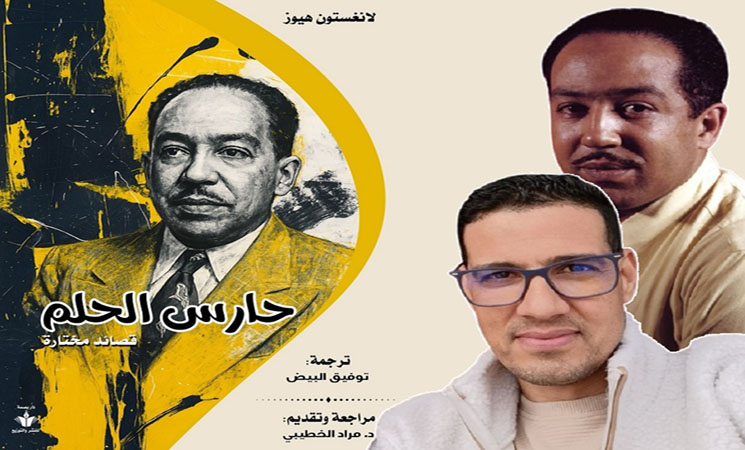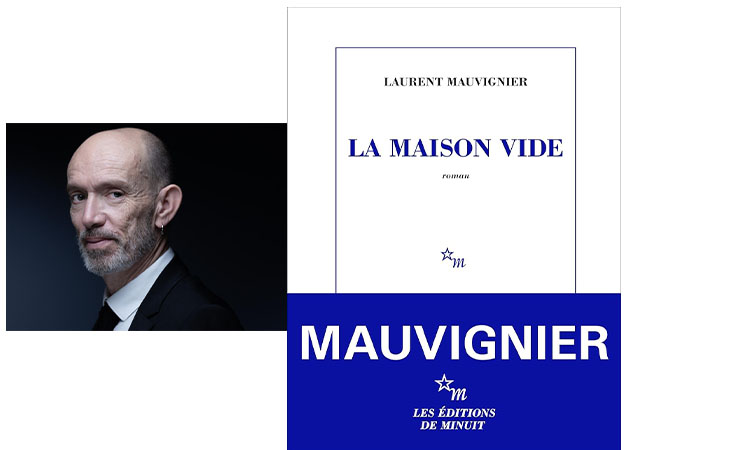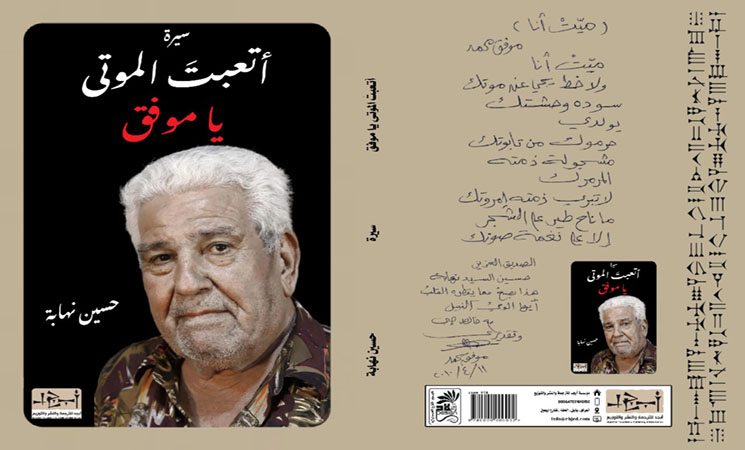هناك، غير بعيد عنا، دار نقاش صاخب جِدًّا، كانت ايقاعاته تَهزُّ مُدرجات الجامعات الأوروبية والأمريكية بنِسب متفاوتة. في واجهة النقاش مراجعات عميقة، مواجهات عَلنية، واصطدامات فكرية بين اتجاهات فلسفية وتاريخية وسو سيو-أنثربولوجية أعادت إلى واجهة الاهتمام من جديد قضايا أبستمولوجية اعتملت في مطبخ التحليل الاجتماعي، واختصت بإعادة التفكير في قضية تعددية البناء التاريخي من جهة، ومَركزة الحدث التاريخي في بُعْدَيه البنيوي، أو الفردي. ففي فرنسا مَثلًا، وبَعد مرحلة تهميش قصيرة أَقَرَّتها توجهات مدرسة الآنال الفرنسية في حق جِنس البيوغرافيا التاريخية تحت وَقع اختيار منهجي فَضَّل دراسة البِنيات والأنساق والمؤسسات على حساب مُكتسبات التاريخ السياسي…تعود اليوم، وبِكثافة سُيولة الكتابة البيوغرافية إلى الساحة الثقافية، ويعود معها الفرد إلى صدارة المشهد التاريخي والأدبي والنفسي…
وبِحق، صاحبت هذه العودة الإبستمولوجية التي تَزعَّمها مؤرخون، فلاسفة، أدباء، بِمعيَّة أنثربولوجيين، رَجَّة قوية مَسَّت مُكتسبات مدرسة الحوليات الفرنسية…جَرى ذلك تحت تأثير رجع الصدى الذي أحدثته ثورة 1968م. لم تكن هذه الفَعفعة عادية وهادئة، بل صاحب الاستشعار حتى رموز الحوليات…بشأن ذلك، خَصَّص المؤرخ الفرنسي الشهير جاك لوغوف في كتابه «التاريخ الجديد» مقاطع مُتكررة لنقد أولئك الذين يَتبنون جِنس البيوغرافيا التاريخية، وهاجم المُرتدين عن ورش التاريخ الشمولي…يتعلق الأمر، وِفْق رُؤية لوغوف ومُنتسبيه بإشهار عداء منهجي صريح ومكشوف اتجاه مناصري البيوغرافيا التاريخية، إلى حَدِّ التشبيه بـ»المهاجرين الذين عادوا بعد الثورة الفرنسية دون أن يتعلموا جديدا، أو ينسوا قديما». إنهم بتعبيره دائما يُشكلون «عودة غامضة» إلى مواضيع تاريخية قديمة، تُحركها نوازع الإيديولوجيا، وروح الانتقام من الحوليات، ورغبة في هدم صرح الحوليات العتيد…
وبالفعل، فقد أثار صدور كتاب «التاريخ المفتت» في حينه للمؤرخ «فرانسوا دوس» جَلبة حادة داخل الوسط التاريخي الفرنسي، وكثَّف الضوء حول قضية الانشقاقات والتصدعات الإبستمولوجية الكبرى التي رافقت تصور التاريخ والكتابة التاريخية، وكشف بجرأة كبيرة عُمق الخلافات البِنيوية لدى ورثة عرش لوسيان فيفر ومارك بلوك…حينما تَفتَّت التاريخ إلى دراسة تشظيات موضوعاتية مِجهرية ذات نفحة أنثربولوجية…فهل كان الأمر، تعبيرًا عن تَصدع عابر؟ أم تعبيرًا عن تصدع غائر وبنيوي داخل صَرح الحوليات؟ هل كانت العودة إلى جِنس البيوغرافيا مؤقتة للفت الانتباه إلى مواضيع أغفلتها مدرسة الحوليات؟ أم أن الأمر، يتجاوز ذلك، ويدفع إلى استعادة تاريخ الفرد، ومعه التاريخ السياسي؟ لكن بالمقابل، من حق البعض، أن يرفع السؤال التالي: أي قيمة للسير الفردية والجماعية لأشخاص بطوليين وحتى هامشيين من أجل إعادة توضيب حلقات الماضي المركب؟
غير بعيد عن فرنسا، انتعشت كتابة جِنس البيوغرافيا في بعض بلدان أوروبا الغربية. وجرى ذلك تحت حضور قوي لمؤرخين ينتمون إلى مدرسة التاريخ من أسفل في إنجلترا، ومدرسة الميكرإستوريا في ايطاليا، ومدرسة التاريخ اليومي في ألمانيا…أعادت هذه التجارب الثلاث إلى دائرة الضوء، من جديد، مساهمة الأفراد في صناعة الأحداث الكبرى، وسلَّطت الاهتمام على فئات اجتماعية ظلت تسكن نتوءات الصناعة التاريخية وخارج مداراتها المنهجية…ينصرف القصد تدقيقًا، نحو بيوغرافيات خِصبة ودَسمة من حيث البناء والتركيب، تقتحم أوراش الكتابة التاريخية، وتفرض نفسها كحقل جديد لإحياء الذاكرة التاريخية والموروث المشترك، وتقترب من أجناس السير الجماعية، السير المتوازية، السير المتقاطعة، السير الفكرية، وسِير الناس العاديين…
وبالعودة إلى سياق التشكل، ففي الوقت الذي ناصب فيه رواد الجيل الثاني لمدرسة الحوليات العداء لجِنس البيوغرافيا التاريخية، واعتبروها «جُثة لا يجب إحياؤها من جديد»، بتَعِلَّة قِلَّة الضبط، والإفراط في الخيال والتخييل، والانتماء للتاريخ السردي على النحو الذي ترافعت عنه المدرسة الوضعانية مع كل من شارل سينوبوس وفيكتور لانغلوا…تألقت مع بداية عِقد الثمانينات من القرن الماضي عِدَّة بيوغرافيات تاريخية، كان قد صاغها باحثون من تخصصات مختلفة، علماء اجتماع، نفسانيون، أنثربولوجيون، إثنولوجيون، كما مؤرخون…فهل تُمثل هذه العودة رِدَّة على مكتسبات الحوليات؟ أم فقط تلبية واستجابة لطلبات سوق القراءة، ومؤسسات النشر وشغف القراء في تعقب الأمور الشخصية؟ هل حَملت معها اقتناعا ببؤس التاريخ البِنيوي وحَجبه لقضايا تاريخية رئيسية، وانتصارًا لتيار الوجودية الذي ظل صاحبها في الظل في الوسط الثقافي الفرنسي؟
مهما بدا للبعض من تجاذب، فإننا أمام توجه جديد، بدأ يفرض نفسه، داخل مسار الكتابة التاريخية، في جامعات أوروبية وأمريكية، بدرجات جِد مختلفة. توجه يستشعر التعقيد الذي تقتضيه الإحاطة بإعادة بناء الماضي، ويُعمِّق النظر والتفكير في الفردانيات البشرية، ويُمعن النبش والتدقيق في خصوصيات الحياة الخاصة لبعض الأفراد والمجموعات، ويُعيد بناء نسق الأحداث التاريخية بناءً جديدا…يتم تكثيف هذه التوجه في تعبير دال جدا تحت عبارة : الانفجار البيوغرافي» كما جاء على لسان مجلة «لوفيغارو» الفرنسية.
بالنزول إلى المغرب، في ما سبق، أثار المُنجز السوسيولوجي الكولونيالي الانتباه منذ وقت جِد مبكر إلى وجوب الاهتمام بسِير بعض الفاعلين، وحياة الأشخاص حتى يتأتى فهم ذِهنيات المجتمع المغربي الماقبل رأسمالي، وبما يُمكن أن تُوفره من معطيات تاريخية وسوسيولوجية عن طبيعة سَيْر النسق الاجتماعي والاقتصادي بمغرب ما قبل الحماية وبعده منذ الدراسات الإثنوغرافية الفرنسية التي واكبت مشروع التحضير لاستعمار المغرب، وصولا إلى مرحلة اقتحام المدرسة الأنثربولوجية الأنجلوساكسونية للمجتمع المغربي عشية الاستقلال.
انشغلت أسئلة السوسيولوجيا الكولونيالية في البدايات الأولى لأعمال البِعثة العلمية على دراسة جوانب المغايرة والتضاد الثقافي للمجتمعات المسماة آنذاك ب «الباردة»، ورصد أنساقها الرمزية والمادية من أجل تقديم مقتربات معرفية دقيقة تستثمرها أجهزة الحماية الأجنبية. في سياق آخر متصل ببداية البحث الأنثربولوجي بالمغرب، هيمنت المدرسة الأنجلوساكسونية على الأبحاث الرائدة داخل المجتمع المغربي، من خلال أبحاث عدَّة باحثين مثل دافيد هارت، رايموند جاموس، ارنست ݣلنير، ديل ايكلمان، بول رابينو، آمال رصام فينوكرادوف، كنيت براون…هذه الأبحاث حاولت في مُجملها تفكيك وتشريح بِنية المجتمع المغربي من شُرفة مؤسساته الفاعلة، وتدقيق جوانب خاصة من معيش المغاربة اليومي….
في نفس الاتجاه، يحضر اسم جاك بيرك…حظي بيرك ولا يزال إلى اليوم بموقع هام ضمن شبكة البحث السوسيولوجي بالمغرب. كتاباته هي مرآة سوسيولوجية تَصدر عن مَنطق مُغاير لمقاسات الأبحاث التي سارت في ركاب الأجندة الكولونيالية…وهي في المُجمل أبحاث عكست تحولات المجتمع المغربي في زمن انتقالي وحاسم عشية الاصطدام بحداثة الرجل الأبيض، ومُحايثة أيضا لتجاذبات المغرب الراهن : مغرب مُسْتثقل بموروث قبلي ومخزني وديني، ومغرب آخر مُتطلع إلى تحديث نفسه على شاكلة المجتمعات الأوربية…
بالنهاية، لا تزال دفوعاته المعرفية تُشكل نسقًا معرفيا مُتراصا يصعب خلخلته، وحتى تجاوزه…كما لا تزال قراءاته السوسيولوجية تَرِنُّ في آذان الباحثين، وتَصدح بعمق داخل جدران الجامعات المغاربية، بعيدا عن الجدل الذي اكتنف ماضي الظاهرة الاستعمارية من تحاملات وطنية، وقصور التصور الكولونيالي في استيعاب خصوصيات المجتمع المغربي…، ويُلاحظ القارئ لمُنجز جاك بيرك تعدد الاهتمامات والقضايا، والتنقل بين الفضاءات الجغرافية في العالم العربي الاسلامي ضمن نظرة منهجية عمودية لواقع البِنيات الاقتصادية والاجتماعية قبل وبعد الاستعمار.
هذه الاهتمامات المُركَّبة قادت بيرك إلى فتح نوافذ مهمة على عدة تخصصات متقاطعة مع السوسيولوجيا، مثل القانون، الفلسفة، العلوم السياسية، الاقتصاد، الفنون الجميلة، اللغة، اللسانيات، الأدب والتاريخ…مما يضع الباحثين أمام صعوبة حصر اهتمامات جاك بيرك والقبض على عناصره الفاعلة…
الحاصل، كُلُّ اقتراب من جاك بيرك وحياته الشخصية في المغرب وحتى خارجه يُمكن أن يكون مَدخلاً أساسيًّا لإعادة اكتشاف جوانب ظليلة من تاريخ رجل السوسيولوجيا بالمغرب. الأفق هنا، تشييد مشروع فكري- بيوغرافي تلتقي من خلاله أسئلة الذات مع قضايا الوجود الإنساني في مُشتملاتها : الأصالة، الحداثة، الهوية، حق الاختلاف، علاقة الشرق بالغرب، الهيمنة الأمريكية، تدمير الخصوصيات الثقافية، أعطاب التنمية، إشكالات التخلف…بصيغة أدق، أفق معرفي ومنهجي يُعيد توضيب تاريخ الفرد والمجال، ويتوسل بالذاكرة من أجل تبديد سوء الفهم الكبير الذي يفصل بين الأنا والآخر…
تعددية البناء التاريخي: عودة إلى زمن الاهتزاز المنهجي
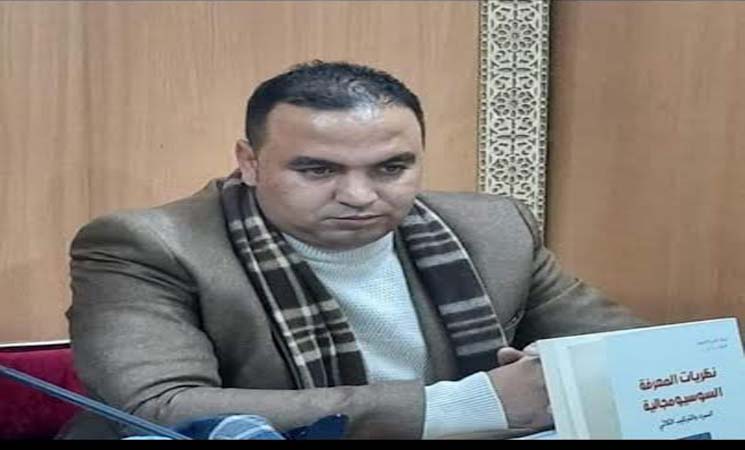
الكاتب : عبد الحكيم الزاوي
بتاريخ : 27/06/2025