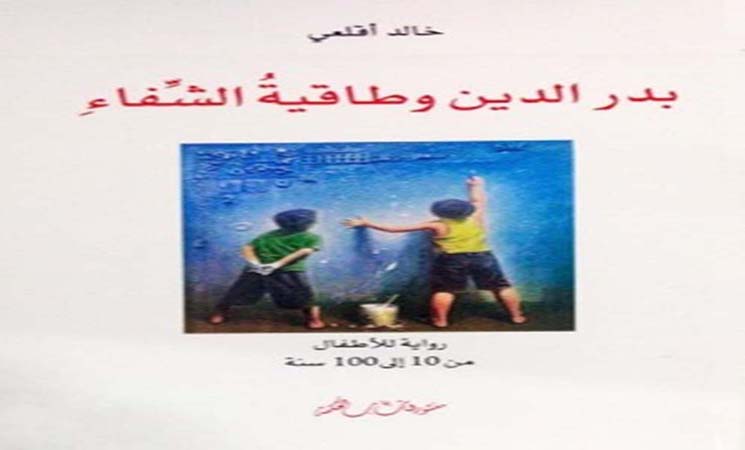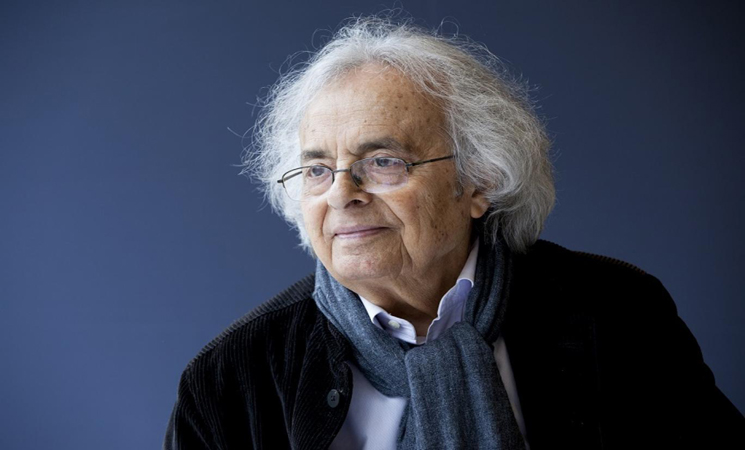في حياته، لم نكنْ نعرفُ عنه، ونحن أصدقاءَهُ الْخُلَّصَ، إلا كاتبا مسرحيا، ومخرجا، وممثلا، ومصمما للمناظر والإنارة، ومنجـزا حذِقًا للوحاتِ وإعلاناتِ عُروضِهِ، أي لا يتعدى حدودَ الجنس المسرحي! ..وفي وفاته، سنكـتـشفُ أنه كان في (وحدته وعزلته) شاعرا وزَجَّالا وناقدا وفنانا تشكيليا، وكاتبا لسِيَــرٍ ذاتيةٍ وغيريةٍ، لم يكُنْ يُــشْهِــرُهاعلى الملأ، تواضعًا منه، كعادته دائمًا، أو ربَّما غير راضٍ عنها، أو يــنــتــظــر اللحظةَ الملائمةَ لـيَــنْــشُــرَها، وبقيتْ في طَيِّ الْكِتْمان، إلى أنْ رَحَلَ عنَّا!
وما “أقواسُ /أيامي” إلا غَـيْضٌ من فَـيْضٍ سيريٍّ كبيرٍ!..كما أنه عاشرنا رَدَحًا من الزَّمن، ونحن نناديه بـ(تـيـمـدْ) وإذا به يُلْغيهِ، ليعوضَهُ بلقب(التيجاني)ويأتي آخرون ليلغوا اللقبين معًا بـ(الراجي المدني)!..وبذلك تـنطبق عليه قولةُ الشاعر:”سبحانَ الذي جمع العالمَ في واحدٍ”!..لكنني أرَجِّح أنَّ لقبه الحقيقي، هو “التيجاني” لعلاقة عائلته بالزاوية من جهة، وسَكَـنِها بحيِّها في مرحلة من مراحله العمرية التي أثَّــرتْ في حياته وشخصيته من جهة ثانية!
يقول عن هذه الصلة الروحية: كان أبي “يأخذني إلى المسجد لصلاة الجمعة (يقصد جامِعَ القرويين) في هذه المرة أخذني إلى سيدي أحمد التيجاني الولي الذي لولاهُ لكنتُ لحقتُ بأخي وبأختي، فقد رفَّــدوني عليه، فأسموني محمد التيجاني”!
إذنْ، بفضل هذا الولي (اعتقادًا من الصَّبي) أُنْـقِــذ الطــفــلُ/ الكاتبُ مراتٍ من الموت، الذي حصد العديدَ من أصدقائه وإخوته وأفراد عائلته!!..يكفي أنه ذات مرةٍ في (ساحة الصَّفَّارين) بينما كان يمسك مع أصدقائه الثلاثة إزارًا، تـتوسَّطه بيضةٌ، فرَحًا بحفظه جزءًا من القرآن، يباغتهم جنودٌ، فيطلقون عليهم وابِـلا من الرصاص، ليسقطوا صرعى على عتبة (مكتبة القرويين) التي كان يرتادها العلامة (عبد الرحمن بن خلدون) و(لْـيون الإفريقي) فيما الطفلُ (تــيـمـدْ)تخطئه رصاصة مصوبة نحو رأسه، فيعدو إلى بيته مرعوبا مذعورا!..ثم يُصابُ شقيقه الأول بـ(الحصبة) فتنتقل روحه إلى بارئها، ويليه سقوط شقيقه الثاني من شُبَّاك الغرفة إلى صحن البيت الأندلسي، فـتُـزْهَــق روحُهُ. وفي عــيــد المولد النبوي، تــندلع النار في ملابس أخته، وهي تُهَرْوِل بين البخور والمجامر الملتهبة، فـتحترق وتموت في الحين. يتبعهما أبوه في الثلاثين ربيعًا، فـتـنـتـقـل تربيته إلى يــد خاله، فزوج والدته الأول، فزوجها الثاني، وهكذا تتوالى المآسي على الكاتب ـ الطفل، الذي ينطبق عليه المثل المغربي: “رأسُ الْمِحَن”!..ألا تُعَدُّ هذه الوقائعُ الأليمةُ المتراكمةُ، سببا قويا في تشكيل ذاته القلقة، المضطربة، ومعاناته القاسية، طوال حياته، وفي إبداعاته المُضَمَّخة بعـبـثـية الواقع والوجود؟!
وقصة هذا الكاتب المغربي الراحل، تدعونا إلى الدهشة والذهول، وما عاناه مدى حياته من أزماتٍ ونكساتٍ، كانتْ له بمثابةِ نقطةِ انطلاقٍ أساسيةٍ، أو حافزا قويا لإبداعاتِهِ المسرحية الثرية، التي أسهمتْ في إرساء فن مسرح الهُواة في المغرب، ما جعلته يتمرد على النمطية والرتابة، ويرفض الانتماءَ إلى الواقع الـمُـرِّ، فيخوض صراعا محتدما مع عائلته ومحيطه…!
وبالرغم من ريادته للمسرح، كتابةً وتمثيلا وإخراجًا، وبإسهاماته الإبداعية، فإنَّ الكثيرين أداروا له “ظَهْرَ الْمِجَنِّ” إلا النادرَ منهم، مثل الدكتور عبد الرحمن بن زيدان.وهذا ليس غريبا ولا عجــيــبا، فــقــد غَــضُّوا طَــرْفَــهُــمْ عــن الــسابــقــيــن، كالــكــاتــب الـمسرحي (محمد مسكـيـن) و(الحُسيـن حوري)و(الـطــيـب الصَّديـقي) و(حسن الـمـنيعي) و(عبد السلام الشْرايْـبي) و(عـبد الرحمن الشَّاوي) و(محمد إبراهيم بوعْـلو) و(محمد عـفيفي) و(محمد الْكَغَّاط) ونستثني شهيد المسرح الوطني المغربي (محمد القُــرِّي) الذي ألَّف عنه الدكتور (رشيد بَــنَّـاني) كتابا!…لكنْ، لا تحْمِلوا رأيي على مَحْمَل الجِــدِّ، فــقــد أكون أغــفــلـتُ بعضَ الـبحوثِ والــدراساتِ والأطاريح، الــتي لم تَغْمِطْ مساهمةَ كاتبٍ مسرحي منهم في هذا المجال!
و”أقواسُ/ أيامي” هما سيرتان لحياته، الأولى بالاِسم الأول، تنقسم إلى قسمين كبيرين، والثانية بالاِسم الثاني، تنقسم إلى سبعة وعشرين يوما أو بابا، كل منها يحمل عنوانا دالا على مضمونه (الديك، الرسالة، الجذبة، الكرز، الطلاق، الطرد، العشق، الامتحان، الصفعة، الخيبة، أول أجرة…) ويعود الفضلُ في طباعتهما إلى زوجـتـه (نادية وادجــيـني) والــدكــتور(حسن المنيعي) والأستاذ (محمد أسْلــيم) فلولا هؤلاء الــفُــضَلاء لأكــلتِ الأرَضةُ مخطوطاتِهِ الإبداعيةَ المتنوعةَ الاتجاهاتِ!
والسيرتان تــتــبــنــيان الشكل الفني للنص المسرحي،أي تُــزاوجان في الكتابة بين السرد السيري والحوار المسرحي، وهذا يدل على أنَّ الكاتب لم يستطع أنْ يتخلى في كافة كتاباته،حتى الشعرية والزجلية والسيرية والنقدية مــنهــا،عــن حــبِّه الــشديــدِ لجــنــس الــمــسرح،الــذي اســتحــوذ عــلى كــل جوارحِهِ!..ومن حيث المضمونُ، فإننا أمام (عالم اجتـماع) إنْ لم أكُنْ (أشُطُّ في تصنيفي) فمن خلال الطفل الذي كانَهُ الكاتبُ، فتح عينيه على المجتمع (الفاسي) ليتغلغل في أعماقه، فيحدد الطبقاتِ الاجتماعيةَ التي يتشكل منها. وعــبــر الأحياء العتيقة، يتدرَّج من أفـقرها إلى أغـناها، ليُظهِر مكانةَ عائلته في رَحِــــمِ هذا المجتمع، وكيف استطاعتْ أنْ ترتـقي من حي إلى حي، حتى كادتْ أنْ تُضاهي أرقى العائلات. وبطبيعة الحال، إذا لم يـكــنِ القارئُ مُـــلِـــمًّا بأحـياء المدينة، أو مستعــيــنا بــمــرشدٍ، مثــلَ أيِّ سائح يزورها، فإنه لن يُحيط عِلْمًا بتلك الطبقات أو الشرائح الاجتماعية، ولو كان مغربيا. كما يرصد فيهما حَواريي الأولياءِ وزُوارَهُمْ، ومريدي الأضرحة والمقابر والكتاتيب، كيف يستغلون الناسَ البسطاءَ والضعفاءَ في قضاء مآربِهِم، وفَــكِّ عُــقَــدهِم النفسية والعقلية، وطرق الاحتيال والمكر التي يسلكونها. وهـــذه الرؤية لـــفـــئات مجتمعه، الـــمُـــتـــأرجــحة بــيــن (الفقر والثراء) هي التي تضمَّــنَــتْها نصوصه المسرحية بمفارقة السخرية السوداء اللاذعة، مِمَّا يُحيلنا على تأثير الناقد والشاعر الإيرلندي (صمويل بكيت) ومسرحه العبثي، الذي كان (محمد تيمدـ التيجاني) عاشقا له، و”سفيرًا” يمثِّــلُه في المغرب، فضْلًا عن رفيق حياته “نبيل لحلو” بمسرحياته “السلاحف” مثلا، وأشرطته السينمائية التسعة!
وهــما معًا ـ الــســيــرتان ـ تـــتــخــذان (فــاسًا) حــيِّــزا مـكانــيًّا لهـما، كــما تحددان، زمانيا، بدايةَ عام (الجوع) الذي نزحتْ فيه عائلته من الصحراء، أو من الشرق إلى الغرب، هربا من المجاعة والجفاف والحــــروب، لــتجــد مرتَــعَــها في فــاسٍ، الــتي كــانــتْ تـــزخــر بالــبــساتــيــن والجنائن والمخازن ومصادر التموين، وبالحماية الكافية!
صدرت (السيرتان) سنة1997 بعد رحيل الكاتب بأربع سنواتٍ، ويطغى على الحكي فيهما (عالمُ الطفولة) في النصف الأول من القرن العشرين. وبذلك، تُـكَـوِّنان وثيقةً تربويةً واجتماعيةً، ذات قيمةٍ بالغةٍ في رَصْدِ هذه المرحلة، لو تجد من يحللها ويدرسها. أتى بناؤهما الفني تصاعديا (من بداية الطفولة إلى الشباب) رغم أنَّ الكاتب من أنصار التجديد والتجريب، الذين تمرَّدوا على الشكل التقليدي السائد في الكتابة القصصية والروائية والمسرحية، بل يعتبر، في رأي العديد من المنظرين والباحثين، رائــدَ التجريب في الكتابة المسرحية بالمغرب!
فـ”أقواسه وأيامه” أبوابٌ أو أوراقٌ، كلٌّ منها يباشر طَوْرًا من أطوار طفولةِ الكاتب، لكنْ، يبدو لي أنَّ هناك خطأ في تبويب وترتيب تلك الأقواس والأيام، رُبَّما ارتُكِب أثـناءَ جمعها وتصحيحها عند طبعها. فقد تخلَّل (يومان) من أيام شبابه، مرحلةَ الطفولةِ، ما يفرض على القارئ ألا يُــفَــرِّط في السير العادي للحكي!
وتــكــاد الــسيــرتان تــنحــصران في مدينة “فاس” على الــرغــم من أن الكاتب أمضى قسطا من حياته في الدار البيضاء وطنجة، كما أنَّ بداية الحكي تنطلق من مدينته نفسِها، دون اللجوء إلى أصول العائلة، وما حملته معها من عاداتٍ وتقاليدَ وسلوكاتٍ، موافقةٍ أو مختلفةٍ مع مجتمعها الحضاري الجديد، فكان تأقلمُها تلقائيا، لم تواجِهْ مشاكلَ في اندماجها، عكسَ أُسَرٍ وعَوائلَ أخرى. وأكاد أُجْزِم أنَّ العديدَ من الأدباء والفنانين الذين ينتمون إلى عائلاتٍ هــاجــرتْ إلى فاس من مــنــاطقَ غــيــرها، تــفــوقــوا في إبداعاتهم، لأنَّ شخصياتهم تـكــوَّنـتْ من رافـديـن: الأول يعود إلى المنطقة التي نزحوا منها، وهي بالنسبة لكاتبنا، منطقة “تافيلالتْ” عاصمة الشعر الزَّجلي، والمواقف البطولية النبيلة، والثاني يتجلى في منطقة الغرب، التي تزخر بالسهول والحقول والأنهار، والحضارة الأندلسية العريقة!
يتذكَّر الكاتبُ كلَّ شيءٍ في طفولته الأولى بالدقة والتفصيل، وهو لم يتجاوز أربعَ سنواتٍ، عندما يتوفى والده، الذي كان يشتغل “رَحَّاءً” يطحن القمحَ بالرَّحى اليدوية، ثم أصبح “حَمَّارًا” يحمل براميل الزيت والزيتون على الحمير والبغال، لأنَّ فاسًا في ذلك العهد، وما زالت غالبيةُ أحيائها إلى الآن، لا تمر بها وسائل النقل الحديثة، لضيق طرقها ودروبها المرصَّفة بالحجر، باستثناء الطريق الذي شُيِّد على النَّهــر، ويشقُّها إلى عُــدْوَتَــيْــنِ: عُـدْوة القرويين، وعُـدْوة الأندلس. ولا يغفل ما قاساهُ من قِــبَــلِ والديه في تربيته الاجتماعية والدينية، ففي صبيحة كل جمعة، يصحبُ أباهُ للترحم على جديه في مقبرتي (باب فَتُّوح وباب الْكِـيسَة) ويتْـلو عليهما ما تيسر من القرآن، وبين المقبرتين مسافة طويلة من المُــنحدارات والعَـــقَــبات، التي تحبس الأنفاس. ولم ينس أيامًا سوداءَ، تفشى فيها وباءُ السُّلِّ والجذري، فحصدا الكثيرَ من أطفال الجيران المصابين بهما، لكنَّ الجذري، وإن أصاب الكاتبَ، لم ينلْ منه، فقد خرج من حَـلَـبَـة مصارعته صحيحا مُعافى، على عكس أصدقائه وجيرانه، الذين رحل بهم الموت إلى العالم الآخر!
لا يغفل في سيرتــيْه، وهو دون الرابعةِ سِنًّا، أجواء الحفلاتِ الروحية، التي كان يُقيمُها والداه في البيت، ومنها “المولودية” التي تُـتـلى فيها الأمداح النبوية، وتُــفَــرَّق كؤوسُ الحليب على الحاضرين، وتُرَشُّ رؤوسُهُمْ بماء الزهر، وتُعَطَّر ملابسُهُمْ بالبُخور: “..وينزل الطعام، فتشمر الأكمام، ويُستعد للطعام، فتنطبق السبابة على الإبهام، وفي شباكها يُرمى باللقام…”!
كل الأجواء التي عاشها الطفل، سواء في “الكُتَّاب” أو في الأضرحة والدروب المسقفة المظلمة الملتوية، شحذت مخيلته، وأطلقت العِنانَ لخياله، ليسبح في عوالمَ غيبية، وبالتالي، تحولتْ إلى أشكال تعبيرية فنية في نصوصه المسرحية. فأمه كانت تحدثه عن حي يمرُّ به، ذهابا وإيابا، اسمه “عين الخيل” لأن عفريتا يخرج منها في صورة حصانٍ. لكنَّ أباهُ يعترض: “لا، يقولون كل مساء خميس تخرج من تحت قنطرتها سمكةٌ، متخَرِّصة الأذنين بخُرْصتين من الفضة، تدور وترقص ثم تختفي…”!..فـبين حكايا الأبوين، سيفقد الطفلُ ذلك الحاجز القائم بين الواقع والخيال، بين الحقيقة والوهم، ليجد نفسه في دوامةٍ، تُـفْضي به إلى “العبثية” ومن ثَــمَّ تُــمَهِّـد له أرضيةً، يبني عليها “مسرحَ العبث”، وتصبح حياته المضطربة بلا حدود بين سيرته ومسرحه إلى أنْ يرحل عنها في الرابعة والخمسين عامًا!
هناك حادثـتان أساسيتان تــنطلق منهما مرحلةُ شبابه، وتؤسسان لكل ما سيأتي في حياته، هما: بداية معانــقــته للقراءة الفــعــلية، وخطوته الأولى في عالم المسرح. فالأولى يصفها بـ”اليوم الأغر” عندما أرسله جارٌ يشتغل “خَرَّازًا” ليحضر له صحيفةً فرنسيةً، ولمَّا أتى بها، ناوله قنينةَ عصير، وأجلسه أمامه، ليقرأ له، لكنه لم يفهم شيئا، بينما الطفل أحسَّ أنه استوعب كلَّ ما في الصحيفة، ما جعله يُعَمِّمُ ما قرأ على كلِّ جيرانِ حيِّهِ. وهذا الحدثُ البسيطُ، سيُخْرِجه من عالم “الكتاتيب” إلى محيطه الاجتماعي الواسع، ليكسب الثقةَ بنفسه أولا، وثقة الآخرين ثانيا، وليُداومَ على قراءةِ الجرائد، ثم المجلات فالكتب باللغتين، العربيةِ والفرنسيةِ!
والثانية، يعدُّها “عاهةً” لا ينساها، في أوائل أيامه بالمسرح، كانتْ سِنُّهُ، آنذاك لا تتجاوز الثامنةَ عشرةَ، ناولته شابَّةٌ أوروبيةٌ، كأسًا من النبيذ، وهو يخطو أولى خطواته في فرقة “أنصار الفن” يترأسها رجل كريم “مارأيتُ مثلَهُ يُدْعى عبد الرحمن” كان مثقفا، خبيرا بشؤون المسرح في العالم، علَّمه الكثيرَ، وحدثه عن جهابذةِ الأدباء والفنانين الغربيين، وهو الذي أكمل له ما بدأته الشابة الأوروبية، إذ كان يصحبه معه إلى المطاعم والفنادق الفخمة، كل ليلةٍ، إلى أنْ أصبح “عفريتا” كما يصفونه، ويقول عن نفسه. غير أنَّ السيرتين، لم تتعمَّقا في تجربة الكاتب المسرحية وتطوراتها، فقد ظلتْ تلامسها من بعيد، لا تحمل رؤيته الشاملة للفن المسرحي!
وفي آخر حياته، حين شعر بوفاته الوشيكة، كتب شهادته حول تطور المسرح المغربي، وختمها بقولته التالية:”لقد تركتُ لهم المجال متسعا، وانسحبت من الازدحام للوصول بسرعة إلى الكراسي الأمامية، ودائما أهرب من الأضواء الباهتة لمسرحنا الوطني،لعلني أنسى من أعرفهم جيدا”!