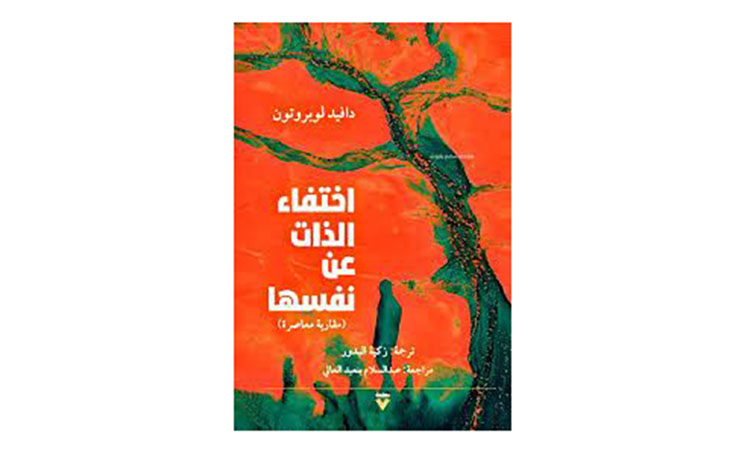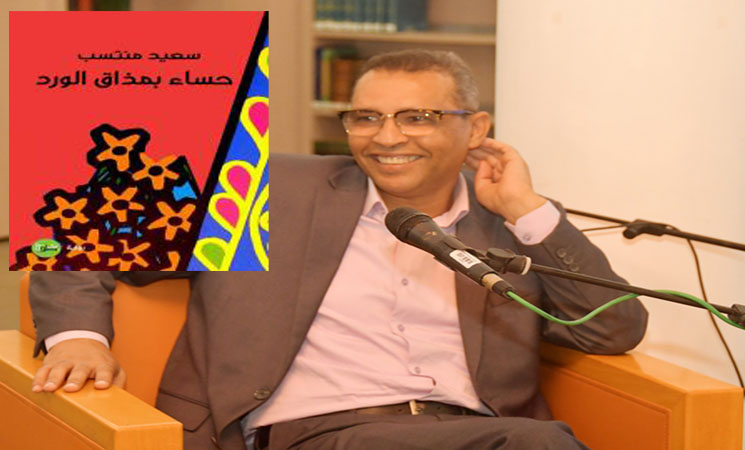مناقشة ديوان ناقد شاعر تحتاج إلى بناء منهجي ومفاهيمي، ذلك أن المبدع هنا ليس شاعرا فقط، بل إنه حفر اسمه في تاريخ الثقافة المغربية باعتباره واحدا من القراء المتميزين للإبداعات القصصية والروائية والشعرية، وهو ما يثير إشكالا كبيرا عنوانه التصنيف. فكيف نصنف الديوان وصاحبه؟ وإلى أي حد تتقاطع هوية الناقد مع هوية الشاعر؟ وهل يستقيم التصنيف المعتمد من قبل باحثين ودارسين للشعراء المغاربة بناء على مفاهيم الجيل والحساسية والاتجاه.؟
لاشك أن إبداع علوط يقع خارج دائرة هذه التصنيفات، بل إنه يفضح ضيقها ومحدوديتها فمفهوم الجيل متجاوز في حالته، ومفهوم الحساسية الشعرية يعبر عن لحظة عابرة أو رد فعل غير محسوب… والحال أننا أمام مبدع خبر المجال وجايل مختلف( أجياله) تنظيرا وتطبيقا. وإذا كانت الدراسات تؤكد أن المبدع ناقد، فإنها تعني ،أيضا ،أن الناقد مبدع …ذلك أن المبدع ناقد لأنه مضطر للدفاع عن إبداعه أو حساسيته الشعرية على نحو ما نجد في تنظيرات أدونيس عربيا ومحمد بنيس مغربيا، لكن الناقد عندما يبدع، فإن دوافعه تكون مختلفة، فقد يرغب في التجريب، أو قد يكون إبداعه اختيارا نفسيا أو استراحة وجدانية؛ لأن النقد بصرامته المنهجية يحد من تسرب المشاعر والأحاسيس، ويحد من شطط الخيال وحريته التي تبقى قرينة الإبداع وعمدته.
نعتقد ضمن هذا الإطار أن إبداع محمد علوط يحرج التصنيفات المعتمدة، ويسائل أدوات النقاد، ويدعوها إلى تعميق التأمل قبل اتخاذ الموقف،لذلك نفترض أن هذا الشعر لا يمكن أن يقارب خارج مفهوم الإبدال باعتباره إطارا مشروطا بسياق مخصوص لا بالسياق الزمني فقط.
يسمح مصطلح الإبدال بإعادة النظر في مسيرة الشعر المغربي بأشكاله وبناءاته ومواضيعه ؛ولأجل تحديد ذلك نصنف مسيرة بناء هذا الشعر ضمن أنساق محددة، وعلى أساس إبدالات شعرية تتجاوز مفاهيم الجيل والحساسية…. هكذا يمكننا الحديث عن خمسة إبدالات كبرى هي:
أولا: إبدال المحافظة المستمرة الذي أصر أصحابه على التشبث بالبناء التقليدي العمودي باعتباره إطارا فنيا يتجاوز الزمن ومتطلباته، بغض النظر عن تجديد المحتويات؛
ثانيا: إبدال التطور الحذر الذي أبدى أصحابه ترددا في الاختيارات البنائية ، فجمعوا داخل الديوان الواحد بين البناء العمودي، وبناءات مختلفة عنه؛ منها ما استمدوه من البناءات القديمة مثل إعادة تبني طرق صياغة الموشح، أو اعتماد التنويع في الأوزارن والقوافي وحروف الروي. وقد أسميناه تطورا حذرا؛ لأنه يبقي على الوزن باعتباره المعيار الثابت للتصنيف، ولكل إبداع شعري؛
ثالثا: إبدال التطور المؤسس على الخلفيات التنظيرية. ضمن هذا الإبدال يمكننا الحديث عن الممارسات الشعرية التي تبنت اختيار البناء على البيانات والتي كانت سمتها الأساسية الاختلاف، إضافة إلى الرغبة في التأسيس لثقافة المدارس والاتجاهات بصورة مضمرة؛
رابعا: إبدال الشعر المؤسس على اللغة، باعتبارها أساس البناء الشعري على نحو ما نجد في الزجل أو في الإبداعات الشعرية باللغات الأمازيغية. ولاشك أن هذا الإبدال يفتح الباب واسعا أمام مقاربات تعتمد معيار اللغة أساسا للتصنيف.
خامسا: إبدال التطور المؤسس على التجارب الفردية. نقصد بذلك تعدد التجارب الفردية التي اختار أصحابها السير على منوال ذاتي قد يختلف من قصيدة لأخرى، ومن ديوان إلى آخر، ويقدم إبداعات تشتغل على فضاء القصيدة وثيماتها،ولغتها،كما أنها إبداعات لاتنطلق من صدى ما يكتب ،بل تؤسس على مرجعية نقدية ورؤية وجودية تتمثل العالم بناء على تجربتها،وتعامل اللغة ليس باعتبارها أداة فقط، بل بوصفها غاية ومادة يتم الاشتغال عليها لا بها….ضمن هذا الإبدال الخامس يقع إبداع محمد علوط الذي يمكن أن تكون له أشباه ونظائر في الممارسات الإبداعية المغربية.
سنفحص كل ذلك من خلال ديوان»أنا مل تحت الحراسة النظرية «.
1 – الديوان وتشاكلاته الموضوعاتية
اختار محمد علوط عنوانا إيحائيا هو:»أنامل تحت الحراسة النظرية»، وهو عنوان واحدة من قصائد الديوان، وأعتقد أن الشاعر علوط كان يخضع لرقابة الناقد محمد علوط لسببين:
السبب الأول أن الحقل المعجمي الذي اعتمده مستمد من المجالين القانوني والحقوقي والمدني (لعلوط تجربة مدنية مهمة)، فالحراسة النظرية فعل لايتبنى حكما ،بل يجعله مؤجلا إلى حين، وملفوظ (أنامل) يجعل المقصود الشعر..،وهكذا يمكننا تشغيل آلية العلاقات الاستبدالي والاستدعائية؛ مما يسمح بإعادة بناء العنوان كالآتي: شعر تحت الحراسة النظرية،أو إبداع مؤجل،أو شعر مراقب… غير أن المفارقة هنا هي أن من يشرف على فعل الحراسة النظرية هو نفسه المعني بتطبيقاتها،لذلك يبدو أن سلطة الناقد ستحاول التحكم في حرية الشاعر بمنحه حرية مشروطة كان عليه أن يفاوضها من أجل الحد من سلطتها. تماما مثلما يفعل المترجم وهو يفاوض نصوصا معينة لينقلها من لسانها الأصلي إلى لسان آخر ضمن ما يسميه أومبرتو إيكو المسارات التفاوضية. فما نتائج هذا المسار التفاوضي بين الناقد والمبدع؟
لنبتدئ بمقاربة موضوعاتية تبحث في أهم تشاكلات الديوان باعتبار التشاكل تراكما لمقولات معنوية سلبا أو إيجابا، ثم نتبعها ببناء القصائد وتشكيلها، ونختم بالاشتغال اللغوي لأن محمد علوط لايشتغل باللغة فقط، بل يشتغل عليها كذلك .وسنتعامل مع الديوان باعتباره قصيدة واحدة ذات مقومات متعددة، لكنها منسجمة بتشاكلات توحدها.
يضم الديوان 37 قصيدة؛ مما يطرح سؤالا منهجيا يتعلق بمقومات تعالقها وانسجامها وتعبيرها عن رؤية معينة، ورغم أن الأمر غير ملزم للشاعر، فإنه ملزم لدارسه كي يبحث في مدى تملك الديوان لما يشفع له بمجاورة القصائد بعضها بعضا، وجعلها ديوانا.
مقومات قصائد الديوان تشترك في خمسة محاور هي:
1.محور المفارقات الوجودية الذي تمثله القصائد الآتية:(جسد يرتدي عريه- الأيادي التي تبصر-عتبات ماورائية- أبيض-أسود- ضوء متجعد)؛
2.محور العرفانيات الذي تمثله القصائد الآتية: (حائط القيامة-عطر الماوراء-أرواح وأشباح- محبرة حنين -ذهبت الى سبأ-قمر وناي) ؛
3.محور العتبات الحادة الذي تمثله القصائد الآتية: (ملل العميان من القياس- عزلة سوفوكل- الغبار قاتل متسلسل-نشرة جوية لطقس سريع العطب-سهم طائش- تمارين في القسوة)
4.محور الرومانسية المعطوبة الذي تمثله القصائد الآتية:(حكايات بيضاء- أخطاء الماء- فن تعلم القبل- لست براق المجاز- أيها الماء كن وأرحني- العقربان – أهواء لاذقية-أوجاع المسافة- سكين الحب- أوجاع المسافة)
5.محور التنظير بالشعر الذي تمثله القصائد الآتية:(-الدليل المرجعي للنسيان- -جزيرة الكنز- أولمبياد الحبر- النبيذ في الزجاجة نص غائب -محاولة تقعيد الغموض- أنامل تحت الحراسة النظرية- كل مصطلح عطش كل نظرية سراب).
2 – ثلاثة تشاكلات كبرى:
1.2. تشاكل الثنائيات الحادة
موضوعاتيا نلاحظ أن ما يهيمن على الديوان هي قضايا وجودية بعناوين كبرى أساسها ثنائيات حادة من قبيل:
الحقيقة- الخطأ
الليل – النهار في (قصيدة ملل العميان من القياس) ص7 أو الجسد- العري في ( قصيدة جسد يرتدي عريه ص5).
2.2. تشاكل الزمن الوجودي:
يحضر الحديث عن الزمن في معظم قصائد الديوان حيث يهيمن تشاكله في صيغ الانتظار القاسي كما تبرزه قصيدة (حكايات بيضاء ص 21)،فالزمن إدمان لايتقنه الشاعر، بل إنه زمن اللاوقت، وهو الزمن المؤجل (قصيدة العقربان ص 35)…هكذا يتم النظر إلى الزمن اعتمادا على المفارقات وإلى ما يسميه الشاعر عتبات ماورائية (ص 43) تدعوه إلى استعطافه؛ لأنه غنيمة السماسرة، ولأنه يقتل الهويات وفق ما نجده في قصيدة قمر وناي (ص80).
3.2.شعرية الفكر:
عندما تحدث ياكبسون عن نحو الشعر كان يفتح بابا جديدا في المقاربات التي ستتبنى مفهوم التوازي باعتباره آلية لبناء هذا النمط من الخطاب الإبداعي. وباستحضار هذا البعد، نرى أن قصائد علوط وما يماثلها من أشعار تجعلنا أمام خصيصة مميزة لمبدعين معينين أسميها (الشعرية الفكرية). وهو شعر يلتقي في الكثير من جوانبه مع القصائد الصوفية الراقية المتغنية بخمرة الوجود، والمخاطبة لعمق النفس البشرية في لحظات انكسارها وعودتها من خيلاء الوجود وادعاءاته. أو وصولها إلى ما يسميه المتصوفة برد اليقين الذي يصل بصاحبه إلى أجوبة تقنعه وتمنحه جواب (دليل الحائرين).
يرتبط هذا النمط من الأشعار بالإيحاءات المتعددة، ويحيا بالاستعارات وأبعادها الذهنية والنفسية أيضا، كما يغتني بالحضور المكثف للإحالات الثقافية في صيغة مرجعيات ومفاهيم واصطلاحات، إضافة إلى اعتماد الأسئلة الوجودية التي تعمق في مرحلة أولية طريق الحائرين (أحذية وأرصفة ص 10،وعزلة سوفوكل ص 11)،ونستنشق (عطر الماوراء) و(تذهب إلى سبأ) لتبحث عن زرقاء اليمامة…ويبدو أن الناقد ظل موجها للشاعر على نحو ما نجد في (قصيدة أخطاء الماء ص 24)،وفي قصيدة (لست براق المجاز ص 31 )حيث تحضر المفاهيم اللسانية والبلاغية ،وفي قصيدة (الدليل المرجعي للنسيان ص32)، وفي قصيدة (جزيرة الكنز ص 45)حيث تحضر روح النفري.
هذه التشاكلات الثلاثة يوحدها تشاكل عام أسميه تشاكل الوجود القاتم بمكوناته الظاهرية، البهي بعمقه غير المرئي، أو ما نختزله في: تشاؤم عوالم الواقع وتفاؤل عوالم الخيال. وهي معادلة نقيسها على ما كان يكرره غرامشي: تشاؤم الوقائع وتفاؤل الإرادة.
3 – الديوان ومرتكزات بنائه
1.3الاشتغال على اللغة باللغة:
يتجاوز الديوان جعل اللغة أداة تبيلغ بتحويلها إلى هدف يتم الاشتغال عليه وتوظيف إيحاءاته المتعددة، ففي قصيدة (جسد يرتدي عريه )ص 5 نقرأ:
النوم في قميص التشبيه
يتلف الحواس
والأرق
في سرير المجاز
كناية بتول
واستعارة تتوضأ بفضة أساورها (ص6)
وفي قصيدة ( لست براق المجاز ص 31)
كما نجد مجاورة بين الفصحى ولغة التداول اليومي مع العمل على تغيير البنية التركيبية لتصبح خاضعة لمرتكزات مغايرة . أمثلة ذلك نجدها في قصيدة( ملل العميان من القياس ص 7 )
أنه حلم لايدخل سوق نهاره.
أو في قصيدة (حزيرة الكنز ص 47 ) :
لم يكن غونتر غراس يشذب الطبل
من حشو الخطابة
فوجدتني أحطه سطلا بلا تقرقيب.
2.3بناء القصائد:
من يطلع على الديوان يسجل حضور اشتغال على صنعة الإبداع، حيث إن بناء كل قصيدة يختلف عن بناء الأخرى، ورغم أن هذا لتشكيل ومعمارية الشعر يجعلان القارئ أمام الفضاء المفتوح للكتابة، فإن بإمكاننا تحديد مجموعة خصائص تميزها عن غيرها :
3-3_البناء بالمجاورة المرجعية:
وهو ما يحيل على شعرية الفكر، وعلى التعابير الكنائية التي تجعل المجاورة بين المعاني أساسا للبناء مع ربطها بآليات مسرحية أحيانا ،وسردية أحيانا ،أخرى وساخرة أحيانا أخرى وهو ما ينقلنا من فضاء إبداع القصيدة إلى فضاء أرحب هو الكتابة . هكذا يحضر لسان العرب والسيميائيات والقرآن الكريم في مشهد يستعير آليات البناء المسرحي حيث نقرا في قصيدة (النبيذ في الزجاجة نص غائب ص29)
غادر الجمهور القاعة
مع بدء الصفير الإنذاري للحجر الصجي
لن يدرك السيمولاكر
الأثر المفقود
الأول: وإذا خرجوا من عندك قالوا :ماذا قال آنفا
الثاني :بينهما برزخ لايبغيان)
وتحضر اللسانيات في قصيدة( لست برق المجاز ص 31)
في هذه القصيدة
لست معنيا بأعطاب المسافة
ولابشحوب الضوء بين الدال والمدلول
لست معول المعجم
ذي اللسان الجريح
ولا
شاقول النحو
المشغول بترميم الجهات الممكنة
بظنون الجاذبية وحدوس الأبدية
ثم إنه لاسماء لي
انأ مجرد غصن معلق في شجرة البلاغة اللامرئية (ص31)
وفي قصيدة (الدليل المرجعي للنسيان ص 32)يتجاور أٍرسطو وديوجين، وابن خلدون وأبو نواس، ويتم اعتماد آلية السخرية أداة للبناء الشعري فيتجاور مصباح ديوجين وأديسون بكهربائيي سوق درب غلف :
ثمة غرفة مظلمة
ثمة مرايا بلا انعكاس
ثمة سورياليون يهربون الحب في قصائد مكعبة
ثمة كهربائيون في سوق (درب غلف)
يقايضون مصباح ديوجين بمصباح أديسون
بلا ندم عاطفي.
وفي قصيدة (جزيرة الكنز ص 45) يتجاور أبو العباس الأعرج مع بروست… وهكذا في إطار مجاورة مشيدة تستدعي من قارئها إعادة بناء العوالم، وعدم النظر إليها في حرفيتها الإسمية لأن عوالم قصائد علوط ليست عوالم مطابقة للواقع ،بل عوالم مشيدة.
وإذا اتضحت معالم البناء بالمسرح والسخرية، فلنقدم مثالا على البناء بالسرد ،وستكون وجهتنا قصيدة (تمارين في القسوة ص52) حيث يتفاعل الشعري مع الحكائي مكسرا نمطية البناء التي هي قرينة الهويات المغلقة والتطرف النوعي.ويحضر الأمر كذلك في قصيدة( أنامل تحت الحراسة النظرية ص50 ).
4.3البناء بالتضاد:
التضاد ليس هو التناقض حيث إن الأول يعني النفي الكيفي أوالجزئي، بينما الثاني يعني النفي الحرماني أو النفي المطلق، وقد اختار الشاعر بناء بعض القصائد بالتضاد، مثلما هو حال قصيدة (ابيض أسود س48 )،وهو تضاد لا يقف عند العنوان، بل يخوض في ثنايا المتضادات النوعية أو الاختيارية.
5.3.-البناء المقلوب بقلب البناء (قصيدة ذهبت الى سبأ )ص 12
6.3- البناء بالتوازيات الجزئية ص15وبالتوزيات الضدية ( ص33)
7.3- البناء بالاتساق القبلي أو الاتساق بالدرجة الصفر، حيث تبتدئ القصيدة بحرف الواو الذي يطرد ويكرر في بداية كل مقطع من مقاطع قصيدة حائط القيامة ص18.
8.3- البناء بإيقاع العين وإيقاع الكلمات فالإيقاع لايتحقق عبر الأذن فقط، بل من خلال العين كذلك( الإيقاع البصري) ، فعدة قصائد ابتدأت (بخط مائل \ ص 7و ص 24و26 )،حيث تبتدئ قصيدة (فن تعلم القبل ) بخط مائل وتتوسطها فواصل
/
بلل على شفاه الكأس
جرعة
على أثر جرعة
أو بين معقوفين (ص 9).
ويقسم الليل
أن آفة النهار
أنه حلم [ لايدخل سوق نهاره]
لذلك فإن الديوان يطرح قضايا التشكيل الخطي وأهمية الكتابة غير التلفظية في الشعر.ويبين وجود الحاجة إلى مقاربة ظاهراتية تجمع بين الشكل البصري والخطاب اللغوي ضمن ما يطلق عليه الاشتغال الفضائي، ذلك أنه شعر يسعى إلى اقتصاد العلامة و الاستفادة مما تقدمه البلاغة البصرية خارج دائرة ماسمي الشعر الكاليغرافي ،وذلك باعتماد تقنيات جديدة في الكتابة أبرزها استثمار الفواصل والمعقوفات وعلامات الضد وغيرها؛ أي عوض ابتكار شكل جديد يتم استثمار المعطيات المتوافرة وإعادة بنائها تماما مثلما هو حال فنان مبدع لا يعتذر عن قيمة إبداعه بغياب مواد جديدة ،لأن له القدرة على (فينقة) العلامات…نقرأ في قصيدة كل مصطلح عطش كل نظرية سراب ص 66
شرفة تطل على شرود الشجر
نحاول أن نفينق الشعر (ص66)
وهكذا فإن جزءا كبيرا من قصائد الديوان التي اعتمدت البناء والتشكيل بالعلامات يفرض دراستها اعتمادا على ما تقدمه النظرية الجشطلتية والسيميائيات والبلاغة البصرية مع التشديد على أهمية الأيقونات ضمن الإبداعات ودلالاتها. ومع استحضار القدرة على فينقة اللغة والأيقونات عموما.
خاتمة
ديوان «أنامل تحت الحراسة النظرية» هو ديوان مختلف عن المعتاد والمتداول،لذلك فإن حراسته النظرية تواضع من مبدعه الذي كان دوما خارج دائرة التعالي المعرفي أو الطاووسية الزائفة، لذلك نهنئ قبيلة الشعراء بهذا الانتماء الذي نرجوه مستمرا مع الدعاء لصديقنا العزيز سي محمدعلوط ببسطة في العمر ،وسلامة في البدن، واستمرارية في العطاء.
*(قدمت هذه الورقة في اللقاء الاحتفائي بديوان الشاعر محمد علوط يوم السبت 17 ماي 2025 بالمكتبة الوسائطية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمنظم من طرف جامعة المبدعين المغاربة)