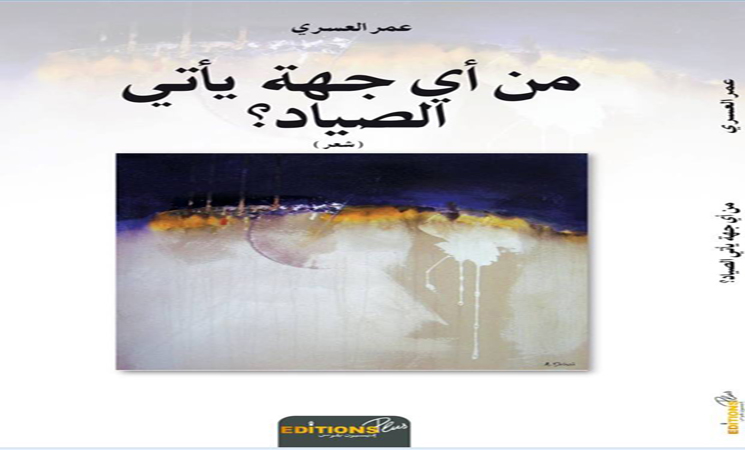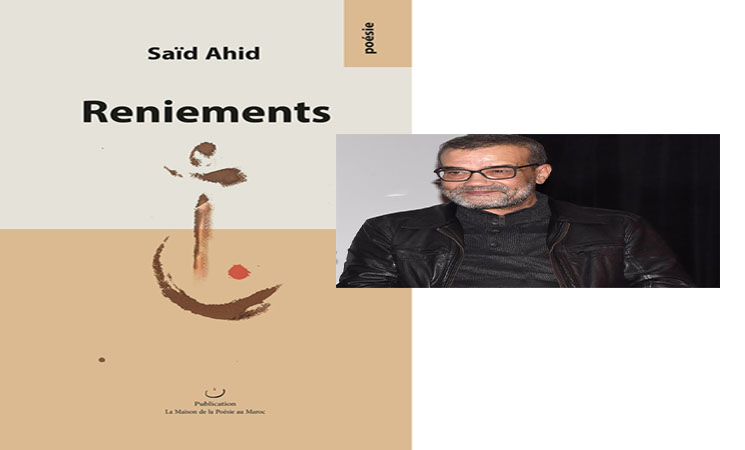أن يكون عنوان الديوان «من أي جهة يأتي الصياد؟» لعمر العسري على صيغة سؤال، لا يعني أن قصائده توضيح وبيان لاستفهام عن مكان بِأداة «من أي»، كما لا يعني أن المستفهم يطلب جوابا من مخاطب عارف بالمصدر الذي منه يصوب القناص رصاصته أو ينشر فيه الصياد شباكه، ذلك أن كلا من المستفهم والمخاطب هما أسيرا سؤال هو بمثابة لغز أو طلسم؛ خير أن يظل مستغلقا كعلبة الباندورا، و أن لا يحل كما حل أوديب لغز الهولة والذي ما أن أنقذ أهل طيبة من بطشها حتى استشرى وباء الطاعون يفتك بالجميع. ومن حيث المعنى فهذا السؤال هو في ذاته جواب بالنفي و الإنكار؛ أي نفي وجود مكان يمكن أن يساعد تجنبه على تلافي رصاصات القناص أو شباك الصياد، ذلك أن صيغة السؤال لم تأت إلا للتخفيف من قوة هذا الإنكار الذي لا يمكن دحضه، وكأنما بالاستفسار عن مكان منفي وجوده، يغدو معه المكان موجودا وقائما، فيه يتربص الصياد وفيه تنكشف خديعته و من ثمة يخيب صيده و تسلم منه طريدته، بينما السؤال هو مجرد لعبة استيهام يخادع فيه السائل نفسه بأمل مستحيل تحقيقه، لأنه لا وجود لمكان ليس له مظهر ولا حدود، ذلك أن المكان هنا هو بمثابة فجوة يتعذر ردمها كما يفعل الخياط مع ثوب يتعذر إكمال نسجه في قصيدة بنفس العنوان (فجوة):
يطرز بلا توقف كي يرتق الفجوة الفاحشة
بين الفجر وأولى خيوط الصباح
الصباح ذاته الذي كان حديقة يانعة
وبما أن لا وجود لمكان هنا أو هو مجرد لاشيء؛ فجوة؛ فراغ؛ وهباء، فإن السائل ما كان ليستفسر عن المكان إلا لكونه طائر يسبح في الفضاء أو سمك يغوص في الماء، أي في المكان الذي لا يمكن الوقوف عنده وحصره في حدود، لأنه مكان يسري ويذوب، ينسل من يد القابض كما ينسل الماء من بين الأصابع، وبذلك فإن هذا المكان أو اللامكان له مواصفات غير المكان، لا يمكن للطائر أن يحط به كما يقول الشاعر
طائر
رسمته المدينة بلا سيقان أنت،
ستطير بلا توقف
ولن تحط أبدا.
وهكذا فإن هذا اللامكان ما هو إلا فعل الزمان أو أنه الزمان وقد تبدى في مكان مفقود، ذلك أن الزمان يمحو كل ملمح أو أثر يمكن أن يدل على حضور الشيء، لا يخلف سيله العارم إلا الفراغ و العدم، حيث يقول الشاعر مخاطبا الطائر الذي هو وجهه الآخر
تملك فراغا
فراغا فقط.
تملك ثقبا
ثقبا فقط.
وقد شبه الشاعر الزمان وفعله في قصيدة «بخفة أعشاب البامبو» بالثمار الساقطة و الحياة الهاربة. فلماذا اتخذ الزمان وفعله الماحق صورة مكان مفقود يُرجى وجوده؟ أليس في ذلك الاستفهام الإنكاري بحث عن جنة الخلاص، عن فردوس مفقود، عن أرض جديدة لم تطلها يد الزمن، أرض الشعراء والأنبياء والكهنة والعرافين وحتى الفلاسفة؟ ألم يكن الشعر العربي منذ تفتحِ قريحة شعرائه يقف على خرائب الزمن ليشدو رحلة نحو أفق اللذة والنعيم، ألم تكن الأديان من وحي أنبيائها ورسلها وعدا بنعيم لا يفنى، و أليست الفلسفة منذ نشأتها الأولى مع اليونان توق لعالم المثل الروحاني؟ فهل أمسى الوجود وفق هذه الرؤيا فخ صياد ننتظر طلقته أو شباك صياد نعلق فيه كلما رمى به نحو اليم، كما يقول الشاعر في القصيدة التي لها نفس عنوان الديوان:
مثل الطريدة
لا يقوى على مغادرة الشاطئ
مثل الرطوبة يتألم
(…..)
ودونما ارتياح يسأل البحر:
من أي جهة يأتي الصياد؟
أو كما اختصر الشاعر هذا الوجود في عبارة موحية بدلالة عميقة بالقول «أن الحياة مداهمة لغيبوبة المكان». فإذا استحال هذا الوجود في ذاته عدما، جوهره الفناء لا الأزلية التي دبجت الأشعار والأديان والتصورات صنعها بلفيف من الصور والعبارات الساحرة والخادعة، فإن الحياة لن تقوى على مواجهة خطر انمحائها وسوف يُنصَّب الموت أمير عروشها الذي سنستسلم لحكمه طواعية. ومن ثمة ما الجدوى من نظم شعر إن لم يكن بلسما يهدأ من قلق الموت، ويدفعنا لعدم الرضا بزوال الوجود،أي يدفعنا نحو الاعتقاد بوجود عالم آخر مضاعف له، ذلك أننا لا نحيا في حياة أو لا نقبل أن نحياها إلا إذا زاوجنا وجودنا بوجود آخر، بحيث لن يكون موتنا عدما بل معبرا نحو هذا الوجود الآخر. و أمام حقيقة هذا الزوال الحتمي واستحالة وجود عالم آخر أو مكان للنجاة من الصياد (الموت) الذي يسرق أرواحنا، لم يكن أمام الشاعر إلا أن ينساق وراء عدمية مغلفة بالشك، وفقدان اليقين في كل من يستطيع أن يعيد لماء الحياة سرابه، إذ ليس أمامه إلا حقيقة واحدة وهي:
هي بطولة التراب
يطلع من أعذاره
ليمحو يد الزمن
فلا مفر له إلا أن يعيش في انزواء ووحدة وعدم تصديق وخوف من الحب و من الحلم و مج أي طعم يمكن أن يُنسي فناء الوجود، أي أن حياته استحالت على حد قوله «خواء بطعم الانتظار». لا عزاء له لا في عقل و لا في اعتقاد ولا في قوة أو جاه وسلطة، هذه الأخيرة كما يقول في قصيدته «ضاحكا كقبعة» لا تقوى على رد حتى أكثر الحشرات ضعفا، فكيف إذن يمكن أن نعيش و نحن لن نعيش إلا ضمن المؤقت والزائل، ضمن زمن يمكن أن ينتهي بغتة دون إعلان عن نهاية ولا مراسيم وداع؟ كيف يمكن أن نحيا ونحن دائما تحت طائلة التهديد بالموت، كالمحكوم عليه بالإعدام ينتظر لحظة قتله كما يصف ذلك الشاعر بقوله:
في كل هنيهة
أعلل وجودي
بشياطين ممددة
على فراش أحلامي
ترى سكينا تجاه رقبتي.
بيد أن الشاعر لن يستكين إلى هذه الحقيقة المفجعة التي سممت حياته، ولن يتغذى على وهم الخلاص في عالم آخر، ولن يأبه لطلقات الصياد ولا لشباكه، يكفيه أن يكون هنا والآن في الحاضر الخالد حيث لا ماضي هناك يتأسى على زواله و لا مستقبل آت يمكن أن يرتقب حدوثه، ذلك أن عجلة العدم تدوس عليهما معا، لكنها لا تقوى على كبح حاضر دائم الحدوث، حاضر يسرق باستمرار نوره من ظلام العدم المعتم، كما هي صورة الضرير الذي لا يرى إلا أمامه كما يقول عنه الشاعر:
لا يبحث عن روحه
في جثث الماضي
يحمل في أنفاسه
صورة ضرير قديم
له أمل واحد
ذاهب إلى لا أحد.
و بذلك يتخلى الشاعر عن وجوده كذات، كما تخلى بوذا عن أناه الكاذبة التي سقته ألم الوجود ووهم الخلود ليعيش كما هو موجود في لاتناهي الوجود، نافيا مبدأ الخلق والفناء، متخليا عن كل وعي يمكن أن يقوده ليعيش غريبا عن طبيعته الأصلية، يعود لمملكة الطبيعة، يعيش التحول الذي هو سر الأبدية، يصير مثل حشرات مضيئة:
يرقد على ظهر الإوز
ويحلم بالسماء
لا يبالغ في الأنين
ولا يرتشف الأحزان
يصير طائرا سابحا في السماء يجدد ريشه، يستحيل دودة لن تكترث لانقضاء وقت بقائها حية، سيغدو في الأخير كوالا المحب للنوم لا يرى العالم بل العالم يراه.
إن الشاعر في سؤاله دعوة لسلام روحي، مصالحة مع الموت لأنها هي حقيقتنا الوحيدة وموحدنا الذي يجعلنا متساوين، كما أن في هذه المصالحة انتصار للحياة، حياة الجميع بشرا و حيوانا و طبيعة، لأن وجودنا في هذه الحياة كما يقول الشاعر مثل هؤلاء المارين «خفافا يمضون».