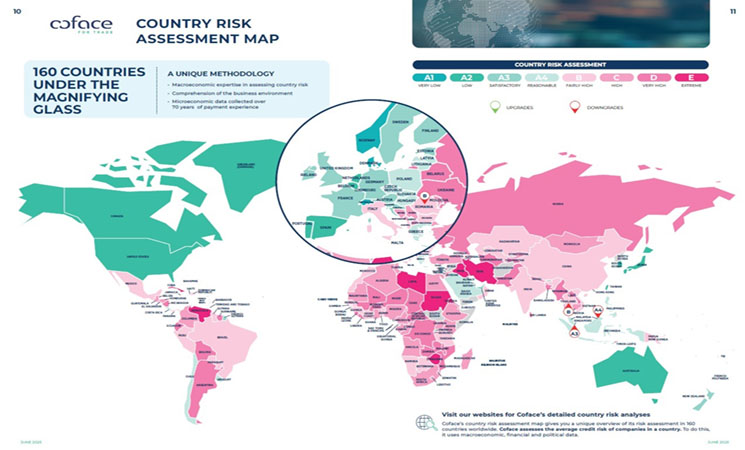إن تأملت قليلا في مجموع الصراعات والتناقضات الدولية الشاملة لكافة المساحات الجغرافية العالمية، ولكافة المستويات الاقتصادية والجيوبوليتيكية، فإن الصورة التي ستراها، لربما أقرب إلى خربشة متداخلة الخطوط والاتجاهات، لا تعرف من أين تبدأ وإلى أين ستصل. ولعل أول ما سيثير انتباهك في هذه «الشخبطة» العالمية، أن الدول جميعا ماضية في صراعاتها التقليدية، داخليا وخارجيا، وكأن جائحة كرونا لا أبعاد إنسانية لها، إن لم تكن مجرد فرصة أخرى «داروينية» البقاء فيها دائما للأقوى. والمقصود هنا بالداروينية، لكي لا نظلم العالم الكبير داروين الذي قدم للإنسانية خدمة معرفية لن تموت، جريان العلاقات الإنسانية الكونية مجرى قانون الاصطفاء الطبيعي، بدل أن تكون خاضعة لفعل العقل البشري الحضاري. وهذا مظهر من مظاهر العجز والانتكاس التي مازال تاريخ البشرية يدور في حلقات احتجازاتها المفرغة. كل ما يكتبه المفكرون والمثقفون في استشرافاتهم النظرية الإنسانية عن هذه الجائحة، لا يزال كلاما رومانسيا لا يثير فضول الماسكين بزمام السلطة والغارقين في صراعات وحشية من أجل البقاء. وإذا كان الجميع يعترف بأن لهذه الجائحة أضراراً كبرى على الوضع الاقتصادي والمعاشي، عالميا وفي كل بلد، فإن هذه الأضرار، هي نفسها، في التركيبة العالمية الحالية، مدعاة للمزيد من التوحش والافتراس المتبادلين حتى لو كان الأمر يتعلق بمجرد الحفاظ على أدنى شرط أخلاقي – إنساني، وعلى غير ما هي عليه الصراعات والمنافسات الربحية والسياسية الجارية حول من سيفوز أولا ببيع وتصدير أي «لقاح» محتمل؟
ولعل ما يثير انتباهك ثانيا، أن قادة العالم قد ضبطوا ساعاتهم وتطلعاتهم على توقيت الانتخابات الأمريكية القريبة. وعلى الأرجح أن قادة الدول الوازنة يتمنون ألا يعود «ترامب» إلى سدة الإدارة الأمريكية من جديد، حتى لو كان فيه شيء مَّا لصالحهم، لأن ممارساته الابتزازية والمعادية لكل المؤسسات الدولية القائمة، والمستخفة بأي حليف تحقيقا لشعاره الوحيد أمريكا أولا، لا تحمل إلا المخاطر واللخبطة في السير المعتاد لما ألفته الاصطفافات والعلاقات الدولية الناتجة عن العولمة خلال عقودها الأخيرة.
والمفارقة المذهلة هنا، أن الملايير التي يمثلها قادة العالم تنتظر كمشة ملايين لا تهتم إلا بما سيؤثر على مصالحها الفردية، ولا تأبه في أغلبها لما يقع في العالم من مآس وخراب وتفقير وتهجير واقتتال، والأدهى أن لحكام أمريكا تحديدا اليد الطولى في جميع تلك الوقائع. إنها ملاحظة مكتومة ولا تفترق عن سابقتها، وإن كانت تطرح أكثر من سؤال عن قصور الديمقراطية الليبرالية وعن النظام الرأسمالي العالمي الحاضن لها، لأن الوعي الانتخابي القاصر في أي بلد، وكذا العلاقة غير المتوازنة بين الدول، هما «صناعة» من نتاج العاملين السابقين معا. غير أن الذي يهمني في هذه العجالة، ليس أكثر من قراءة تفكيكية سريعة لشذرات تلك الخربشة الظاهرة على السطح السياسي في أفق الانتخابات الأمريكية القادمة.
القراءات الظرفية للتناقضات القائمة في عالم اليوم، تنطلق من قمة الهرم في التركيبة الرأسمالية العالمية الحالية. ولعل جل القادة والمجموعات الكبرى، تراهن أو تحتمل سقوط ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وتعول، بالتالي، على نجاح منافسه الديمقراطي «بايدن»، أملا في أنه سيهدن العديد من بؤر التوتر التي أشعلها ترامب، وفي ظرفية كساد اقتصادي لا يطاق. وبالقليل من التبصر، ليس هناك بين المرشحين والحزبين فروقات استراتيجية كبرى، وهذه من العلل المزمنة في الديمقراطية الأمريكية في الشؤون الداخلية وخاصة في الشؤون الخارجية. إذ كلاهما يعتبر الصين العدو القومي الأول، والذي ينبغي لجم تطوره المتصاعد بأي ثمن تقدر عليه الولايات المتحدة. والطريف في الحملة المسعورة والمشتركة، بتفاوت بين الحزبين، والبالغة حد العنصرية ضد كل شيء يمت إلى الصين، أن الخبراء الأمريكيين الذين يتداورون على وسائل الإعلام، هم الذين يتقصدون تذكيرنا بأن الحاكم في الصين، لكي لا ننسى، هو، الحزب الشيوعي، والذي قلما نسمع ذكره من قبل الخبراء الصينيين، وربما عن عمد أيضا. والغاية طبعا من هذا التذكير الأمريكي المستمر، استثارة الرأي العام الأمريكي الذي تربى على معاداة الشيوعية ودُجن منذ محاكم التفتيش المكارتية. وكذا إيهام الرأي العام الخارجي أن المعركة الديمقراطية ضد الشيوعية مستمرة وستتكلل بنفس النجاح الذي تكللت به في المعركة مع الاتحاد السوفياتي. وكلا الحزبين يعتبر روسيا الاتحادية العدو الآخر الذي لا يقل خطورة وأولوية عن الصين، وخاصة من الجانب العسكري ودور روسيا المتنامي النفوذ السياسي على المستوى الدولي. وقد يكون أسهل، في التصور الأمريكي، الإطاحة بالنظام السياسي لروسيا الاتحادية، بثورة ملونة من نفس طراز الثورات التي ساعدت على إشعالها في أوربا الشرقية، لا سيما وأن نظام التعددية الليبرالية الذي اختارته روسيا الاتحادية، خلافا للصين، يتيح أوفر الفرص لاختراقه من الداخل. هذا فضلا عن تطويق روسيا عسكريا وسياسيا من الخارج بدول جارة مازالت تحمل العداء لروسيا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي، وارتمائها المطلق في أحضان أمريكا حتى وهي في الاتحاد الأوروبي أو على أبواب الدخول إليه. وفي الجملة، تسعى السياسة الأمريكية للحزبين أن تجر روسيا الاتحادية إلى حرب باردة تكرر نفس السيناريو الذي جربته مع الاتحاد السوفياتي. ولعل الحزب الديمقراطي سيكون أكثر شراسة مع روسيا من ترامب الذي اتهم مراراً من أنه يوالي ويحابي الرئيس «بوتن». وإذا تغاضينا عن الاختلافات الثانوية في الأساليب بين الحزبين مع بقاء نفس العداوة الاستراتيجية بينهما للصين وروسيا، فإن الخلاف الواضح بين الخصمين، والذي له أهمية دولية، رغم ما قد يحدث من تحجيم له بفعل أدوار البنتاغون والمجمع الصناعي – العسكري واللوبي الصهيوني، ليس إلا الخلاف حول «الاتفاق النووي» مع إيران الذي حاز على ضمانة دولية. وكان لتخلي ترامب عنه السبب في التخبطات الديبلوماسية التي أضعفت مركز وهيبة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي. ولهذا من غير المستبعد مطلقا أن يعيد الديمقراطيون في حالة فوزهم العمل بالاتفاق الدولي الذي أبرموه سابقا. لكنهم لن يتخلوا عن تحجيم ما يحسبونه انتشارا للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. وما يحمله من تهديد مستمر لدولة إسرائيل. ولن يتخلوا عن استثمار الخلاف المبطن لمسألة الصورايخ الباليستية الإيرانية القابلة في نظرهم لحمل رؤوس نووية، وفي هاتين النقطتين ستجد السياسة الأمريكية دعما أوروبيا أيضا. ومع التشديد على أن الخلاف الجوهري بين الحزبين الأمريكيين، أن الديمقراطيين يراهنون في الأساس، وإن على مهل، على إمكان تفجير معارضة شعبية قوية ضد النظام، قابلة لأن تطيح به، إن حفزوا جميع شروطها الممكنة في الداخل الإيراني وفي تحالفات المنطقة، وهذا لا يتعارض، كما قد يبدو، مع الرفع التدريجي للعقوبات، وتحقيق قدر من الاختراق الاقتصادي لشركاتهم الاستثمارية، مادام ذلك يرخي ويفكك «العصبية الوطنية» التي تزداد شدتها في واقع العداء والحصار والتطويق الشامل.
خيار الديمقراطيين هذا، والذي تخشى منه خصوصا بعض دول الخليج، لابد وأن يتناسب بقدر مَّا مع مرونة سياسية في «القضية الفلسطينية الأم» لكافة صراعات المنطقة. والاستراتيجية الأمريكية على هذا المستوى ستبقى في جميع الظروف سجينة لانحيازها المطلق لجانب مصلحة إسرائيل وضمان تفوقها على جميع دول المنطقة. صحيح أن الديمقراطيين مازالوا يعلنون أنهم مع حل الدولتين، بدون القدس التي هي في نظرهم عاصمة لإسرائيل، وبدون أشياء أخرى كثيرة أو غامضة، وصحيح أن فوزهم في الانتخابات سيعطل تسارع مشروع الضم، وسيجمده من الوجهة السياسية العلنية، مع استمراره عمليا كما كان في الماضي، لكنه في جميع الأحوال، ليس في الوارد أن يكون لموقف الديمقراطيين من القضية الفلسطينية، الإيجابي نسبيا في الظاهر، أسنان عملية قاضمة للاحتلال الإسرائيلي، بقدر ما سيكون لحفظ ماء الوجه عالميا للمسايرة الديبلوماسية الدولية يتيح لأمريكا هامشا أوسع للمناورة، بهدف تمطيط الزمن ولصالح إسرائيل دائما.
وخلاصتي، أن كاتب هذه السطور لا يعتبر رئاسة ترومب ظاهرة فردية، ولا يعتقد في أن الحزب الديمقراطي سيغير كثيرا في السياسة الأمريكية. والحزبان معا لن يغيرا من التراجع البطيء للهيمنة الأمريكية العالمية، ولن يوقفا أزمة الانتقال في تراتب القوى العالمية لصالح المحور الصيني الروسي وتحالفاته، ولعل العلامات بادية حتى في ظل تفاوت أضرار الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كرونا.
الساسة الأوربيون هم أول المتضررين والمراهنين على الانتخابات الأمريكية القادمة. وهم أكثر من يستشعر خطورة هذه «الشخبطة» التي أدخل فيها ترامب دول العالم. ومن الأمور ذات الدلالة الكبرى في تفسير هذا الوضع الأوروبي الانتظاري إلى حد كبير، العجز الذي أظهرته البلدان الأوروبية الراعية للاتفاق النووي في تأمين التزاماتها الاقتصادية تجاه إيران، لارتباطات شركاتها الكبرى بالاقتصاد الأمريكي، ولعدم قدرة الدول على أن تفرض عليها قراراتها السيادية الداعمة للاتفاق. ألا يبين هذا كيف تآكلت السيادة الوطنية للدولة تجاه ارتباطات المؤسسات الرأسمالية العالمية، ولصالح السياسة الأمريكية خصوصا؟ !
يرى الأوروبيون، قادة ونخبا، أن إدارة ترامب تصرفت بخشونة وطيش وغوغائية، وبدون أن تراعي حتى قواعد الاحترام المتبادل بين حلفاء تاريخيين، وهم يقاسمونها بعض أهدافها الاستراتيجية ويشاركونها فوائد الهيمنة العالمية، ومن بينهم دول أوروبية كبرى لها مكانتها المرموقة في الهرم العالمي. ومن بين تلك التصرفات الترومبية تشجيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والضغط على سيادة الدول الأوربية في الحالتين، لجهة سياستها المستقلة تجاه إيران. ولجهة الضغط على السيادة الألمانية في مسألة توريد الغاز من روسيا الاتحادية، وسحب بضعة آلاف من الجنود الأمريكيين المرابطين في ألمانيا بدون استشارة مسبقة مع الحكومة الألمانية. هذا عدا التهديد بالعقوبات في شؤون أخرى، منها أيضا علاقاتهم مع الصين، والاستفراد الأمريكي بالانسحابات المتتالية من اتفاقات كالبيئة والاتفاق النووي، ومن مؤسسات كاليونسكو، وآخر الزلات فرض عقوبة على ممثلة محكمة الجنايات الدولية… وجميع هذا الاستفراد وبكل أشكاله يضر في النهاية بسمعة وهيبة و بمكانة التحالف الغربي المسمى «بالعالم الحر». !
ما يشدنا أكثر في تلك الصورة العامة للعلاقات الأوربية الأمريكية، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي ضربة قوية له، لكن تبعاتها في نظري، ستتحول على الأرجح إلى ورطة بريطانية داخلية، تهدد وحدة المملكة في إرلندا واستكتلندا الشمالية على إثر الخلافات القائمة في كيفية تطبيق اتفاقية البريكس الضابطة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ويقول العديد من المحللين للشؤون البريطانية، أن هزيمة حزب العمال، بقيادة كوربين، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو الذي كان أميل للبقاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت، بعد حملة إعلامية مسبقة، شاركت فيها جل وسائل الإعلام الكبرى، كما سخرت فيها شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ركز الجميع على استنفار الرأي العام حول مسألتين أساسيتين، اتهام الحزب في أنه تحول إلى قيادة شيوعية من جهة،واتهامه بأن لقيادته نزعة معادية للسامية من جهة ثانية. والحقيقة، أني لم أستسغ منذ إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، اعتماده على قاعدة الأغلبية البسيطة، كما جرى وبفروق لم تتعد بضع عشرات الآلاف، في مملكة مركبة يحتوي اتحادها على مصالح إقليمية متناقضة وعلى ميولات انفصالية كامنة وممكنة. وبوجه عام، أرى في استفتاءات تحتمل تفككا وطنيا مَّا أن تكون مشروطة بنسبة أعلى تقلص من خطورة المزاج الشعبوي العابر. هذا رأيي وحسب، ولا أجادل به الحالة البريطانية، وهي دولة لها تقاليدها الديمقراطية العريقة، لكني أتحسسه في واقع العديد من بلداننا العربية، وهي التي مازالت تبحث عن دسترة مستقرة لها. وفي جميع الأحوال، يرى العديد من المحللين أن بريطانيا ستعاني من ورطة داخلية ناجمة عن اتفاقية بريكس سواء التُزم بحذافر بنودها أو تم التنصل منها. وستكون لهذه الأزمة، بعد الصدمات التي تستعيد استفاقة الرأي العام الداخلي، أن يستدعي تواصلها استفتاءً آخر، يصوب نتائجه السابقة.
وإذا ما استثنينا الضربة القوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخطوة الكبرى الإيجابية التي قام بها الاتحاد لشد عصبه ولتجديد الثقة فيه، بعد أن ارتفعت الحزازات البينية داخله من جراء انعدام التضامن الجماعي إزاء جائحة كرونا، كانت في الاتفاق الجماعي على تخصيص حصة مالية معتبرة، تزيد عن سبعمئة مليار ونصف يورو، تم التراضي على كيفية استخدامها وتوزيعها المشروط للتقليل من أضرار الجائحة التي طالت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الاتحاد الأوروبي. ويبقى أن «البيت الأوروبي» (بتعبير سابق لبوتن) لا يكتمل استقراره إلا باستقرار علاقات دافئة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية. وفي هذه الدَّائرة الحاكمة في تموقع الاتحاد الأوروبي على مسارات البعد الدولي، القريب والبعيد، يبدو أن العلاقات مع روسيا الاتحادية مازالت على حالها من التذبذب والتوتر. وقد انضاف إليها بعد قضية أوكرانيا وما ترتب عنها من عقوبات على روسيا الاتحادية، ما قيل عن تسميم المعارض الروسي «ألفاليني»، والطعن الأوروبي في الانتخابات الرئاسية في بلاد بيلاروسيا وما قد يحمله الحدثان من توثرات وعقوبات جديدة. كما قد تكون أزمة بيلاروسيا أخطر من سابقتها في أوكرانيا، لأنها هي العمق الاستراتيجي المتبقي لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وأي قلب جذري لهذه المعادلة يضرب في الصميم بقاء روسيا الاتحادية ذاته.
ما يهمنا في هذه العجالة، أن لا شيء بعد ينبئ بخروج العلاقات الأوروبية الروسية من دائرة ترسبات الماضي التاريخي والحرب الباردة وخدمة الاستراتيجية الأمريكية تحديدا. مع أن واقع روسيا الاتحادية اليوم يختلف جذريا، من حيث المصالح والإمكانيات والاختيارات، عما كان عليه في الحقبة السوفياتية. والمصلحة الأوروبية العليا هي، جغرافيا واقتصاديا وعسكريا، في إيجاد ما يجمعها مع روسيا الاتحادية في «بيت واحد» ! ولا غرابة، في أن روسيا الاتحادية في عهد يلتسن، الذي وهب كل مقدرات روسيا للغرب ولرأسماليات المافيات الداخلية، بلا طموح وطني وبلا ثمن، ما كانت حينها عدواً للديمقراطية، كما هي اليوم في عهد بوتين ! هنا إذن تكمن كل أسرار تلك الممانعات الغربية المتوترة ! أما صرخات الاحتجاج الأوروبية على الديمقراطية المهدورة في أي بلد، من أمريكا اللاتينية في فنزويلا وبوليفيا، مرورا بالصين وروسيا وبيلاروسيا اليوم، إلى بلداننا العربية، فليست إلا صدىً سياسيا لمواقف الولايات المتحدة. والاستثناء الوحيد في الموقف النسبي المتقدم من القضية الفلسطينية، والذي لا يخلو هو الآخر من شوائب أمريكية عديدة.
الجديد الذي يلفت النظر في منظومة الاتحاد الأوروبي، الدور الذي تسعى فرنسا «ماكرون» للقيام به. فهي أولا تشككت في جدوى حلف الناتو معتبرة إياه «على سرير الموت البطيء»، فدعت إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية مستقلة. وهي ثانيا، تضطلع في «فترة الانشغال الأمريكي بالانتخابات» بأدوار بارزة في ملفات، لبنان وليبيا وشرق البحر المتوسط. وفي جميع هذه الملفات فرنسا تناوئ تركيا الحليف في الناتو. وليس بوسعي إلا أن أقدم الملاحظات المركزة التالية:
* ينبغي ألا ننسى أن فرنسا هي التي تزعمت التدخل الجوي للناتو في تدمير الكيان الليبي، وهي التي شاركت مع تركيا وقوى إقليمية أخرى في تدمير مماثل لسوريا. وفي الحالتين لم تكسب مصالح ثابتة لها في البلدين. وإن عادت متأخرة إلى ليبيا بعدما تركتها فريسة للاقتتال الداخلي، فلا شيء يضمن لها في التسوية القادمة، إن تحققت، مصالح بقدر ما كانت عليه في الماضي على الأقل.
* ما كانت الدعوة إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية مستقلة، لتجد إطلاقاً استجابة مَّا داخل الاتحاد الأوروبي، لا من ألمانيا القوة الأكبر، ولا من تلك الأشد ارتباطا بالولايات المتحدة. ولذلك، ألم تكن الغاية من الدعوة «فرنسية داخلية» لكسب مشاعر الاستقلالية الموروثة في فرنسا لدى فئات واسعة من اليمين واليسار معا؟!
* رغم كل الحشود والمناورات العسكرية في شرق البحر المتوسط، ورغم التعقيد الفني في ضبط حقوق الأطراف المتنازعة في هذه المنطقة البحرية الغنية بالغاز، لكثرة الجزر ورفض تركيا لما تعتبره إجحافا لها من اتفاقيات قديمة، ومنها لوزان، وُقعت نيابة عنها وفي غيابها، فإن إيجاد تسوية مَّا ممكنة مادام حلف الناتو مظلة الجميع وفوق الجميع.
* في خصوصية الوضع اللبناني المأزوم على كافة المستويات، والقابل للانفجار في أية لحظة، والمعرض إلى التفكك وحتى إلى تكرار صور أخرى من الحرب الأهلية، تجد قوى التقدم الحقيقية نفسها مضطرة، عن وعي وبعد نظر، لإعطاء الأولوية المطلقة لإنضاج أوسع توافق وطني، لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي من الإفلاس، ولو بالقدر الذي يعود به إلى مؤشرات حيوية تكون قابلة لتحمل إدخال إصلاحات جذرية على خياراتها وبنياتها.
عند هذا الحد ولهذه الحاجة بالذات، تقاطعت المبادرة الفرنسية، المدعومة دوليا، مع هذا الاختيار للقوى الوطنية الحقيقية، لا سيما وأن المبادرة لم تضع أياً منها في قفص الاتهام، ولم تتبن أيا من الاستهدافات الفتنوية التي يطرحها الآخرون. وبدون الدخول في تفاصيل هذه المبادرة، وما يعترضها من عقبات وتحرشات داخلية وخاصة خارجية أمريكية، فمن الأرجح أنها الورقة الوحيدة التي بإمكانها إخراج لبنان بمسافة مَّا بعيدا عن أسوأ السيناريوهات المحتملة، ولفرنسا فيها عوائد اقتصادية وسياسية كبرى، قد تكون مدخلا لتصويب مكانتها الجيوبوليتيكية في المنطقة الشرق أوسطية عامة.
بعد تلك اللمحة السريعة السابقة عن الوضع الأوروبي ودور فرنسا، وفي أفق الانتخابات الأمريكية، تأتي المجموعة العربية في تعاطيها مع نفس الأفق. ولا أستطيع أن أخفي في هذا الموضوع تحديدا، قرفي وأسفي، لأن «توضيح الواضحات من المفضحات» كما يقال. ولأني لا أجادل في أن «للعقلانية» دلالات متعددة، تاريخية واجتماعية وفلسفية، تبعا لتطور التقنيات وعلاقات الإنتاج وللمعرفة العلمية المكتسبة. وبلا توضيح لهذه الدلالات، فإن حدا أدنى من «المنطق السليم» لابد وأن يكون حاضرا في أي خطاب يسعى لتحقيق غايات معينة. وإلا كان تهويما وتغليطا وديماغوجية لا أكثر. ولهذا سأحصر كلامي في إعادة التأكيد على كشف بعض الأباطيل التي تسوغ في الظاهر، وكما يقدمها أصحابها، الهرولة التطبيعية الجارية مع إسرائيل.
أول هذه الأباطيل، أن لكل دولة الحق السيادي في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها. وهو كلام حق أريد به باطل. ليس لأن لدينا طعونا جدية في أن قرار التطبيع كان مصدره سياديا صرفاً، بل ولأن أي مجتمع أو تحالف يخدم المصالح المشتركة ينطوي حتما على تنازلات متبادلة تدخل في حيز «السيادة المشتركة». وإلا ماذا بقي من فائدة للجامعة العربية، لميثاقها ولقراراتها السابقة، إذا ما فقدت، «ورقة التوت» الوحيدة التي كانت تغطي على عوراتها المتعددة الفشل الدائم، سوى أنها كانت تحافظ على بعض التضامن العربي الأدنى من الأدنى في القضية الفلسطينية بالذات. ولن نخوض في نقاش آخر برتبط بالأمن القومي العام، لأن أصحاب هذا المنطق لم يعد في معجمهم هذا المفهوم، ولا يدركون أن في تفضيلهم مصلحة قطرية آنية وافتراضية يضربون في الصميم المصلحة الوطنية البعيدة في الاندماج والحفاظ على الأمن القومي العام، كما تجعل منهم في الآني أيضا نِعاجا ضعافاً يسهل افتراسها.
وثاني هذه الأباطيل، أن السلام مقابل السلام ليس خارجا عن المبادرة العربية، وإنما هو الحل الوحيد المتبقي لخدمة القضية الفلسطينية، بعد أن أكدت الحروب والمقاومة المسلحة فشلها. لعل هذه أكبر الأباطيل، ويحتاج الرد عليها لعشرات الصفحات. نكتفي منها هنا بهذه البرقيات السريعة:
لماذا هذا التهويل بالفشل، والاحتلال الإسرائيلي لم يتجاوز بعد السبعين سنة، بينما دام احتلال الجزائر ما يزيد عن مئة وثلاثين سنة. وانتصرت الجزائر. والعنصرية في جنوب إفريقيا تشكلت عبر عشرات وعشرات السنين، قبل أن يتأسس نظام الأبارتايد وتندلع مقاومته قرابة نصف قرن. ناهيك عن أن التاريخ يعلمنا انهيار إمبراطوريات كانت لها من القوة والمكانة الدولية ما لا يقارن بالكيان الإسرائيلي، فأين هي في التاريخ القريب الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن الشمس تغيب عنها، وأين هو الاتحاد السوفياتي ومعسكره؟ ! العبرة من كل ذلك، أن التاريخ لا نهاية له، وأن الحقوق الوطنية لا تُبلى مهما طال عليها الزمن، ومادام وراءها شعب صامد مقاوم !
ولماذا التهويل بالفشل، وتزوير وقائع التاريخ. فالسادات لم يحصل على سيناء بالمناشدات السلمية، بل عبر حرب أكتوبر التي كيفما كانت نقائصها، أثبتت في الحصيلة توازنا يشي بالقدرة على الانتصار في أي حرب قادمة، قد تخوضها مصر بالسادات أو بغيره. ولهذا استبقت إسرائيل هذا الاحتمال، وأدركت أن تحييد مصر في الصراع العربي – الإسرائيلي فرصة ذهبية لن تعوض أبداً. وكيفما كان موقفنا من السادات ونهجه، فهو على الأقل فاوض على السلام مقابل الأرض. أما اتفاقية وادي عربة مع الأردن، فينبغي التذكير، أن لإسرائيل كل المصلحة فيها، ما دامت لن تُقدم شيئا من أرض فلسطين، وما دامت ستجمد دولة من دول الطوق حابلة بجميع الاحتمالات المهددة لها. ومع ذلك تظل الأردن في الحسابات الإسرائيلية «الموطن البديل» للتهجير الفلسطيني المخطط له في «يهودية الدولة».
ولماذا التهويل وتزوير الوقائع، بينما إسرائيل هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن فشل طريق التفاوض السلمي، لرفضها الصريح للمبادرة العربية أولا، ولإفشالها المتعمد طيلة ربع قرن من المفاوضات الناجمة عن اتفاقية أوسلو ثانيا، ومع أن منظمة التحرير قدمت لها تنازلا لم يكن واردا حتى في الحلم، الاعتراف بدولة إسرائيل والتفاوض على إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في 1967 مع حق العودة للاجئين وإيجاد حل عادل لها. تبرئة إسرائيل من مسؤولية فشل مفاوضات السلام، بأية ذريعة كانت، هو تزوير للتاريخ وتواطؤ مع الاحتلال. فالذي فشل هو الطريق السلمي لا المقاومة الشعبية بكل أشكالها.
وثالث هذه الأباطيل، هل التطبيع حقاً اتفاقية سلام أم هو أسْرلة لدول الخليج المطبعة؟ لا يخفي الأمريكيون والإسرائيليون أن الهدف الذي يعملون على الوصول إليه، تشكيل حلف أمني وعسكري لتطويق إيران أولا وأخيرا.
وقرينة الإدانة المفحمة لهذا السلم المزعوم، أن اليمن، الدولة الشقيقة، تتعرض لحرب همجية لخمس سنوات مضت، هُتكت خلالها كل القيم الأخلاقية الإنسانية، والهدف بات مفضوحا، فهو من جهة، تقسيم اليمن بين شمال وجنوب أُعد للتطبيع ولكي يكون لإسرائيل موطئ قدم أمني فيه، ليسهل على إسرائيل الإشراف على المسارات والمضايق البحرية ذات القيمة العالمية الاستراتيجية، تجاريا وعسكريا. ومن جهة ثانية مواصلة تدمير إمكانيات نهوض الشمال، إن نجح التقسيم، وبعد أن عجزت الحرب على الوصول إلى هدفها في استرجاع الوصاية الرجعية التقليدية على دولة اليمن. وفي الحالتين، تدمير وتقسيم اليمن، البلد الأفقر، ولكنه الوحيد في المنطقة المتجذر تاريخيا والأكثر قدرة شعبية واجتماعية وسياسية على التحرر والاستقلال الوطني.
يُراد لنا أن نصدق بأن إيران هي العدو الأول والأخير، وكأنها هي التي تحتل فلسطين لدعمها المقاومة ضد إسرائيل، وهي التي دمرت العراق وسوريا وليبيا واليمن بجيوش وأسلحة دمار منظورة تفقأ العين، وهي التي تقيم قواعد عسكرية في كل الخليج وليس أمريكا حليفة إسرائيل في جميع مراحل الصراع. وهي التي تفرض أشد العقوبات الاقتصادية على نفسها وعلى سوريا ولبنان واليمن وغزة والعراق سابقا وحتى حاليا. مغالطات لا يصدقها عقل سليم ! وصدق من قال، أن ما يجري ليس سلما ولا تطبيعا، إنه بالتعريف الدقيق أسْرلة لدول الخليج المطبعة ! ولن تزيد المنطقة إلا توترا وصراعا مع إيران. ومن غير المستبعد أن تأخذ المنطقة إلى انفلاتات مسلحة مباشرة بين حين وآخر. أما حكاية بيع الأسلحة المتطورة، فنحن نعرف من زمن طويل ولى أنها مجرد جزية تُدفع لأمريكا مقابل الحماية.. وعن الازدهار الاقتصادي الموهوم، فليس عسيرا على من يقرأ أرقام الإنتاج القومي وتركيبته لدول الخليج وإسرائيل، أن يعرف أين ستصب أكثر الأموال ولمصلحة من !
وختاما، عندما يضطر فاعل مَّا الاعتماد على المغالطات وتزوير الوقائع والحقيقة، فليس هذا دليلا على اللاعقلانية وحسب، بل ودليلا على أن هناك سراً مَّا يريد صاحبه أن يخفيه، والسر ليس إلا حماية «الحكام» مقابل هدايا مجانية لترومب ونتنياهو من أجل خلق أمر واقع يصعب مراجعته في أي احتمال آت لتظل الحماية مستمرة.