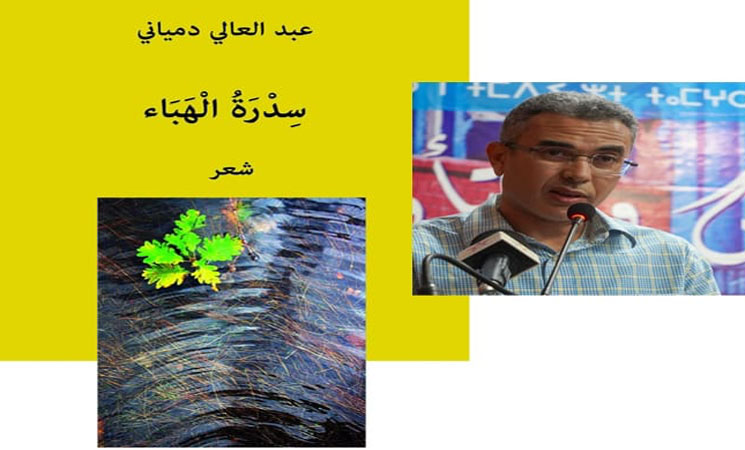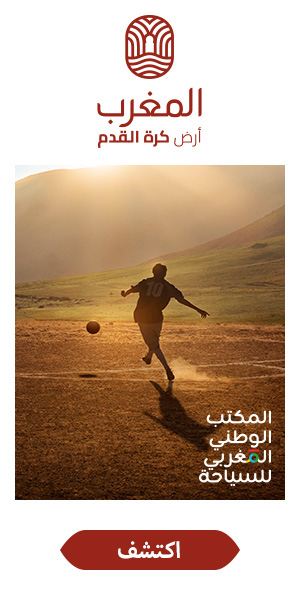لم يعد سؤال الهوية الشعرية سؤال [مصير جمعي] كما ساد في أدبيات المنزع الشعري المحمول على سند المرجعيات الإيديولوجية الهادرة: نهضوية أو ثورية.
لقد صار سؤالا متجذرا في [العزلة الذاتية] للكائن. سؤال الإنسانية التي تتغيأ المصير في قلق الوجود ومكابدات الكينونة بكل حملها الأنطولوجي الميتافيزيقي.
وهو سؤال أعاد اللغة الشعرية، كما أعاد فعل الكتابة، ومعنى الأدب إلى [مبدأ الشرط الجمالي]، أي إلى محاضن الإستطيقا التي تُوحّد في فضاء الوعي الشعري ما بين [الفكرة] و[الشكل]، لا باعتبار الشكل وعاء للفكرة، بل هما وجودٌ أنطولوجي لا يعرف الاغتراب والانفصام. ذلك أن الشعر لا يكتب بـــ[اللغة الأداة] التي تملأ الشكل، وإنما باللغة/المحو التي تبدد الشكل الجاهز بأشكال مرتهنة بنداء البعيد، نداءات [العبور] التي في تجسيراتها الإستطيقية يتجسد ذلك اللقاء الفريد بين المتناهي واللامتناهي، بين الحد والإمكان، بين الجواب اليقين والسؤال الذي يحفر في محتملات الوجود المتحررة من أسر المطلق.
تذهب بلاغة النص الشعري في ديوان «سدرة الهباء» للشاعر عبد العالي دمياني معانقة هذا الاختيار الإستطيقي، متبصرة وعيها الشعري من غور أنساغ كتابة لا حدودية تجترح مسكنها من أثر العبور الدائم للصوت الشعري ما بين [النشيد الغنائي] المُشكِّل لإيقاع مدِّ الكتابة و[الشذرة الشعرية] التي تصوغ إيقاع جزر. كأنهما معا استعارة كونية لأبدية البحر والموجة_ اللحظة.
نقرأ من قصيدة «حامل الريشة»:
(لا شُغْل له
إلا تنْقيح الصّمت
على إيقاعِ البراكين
الثائرةِ
داخله
قيّافُ اللّمعِ
في مكامنِ اللاّمعنى
المُضَيِّعُ كُـلَّ أثرٍ
جَرْسُ الأخرَسِ
على الموْجةِ الصِّفرِ
صانعُ اللاشيء
من رقصةِ ريحٍ
في جُبّ) [ص 11_ 13]
تعلن رمزية المحو عن فاعليتها من خلال القول التشذيري [المُضَيِّعُ كُـلَّ أثر] حيث المحو حبرُ كتابةٍ داخل فراغ لا يكف «يتحرى مكان البداية [Au commencement] ولحظة المآل [A venir]» بتعبير موريس بلانشو في الحديث عن إرجاءات المعنى.
يتلاقى هذا الوعي الشعري مع تخوم كتابةٍ ذاتِ أثرٍ اختلافي تفكيكي. كتابة أشبه بصحراء سحيقة تأخذ استعارة فراغ أو منفى أو مجازِ صمتٍ أو نسيان. ومن داخل كل هذه الجينيالوجيا الرمزية تنهض فجوات النص، لها [هويةُ كتابة العدمِ والتمزق]، حيث الكلمات لها شكلُ «الأثر“ الذي يروم قول [ما لا يوصف]، وهي كما يقول محمد بكاي: «كتابة يتعذر الإمساك بنسيجها، صورة لفكر يهوى كتابةَ الهاوية».
هكذا يندرج الديوان في اشتغاله على المعنى والشكل ضمن الاختيارات الإستطيقية لـ»شعرية النفي»، لأنها تتقفى صورة متخيل شعري متحرر من بلاغة المسكوك والجاهز، حاملة دمغة أفق انتظار ينافي البداهة وطمأنينة التوقع، أفق انتظار يضع النسيان عتبة ملكية للغة، التي تنكتب على حافات الصمت وهاويات المجهول:
(أنا هواءُ عدمٍ
يتلبّسُ
عَماءَ وجودٍ
أنا: أداةُ نفيٍ ذاتي
آلةُ ريحٍ
تعزفُ
على
أثرٍ مدروس
أنا لا أنا
كينونةٌ يجلوها الهَباء) [ص 5]
يمكن للمتلقي أن يقرأ برَوِيَّةٍ وعلى مهل، وبإصغاءٍ من داخل جسد الكتابة لا من خارجها، النصَّ الحاملَ لعنوان (التروبادور الأخير يسيح في المدينة). وهو نص يتَبصَّمُ ذاتَه في تلك العلائقية المنسوجة من انخطافات الومض الهايكاوي والغنائية التجريدية التي تستدعي في آن واحد نبضَ الحواس ويقظة الفكر.
هو نص ذو نفس اغترابي وجودي على طريقة شذرات سيوران في تشريح كيمياء القلق الإنساني. انعكاسٌ لصورة واقعٍ في مرآة الوعي المُتشظي. وضعٌ للأنا الشعري في مَسَاوِقِ السؤال/ المنفى، وفي تراجيحِ البوحِ الذي يكتب المعنى ويمحوه في ذات الوقت:
(ها صوتٌ
له أبّهةُ الهُبوب
يُهسْهِسُ من جهةِ المجهول:
«لا تبُحْ بسرك للرّيح»
…
تعلمْ
تلميعَ الصّمت
بروح شامان
استقطِرْ
من دواة
الجرحِ
آخر حرفٍ
في طرْس العدمْ
دم
م) [ص 43_ 44]
يبتعد الشاعر عن [شعراء الهدر الشعري]. القصيدة تُكتب مرة واحدة في مواطنة العبور، في المعنى المرتجئ والمؤجل. تصير مدينة كــ[الدار البيضاء] مجردَ مكانٍ فيزيقي لهندسات الألم الإنساني. داخله كما خارجه يتسيد [اللاشيء]. هذا اللاشيء الراسبُ في لغة الشاعر مثل حجر ثقيل في قاع بئر اللاوعي.
من جراء هذا النحت اللغوي ينكتب [المكان] من خلال شعرية المجازات المفارقة والبلاغة السوداء لبَكَمِ وخَرَسِ وعاهاتِ اليومي السّادر في ظلال العدم والعبث. من [بلاغة القبيح] تنهض إستطيقا شعريةٍ تُسفّه تنميقات البلاغة المحاكاتية، وتنفي مبدأ الصورة الشعرية التزيينية، وتُبطل «زخرف القول».
لا نحتاج في هذه اللغة الشعرية إلى «بحر» أو «تفعيلة» يُسندان هيكل الإيقاع. الشاعر لا ينْظم لأن المبدأ الإيقاعي لديه مشدودٌ إلى دينامية داخلية تستبق فيها اللغةُ الفكرَ، ليس بأثرٍ رجعي، كما في نمطية الشعر التفعيلي، وإنما من خلال استغوار يضع [اللحظة الشعرية] في إرباكاتٍ حركيةٍ إيقاعية نومادية، ما يمكن أن نسميه مجازا بــ[الإيقاع المترحل].
إيقاعٌ مُترحّلٌ يضع متوازياتِ الجملة الشعرية خارج نسق الخطية من خلال تفضية متشظية تعكس تشظي الذات والعالم. الجملة الشعرية «تسرد» حدثا يقع داخل الفكر، والجملةُ الإسميةُ لها وقعُ الارتداداتِ الزلزالية داخل جسد اللغة تهيؤك لانتظامٍ لا يحدث أبدا. إيقاع يتلاعب بــ[الأثر المرجعي] جاعلا من أفق الانتظار مساحة مربكة لتلاقي التخييل الشعري الواقعي بالتجريد الرمزي والوقع السريالي:
(يَسْطعُ الإيقاعُ
في أقصى العتمة
قواقعَ برقٍ
ألْفُ عربةٍ
شُعَل من أنفاسٍ
يجْرِينَ
في غَـبَـشِ الفجرِ
يَجْرُرْنَ الليلَ
من جذورِه
إلى الحديقَةِ الخلفيّة
للنشيدِ
مُكلّلا
بِغارِ اللحظةِ
الصِّفر) [ص 65_ 66]
يحتاج هذا الشعر إلى قارئ لا يتأولُ النص آليا اعتمادا على «مبدأ المناسبة» أو إسقاطات «الواقع والتاريخ»، ومَردُّ ذلك إلى كون الوعي الشعري لا يشتغل كــ[عربة نقلِ] الخارج_نصي إلى داخل النص. إن اللغة، كما الذات والواقع والتاريخ، محافل تنكتب في النص كــ[تشييد جوّاني] حيث ينشأ النص مثل سطر يكتب على خط الأفق.
تتاخم الكلمة الشعرية لحظةَ ميلادها مشدودةً إلى ذاكرةٍ قيدَ الانبناء. والمعنى الشعري ينصت إلى طريقه كــ[خطو أول]. وحتى حين يستعيد «زمنا مرجعيا» فإنه يزجُّ به في دائرة الاحتمال مشدودا إلى سحر الدهشة وغرابة المجهول، حاملا لأوحام الغامض من رحم الآتي والمنذور لما [لم يحدث بعد] ولما [لم يُقل بعد].
الفعل الشعري هو ذهاب إلى القصيدة، إلى ذلك [الهنا] الذي تقوده (عصا الغريب):
(أفتحُ بابي على البحرِ
أفتحُ قلبي
وأنْهمرُ…
موجةً تشردُ بي
نحو سفنٍ راسياتٍ
على رِمْشِ الأفق) [ص 45]
ذاك ما يجعل شعريةَ الديوان حابلة بــ[متخيلٍ ترحالي] معَابِري ونومادي، بَرَازِخي تتخذ فيه اللغة بصورها ومرموزاتها صورةَ الطريق وهيأة اقتفاءِ الأثر.
إن فعل الترحل (المُشَاكِلِ للإقامة في العابر) يتماهى في رمزياته الاستعارية والمجازية بمتخيل أسطوري ضاربِ الأعماقِ والتجذر في [أنطولوجية المصير الإنساني] من سِفْر التكوين وأسطورة النشأة والنزول الأرضي وأثر جلجامش في اقتفاء عشبة الخلود، ورمزيات الرحلات الصوفية الإسرائية.
تخلق القصيدة في الديوان متخيلَ معارجها الكونية من خلال نحتٍ تشكيلي في استعارات العناصر الكونية الأولى (التراب، الماء، النار، الريح)، تلك العناصر التي تحتشد يشكل بليغ في قصيدة مثل «لا تبح بسرك للريح» المنسوجة من تلاقح رمزية الضوء والريح والغبار. وأيضا في قصيدة «عمى» التي تستقطب رمزية الضوء والماء والريح والتراب متكاملة في التعبير عن نشدان معنى الاكتمال في واقع يؤثثه الفراغ والغياب والحطام.
بحسب منظور جلبير دوران قي قراءته لمجرّات تشعُّبِ الرمزية الدلالية لمتخيل العناصر الكوسمية فإن المناخ الميثولوجي للمعجم الرمزي للديوان ينبني على نوع من تبادل الأدوار بين النظام الليلي Régime nocturne والنظام النهاري Régime diurne، في حركة نفي وإثبات، وحلولٍ متناسخ للعناصر في نقائضها وإبدالاتها.
لأجل هذا تتكاثف الصورُ المحيلة على رمزية الظل، ورمزية الكهف، ورمزية المتاهة من بين صور أخرى ذات الرمزية المتجانسة، لتتعارض مع إبدالات عبور من طور الكمون إلى طور الانبجاس والإشراق، من خلال رمزية السماء والنهر والبحر الطائر.
إنه لمن الشيق بالنسبة لباحث في المتخيل الشعري قراءة هذا الديوان لاستكشاف ما يمكن وصفه بــ[كتابة رمزية ميثولوجية] تشكل لغة ثانية، داخل الديوان. لغة الشفافية الداخلية (La transparence intérieure) باصطلاح دارسي المتخيل. لغة متعالية عن كثافة الواقع، في ذلك البعد الذي تصير فيه للكلمة الشعرية حياتُها الخاصة، مثل مجاز يغسل وجه العالم، وصوتٍ يتهجّى حدوساته الأولى في أبجدية الرمز، أو فقط مثل كناية تتوسد خصر غيمة:
(هنا
سفحتُ أغنيتي
على مَطْهر السُّرّة
ولذتُ بظلِّ الغمامةِ
(….)
هنا
تعلمتُ أسماءَ الوردةِ
على ألفِ وترٍ
وبكاء) [ص 62_ 63].