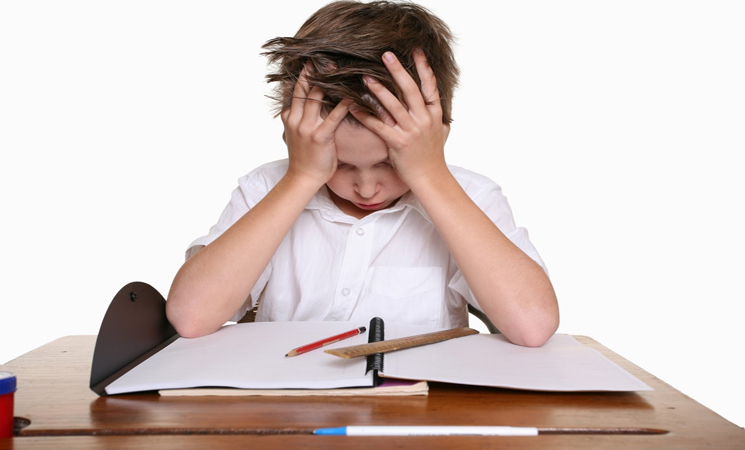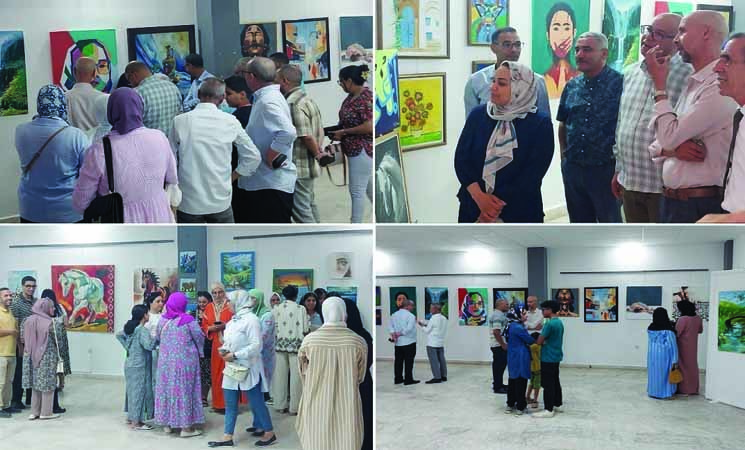ظاهرة التعثر الدراسي تعد إحدى أهم الظواهر التي تشغل كل المعنيين بالحقل التربوي، سواء كانوا ممارسين في الأقسام يواجهون هذه الظاهرة في حياتهم المهنية كل يوم ويلمسون تجلياتها من خلال ضعف أداء تلامذتهم وتردي واقع الممارسة التعليمة وانعكاساتها على دورهم التربوي وعلاقتهم بالمتعلمين، أم مهندسين للنظام التعليمي يعملون على التخطيط لأهدافه – البعيدة ومراميه،أم مؤطرين يعانون في وظيفتهم التأطيرية بؤس الممارسة التربوية وضحالة مردوديتها، أم تلاميذ يواجهون من جهة رتابة تدريسهم بفعل ضغط المقرات وزمن انجازاها. ومن جهة ثانية حيف وعدم شفافية تقويم واجباتهم المدرسية وتقييمهم التأهيلي بفعل عدم توفر الشروط التربوية الملائمة لإنجاز هذا العمل في الظروف المطلوبة. وآباء يتحملون نفقات أبنائهم حاملي الشهادات الذين وصلوا سنا متقدمة ولم يمكنهم تكوينهم من احتلال موقع في سوق الشغل.
*إن الحديث عن التعثر الدراسي وما يستتبعه من هدر للمواد والإمكانيات يستدع مقاربة هذه الظاهرة والبحث في أسبابها ودواعيها وتجلياتها والنتائج المترتبة عنها. وهو عمل يتطلب تضافر جهود باحثين متعددي الاختصاصات والاهتمامات وذلك قصد رصد كل الاعتبارات المحيطة بالظاهرة. وبالتالي اقتراح حلول وآليات تربوية وبيداغوجية لتطويقها.
وإسهاما في لفت الانتباه إلى ما أصبحت هذه الظاهرة تطرحه من تساؤلات مقلقة بالنسبة للممارسين الفاعلين في الشأن التربوي فإننا نعرض مفاهيم رغم أننا لا نسعى إلى الإحاطة بكل مستويات الظاهرة بقدر ما نسعى إلى ملامسة بعض أسبابها ومستوياتها .
تحديد مفهوم التعثر الدراسي
إن مفهوم التخلف الدراسي ظل مختلفا عند معظم الباحثين حيث يلاحظ وجود تسميات متعددة لوصف الظاهرة مثل: التأخير الدراسي، الفشل الدراسي- التعثر الدراسي-اللاتكليف الدراسي- الهدر المدرسي. ولنا الحق في أن نتساءل عن مدلول هذا التعدد. أهو مجرد تنويع لفظي لمسمى واحد، أم أنه يدل على اختلاف في صفات ووجوه المسمى؟
ومن المعروف في مجال الدراسات الإنسانية أن الاختلاف في تسمية ظاهرة ما يؤشر على اختلاف في المواقف والرؤى والتصورات وينطبق هذا إلى حد كبير على هذه الظاهرة. إضافة إلى اضطراب التسمية فإن تعدد التسميات يكشف على دلالتين هامتين. تفيد الأولى وجود مواقف ضمنية من الظاهرة، وتشير الثانية إلى تفاوت في درجات وحدة الظاهرة.
بالنسبة للدلالة الأولى : نلاحظ أن كل تسمية من التسميات التي تصف ظاهرة التعثر توحي ضمنيا بموقف ما. فتسمية التخلف الدراسي تدل على تبني تفسير للظاهرة على بعدها المرضي أما استعمال تسمية «الفشل الدراسي» فإنه يؤدي إلى افتراض أمد واقع ونهائي يتجلى في فشل تام عن متابعة الدراسة. ويقوم هذا الافتراض على أساس الاعتقاد في أن حالة الفشل غير قابلة للتعديل والتصحيح أما استعمال تسمية «اللاتكليف الدراسي» فيؤدي إلى الإقرار بوجود خلل أو نقص لازم يعيق التلميذ عن متابعة دراسته بكيفية عادية.
وانطلاقا مما ذكر يمكن القول أن مقارنة ظاهرة التعثر الدراسي تستلزم القيام باختيار أساسي يتعلق بالتسمية التي ينبغي أن تحدد الظاهرة من خلالها لأن اختيار التسمية يعني تبني تصور معين عنها.
وإجمالا فإن تسمية «التعثر الدراسي» اصطلاح إجرائي يستقي معناه من سياق الممارسة التعليمية كممارسة تربوية فصلية. حيث تنبني على استراتيجية تقود إلى تحقيق أهداف متوخاة من جملة من الوسائل والأدوات والعمليات الخاضعة للتقييم والتعديل والتصحيح من أجل جعل التلميذ يحقق هذه الأهداف. ومن هنا يمكن تقسيم تعاريف التعثر أو التخلف الدراسي حسب أصناف الباحثين.
الصنف الأول: يعرف هذا الصنف من الباحثين التعثر الدراسي بأولئك التلاميذ الذين يكون تحصيلهم الدراسي أقل من مستوى أقرانهم أو يكون مستواهم التحصيلي أقل من نسبة ذكائهم وهذا ما جاء في كتاب «خليل ميخائيل معوض» «القدرات العقلية» حيث قال : « يقصد بالتخلف الدراسي التخلف عن التحصيل الدراسي فالتلاميذ المتخلفون دراسيا هم هؤلاء الذين يكون مستوى تحصيلهم الدراسي أقل من مستوى نظرائهم العاديين الذين يكونون في مستوى أعمارهم أو هؤلاء الذين يكون تحصيلهم الدراسي أقل من مستوى ذكائهم.
الصنف الثاني: يحدد هذا الصنف من الباحثين التعثر الدراسي بطائفة من التلاميذ الذين ترتفع نسبة ذكائهم من 70 درجة وتنخفض عن 90 درجة أي المستوى الراقي من ضفاف العقول. وهذا ما يراه «حامد عبد العزيز الفقي» حيث قال: إن التأخر الدراسي يقاس أساسا بمستوى ذكاء التلميذ.
الصنف الثالث: ينطلق هذا الصنف من كون التعثر الدراسي متعدد الأسباب وأن المؤشر الذي يمكن أن يحدد لنا التأخر الدراسي هو المتجسد في تكرار التلاميذ للأقسام أي إعادتهم لنفس الدروس التي سبق أن تلقوها في السنة الدراسية السابقة وقد يكون هذا التعريف هو أبسط التعاريف للتعثر والتأخر الدراسي لأن التلميذ الراسب أو المكرر ليس في نفس الوقت إلا تلميذا متعثرا دراسيا كما يرى ذلك
« محمد الدريج» أما الأسباب المسؤولة عن ذلك فتختلف باختلاف حالات التعثر الدراسي.
الصنف الرابع: ينطلق هذا التصور من منظور تربوي بيداغوجي حيث يعتبر المنهاج الدراسي عبارة عن مجموعة من الأهداف وأن وظيفة المدرسة تكمن في مساعدة المتعلمين على بلوغ تلك الأهداف مع مراعاة استعداداتهم وقدراتهم أما التلاميذ الذين يعجزون على تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة في النسبة لحصة دراسية أو مقطع تعليمي، فإنهم يعتبرون من المتعثرين دراسيا.
بالإضافة إلى هذه التعاريف ينطلق «AVANZINI» في تحديده للتأخر الدراسي من التمييز بين ثلاث حالات مترابطة، إذ أن التلميذ يكون في وضعيته تأخر دراسي : 1) إذا كانت إنجازاته المدرسية دون المستوى الذي يتطلبه قسمه أو درسه أو معايير الإمتحان الذي يتهيأ لاجتيازه.2) إذا ما وجد نفسه بالتالي في أقسام أو شعب دراسية لا تلائمه مما يؤثر سلبا على مستقبله المهني والاجتماعي .3) إذا كانت انجازاته الدراسية العامة أو الخاصة لا تسمح له بأن يوجه التوجيه الذي يطمح إليه.
وعلى العموم فإن التعثر الدراسي يعني تربويا عدم قدرة المتعلم على مسايرة عملية التعليم. وذلك بفعل مواقفه السلبية تجاه مادة دراسية أو مدرس أو المؤسسة بأكملها. الشيء الذي يدفعه إلى التقاعس عن أداء واجبه التربوي وبما أن التعرض إلى مسؤولية التلميذ في التعثر الدراسي، تعتبر عملية معقدة ذلك أن منهاج علم النفس الاجتماعي تعجز عن عزل التلميذ وتجرده عن المؤثرات المختلفة التي تعرض لها التلميذ وكونت شخصيته فإن الفصل لفرضية التلميذ بالتعثر الدراسي هو فصل وعزل منهجي مصطنع. إذ لا بد من التأكد في نفس الوقت على تفاعل هذا العامل مع غيره من العوامل البيئة الأخرى التي لها صلة وثيقة بظاهرة التعثر الدراسي.
بعض سبل علاج ظاهرة التعثر الدراسي
إن التعثر الدراسي في حد ذاته هو مرض أصاب الجسم التعليمي بالمغرب. وإذا لم تؤخذ الاحتياطات اللازمة منذ الآن لمحاولة تشخيص الداء.وتقديم وصفات لعلاجه، فإن هذا المرض سيصبح مزمنا وديمومته هذه لربما تقود إلى هلاكه. و عندما نتساءل عن البديل الذي يمكن أن نقدمه لعلاج الظاهرة في المدرسة العمومية المغربية. فإن الجواب الذي يفرض نفسه هو العمل على علاج العوامل والأسباب المسؤولة عن الظاهرة وأول ما يجب البدء به.
العلاج المدرسي والبيداغوجي
إن المدرسة المغربية العمومية أصبحت تعرف مشاكل تربوية واجتماعية مركبة ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة التعثر الدراسي. لذا وجب على هذه المؤسسة أن تعمل على محاولة موضعة نفسها في سياق يضمن لها إعادة الثقة في نفسها وإعادة الثقة للآخرين فيها. وذلك عن طريق ذوي الاختصاص لأن المدرسة نفسها لا يمكن أن تقوم بهذا على اعتبار أنها تعتبر طرفا في المشكل وهؤلاء المختصون يقومون بوظيفة التشخيص والعلاج للتعثر الدراسي لأن هذا الوظيفة لا يمكن أن تتم في غياب مجهود العمل الجماعي المتكامل إذ جل الدراسات لم تقف فقط عند وظيفة مدرس بالمدرسة باعتباره قادرا بمفرده على تشخيص التعثر الدراسي وعلاجه. فالأمر لا يتعلق هذا فقط بطريقة التعليم أو علاقة المدرس بالتلاميذ فقط بل بالإضافة إلى ذلك توجد عدة عوامل لها صلة بنفس الظاهرة كمستوى الذكاء والمناهج المدرسية اتجاه التلميذ نحو المدرسة والحياة واتزانه النفسي إلى غير ذلك من العوامل المتعلقة بشخصية المتعلم وبظروفه الأسرية الاجتماعية والاقتصادية التي يتفاعل معها باستمرار ويمكن لهذا الطاقم أن يتكون من :
*- سيكولوجي مدرسي : وتقوم وضيفته على تطبيق الاختبارات المقننة كاختبار الذكاء والشخصية وغير ذلك من الأدوات العلمية التي تساعد على تشخيص ومعرفة الاستعدادات والقدرات العقلية والوجدانية والحس الحركي عند المتعلمين وكذا القيام بمقالات قصد التعرف على سمات شخصية التلميذ وأشكال العلاقات الأسرية والمدرسية والظروف الاجتماعية التي يتفاعل معها التلميذ.
* مساعد اجتماعي : مهنته تكميل وظيفة السيكولوجي المدرسي حيث يمكنه القيام بزيارة أسر التلاميذ والتعرف على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لهم هذا بالإضافة إلى تكوينه السوسيولوجي الذي يعيش فيه التلميذ كما أن هذا المساعد يمكن أن يلعب دورا هاما في عملية علاج عدة عوامل مثل العلاقة الوالدية ،أو علاقة المتعلم بالوالدين أو رفاقه.
*- طبيب المدرسة : إن الصحة الجسمية للمتعلمين تجب العناية بها خصوصا وأن طبيعة الطفل الفيزيولوجية تجعله متعرضا لعدة أمراض تكون لها علاقة وثيقة بالتخلف والتعثر الدراسي مثل : ضعف البصر-اضطراب بعض الغدد التي لها علاقة بالعمليات العقلية- اضطراب بعض الوظائف الفيزيولوجية خصوصا عند بلوغ وبداية المراهقة.
*- المدرس : بشكل تلقائي أو لاشعوري نجد أن المجتمع يحمل المدرس عدة مسؤوليات نذكر منها – تعليم التلميذ القراءة والكتابة – إعادة تربية المتعلمين وذلك بالعمل على تعزيز وتقوية بعض السلوكات ومحو أو القضاء على السلوكات السيئة التي تكونت في الأسر أو من طرف الرفاق –التعرف على مكونات شخصية التلميذ: كمستوى ذكائه واتجاهاته ومستوى اتزانه النفسي.. التعرف على مستوى الصحة الجسمية للتلميذ.. التعرف على الظروف الأسرية للتلميذ والعمل على مساعدته لتجاوز معيقاتها.
فآباء وأمهات التلاميذ لا يمكن لهم القيام بتلك الوظائف مع أبنائهم نظرا لتعدد أدوارهم ووظائفهم الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالمناهج المدرسية فقد عرفت موجة من الانتقادات من طرف التلاميذ وبعض المدرسين والآباء فالتربية المغربية ترتكز على ازدواجية اللغة التي لا تتم إلا في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي بشكل رسمي. أما السنة الثانية فيتعرف التلاميذ فقط على الحروف والنطق بها. الأمر الذي يقوي العوائق البيئية الثقافية للطفل المغربي . أما الأهداف العامة التي ينتابها المنهاج الدراسية ينبغي أن التجربة والواقع الخاص بالتلميذ وأن تكون ملاحظة الواقع البيداغوجي ملاحظة نسقية أي ملاحظة الواقع البيداغوجية لإدراك وتحديد العلاقات المختلفة والمتجلية في الواقع. فمن واقع التلميذ- خصائصه النهائية- امكانيته العقلية والجسمية والوجدانية- ومن واقع المجتمع مستوى التطور الاجتماعي – الخصائص الثقافية للمجتمع – حاجات المجتمع.
وبعد كل هذا وبشكل تلقائي- تطرح قضية الوسائل البيداغوجية التي بواسطتها يستطيع المدرس تحقيق واجبه- ومن أهم هذه الوسائل:- الطرق التعليمية وتقنيات التنشيط- مواصفات المدرسين والمؤطرين والبيداغوجيين- اشكال التقييم وطرق تطبيقها.
العلاج الاقتصادي والثقافي
إن علاج ظاهرة التعثر الدراسي يرتبط أساسا بالعامل الاقتصادي والثقافي للأسرة ذلك انه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي كلما ارتفعت معه عناية الأسرة وأبنائها، إن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف مكن الرفع من المستوى الاقتتصادي والثقافي لأسر المجتمع المغربي الذي ينتمي الى دول العالم الثالث.
إن الجواب على هذه الاشكالية يرتبط أساسا بمفكري هذا المجتمع وذلك باقتراح علاج لهذه الظاهرة كأن يشمل هذا العلاج تقديم 1- الدعم الغذائي بالنسبة لأبناء المعوزين بتكون داخليات مدرسية عوض المطاعم المدرسية 2- الدعم الادواتي وذلك بإمداد أبناء المعوزين بكل الأدوات المدرسية بالمجان لأنهم لا يستطيعون اقتنائها مما يجعلهم عرضة للتعثر الدراسي. وقد انطلقت هذه العملية بالمستوى الإبتدائي عبر المبادرة الملكية (مليون محفظة) ولا شك أنها أدت الى حد كبير واجبها وهدفها.
-3- الدعم الصحي-4-تقديم الدعم الثقافي للآباء ويمكن اللجوء في هذا الصدد الى : تكميل تكوين الآباء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. وهذا دور جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. أو عبر تنظيماتهم كالفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ونظرا لصعوبة تطبيق هذه العلاجات في الوقت الراهن على الأقل .فإن أبسط سبل علاج هذه الظاهرة يكمن في الأخذ بأيدي المتعثرين دراسيا قصد ادماجهم في العملية التربوية وبالتالي جعلهم قادرين على مواجهة جميع الصعاب التي تعترضهم.