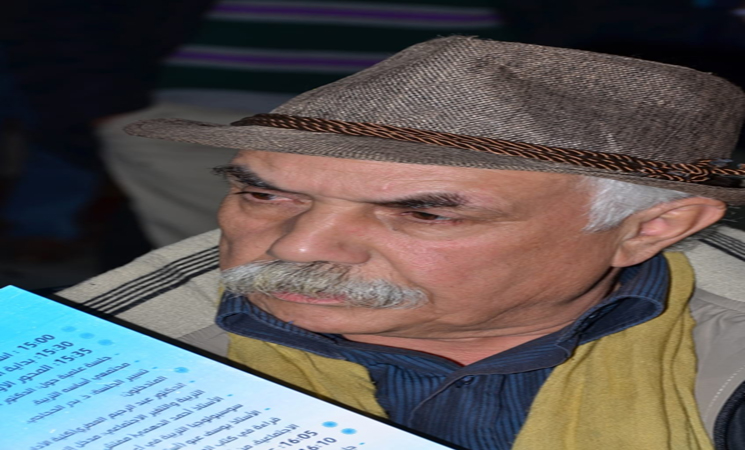ليست قرية «ماكوندو» التي كتب غارسيا ماركيز عن عقودها العشرة من العزلة في رائعته «مائة عام من العزلة».. إنها العالم وقد انتبذ ركنا قصيا من الحياة، يترقب ما وراء العاصفة. عام من عزلة موبوءة، لايزال العالم، يتفصد عرقا من حرارتها، يتحسس أعضاءه ويطمئن على سلامة الحياة داخل رئتيه.
يقال إن الأدباء أبناء العزلة الشرعيون، ففي عزلتهم يكتبون ما يرمم المبعثر، وما يجعل الإحساس متقدا يقظا بما حولنا.
اليوم، وبعد عام على الوباء نطرح على هؤلاء الأبناء سؤال: كيف استثمرتَ هذه العزلة؟ هل أوصلتك الى نقطة عميقة في الروح؟ هل كتبتَ بنضج وأنت مدفوع بقهرية اللحظة؟ هل حررتك العزلة؟ ( بيسوا: الحرية هي امتلاك إمكانية العزلة) سيأتيك الجواب على لسان الراحل محمود درويش: «نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل
نربي الأمل».
في هذا الزمان الغائلي أصبحت أكثر قربا من جسدي، الأمر الذي لم أعشه وأجربه من قبل إلا في حالات المرض والألم والكمد والغضب والفشل..في مثل هذه الحالات البئيسة كنت «أنصت لعظامي» ونبضي وتنفسي وأحاول امتلاك توتري واحتواء كبواتي . أما الآن ورغم إكراهات الحجر أصبحنا أنا و جسدي صنوين صديقين مقربين تقريبا. في غرفة صغيرة بالكاد أتحرك فيها، لكنها تروقني بشرفتها الصغيرة المطلة على الدرب العتيق «برسيصو» تحتوي على تلفاز لما يشبه الترفيه وبضع لوحات فنية محمد كريش، حسن العلوي، عبد المالك العلوي.. و كتب مبعثرة جوار السرير حيث أنام وأقرأ وأكتب، فيها أقضي حجري أنا وجسدي.
منعنا قانون المكوث في الدار من حقنا في الرياضة اليومية وهي عبارة عن مشي يذرع مسافة خمسة كيلومترات تقريبا يوميا بإطلالة على الشاطئ. ومع ذلك لم يحتج جسدي العليل لا من خلال هذا المرض ولا هذا العرض . حتى وزني وهو وزنه لم يزدد بشكل ملحوظ، ربما السبب هو الصوم وانتقاء الحمية والاعتماد على السمك والخضروات دون ملح ومع القليل من الخبز والكثير من الماء. في هذه الحالة فنحن على وفاق إلى حين. ربما بعد رمضان ولأسباب أخرى قد تتغير علاقتنا. لكن هذه مسألة أخرى أرجئها إلى ما بعد.
في سياق الوفاق، لم أشعر بتفاعلات جسدي وإفرازاته ولم أحس أن للغازات كل هذا الصوت الباطني مثلما أحسست بذلك في هذا الزمان التاجي. للجسد في ما يبدو منطق بيولوجي محكم، فهو يستجيب أو يرفض، يستحب أو يستكره ما يقدم إليه. الظاهر أن كورونا جاءت لتفسد هذا المنطق ولتخلخل توازنات الحياة والموت فيه.
طيّ هذه التوازنات، تجتاح جسدي طيلة أيام الحجر الفائتة نوبات متقطعة أشعر فيها بفراغ رهيب في كل أعماق جسدي وأطرافه.خواء في المعدة وفي البطن.. دقّات في الفؤاد.. وحين يسري هذا الخواء في أثلام العقل، أصاب بذهول يذكّرني بحمّى ابن سينا ونيتشه في آخر أيامه.لولا الحياة والوعي فجأة أن هناك إحساسا بالحياة، لاستسلمت لتيار العدمية السلبية تلك التي تنفي جمال الحياة وما يستحق العيش على هذه الأرض جملة وتفصيلا. وأحيانا أخرى ينشرح صدري بغتة وتلقائيا دون سابق إنذار ويتحول ضغط المينوخوليا إلى فرح وفخر واعتزاز خاصة أثناء تذكر سفريات جميلة ولقاءات جديدة وأماكن تقطنها فراشات كان لزاما التعرف عليها.
الذاكرة هنا تنطّ بسرعة فائقة وتعمل بموجّهات حسية سمعية وبصرية وشميّة وما تستقر على موضوع حتى تستبدله بآخر .. الشيء الذي يجعل جسدي ورقة في مهب الريح. أشعر بترحالي الخفيف هذا حتى أثناء النوم والحلم. في مثل هذه اللحظات ينفصل عني جسدي لكن بعد صراع مرير. توطئة النوم لدي تبدأ دوما بفلاشات عديدة وسريعة.. إنها كوابيس حقيقية ، نادرا ما تكون مرحة مفرحة . اللهم إن أنا اختلقتها عمدا. وغالبا ما أستدرج النوم بافتعال منامات جميلة وممتعة . لمّا لا يبقى منّي ومن جسدي إلا اللاشعور أكون نائما. الجسد بدون وعي هو الجسد الفطري الحقيقي، هو الحدس والجبلّة، لكن فيه في ما يبدو جانبان: جانب الهاوية السحيقة وجانب الإحساس والمشاعر الرقيقة .كان نيتشة ينتصر لهذه الأخيرة، أما فرويد فيميل إلى الأولى .كل ما هو مقلق، فرويدي وكل ما هو مرِحٌ، نيتشوي .التراجيديا هي القاسم المشترك بينهما . كيف يمكن للمشاعر الرقيقة (شعر، تشكيل، موسيقى) أن تستكشف الآثار العميقة ( الفطرة ، اللاشعور) وتجعلها قابلة للحياة المشتركة؟
الحياة احتفال وصخب إلا أن الحجر الصحي حوّلها إلى صمت وتكرار. يحصل لي ألا أتكلم مع نفسي ولا مع الآخر أياما معدودة ، كنت مدمنا على التحدث مع ذاتي وبصوت مرتفع وفي الكثير من الأحيان لا أحدث ذاتي إنما جسدي . هذا الأخير هو الآخر لا يكل عن الكلام. له وسائل كثيرة للحديث والتواصل. إما عن طريق العينين أو الكلام الباطني الميمي ، أو الحركات الصامتة أو الصمت المريب. التعب والعياء ، الفرح والمرح هي من الأضداد في لغة الجسد. حتى أثناء نومي يتحدث جسدي معي، بلغة هيروغليفية يقول فرويد : استعارات وكنايات وتشبيهات ومفارقات .. والغريب في الأمر أني أستجيب لها بطريقة غريبة إما بالهلوسة أو بالصراخ المكتوم، وفي الصباح لا أتذكر شيئا تقريبا أو الأصح تبقى عالقة في ذهني بعض المقتطفات غير المنسجمة ولا المنطقية كدليل على حوار لم يكتمل أو لم يكن فيه السّنن واحدا.
في العديد من المرات كنت أجد نفسي أتساءل عن الفرق بين الجنون والرشاد. ولقد جرّبت بعض الحالات في حياتي ألزمتني بالقول إن الجنون أوّل ما يمسّ يمسّ الجسد في شكل تجشآت وإغماءات واختناقات ثم استيهامات وهلوسات. من الجسد إلى العقل يصعد الجنون في شكل مادة رمادية تعمي الأبصار وتتلف العقول. أتيحت لي أكثر من فرصة لاختبار بداية هذا المس: أذكر منها ذات يوم لما خرجت من الحانوت وانعكس الشارع بعماراته في عيوني رأسا على عقب وكأني أرى الشارع وأنا على رأسي لا على قدماي.ذهلت برهة من الوقت وذعرت قبل أن تعود الأمور إلى ما اعتدته واقعيا، والأخرى كانت قبل نومي مباشرة ذات ليلة .افتعلت بعض الأحلام الجميلة، لكن التي كنت أريد إبعادها هي التي فرضت نفسها عليّ كانت بلغة غريبة لم أألفها من قبل و وفق منطق غريب لا عهد لي به. أحسست بغربة اختلاف جذري تناقض واضطرب فيها عقلي مع جسدي وبدا لي أن بين الجسد والعقل خطّا رقيقا هو نفسه الخيط الناظم بين الاضطراب والصفاء.