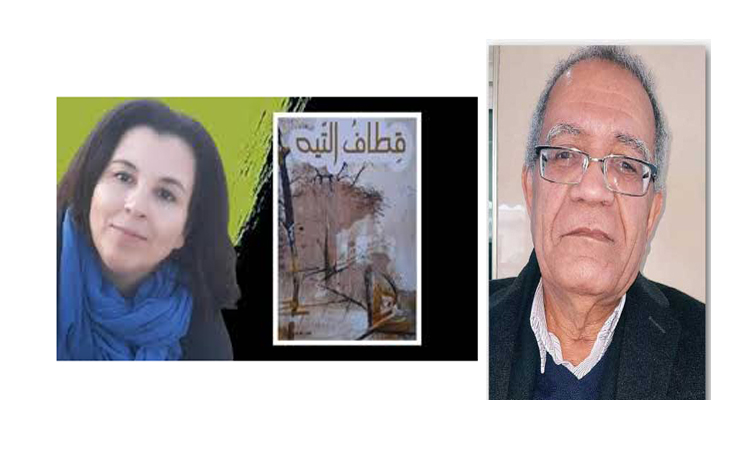ولعل سائلا يسأل مستنكراً: ـ أهكذا كنتم ولا زلتم يا من تدَّعون النضال، ومطارحة القضايا الجسام؟
أبدا، فما كل طالب شرب وأدمن، وتحشش فأولغ. وما كل امريء في طوقه وضع اليد في المقلاة وزيتها يُبَقْبِقُ. إنما عنيت زمرة من الطلاب بأعيانهم زين لهم ما قرأوا وطالعوا ما أقدموا عليه من جمع وتشبيك بين النضال والغرام، وإتيان الدنان في بعض الأحيان. لعلهم بذلك يبلغون مستوى بودليرْ، وكولنْ ولْسونْ، وفرقة البيتلزْ، وبوريسْ فيونْ، ورامْبو، وأنطوننْ أرْطو، وأعضاء بعض الفرق الغنائية كناس الغيوان، وجيل جيلالة، ولْمْشاهبْ، وشعراء الجيل الضائع الأمريكان السبعينيين، وغيرهم. هكذا خُيِّلَ إليهم، وسوَّلت لهم أنفسهم الأمّارة بالنشاط والتحليق. إذ كانت تتناهى إلينا أخبار تفيد بتعاطيهم الحشيش، ومعاقرة الخمور، وإطلاق الشعور واللِّحى، والنوم على الأرصفة، وفي أبهاء المحطات، كبرْهان تمرد وعصيان، وتجاوز للقيم « البورجوازية»، والقوانين / القيود.
وكانت «الحرية « شائعةً منتشرة، ومن علامات وآيات ذلك، أننا كنا ندخن « على راحتنا « بالأقسام، وبالمدرجات المكتظة في حضرة أساتذتنا؛ حتى أن الامتحانات الكتابية لم يكن بالإمكان فض مغاليق موضوعاتها، والوصول إلى حرقة سؤالها، وخبيئها وغميسها، مالم نحرق السيجارة تلو السيجارة مما ينتج عنه رائحة خانقة، وضباب يزدرد القاعة ويحجب الوجوه، من دون أن ينهرنا أستاذ أو يطردنا، أو يحتج علينا طالب أو طالبة لا يدخنان. ومرد ذلك إلى أن الأساتذة كانوا بدورهم يدخنون أمامنا وهم يحاضرون، ويلقون الدروس. فهل تكون هذه الحرية المفتراة كسبا نِلْناه بِ « جهادنا «، وتَفَضُّلا من الإدارة مخافة أن ننتفض، ونقاطع الامتحان، ونترك الأستاذ وحيدا بلا حول وبلا قوة؟
يا للأيام، ويا للأوهام، ويا للغطرسة والتدايك الخاوي، ويا للمكاسب التي حسبناها تدوم وتتطور؟، أم كنا أنصاف مناضلين، وأدعياء فحسب. لكن، دعوني أذكرْ لكم مكاسب حقيقية أخرى جديرة بالذكر مثل تحسين الوجبات، وإبدال البطانيات، وتوزيع المنح في إبانها، ومنحنا تذاكر الوجبات مُقَدَّما.
وكانت كليتنا، كلية ظهر المهراس العتيدة ، تتلألأ بنجوم في سماء الأدب، وفرسان في مضمار الفكر والمعرفة. فهل لديك ظل من شك في علم الأكاديمي المرموق: السوداني عبد الله الطيب رحمه الله، وهو يفتح فتحا مبينا، بابا تلو باب في الشعر الجاهلي، ويرصع شرحه وعرضه بأقوى الشواهد العربية والإنجليزية، كعارف متبحر ومقتدر؟. وفي براعة ورهافة الشاعر المغربي الرائد أحمد المجاطي، الذي كان خجله الإنيُّ يزركش بالدقة والرقة ونعومة المأخذ، وبديع الصور، لغته الشعرية الفارهة، وتحليله لأنشودة المطر للسياب، ونصوص صلاح عبد الصبور في محاضراته؟، والشاعر البارع الرائد محمد الخمار الكنوني، وشيخ الشعراء: المحيط محمد السرغيني، والدكتور المتمكن العميق إبراهيم السولامي،؟.
وقل مثل ذلك في مقدرة الناقد والروائي والمترجم والأكاديمي: محمد برادة، واللساني الكبير عبد القادر الفاسي الفهري، وفقيه اللغة المتمرس عبد الهادي سعود، والبحاثة المُفوَّه: محمد نجيب البهبيتي، والأديبة الجليلة الزائرة الطائرة: سَهير القَلَماوي، والكفيف العارف الغواص في الأدب الشعبي: عبد الحميد يونس، فضلا عن علماء أفذاذ قدَّموا يدا بيضاء، وخدموا اللغة والأدب خدمة جُلَّى لا تنسى، وهم يحفرون حفر العلماء المتمكنين في تراب وتِبْر الأدب المغربي والأندلسي في الأزمنة الذهبية الماضية، ويصقلون مراياه التي صدئت، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من التشظي، والبعثرة بلْهَ والدثور، لولا أريحيتُهم، وعلمُهم، وصبرُهم، وفِراستُهم. وهم تمثيلا: المرحوم العلامة محمد بنشريفة، والمرحومان النابهان الكبيران: عبد السلام الهراس، وعبد القادر زمامة. صحيح أن الإيديولوجيا عمياءُ لا تترك للمؤدلج قُلامة ظُفْر من اعتراف وإنصاف. وهو ما كنا فيه سادرين، عمياناً أو نتظاهر بالعَمَى. لذا، كنا ندير ظهورنا لهم واصمين إياهم بالماضوية والرجعية والتحجر، حتى أننا كنا نمنع قادة سياسيين، وأدباء ضالعين، ومفكرين مرموقين من القدوم إلى الكلية، قصد إلقاء محاضرة، أو تنشيط ندوة لا لشيء سوى لكونهم ينتمون إلى أحزاب غير يسارية. فقد مُنِعَ الكاتب الكبير عبد الكريم غلاب، واعْتُرِضَتْ سبيل الزعيم علال الفاسي من قِبَل جماعة متوثبة محمرة العيون من اليساريين حتى لا أقول المتياسرين، بدعوى أنه استقلالي، وبوق للنظام، ورمز للرجعية الدينية. ومع ذلك أخذ مقعده المنيف في رحاب مدرج بالكلية، حيث ألقى كلمة فينا ذات قوة وعمق، ومعرفة ـ نحن الطلاب والطالبات الحاضرين بمعية جمع من الأساتذة الذين أكْبروا في الرجل تواضعه الجم، وهو العالم البحر، والزعيم السياسي الكبير، والأديب النّحْرير، والشاعر الوطني المستنير.
هي اعتراضاتٌ وحماقاتٌ كانت تقع حينما يتناهى إلينا أن الزعيم أو المفكر فلان سيزور الكلية ليلقي محاضرة. وكنا نسأل قبل كل شيء، عن انتمائه السياسي، وخطه الإيديولوجي.
كانت اعتراضات مجانية لا أساس لها سوى عَمَى الأدلوجة الذي غَشيَ أبصارنا ورحنا نشك في كل شيء حتى في الحجر الملموم، والشجر الشارد المكلوم. ولعل شراسة القمع آنئذ، واندساس المخبرين والبوليس في أوساطنا، هو ما كان يحملنا على الشك والاعتراض، وتَتْفيه بعض الأساتذة مع أنهم كانوا لامعين، وطُلَعَةً في تخصصاتهم، ومجالاتهم، وذوي صيت علمي مكين، ومكانة أكاديمية لا يرقى إليها ظل من شك.
بلى، وكان للبعد الآخر فيَّ، للجانب الذي أخفته أو حاولت أن تخفيه الغرائب السياسية، و» النوائب « الوطنية، حضوره وشبوبه بإغراق الهم السياسي، والغبار النضالي في أحضان السينما، وأحضان الأنثى، تخفيفا وتلطيف للّظى، وتطفيفاً لحرائق السياسة، وضِرام الإيديولوجيا والمعارك الصاخبة التي ما أن يخفت أوارها حتى تتَّقد بالنظر للأخبار والأحداث والمرويات، والإشاعات التي تَتْرى صباح ـ مساءَ والتي تَفِدُ إلينا عبر طرق شتى، ووسائل مبتكرة في غياب الهواتف الجوالة الذكية، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي فترتئذ. فما يقع في الرباط يصل إلينا، وما يقع في فاس يصل إليهم عبر الهاتف الجاثم التقليدي، أو عبر التلغرام برغم الرقابة والحصار، أو عبر تطوع المناضلين بالقطار.
نتأبط، في الأماسي الرائقة بعد أن تضع « الحرب أوزارها «، بطانياتٍ وملاحفَ وملاءاتٍ، نبسطها ونسرحها على العشب الندي أو اليابس، تحت أشجار مبثوثة ومنتشرة هنا وهناك خلف الحي الجامعي، وبالساحة الحمراء، ساحة البوح والعشق والمناغاة، وشكاوى القلب، ونداءات الجسد المحمومة، والعواطف الجياشة. كأن جلوسنا إلى الطالبات، وتبادل حديث البُرَحاءِ والحُمّى والغرام، واحةٌ تفيض خضرةً، وتتواثب طيراً وماءً نستريح فيها بعد كد وجهد ووَعْثاءَ في صحراء شمسها لهيبٌ، ورملها جمرٌ ورمضاءُ. ولم تكن تلك الصحراء بالتعبير المجازي سوى مرارة الواقع، وحُمَيّا النزال، وكسر النصال على النصال.
فلهنَّ، للبنات الحسناوات، للطالبات المناضلات المتوثبات المشمرات، غنينا فيروزاً وكلثوماً، ومحمد عبد الوهاب، ونجاة الصغيرة، و..و.. وَغنَّيْن لنا بدورهن، وركبنا معاً مهاري البراري، وسُحْنا في أرض تظللها خضراءُ، وترعاها سماءٌ قمراءُ، وتسبح في ملكوتها عرباتٌ من نور تقودها أفراس عذراءُ لم تطمثهن خيول عِرابٌ، ولا نَزَتْ عليهن كواكبُ مضيئة، ولا غيوم رمادية غبراءُ.
هكذا، سلختُ / سلخنا أشهرَ وأعوامَ الجامعة في الكر والفر.. في النضال والنزال.. في الجنون والخَبال، وفي الجوع والشبع، في الحب والبدع، وفي ما عشناه من أوهام ليتها استمرت، مع ذلك، تغذي مسعانا، وتنخس رؤانا، وتلهم خطانا، وتشحننا بالآمال الكِذابِ. آآهٍ لو بقيتْ، ليتها ما انطفأت فبدَّدَتْنا الإفاقةُ الظالمة، وشردتنا الأمكنة والأزمنة، وخذلتنا الأرض والسماء، وإذا الدنيا كما نعرفها: محنةٌ وامتحانٌ، وشقاءٌ وهباء.
هل كانت، حقّاً، سنوات السبعينات الماضية، شقاءً وهباءً؟، ألم نحقق بفضلها ما سوّانا، وركّبنا، وقوّمنا ورَمانا في بحر لُجيٍّ، فلا نحن غرْقى، ولا نحن أرْقى، ولا نحنُ نحنُ، ولا نحن سوانا؟.
عباس بن فرناس يحط بحاضرة فاس 5

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 22/10/2021