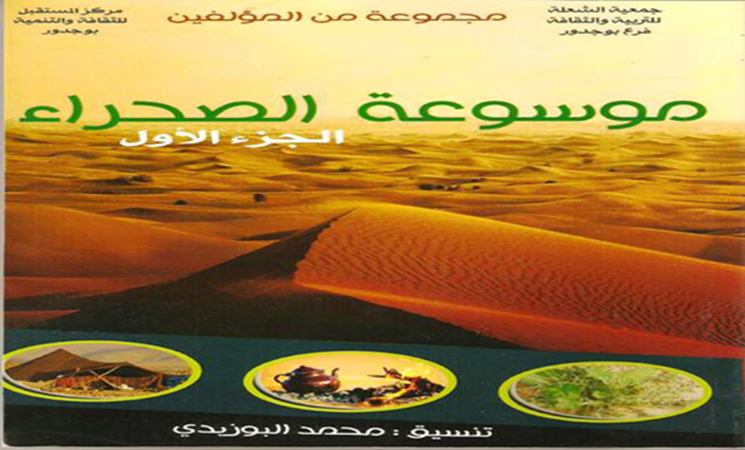تعززت المكتبة الوطنية أواخر السنة الماضية بكتاب مهم يحمل عنوان « على عتبة التسعين، حوار مع الذات « للشيخ عبد الرحمن الملحوني.و فيه يغوص الكاتب الذي عُرف بغزارة عطائه خدمة لتوثيق الذاكرة الشعبية بمراكش و لأدب الملحون، في ما أثمرته ستون سنة من البحث و التنقيب فيما تختزنه الصدور من رصيد شفهي، و في ما توارى من مكنونات المخطوطات و الكنانش والتقييدات، التي لولا انتباهه السابق لزمانه، لكان مصيرها إلى الإتلاف. ليضع أمام الوعي الجمعي المغربي رأسمالا استثنائيا من الدرس و التدقيق في مكونات الثقافة الشعبية المغربية عامة، و الثقافة المراكشية خاصة. في هذه السلسلة نستعيد مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني جوانب مما تضمنه هذا العمل، في جولة ساحرة تجمع بين ذاكرة الطفولة و تراكم العادات، و تقاطع الخطاب و فنون العيش في الحومات، إضافة إلى تطور سيرته العلمية في الزمان و المكان في احتكاك مع هواجسه المعرفية التي حركت أعماله.
p ما يستفاد من تحليلكم للشخصية الثقافية لساحة جامع الفنا، أنها انتعشت أيضا بشغف الصانع التقليدي الذي كان يدير الحاة الاقتصادية و الاجتماعية، و هو أيضا من كان مغذيا لقصيدة الملحون و حتى لفعل سياسي مؤثر كالمقاومة الوطنية من أجل الاستقلال.
p الشيخ عبد الرحمن الملحوني: ارتبط قطاع الصناعة التقليدية بحضارة مدينة مراكش، وبجانب كبير من جوانب اقتصادها وازدهارها. نعم، كان الصناع التقليديون – يومئذ- يشكلون في مجتمع المدينة اللبنة الأولى في الشريحة الاجتماعية. فهم الذين كانوا يمثلون الأعيان، والوجهاء، وهُم أدباؤها الشعبيون، وزجالوها المبدعون … وهم – أيضا- صانعُو مجدها، وحُماة عوائدها، وبالتالي، فهم الشريحة الاجتماعية التي قد ساهمت في تكوين خلايا المقاومة، وفي تفجير الأحداث الوطنية الكبرى التي قد آلت إلى طبيعة أو نوعية التغيرات الشَّاملة التي عرفتها المدينة في عهود خلت، من فترات تواجد الاستعمار الغاشم، ويوم عـَتـا عتوا كبيرا على الشعب المغربي بعتاده وعدده.
كما أنه لا يخفى على المتتبعين للحركة الوطنية بمراكش، أن خلية الصنَّاع التقليديين، قد بدأت تنشط في الأسواق، والأحياء، وداخل الزوايا، ومنتديات دُعاة الإصلاح الديني، والوطني. وخاصة بعد أن بدأت تظهر تجمُّعات رجال المقاومة بالأحياء الشعبية، وبضواحي المدينة، وفي بعض الأحيان بساحة جامع الفناء، رغم محاولة زرع بعض أعوان الاستعمار، في صفوف الصناع التقليديين، ولكن مع مرور الأيام، ظهر الحق، وزهق الباطل، فتحلت صفوفهم باليقظة التَّامة، والتَّعرُف على كل من ينتمي إلى شرائح المقاومين الأحرار !
p بالنسبة لحياة ساحة جامع الفنا، كيف كانت تتنفس في ذلك الزمن، زمن طفولة والدك. قد تكون تلقيت مرويات عنه في هذا الصدد؟
p الشيخ عبد الرحمن الملحوني: عرفت ساحة جامع الفناء أسماء كثيرة من “لحلايقية” الذين لعبوا أدوارا شتى في هذا الفضاء الرَّحب، فكان منهم القصاصون، والمنشدون، والعرافون، والبهلوانيون، والعشابون، والرياضيون، وأنواع أخرى غابت أجيالها، والقائمون بشؤونها، وإلى اليوم لم يبق من آثار هاته الساحة العجيبة، إلا ما يخبر عن هجر طويل، وغياب مرير.
ومع هذا، فالساحة تاريخ مجيد، احتفظت به ذاكرة مراكش مع توالي الأجيال، وبالمناسبة كنت أقضي مع والدي شيخ أشياخ مراكش الحاج محمد بن عمر الملحوني أمسيات في فصل الشتاء فصل الحكي، والسَّمر،ومن جملة ما كنت أدوّن من أماليه، ما كانت تجود به ذاكرته الغضة حول رجالات ساحة جامع الفناء، فتجمَّع لدي الكثير من هذه الأمالي، إلى أن أصبحت أذيعها في حلقات إذاعية بمحطة مراكش في برنامج : “أسماء في ذاكرة مراكش” ساحة جامع الفناء “نموذجا” ومن هاته الحلقات نسوق حديثا طريفا حول الشيخ الحمري مولاي سعيد، الذي كان يحضر حلقته بانتظام الشيخ محمد بن عمر الملحوني – رحمه الله -.
فالشيخ الحمري كان من أصحاب تفسير الأحلام. لقد قدَّم الكثير عن هذا وما كان قابلا لأكثر من تأويل واستنتاج، وذلك على المستوى المعرفي والنفسي، مما يمكن أن يخرج به المتلقي من أن الحلقة الشعبية عند روادها والمولعين بها – أيام زمان – مكان مناسب للتسلية والترفيه، ومكان – أيضا- للتثقيف والترشيد، يُبدع “لحلايقي” بداخل حلقته إبدعات جميلة، ولطيفة، تتحطم بها أسوار السّأم والملل وتتجدد بها – أيضا- الفرحة ونسيان هموم الذات، فرجة لا يحتسب للزمان فيها حساب، ولا يعتد بوقائعه وأحداثه.
والمحيطون بصاحب “الحلقة” من رواده ومحبيه، يمتلكون ما يمتلكون من الإعجاب به، ومن القدرة الفائقة على التحكم في أنفسهم، وهواياتهم، فيعلنون عن هذا الإعجاب، وهذا التقدير بما ينفحونه من نقود، وبما كانوا يقدمونه من تصفيقات حارَّة في مختلف التقاطعات، التي كان يُبدعها بين الحين والآخر، وبين موضوع ، وموضوع. وفي نهاية المطاف لا ينسحبون، الواحد، تلو الآخر من داخل الحلقة، إلا عندما تقرأ الفاتحة، وإثرها يعود الهدوء، وينصرف الجميع ! نعم، إن الرصيد الفني، والأدبي بداخل الحلقة الشعبية بساحة جامع الفناء قد يسمح للمتتبع بالوقوف – مباشرة عند أشكال فنية متنوعة، وأجناس أدبية مختلفة .
ففي هذا السياق نسوق مثالا آخر من مجالات الحلقة الشعبية، للرائد الكبير الحاج بومقيس الذي يعتبر من أعلام الحلقة بساحة جامع الفناء، اختص بما كانت تسميه العامة “السولان” فهو في هذا المجال الذي كان يمارسه عن جدارة، وفي حذاقة، لم يكتف بترويض عقول المُحيطين به، على تعدد شرائحهم، وفي هدوئه الخارق، وإنما كان يلجأ في عملية “السُّولان” إلى اختبار الأذهان في المعارف والمعلومات، بل يلجأ إلى توظيف أسئلته التي كان يطرحها، ويرمي إلى ما يرمي إليه من بعيد، والقاعدة عنده أن يرد “السُّؤال” ملفوفا بلغز من الألغاز، طالبا من الحاضرين الجواب عنه في حينه، كأن يقول – مثلا – : “خَبَّرْني يَالـْوَاقف على اللي يَدْخَلْ الكل مَنفذ بلا استئذان، يْفَرَّق، ويشتت الأهل والإخوان، سيفُو على الدّوام، قاطع ما فيه أمَانْ ” “الموت”.
فإذا عجز الواقفون عن حل اللغز، التفت إليهم – وهو يبتسم ابتسامة عريضة – ويقول لهم : مَن يشتري مني الجواب؟ ثم يطرح لغزا آخر، فيقول : “خَبَّرني على اللي يتكنى بالصَّاد والصاد حرف من حْرُفوا، ما توجْدُو إلا عند الغسيل، ردّْ بالك ما تشوفو” .. “الصابون” الذي تتم به النظافة.
ثم يقول – مرة أخرى – : من يشتري مني الجواب ؟ وبهذا يُهيئ الواقفين لما يأخذ منهم من نفحات، ثم يدخل في صلب الموضوع عن طريق ما قدَّمه من ألغاز : فالأول حول “الموت” والثاني حول “النظافة”.
فالصورة لفن “السُّولان” عند “لَحلايقي” هي إطار لظاهرة متعددة الجوانب، صورة اجتماعية تقدم في أساليب شتى لتستجيب إليه النفوس استجابة فعلية وفعالة. وموضوعات السُّولان تنتقل من الحديث العابر، إلى القصَّة، ومرة ترتكز في الأساس على مجموعة من “الحوارات” تؤدَّى بأصوات مختلفة، وبراعة فائقة، وكأنها تصدر عن أشخاص أحياء يؤدون أدوارهم فوق الخشبة وفي إخراج جيّد، وهذا الموقف كان يولد في “لحلايقي” قناعة، إيمانا منه – وعن وعي – بأنَّ ما يقوم به من خدمات إزاء جمهوره العريض، يؤدي فيه دوره في استنهاض هِمم جماعته، وكأن الأمر عنده يتعلق بقضية إبداع، وتدخل ذاتي، ممَّا عوَّدنا عليه فيما كان يصوغه أو يوجهه من حين لحين، وفي كثير من المناسبات عندما ينتقل إلى ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة في زي آخر وفي فن آخر من فنون الحلقة الشعبية الأصيلة.