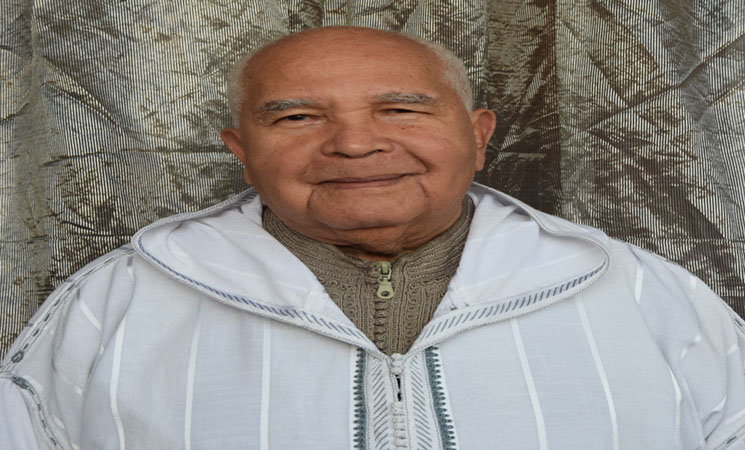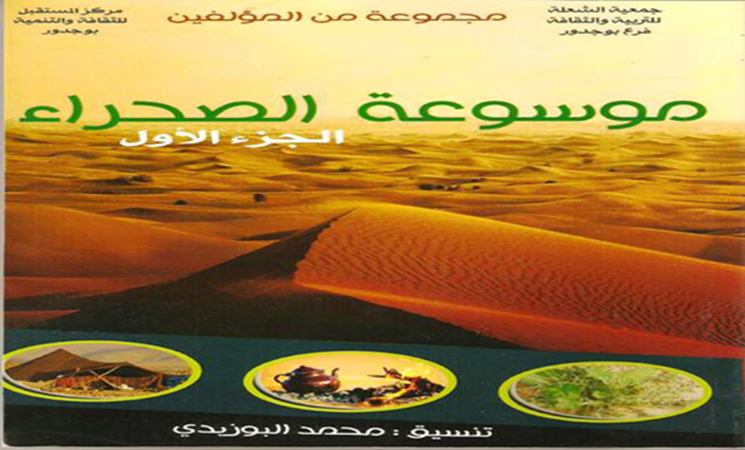– توقفنا في الحلقة السابقة عند مرحلة النشأة بدرب الجامع بحومة درب ضبشي بمراكش، وظروف الحياة أيام الحرب العالمية الثانية. نسألكم : اي دور كان لالتحاقكم بالكُتاب ( الحضار)، أعتقد أنك التحقت بكتاب سي الفقيه سي المختار الشهير بدرب الجديد بنفس الحومة؟
– المحطة الثانية في طفولتي كانت الدراسة الأولى بالكتَّاب. إنَّ مدارس التعليم العتيق، تُعَدُّ تراثا نفيسا، تتوارثه الأجيالُ المغربيةُ على تعاقبها منذ زمان بعيد؛ وهي التي حافظت، ولا تزال تحافظ للعلم على أصالته الأصيلة، فكانت – برعاية الدولة – منابع طيبة، ومناهل عذبة للعلوم العربية والشرعية عامة.
و أعتقد أنه من الواجب الوَطني الحفاظ على هذا الميراث، حتى لا تجف روافده؛ وفي عهد الدولة العلوية الشريفة، تكاثرت هذه المدارس بشكل كبير، وتضاعف رُوادها، ومُحبُّوها، واكتظت بالطلبة حاملي كتاب الله، فأعطت أكلها بإذن رُعاتها الأجلاء في كل زمان ومكان، ولا تزال إلى اليوم تقدم عطاء مُثمرا متزايدا في عهد أمير المومنين، جلالة الملك، محمد السادس – نصره الله –. والكتَّاب: المقصود به المكان الذي يدرس فيه الكتاب، وجمعه (كتاتيب)، والمكتب اِسم لموضع التعليم، وينعت الكتَّاب القرءاني باسم المسيد)، نسبة إلى (المسجد)، وينعت – أيضا – بالجامع، أو (تمزكيدة) باللهجة الأمازيغية.
أما المدرس فيها فيسمى بالفقيه، أو الشيخ، أو الطالب، أو المعلِّم. و «الكتَّاب» يقتصر على تعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة، وعندما يحفظون القرءان كله، ولهم رغبة في الدخول إلى كلية ابن يوسف بمراكش، فإنهم يتدارسون بعض المتون العربية: الأجرومية، ولامية الأفعال والألفية، وغيرها من المتون اللغوية، والنحوية والبلاغية والتفسيرية والشرعية التي كانت العمدة في التدريس يومئذ. وإني لازلت أتذكر، أنني بقيت في كتاب الشيخ المختار مومن، من عهد الطفولة، إلى سن مبكر، تقريبا من عهد الشباب، لأن فيه تلقيت مجموعة من «المتون» صحبة ابن الشيخ المختار مُومن – رحمه الله -، والذي كنت أشاركه مجموعة من الدُّروس بأمر من والده، نتلقاها على بعض العلماء من كلية ابن يوسف، ومنهم الحاج العربي بنجلون – رحمه الله – الذي كنا ندرس عليه «لامية الأفعال» إلى جانب (الألفية)، وعُلوم أخرى في اللغة العربية على يد غيره ممَّا تقوَّى به زادُنا العلمي في اللغة العربية للدخول – مباشرة- لكلية ابن يوسف.
وفي «الخَمسينيات» ومع حالة الطوارئ التي عرفتها الكلية من حين لحين، لاسيما حين اشتدَّ الصراعُ بين النخبة الوطنية، وبين أعوان الاستعمار، وباشا المدينة التهامي الكلاوي، وفي هاته الفترة الحَرجَة من تاريخ المغرب، اِجتزت امتحان الدخول إلى الكلية قبل عهد الاستقلال بعدما عاش الطلبة في دراستهم في أحوال مضطهدة ، في حين استمرت الدراسة بشكل متقطع على يد مجموعة خيّرة من الفقهاء، والعلماء ؛ أذكر منهم في فجر الاستقلال الحاج العربي في مادة الصرف، والفقيه السلطين في مادة التوحيد، والأستاذ بازي في مادة اللغة العربية، وجماعة أخرى من العلماء، والفقهاء والأدباء وتطورت الدراسة في عهدهم بعد الاستقلال كما تنوعت الأمكنة الخاصة بالطلبة وبإقامتهم، وأدخِلتْ بعض المواد الدراسية الجديدة كالفرنسية، والرياضيات بطرق علمية بيداغوجية حديثة، إلى سنة 1958/1959 حيث اجتزت امتحان الدخول إلى مدرسة المعلمين الإقليمية، وقد أعانني على هذا الدخول ما كنت قد تلقيته من دُروس خُصوصية في التربية والأدب على يد الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال، حيث كان – رحمه الله – يُخصص لي دروسا في علوم اللغة العربية في منزله يوميا بحومة روض الزيتون لمدة ثلاثة شهور، فكانت بمثابة سنة جامعية من حيث عطاؤها في مجالات لغوية وأدبية مختلفة، وتم تعييني بالتعليم الابتدائي، من سنة 1959/1960، إلى أن اجتزت امتحان الأستاذية بالرباط في السبعينيات، وقد سبق أن تم تعييني 1967/1968 أستاذا منتدبا بثانوية أبي العباس السبتي، ثم بمدرسة أحمد شوقي مُرشدا تربويا تابعا لمركز تأهيل الأساتذة بمراكش بعد اجتياز امتحان الأستاذية بالرباط.
– لكن طفولتك، كانت أيضا تشربا من مدرسة أخرى، هي مدرسة الحياة و الأهل و المجتمع، بثقافته الروحية السائدة حينها، و طقوسها، و سردياتها التي تتناقل شفويا..
– نعم، عشت في مجتمع خليط من أمشاج، وأنماط مختلفة من الطبائع والعلقيات، مَواقع اجتماعية شتى، من مجتمع مراكش، وأخرى عايَشتها وجَايَلت أصحابها من موقع المراكشي المثقف، والمتحضر، لتخلق – بذلك- فضاء جمعويا فيما بعد يستقطب أطيافا من كل العينات البشرية التي كانت تحيط بي، في أمسها، وغَدها، بل تعمر مجالسها الفنية، والثقافية في كلّ وقت وحين. فخالطت في شبابي بحكم توجهاتي الرَّجل الخراز القانع البَسيط، والدرَّاز الشاطر العفيف، وخَادم الضريح، والزاوية، والشيخ الدرقاوي، والكتَّاني، والبُوني، والقادري، والعيساوي، والحمدوشي، والطالبي، والإبراهيمي، والمُسمع، ومستظهر كتاب دلائل الخيرات، وغير ذلك من الشرائح الاجتماعية، والفصائل المهنية التقليدية، التي كان يتألف منها مجتمع مراكش العتيق، ومن مريدي والدي الحاج محمد بن عمر الملحوني حفَّاظ شعره.
ففي هاته العقليات المختلفة، والمتناقضة داخل مجتمع المدينة فتحت عيني في منزل كان يستقبل كل هذه الأصناف البَشرية، بحكم ما كان يمارسه والدي شيخ الملحون، الذي كان يزود هؤلاء بما كان يروج في محافلهم، ومجالسهم، من أشعار، بعضها يُنشَد في مجالس التَّصوف وبعضها في مجالس منشدي فن الملحون. إذن، فقد كان له من التقدير والاحترام، ما جعل هؤلاء يواظبون على زيارته، مُستفيدين من إرشاداته وتوجيهاته.