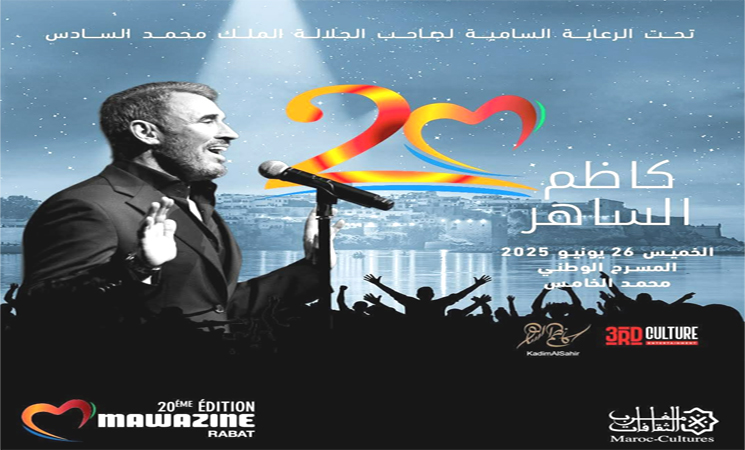نموذج «فيلم العثور على فورستر»
يطفح الفيلم الأمريكي «العثور على فورستر finding-forrester» {1}، بأبعاد غائرة ولامتناهية: فكرية – أدبية – تربوية – إنسانية – سيكولوجية – فلسفية – إيديوسياسية، تعدّت بشكل موفور أولية الإطار المشهدي المٌخرَج بصريا. وحسبنا أن نتقاسم شهادة مع القارئ الكريم في مفتتح هذه الورقة لا تزركش المضمون أو تضاعف العٌملة المعرفية أو حتى توجهه إلى استطابة فحوى الفيلم. فعلا نرفع القبعة عند مشاهدة هذه القطعة «pièce» التي موقعت نفسها في جسم السينما الهوليودية بكل أناقة وأصالة، لم يستطع أن يُقبرها سيل الإنتاج الفيلمي المدرار حتى في زمن الألفيات.
فكون السينما فنّا فاتنا ومُغريا في تقديم الصور مع تشكيلها وترتيبها ولمّها في معراج تسلسلي مختلف الوثائر والإيقاعات، متخللّة إياه لمسات تصويبية وإضافية من طرف مختلف الفاعلين في هندسة هذا المنتوج الفني، لا يعني ذلك أن المحكي {السيناريو اللفظي} قد يتوارى إلى الخلف أمام ملذات العين الناظرة / المُنتظرة {2}. بل ينبغي الحرص على طيّ اللفظي والبصري في بوتقة واحدة حتى يتّم لمّ الشمل بين ما يُقال le dire وما يُبصر .L’image فالتفاصيل لا يشتدّ عضدُها إلا بنسجها مع فتائل الحبكة، وحقل الرؤية لا يتفتّق بغير ملفوظ قوي، هامس، مُرّن في الأذن، والمعاني الظاهرة أو المبطّنة خاصة تلك التي ترتبط بفلسفة الصورة، لا تفيض بالدلالات بدون تيسير قنوات ومعابر للفعل التأويلي acte interprétative ، إذ لا حاجة فقط للتفسير مُرفقا بالفهم عندما يتعلق الأمر بمادة صُلبها الذات الإنسانية نفسها، نقصد في هذا السياق الذات المفكّرة والمفكّر فيها على حدّ سواء.
إن أي عمل يسلّم نفسه لعالم الفن، يكون بصدد اختبار الحقيقة لا تأكيدها أو نفيها، وإنما ترويضها هي ذاتها، بلا ثقة أو استهتار، بلا عبث أو صرامة، بلا انكشاف أو استزادة في الغموض {…} الخ. بمعنى آخر، تبقى النتائج المستخلصة من أي عمل فني {خاصة منه السينمائي} غير صالحة للتأبيد والغرس في تربة اليقين، ما دامت كل محاولة محمودة من طرف كاتب السيناريو أو المخرج أو الشخوص أو الجمهور أو الناقد، تظل فقط تحدّي شغوف للكشف عما وراء المعنى.
امنحني الجوّ .. أعتنق عقيدة المعنى
يفتتح المخرج مُنطلق الفيلم بمقطوعة غنائية تنتمي إلى جنس الراب «rap» وبالضبط الصلام «Slam»، يؤدّيها صوتا وصورة شاب في مقتبل العُمر، يبتغي من خلال كلماته المسترسلة بسرعة، تشخيص واقع الحياة في حيّ البرونكس «bronks»، الذي يعدّ من أخطر المناطق في جغرافيا المدينة التي لا تنام نيويورك «New-York»، كما يصفها العَالم. ويتضاعف الإحساس بالكلمات عند إدماج الفعل الإخراجي موسيقى صامتة لا هي بحزينة أو بئيسة ولكن ثقيلة على الأذن، أجادت حقا التعبير الايحائي عن مناخ العيش والتواجد في زقاق وشوارع تصنّف كهوامش أو نقط سوداء.
وفي خضم هذا الإيقاع الذي شكّل عُنق الفيلم انتقلت بسلاسة عدسة المخرج إلى إلقاء نظرة عجولة على واقع الناس وخاصة منهم شريحة السود، مُبرزة المتسولين، الطرق، السطوح، التلاميذ، العمارات الشاهقة، صالون الحلاقة – الذي يعتبر عمودا فقريا في ثقافة السود- تُجار المخدرات وكذلك الشباب العاطلين عن العمل {…} الخ، مختتما هذا المشهد البدئي بالولوج إلى غرفة «جمال والاس بروان»، مسلّطا العدسة بشكل خاطف على بعض الروايات والكتب الفلسفية المصطفة في خزانته المتواضعة، أصحابها من قبيل: Kierkegaard ; marquis de Sade ; James Joyce ; Ken kesey ; yukio Mishima ; uchekhov … {3}، وبعدها يزحف مخرجنا بالكاميرا عبر جسد «والاس براون» المستلقي على الفراش حتى يصل بها إلى عينيه التي انفتحت من النوم – بحدّة وإمعان كنظرة الصقور – على صراخ أمه، داعية إياه الاستعجال للحاق بموعد المدرسة.
يطوي المخرج بحركة خاطفة هذا المشهد الافتتاحي ويلفُّه ببراعة ضمن مشهد آخر مُوالي {مُنتشل من حيث البناء الدرامي من أحشاء سابقه}، لكأن فعل الإخراج كان متعطشا أكثر من المشاهد إلى إظهاره، مُستثمرا تركيز الرائي على الدقائق الأولى من متواليات الفيلم، وهنا يبرز ذكاء المؤلف على كل حال، من حيث تحكّمه في عتبات الإغواء والاستثارة المطلوبة بأقلّ جهد مبذول.
وبالعودة إلى تركيبة المشهد، فهو في عمومه يتمفصل بين مقطعين: الأول تظهر فيه جماعة من الشباب السود يزاولون كرة السلة بعد أن انظمّ إليهم «والاس بروان»، أما المقطع الثاني الذي نجده يشكل بؤرة الاستفزاز المراهن عليه فيما يخص جاذبية التشويق، فينقشع فيه «وليام فورستر» من وراء ستائر نافذته، متجسّسا بخلسة على جماعة المراهقين من خلال الاستعانة بمكبّرات النظر.
ونستطيع القول هنا أن مركز الثقل وقوة الجذب في كيمياء العرض الفيلمي قد تكثفت كلّها في هذا المقطع الذي تدفّق كموجة عالية على باقي الأحداث الأخرى اللاحقة. ففي اللحظة التي توجهت أبصار الجماعة إلى النافذة متسائلين: يا ترى من هذا الشخص الذي آلف التلصص علينا دوما وبدون ملل؟ مُلقبين إياه «برجل النافذة»، قد استنفر المخرج أقصى مجهوداته الفنية لبرمجة إدراك المشاهد صوب شخصيتان محوريتان، ألا وهما: «وليام فورستر» و «والاس بروان» دون الآخرين.
أكثر من ذلك نؤشر على كون المحتوى الفيلمي قد اختزل نفسه في دقائق معدودة وبعدها أمسى يزاول نوعا من التقشف على انتظارات الجمهور، جوالا بين مدارات السرد، تكشّفات الشخوص، اندلاع الأحداث، العلامات المنتظر أن تطفح على السطح، الوقائع المكمّلة والشهادات الصادمة أو غير المرتقبة.
رجل النافذة
لقد كان الكاتب المتوحّد «وليام فورستر» يعيش عُزلة أنطولوجية تمنعُه من مخالطة الناس والتجول في أروقة الشوارع وتجاذب أطراف الحديث مع الأغيار، لكنه لم يستطع أن يُوقف حسّه الفضولي الخافت في التلصّص والنظر إلى العالم الخارجي من خلال نافذة غرفته العُليا، محرّكا الستار بروية وتقشّف حتى لا يُكشف أمره من قبل جماعة السود اللذين كانوا يُداومون على لعب كرة السلّة في ملعب يقع على مرمى المسكن الذي يقطن فيه هذا الأخير في حي «البرونكس».
وعندما انتبه معشر السود {رفاق شخصية جمال بروان والاس} إلى تجسّسه اليومي عليهم، ما كان في وسعهم سوى تلقيب المنزل وقاطنه برجل النافذة. ربما هو ذكاء المراهقين، لأنهم لم يخطئوا التوصيف حقّا. فالنافذة لا تدلّ فقط على رُكن أو زاوية ضيّقة من الهندسة الطوبولوجية لبنية المنزل، وإنما هي تكتنف دلالات عدّة، لعلّ أهمها: مُتعة النظر أفقيا وعموديا – الإحاطة بزوايا المشهد المنظور بصريا – منفذ {نافذة وفق الاشتقاق اللغوي} إمّا أن يُعبّر عن ضيق الرؤية للحياة أو سعتها. وتحضرنا هنا قولة الرسام الأيقونة «بابلو بيكاسو»، ذاكرا: «هل تراني كما أراك»، وهو الذي كان يهوى النظر من نافذة منزله واضعا يديه على الزجاج لا الريشة، عندما يحقق لذّته الفنية.
إنه ما يستقيم وصفه بالحالة الإنسانية «condition humain»، التي تجعل المبدع مرتبط بجنسه الآدمي ومحسوبا عليه، مهما بلغ منه الوجد حدوده القصيّة والعاتية. فقد تكفي همسة – كلمة – لمسة أو احتكاك جسدي – نظرة {…} الخ، لسلخ جلد التمساح الذي نمى بصلابة فوق ذاته، وتنقلب السمة الواصمة إياه إلى نقيضها، فالحزن قد يدلّ على البهجة، القسوة قد تؤشر على رهافة الإحساس، الفراغ الملحوظ خارجيا قد يحيل على الامتلاء والانتشاء الداخلي، إلى غير ذلك.
من ناحية أخرى لا تقلّ تعبيرا عما ذكر، فالمعلوم أن النافذة تتيح للناظر منها إمكانية مشاهدة المارة والأحداث والوقائع دون تحديد هوية الرائي، إذا ما أجاد فن التخفّي. هكذا يُقولب المخرج الصورة السينمائية في كفّ المحمول بدل أن تكون هي الحامل، مُربكا قاعدة الالتقاط المشهدي للحدث {أي الشوتاج}، ويعدو الحقل البصري المتاح من خلال النافذة مُلهما وملتهما ذات الحين لعدسة المخرج، متحكما في الكادر، بعد أن خلق هذا المنفذ، إطارا داخل إطار، ووفّر وفق حركة انسيابية إمكانية تضمّن اللامرئي للمرئي، وتمفصل الحركة بالزمن الذي انفجر من بيضته، موحيا بعلامات مكنونة تخاطب إدراكات الجمهور وعتبات توغّله في طبقات النص الفيلمي.
إن تلك الإطلالة العابرة والمحقّقة أحيانا من طرف «وليام فورستر» عبر نافذة غرفته المتواجدة بالطابق العلوي، أضحت بمثابة نظرة ملاك {مُتعالي} إلى عالم سفلي – أرضاني. ومن باب الإشارة يتكاثف معنى الوصف الملائكي لشخصية «وليام فورستر» متعدّيا نطاق الصورة المجازية المراد تبليغها إلى اسقاط الصفة عليه وإلصاقها به، ما دام الملاك موجود لكن هو غير مرئي أو منكشف للبشر، إلا بتلبّسه هيئة آدمية {وليام فورستر الكائن المجهول بدل الروائي المتميز}.
من خلال هذه الحركات المرتقبة من طرف شخصية «فورستر»، ذبّ إحساس غريب، متقطع الأنفاس، عاصف وعنقودي، نال اهتمام جماعة السود، وصعد بهم من الناحية التخمينية – التساؤلية إلى طابق منزل لا رقم أو عنوان له، كما انحدر بهم تارة أخرى إلى أسفل السافلين، دون الظفر بإمكانية تحديد هوية هذا الجاسوس الذي خطّ بصمت رُقعة اللعب لكن بدون قواعد.
على هذا النحو المستغلق والغامض، تمكنت تلك القطرات المرشوقة برويّة من لدن «فورستر» على خلع السكينة الموهومة عن شخص «جمال والاس»، المراهق الذكي وذي القدرات الأدبية الفذة، لتشعل سعير رغبته العارمة في معرفة هوية من يقطن ذلك البيت، حتى يُوقف سيل لعاب البصر ويوفّر عن عنقه تعب الانتصاب إلى العُلى، وأيضا لكي يضع حدّا لتنامي سيولة الاستفهام والتعجب!
لم تعد هنا الصورة المركبة ضمن إطار «تقنية المونتاج» ذات أهمية توليفة – إدغامية، بقدر ما لبتت عيون المشهد من داخل تمرئيات الفاعل/ الممثل، لا المشاهد/ المتلقي، مشغولة بكشف أو حتى سحب الغطاء عن الصورة ذاتها، فطيّ الحدث داخل حدث آخر محايث، تلك في نظرنا لغة الفيلم العصية والتي لم تتوقف عن تمطيط تمدّدها.
لم يكن من الهيّن، أن تخلق النافذة أو رجلها، كل هذا الإزعاج والاهتمام والانتباه، فوحدها شخصية «جمال والاس» من طالتها غواية ذلك اللامنكشف واستيلاباته الناعمة، قياسا على باقي رفقائه الآخرين. فمن موفور الشغف الذي استنزل على هذا الأخير، وهزّه هزّا، ابتدأ مشوار البحث عن فورستر كما يشي بذلك عنوان الفليم، ولو أن باقي تفاصيل النقد السينمائي لهذه الرحلة، تعدنا لا محالة بقراءة مضاعفة، لا تبتعد عن فكرة كون جمال والاس المراهق المتمرد على أسلوبه الخاص، يبحث في حقيقة الأمر عن ذاته لكن من خلال شخص آخر، بإيعاز من مشيئة الأقدار أو لنقل الصدف حتى لا نضفي بعدا ثيولوجيا عن العبارة، فكان وليام فورستر مرآة لهذا الانعكاس اللاشعوري أكثر مما هو مشعور به من الناحية التحليلة النفسية طبعا.
ولا مندوحة أن السرد الفيلمي بالموازاة مع التمرئي البصري، يدلّلنا في القادم من العرض على عدم حصر هذا المشوار البحثي عن فورستر في جانب أحادي، حيث ستتلو هذه المرحلة التعارفية بين الشخوص المحورية، استبدال رشيق للمواقع يحدث أن ينجم عنه التفاف أكروباتي من قبل فورستر حول ذاته، يقدّر في نظرنا كروح للحبكة برمتها، وحينها سيبدأ هو الآخر في البحث عن نفسه من خلال التآلف والأخذ والردّ الحاصل بينه وبين شخصية والاس بروان، مطمئنا نرجسيته المكلومة بخواطر بكماء لم يفضحها المحكي.
ونضيف في هذا الإطار مسألة ذات وقع ثقيل على المضمون الفيلمي، وهي تتعلق بمفاعيل المادة الأدبية التي كانت القاسم المشترك بين الشخصيتين. فهي وحدها من حشدت شياطينها للجمع بين هذه الأرواح الضائعة أو المتمردة بلغة «جبران خليل جبران». غير ذلك نجد نوعا من الاستقباح للذات لدى الشخصيتين عملا بالحكمة القائلة: «من لم يستقبح نفسه لن يراها». هذا القُبح لا يرتبط بالهيئة أو طريقة التصرف أو وخز ما للضمير {…} الخ، وإنما متصل بشعور باطني عميق يجعل كل منهما يؤمن في صميم نفسه بأن الجمال الحقيقي يكمن في تمتيع الذات بما تملك لا هجرها لصالح عالم مزّيف قد يُفرغها من أصالتها ويُهلكها في دوائر الاستلاب والاغتراب والاستسلام لعبثية الحياة.
ولوج «والاس براون» إلى مغارة الأديب الشبح
بعد طول انتظار حدّده الزمن الفيلمي المرتبط بديناميات السرد لا بالمحصلة التوقيتية للفيلم، قرّر «والاس براون» خوض التحدي الذي بادره به أصدقاءه، ليذهب معهم في أواخر الليل ناحية السلالم الخلفية للعمارة التي يقطن فيها «فورستر»، وهو على أتم الأهبة للصعود عبرها إلى شقة «رجل النافذة» كما يدعونه، مع تخوّف رفقاءه السود من خوضه غمار هذه المحاولة الموحية بالفشل منذ منطلقها، لكن براون بدا مصرا على تقمص دور سندباد، حتى يجد جوابا عن هواجسه الخاصة لا أوهام الجماعة.
وفق هذه الحركة بالضبط، نستطيع القول أن «والاس بروان» قام بأول خطوة في مشواره الأدبي المنتظر، ولو أن الأمر سيق على نحو معكوس تماما. فما يشيء به السرد في هته اللقطة لا يعدو أن يوحي للمشاهد سوى بتلك الرغبة لدى المراهقين في إشباع فضولهم ليس إلا {كما لو أنهم بصدد سرقة سيارة مركونة في حي ما والتجول بها وفي الأخير إعادتها إلى مكانها}. والحال بالنسبة ل»والاس» على الصعيد النفسي اللاشعوري، أنه كان على يقين بموعد غير مقرر مع شخصية تنتمي إلى عالم الفكر والابداع، مزيحا ولو بشكل نسبي من ذهنه كون «فورستر مجرد مجرم يختبئ في شقته لمدة تناهز عشرون سنة مخافة القبض عليه.
وقد نفهم هذه الجرأة كدافع خفي جعل «والاس» يتوق إلى كسر ذلك الحاجز النفسي الذي يطوق إمكاناته الأدبية، مستجيبا في هذه الآونة إلى نداء الهوية الثانية {الكاتب المبدع} كما أوضحنا هذا الأمر آنفا. لقد بدأت مفاعيل الفلسفة الوجودية التي كان يحب الاضطلاع عليها تأتي أكلاها على نحو ضمني فيما يمس تكشّفات شخصية «ولاس». إن فكرة الاختيار نفسها هي التي تمنح للإمكان قيمته. فما من أمل سوى في الفعل والفعل وحده يسمح بالحياة {جون بول سارتر}.
يتسلّل والاس بحذر شديد عبر النافذة المفتوحة للشقة، ثم يشرع في فتح معصم الباب الذي يسمح له بالولوج إلى وسط المنزل، مع كامل الدلالة الرمزية المنوطة بفعل فتح الباب، إذ يرتفع المعنى المراد تبليغه من عتبة الصورة المادية {الباب كباب} إلى استولاد صورة فكرية تأتي بذلك العالم الممكن وفق تعبير فيلسوف المعنى «جيل دولوز»، مما أضفى على هذه اللقطة مُسحة هتشكوكية، كانت كفيلة بتسريب انفعالات متزاحمة في نفسية المشاهد، مثلا : كالانتظار، التشويق، القلق، التساؤل، الانغماس في الحدث {…} الخ، فيا ترى ماذا سيجد بروان في الشقة بحق السماء؟
سيقوم والاس بجولة سريعة في أركان المنزل الذي اقتحمه بدون مبرّر مدني أو أخلاقي طبعا، على ايقاع «موسيقى الجاز»، ناظرا بكلّ تأني إلى ما يوجد من حاجيات في الفضاء، فصادف أن لمحت عيناه سكينا من الطراز القديم موضوع فوق طاولة، لم يتردد والاس براون في سحبه بسرعة ودسّه في محفظته خشية من أي ضرر قد يلحقه من ساكن المنزل، لا سيما وأن احتمال أن يكون فورستر قاتل مبحوث عنه من طرف الشرطة لم يحسم فيه بعد.
سيصل والاس براون في زحفه المقدام إلى أهم نقطة من فضاء المنزل وهي ركن المكتبة {نقصد مكتبة الروائي فورستر}، ممدّدا يديه المرتعشة إلى كتاب بعينه من ضمن كتب عديدة، تصفّحه بعجالة دون أن يحظى المشاهد بفرصة التقاط عنوانه، وبعد بُرهة سيباغته صاحب المنزل بقفزة من وراءه، صارخا بصوت مُفزع وكنيبالي إلى حدّ ما، لقطة فيها شبه قوي بانقشاع تلك الشخصية المخيفة في أفلام الرّعب والتي كانت بالمناسبة تنال منا جميعا. وهذا المعطى لا يعود إلى منسوب الخوف وإنما يُعزى إلى توجسنا من طبيعة الحدث المجهول.
سيقفز والاس بروان من مكانه هلعا، مبادرا بالركض حتى وجد نفسه بقرب أصدقاءه بالأسفل، مع شتمه بالسارق الوغد. يفتتح إذن هذا المشهد مالغا التشويق في الفيلم بكل حرفية، خاصة من طرف الممثل المخضرم شون كانري {شخصية فورستر}، التي كانت لها فيما بعد مساهمة مائزة في السمو بالقيمة الجمالية للفيلم، مما يعزّز فكرة التأليف المشترك للمنتوج السينمائي.
من أبرز الديناموهات التي حركت بليونة عجلة السيناريو هي عنصر «التشويق»، ونحن نعلم أن عنصر التشويق يتضمن درجات من الحيرة العقلية والفضول والقلق الإيجابي والتعاطف. وعندما برزت هذه العوامل بشكل لافت في الفيلم عبر مختلف محطاته، استجاب الجمهور لدرجة أنه استطاع أن يعاني عن طريق التعاطف نفس القلق والحيرة تماما مثل الشخصيات. كما أمكن أن يساهم التشويق في تدفق الاستمرار وإرغام الجمهور على الرغبة في معرفة الطريقة التي سوف تسير بها الأحداث.
سيستفيق والاس بروان في اليوم الموالي، وكله نشاط وحيوية، مداعبا كعادته كرته فوق أرضية المنزل، يهزّه شعور غير بادي للعيان، يُطمئن حدسه حول براءة فورستر من التهم والافتراءات التي يلصقها به الآخرون. قائلا في خواطره: «على الأقل يوجد هناك قاسم مشترك بيني وبين هذا الرجل الغامض، ويكفي هذا الكشف لحدّ الآن، فإفساد الأمور يأتي من حرقة معرفتها دفعة واحدة». هذا القاسم المشترك هو محبة الأدب.
بعد هذا المشهد بالضبط، بدأ السيناريو ينمو رويدا رويدا واشتعل النص الفيلمي بزناد الإرادة اللاواعية المتاخمة لذاتية الشاب المراهق جمال والاس، حيث سقط ميكانزيم الممانعة لديه وقاده شغفه الخجول إلى استخراج مذكراته من محفظته التي تركها مرغما في منزل فورستر، أي بعدما رماها له من النافذة في الصباح كما أشرنا آنفا. ليفاجئ بمراجعة وتصحيح وتعقيب بل ومدح «This passage fantastic» من طرف رجل النافذة، مستطيبا تلك السطور التي اعتقد والاس أنها ستعاني اليتم والضياع وستظل مطوية في سجن خواطره ليس إلا.
لقد ألقى فورستر «الكاتب المجهول إلى حدّ الساعة» سحره على والاس بقلمه الأحمر دون أن يُعرب عن هويته. دعنا نقول لقد عرّف الأستاذ نفسه على التلميذ فقط بوساطة الرمز {القلم الأحمر}. سيذهل والاس من ملاحظات فورستر على كتاباته الفتية قائلا بصوت مجاهر: « لقد عبث بحاجياتي». غير أن هذا التعليق ينفي نفسه بسرعة إذا ما وضعنا المشهد في سياقه، فكما لو أنه أراد أن يقول على نحو معكوس: «لقد اهتم بحاجياتي». إنها إذا جاز التعبير مفارقات أمتعنا بها صانع الفيلم. لكن لم يترك فورستر فرصة تقليبه لمذكرات زائره تمرّ مرور الكرام، حيث اختتم تعليقاته بجملة دقّت كذبذبات الناقوس في نفسية والاس، ذاكرا: were are you taking me» إلى أي وجهة تقودني ؟!
هذه الجملة الاستفهامية – التعجبية أيقظت صراخا عذبا في دواخل ولاس «الكاتب المبتدئ» وأجابته ذات الحين عن بعض هواجسه. في هذه الليلة التي اقترب فيها القمر من أرض قاحلة {تعبير مجازي} تعمّق لدى هذا الأخير الإحساس بالعوز والحيرة والتيه زكّته نوتات موسيقى الجاز الخافتة والمرتجلة، مواكبة جل أحداث الفيلم ومنعشة ذات الحين روح العمل السمعي – البصري.
يتلو هذا المشهد المرتعش من حيث الافاضة الدلالية، لقطات معدودة الدقائق، تبتدأ بصعود جمال والاس إلى شقة فورستر {رجل النافذة}، ناقرا على بابها نقرات مستخيفة من نفسها، آملا في نواياه أن تجمعه مع هذا الشخص طاولة واحدة، لكن يحدث أن أطلّ عليه فورستر من ثقب الباب بكل وقاحة ورفض وعدوانية، مستكملا كلامه غير اللبق بطلب الابتعاد عن منزله وتجنب ازعاجه.
لا شك أن هذا التعليق اللاذع من طرف فورستر قد صدم المشاهد وصعّد من حجم الظنون السلبية المحيطة بشخصية قاطن هذا البيت. غير أنه من مميزات الحبكة أنها تميل إلى استعدام القراءات العجولة وتدير مدارك هذا الأخير صوب فلسفة خاصة بالفيلم، ولا أدل على قولنا هذا سوى استعشاق جمال والاس لهذا الصدّ بدل اعتباره جدارا نصب أمام عيونه المتشققة. فعندما حمل معه محصوله اليسير من تلك الزيارة البلهاء، عاد إلى غرفته وخصص وقته للكتابة بدل مداعبة كرته التي لا ترافق أنامله.
إنه أول درس وجودي يتعلّمه جمال والاس بدون اطناب أو حشو أو بروتوكول ما في الكلام من طرف فورستر، وإنما فقط حوار مرّ بنظرة قاتلة، بكلمات ساقطة، بانفعال حركي … الخ، ارتفع بهذا الأخير من رقعة شبه ميتة أو على شفى الاستسلام، إلى عالم مستخفى عن العامة، سرّه الوحيد هو العزلة والتضحية والكتابة العاشقة.
ازدواجية نداء الاستغاثة بين المرسل والمرسل إليه
عندما ينظر المشاهد إلى العنوان المختار للفيلم «العثور على فورستر»، ينسحب تفكيره على نحو بديهي إلى طرح الأسئلة التالية: من هو فورستر؟ ولماذا ينبغي ايجاده؟ هل هو شخص ضائع من الناحية الكيانية الرمزية أو من الناحية المادية العينية؟
يرتكز السيناريو حقا على هذا المطلب، أي جعل شخصية فورستر محط عجب واستفسار، غير أنه في إطار التصاعد الحادث في أنفس الأبطال إلى جانب تواطئ التعبيرات الرمزية مع صيرورة التموضعات الحاصلة، ينقشع لنا في هذا المضمار بعد آخر غير مصرح به، وهو كون المحتوى الفيلمي في جلّه، عبارة عن «رحلة البحث عن الذات»، وعليه يمسي فورستر البطل المركزي مجرّد رمز يفتّق صورا سيميولوجية – دلالية لا حصر لها، تليّن بنيات الاستقبال والارسال، فيعدو المرسل مرسل إليه والعكس صحيح، أو لنقل ازدواجية نداء الاستغاثة. وقد تعددّت اللقطات التي ترجمة هذا الجانب وأوحت «بالأسلوب اللاكاني» في تقصي خطاب «الآخر» ورغبته، وهو ما لا يبتعد عن فلسفة ديالكتيكية «كوجيفية» نابعة من الإرث «الهيغلي» المسموع جدا.
على هذا النحو يجوز القول أن فورستر، قد يكون الوجه «الآخر» لشخصية جمال براون، تلك الشخصية المرجو أن تنبجس في ثنايا السرد وسيل متواليات الأحداث، أو قد يكون رمزا لتلك الغرابة التي تسكن كل واحد منا كما وصفتها «جوليا كريستيفا» وعليه لا داعي لاعتبار هذا «الآخر» غريبا أو دخيلا عنا، أو قد يكون لا هذا أو ذاك، وإنما مجرد شبح استوطن السيناريو الفيلمي ليخلخل ثنائية الغياب والحضور بلغة «جاك دريدا».
ولعل الانكشاف والحضور المادي والمعنوي لشخصية فورستر في أواخر الفيلم وبعد عشرون عاما من الخفاء، من أجل تبرئة جمال ولاس من تهمة السرقة الفكرية التي ألصقها به الدكتور الحسود كراوفورد الذي يعاني من عقدة التجاوز، دليل ساطع على الهوى التناصي للمخرج، فهو يفعّل نوعا من الأثر غير المحكوم بالزمن الفيلمي وينفلت على الطراز «البرغسوني» من متاهات الديمومة التي متحت منها السينما كثيرا، فيشبك بعلم منه أو لا شعوريا ما لم يظهر مع ما ظهر وترتسم معالم تلك الكينونة الإنسانية التي لا تقبل بزمنية ما للموجود خارج الوجود.
معارج الارتقاء بالنفس وعطاءات الأدب
من الراجح أن الصورة تتبوأ مكانة بارزة في مجال السينما والتصوير الفيلمي، ومنها يتدفق الحديث عن منظومة من المصطلحات التقنية: كالكاميرا، العدسة، الكادر، الزاوية، المسافة {…} الخ، غير أننا بمجرد الانتقال الى مراكز الثقل في السيناريو قبل الصناعة السينمائية للأحداث والوقائع والمشاهد واللقطات، فإننا نفطن بسرعة إلى مقام اللفظي/ المنطوق، بما هو يستبق التمرئي البصري الماثل في الإخراج الأخير للفيلم كمادة قابلة للنظر والسمع معا.
بمعنى آخر يحدث تشويش ما محتمل أو أكيد لهذه السيادة، عندما يتعلق الأمر بتناول مادة أدبية من قبل السينما، من المرجى تجسيدها بعدسة الفن السابع. فعندما يتعلق الأمر بالمعنى المُراد تبليغه للمتلقي لا مجال لافتعال منطق التفاضل بين المرئي واللفظي، بين المنظور والمُقال، بين الكلمة والصورة سواء كانت بادية مرئية أو تحتويها عن طيب خاطر لغة المجاز والرمز. إن الحوار يأتي قبل عملية التصوير، وبذلك يساهم في إنعاش مخيلة المخرج حتى يحقق أقصى درجات التطابق بين الكلامي والبصري. على هذا النحو تتواضع فتنة الصورة أمام هيبة الملفوظ، ويحصل ذلك التناغم المطلوب بينهما، وخير دليل على ذلك حقل الرؤية بالنسبة للمشاهد الذي أمسى محكوما بمنطوق السيناريو، وإلا غاب أي استيعاب ممكن لدى المتلقي لفحوى الحبكة. يمكن القول في هذا النطاق أن المادة الأدبية هي من تنزلت بكل ثقلها على المضمون الفيلمي وطالت أنفاسها الإخراج البصري.
غوص في ذاتية الأديب المهجور فورستر
تبدو شخصية الكاتب وليام فورستر في أولى أطوار الفيلم على درجة من الغموض والبغض والانطواء، إلا أن هذه الصفات الغير مستبعد الإقرار بها، لم تطوق إرادته الخيرة، لنقل نوع ما من الاستقامة الكانطية وأخلاق الواجب. هكذا ينقلب الحسد اللاشعوري –إذا وُجد طبعا-إلى رغبة محمومة في بعث كائن على شفى الاندثار من مسرح العالم في وجدان روح أخرى، يرى ببصيرته النافدة أنها ذات قابلية لتبليغ الرسالة، كما لو أنه كان يبحث خارج عن إطار وعيه المهجوس عن شخص يحمل المشعل، حتى لا يكون نسيا منسيا أو سحابة عابرة لم تترك أي أثر يشهد له. إنه نمط التضحية بلغة سينارستية، وهو عكس نمط الانتقام.
وفي إطار المتابعة لتكشّفات شخصية فورستر، يبدو لنا أن عالم هذا الرجل المنسي كصحراء شاسعة يملأها السراب، فاصلة إياه عن الذوات الأخرى مساحات عريضة في ظل غياب جسور التواصل المشتركة والممكنة. ولو أن دوافع اليأس والألم والتيه والعزلة كانت بادية عليه، غير أنها لم تتمكن من إبدال شخصيته. فالاكتفاء بالصمت كان سبيلا لقول كل شيء دون أن يقول أي شيء. إذ الشيء الأكثر أهمية في التواصل مع الآخر هو سماع ما لم يقال كما جاء على لسان بيتر دروكير.
لقد قدّم المخرج ذلك السر المخبوء وراء الجمود الذي طوق لسان فورستر وصعّد من درجة البرودة إلى مداها الأقصى، حيث تكفي نظرة واحدة إلى عيونه البلورية، لتشعر الناظر بصقيع وجليد مسطح على وجهه، تبثُّ في الطرف الآخر خشية ورهبة وتنبأه بعدم ارتكاب حماقة فاشلة المطمح في محاولة تكسير هذا الحاجز الذي صمد أكثر من جدار برلين.
ومن الملاحظ ذلك الفرق بين تكشّفات الشخصيتين، فبينما شخصية فورستر يستوطنها الغموض على طول مدارات السرد، تنكشف بالمقابل شخصية جمال براون كمراحل نمو البذرة في التربة رويدا رويدا حتى تصل إلى خاتمتها المنطقية. فمن ذا الذي يستطيع أن يُحدد بدقة تلك الخطوط التي مفصلت عطش الرغبة بسعي الإرادة في وحدة مجاملة للناظر ومعاشة كقلق وألم على الصعيد الذاتي عند كل من الشخصيتن المحوريتين.
علاقة أبوية بطعم الصداقة
يُستعصى تدبر فحوى السيناريو دون الالتفاتة إلى مقولة «اسم الأب» كما صاغها المحلل النفسي جاك لاكان. فمن البين أن شخصية المراهق الصنديد جمال بروان والاس ظلت تتخبط بين ثلاثة سجلات ترسم فوق خرائط نفسيته انفعالات وهوامات أجادت نُطقها دواوير اللقطات وأقبرها المنطوق السردي. وقد نجملها في الأبعاد التالية: الرجاء المُفضي إلى التماهي والكره والافتقاد. لقد عاش جمال والاس على المستوى النفسي اللاشعوري مظاهر لولبية للأبوة، أولها «الأب المفقود» وهو الأب البيولوجي الذي لم يظهر مطلقا في الفيلم، وثانيها الأب الأوديبي الحسود، والذي شخصه في الفيلم الدكتور كراوفورد، وثالثها الأب المثالي، وهو الأديب وليام فورستر. ويمكن القول أن هذا الأخير هو من كسب موقعا داخل صيرورة الترميز التي كاد أن ينتهي بها الأمر إلى التخندق في نفق مسدود.
وحتى لا ننتصر إلى مقولة الأبوة المخاتلة لروابط العلاقة المنسوجة بين فورستر وجمال والاس، نحيل القارئ على شكل آخر تلوّنت به هذه الأخيرة: إذ نجد نوعا من التوافق الباطني بين الشخصيتين ماتحين المفهوم من فلسفة «إدموند هوسرل» الفينومينولوجية، والمقصود به حينما يلتحم أناي بأنا الآخر، ويصبح أنا الآخر في محط أناي والمعبر متبادل طبعا.
فكلا الطرفين كما هو ملحوظ، يتحدث أحيانا باسم الآخر ويستبق حتى أفكاره وينغمس في خواطره ومخاوفه اللامُعلنة، مع استطعام هذه العلاقة الفتية بملح القبول والرفض، إذ يتشاكل فيها الوفاق على نحو لا يكاد يستوعبه حتى هم أنفسهم، إنه إذا أذن التعبير تآلف يخيط نوعا من «البينذاتية» بين الكاتب المتوحّد ومراهق مبدع تفيض قطرات حروفه على صخرة الإرادة.
وفيما يخص النقطة التي وصل إليها البطل جمال براون والتي يمكن نعثها بنقطة التحول، حيث توجد القيم الدرامية بصفة عامة في المواقف التي تجد فيها الشخصية نفسها كما لو كانت على قرون الحيرة. فيجب أن تواجه موقفا تضطر فيه إلى القيام باختيار حاسم. وكما اصطلحت عليه «هوليود» يصبح داخل بالوعة يجب أن ينتشل نفسه منها أو يُهلك. ففي اللحظة التي اقترب فيها جمال براون من الانهيار التام واختلطت عليه الأمور، قد قفز برشاقة من منزلة لأخرى.
عنصرية مرسخة أم مفتعلة ؟!
يململ المحتوى الفيلمي تاريخا فضيعا من العنصرية تجاه ذوي البشرة السوداء، لم يكن من المتاح جمع أشلائه المتناثرة في زمن الفيلم المحصور مهما دقت ثوانيه. لكن بوضع المؤلف الأصبع على ذلك الوثر الحساس-أي المضمون الأدبي-يكون قد وفّر على نفسه التجول عبر باقي التمظهرات الأخرى. فليس هناك من قناة أضخم من العطاء الفكري الذي بواسطته ومن خلاله يتمنهج السبيل إلى التحرر، ويرتسم الطريق للتخلص من توابث أو بقايا الحس العنصري تُجاه السود المتواجدين ببلاد العم سام وغيرها.
ومن باب الإضافة، نُعرّج إذا سمح السرد بذلك، على ذكر بعض الأسماء التي لمع ذكرها في سناء الحقل الأدبي المنعوث بالنزعة الزنجية، مثلا: فريديريك دوغلاس، جيمس بالدوين {القدماء}، توني موريسون، مايا أنجلو {المعاصرون}. ويهتزّ حقا عرش الحرف عند الحديث بيانا أو استبيانا على اسم فريديريك دوغلاس الروائي القدير الذي جسّرت كتاباته قنطرة ممدودة لانعتاق السود من أسر العبودية والمضي صوب الحرية، حتى نُعت بالوجه المقلق.
لهذه الأسباب وغيرها قد تحرّج الدكتور كراوفورد من حضور شخص جمال براون، الطالب المبدع، فحار أمره واستدمت نرجسيته، معربا ضعفه الأكاديمي في القول التالي: «كيف لمراهق زنجي ينحدر من فضلات الأحياء الهامشية ومولوع بلعب كرة السلة، أن يكتب مثل هذا الكلام؟
قد لا تتعثر جوارح الناقد في الالتفاتة إلى نغم موسيقى «الجاز» الطافحة على جلّ المشاهد الفيلمية خاصة تلك التي تخيط السرد بالصورة. هكذا وبدون مبرر لا مبرر له، أحب المخرج توظيف هذا الجنس من الطرب، من أجل إحياء مكانة أقلية السود داخل نبض المجتمع الأمريكي، فحسّن المراد وتوطن الإيقاع الموسيقي في صلب الابداع الأدبي.
أنثى تصادق الجمر
يُقحم السيناريست بقدارة وقصدية شخصية صديقة جمال براون في خط القصة الرئيسي، ويكون لحضورها بالغ الإفادة في لحظة التنوير. إن طبيعة العلاقة التي جمعت بين شخصية «جمال والاس» وصديقته، تعدّت حدود الوصال والارتباط العاطفي، لتذيب سعرات العنصرية التي كان يعاني منها جمال براون، فعندما وجد نفسه محط قبول من طرف فتاة بيضاء البشرة {تنتمي إلى المعسكر الآخر}، أفضى به الأمر إلى تلمّس طريقا ثالثا يسمح له بتطبيب ذلك الجرح الوجودي الذي نُحث وبإيغال فوق صدور أقلية السود.
بل يبشرنا هذا الحضور الأنثوي بإمكانية التحرر من عقدة النقص {تلك المتعلقة بجمال براون وبشرته السوداء}. حيث قوت نفسيته ومكّنته من مطاردة حُلمه حتى يصبح روائيا، بدل السجود للواقع والبكاء على الأطلال، ولو أن مفعول هذا التأثير قد مرّ بشكل ضمني غير مصرح به. وهكذا تضاعف الأنثى سحرها على المذكرن وتزكّي مكانتها في عالمه الفياض بالتحدي والإرادة والخوف من السقوط. إن هذا التأثير المشار إليه من طرف صديقته، قد لا يبدو كما أسلفنا الذكر واضحا بشكل جلي، لكنه مرّ بهدوء من تحت عدسة المخرج، إنه جبروت السر المنقول على نحو غريب لكن فعال ذات الحين.
صالة المحاضرة كمحكمة افتراضية
يتصدر المشهد الذي جاء على مشارف اختتام الفيلم موقعا استراتيجيا بامتياز، وذلك لسببين مرتبطين بالزمان والمكان. فمن حيث المكان نادرا ما نجد إخراجا متفنّن يُبدل فضاء فيزيقي – عيني بفضاء ايحائي – رمزي، ليتم الانتقال بوعي المشاهد من الممكن الفعلي إلى الممكن الإدراكي. نقصد في هذا النطاق ذلك المشهد الذي تحوّلت فيه قاعة المحاضرات إلى شبه محكمة يؤثث فضاءها جمهور عريض من الطلاب وقاضي غير نزيه {شخصية الدكتور كراوفورد} ومحامي مُؤمن بأن القضية التي جاء ليرافع عنها مكسوبة {شخصية الكاتب فورستر} ومتهم بريء ذات الحين من السرقة الأدبية حتى تثبت إدانته {شخصية جمال والاس}. ويعدّ هذا القلب للمواقع الذي ألبس هذه الشخصيات صور إمكانات أخرى من أروع ما جادت به الحبكة، فتحققت فكرة العدالة بماهيتها الفلسفية التي تُقيم حداّ بين المساواة والإنصاف.
لقد استل المخرج من الجمهور الحاضر والمشاهد أيضا تعاطفا مع شخصية جمال براون ذلك الطالب الذي يحلم أن يصير أديبا في المستقبل والذي تعرض لمضايقة شديدة تعرب بعقدة التجاوز من قبل الدكتور كراوفورد، عندما سولت له نفسه بأن يتهمه بالسرقة الأدبية بعد أن انتهى من تقديم مجهوده الفكري أمام الملأ. أما هذا الأخير فقد كان يعلم منذ أول لقاء له مع كراوفورد بأنه أمام آذان موقورة {الأب الحسود} لن تكلف نفسها عناء الإنصات وإنما تقتفي أي إحالة أو مرجع أو حتى تعبير غائر في لغة الأدب المنيعة على المتطفلين حتى يؤكد من خلالها تلك «البلاجيا» التي يمني به نفسه، وهنا يظهر ذلك الصد اللاشعوري الدفين والمدفوع بنزعة عرقية لا تتقبل إبداعا آتي من طرف السود.
فالمعتقد الراسخ عند نسبة عريضة من البيض هو كون السود لا يصلحون سوى لحمل الأثقال أو القيام بمهام عضلية ولذلك يتم توجيهم بشكل أو بأخر إلى الألعاب الأولمبية وغيرها أما تلك المهام الفكرية فهم مستبعدون منها إلا من شاء رب الجميع. لنقل إنها سياسة إعادة الإنتاج كما يبرز مفعولها مبحث السوسيولوجيا.
من هذا المعبر الذي شكّل ذيل القصة، يمكننا أن نمرّ إلى السبب الثاني المتعلق بالزمان. فكل من شاهد الفيلم قد تفاجئ من الظهور اللامرتقب لشخصية فورستر هذا الرجل خاصم الحياة الاجتماعية سنينا طويلة، أتى إلى قاعة المحاضرات داخل الكلية في منتهى أناقته ومزاجه الفكري الغني بغرض الدفاع عن جمال ولاس وتصويب مسار الحقيقة المنحرف. هذا العنصر المفاجئ/المحول سيغمر مدد الزمن الفيلمي في أواخره بعد أن ارتمت مخيلة المشاهد في توليف سيناريوهات مضرة نوعا معا بمستقبل قلم واعد.
وهو حضور لا يمس فقط جمال براون تلميذه العزيز والمقرب، وإنما يلبي أيضا حاجة لديه في البوح، إذ الكلام هو دوما بمثابة ولادة ثانية. لقد كان خطاب وليام فورستر الأخير بمثابة حجة الوداع حيث لم تمضي الكثير من الأيام على وفاته، مهديا شقته إلى جمال والاس. أما من حيث مضمون هذا الخطاب، فقد تحدث فيه عن دور ومكانة الأسرة في حياة الإنسان سواء أسرة تربطها قرابة دموية أو أسرة تجمعها علاقات إنسانية صادقة.
تأملات في الخطاب الأخير
أتيت هنا للحديث، لأن صديق قريب مني لم يستطع الحديث. فسؤل من طرف الدكتور كراوفورد، وهل والاس صديق لك؟ نعم كجواب، وبنبرة لا تخلو من صدق منبعث من أعماق ذاته ولسانه المبلوع في بئر الصمت. وبعدها استرسل في قول ما يلي: « خسران العائلة يدفعنا أن نجد عائلتنا، ليس ضروريا أن تكون من لحمنا ودمنا، ولكن العائلة التي يمكن أن تصبح من دمنا. ويجب أن تكون لدينا الحكمة لكي نتقبّل هذه العائلة الجديدة … ونجد أن المتمنيات التي كانت لدينا للأب الذي في وقت من الأيام كان يوجهنا، والأخ الذي كان دوما بقربنا «.
توقف الكلام وراحت عدسة المخرج تترحل بين الوجوه الحاضرة مع موسيقى معبرة عن مشاعرها الكتومة، كما لو أن مطمح استولاد بقايا القول قد فضل المخرج أن يمنح إياها للجمهور الذي تورط وجدانيا في عمق الحدث. يستنتج من مضمون هذا الخطاب الكثير من الأشياء، لعل أهمها ذكرا حالة الفراغ الداخلي الذي يعيشه فورستر بعد افتقاد أسرته وحياته السابقة في نفس الشقة التي عاد ليسكن فيها وأيضا انتهاء مشواره كروائي محترف. هذه الصدمة التي أصبح يعيشها فورستر على نحو لاشعوري كانت غير قابلة للتخطي إلا بفضل علاقته الحميدة مع جمال بروان الذي منحه طاقة إيجابية من أجل تجاوز ما يتعبه صباح مساء، فالذكريات التي لا تموت تميت كما يقول المثل.
تلك هي المحصلة التي ختم بها الفيلم، وفعلا لقد ممكننا هذا المنتوج السينمائي الراقي من استذواق طعم آخر للإنسانية بدون توابل حتى. فوحدها الحالات القصوى من تجمع في مبيضها: الفشل والنجاح / الاستسلام والطموح / النفور والشغف / التيه وتحديد الهدف / الصمت والكلام / الحياة والانتحار / الرغبة والاستكشاف / الصمود والزوال. تقلبات يختبرها بحساسية مفرطة هذا الفيلم الى آخر رمق.
*ناقد سينمائي من المغرب