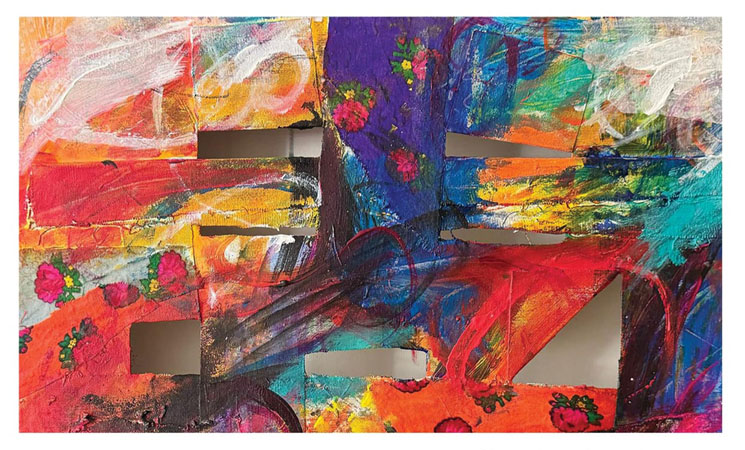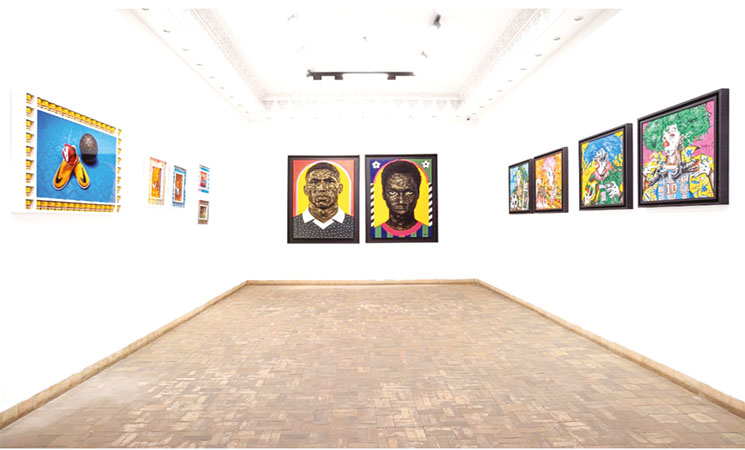يعود بنا فيلم «الخندق الأبدي» (la Trinchera infinita)، االذي تعرضه شبكة نيتفليكس، إلى بدايات الانقلاب العسكري 1936، الذي قاده الجنرال فرانكو ضد الحكومة الاشتراكية المنتخبة، مطلقًا بذلك شرارة الحرب الأهلية الإسبانية 1936 ـ 1939، التي تمخضت وقائعها الدموية عن سقوط ما يقارب النصف مليون ضحية من أنصار الطرفين المتخاصمين الجمهوريين والملكيين.
يقدر بأن نصف هذا العدد قد سقط في المعسكر الجمهوري (سكان قرى وبلدات ومدن) بفعل سياسة الإرهاب التي أتبعها فرانكو، والتي جاءت على شكل إعدامات ميدانية لكل من تم الاشتباه بمناصرته للجمهورية الإسبانية الوليدة، بغض النظر عن انخراطه بأية أعمال عنف ضد الطرف الآخر. الأمر الذي يفسر العدد الكبير من المقابر الجماعية (2500 مجزرة جماعية)، واضطرار من تسنى له الإفلات من قبضته الدموية، للعيش تحت الأرض في مخابئ أقرب ما تكون للجحور، ناهيك عن المشاعر الحافة بها من عزلة وعتمة وخوف.
يضعنا فيلم «الخندق الأبدي» منذ لحظاته الأولى أمام محنة معاينة المرء لفشله في التعويل على البراءة، براءته من إذلال الخصوم أو العصف بحياتهم، ليضمن لنفسه النجاة في زمن فرانكو الذي لا يقيم اعتبارًا لمبادئ العدالة التي تضع حدًّا بينا بين البريء والمذنب. يعول هيغينيو (Antoio de la Torre) على البراءة فيما تعول زوجته روزا (Belen Cusesta) على الحذر.
في النهاية، لا يجد أمامه من مفر لتهدئة مخاوف زوجته الشابة سوى الرضوخ لرغبتها في مباشرة ملجأ حماية مؤقت على طول أحد جدران المطبخ.
حين أذعن هيغينيو لتوسلات زوجته، في النزول إلى عمق الجحر، لم يكن يتوقع أن يكون أسيرًا لهذا الأخدود الترابي أبد الدهر، إذ طالما تعامل معه على أنه نزل مؤقت لحالة طارئة. لذا نراه يسارع لمغادرة تلك الحفرة الوضيعة عند بزوغ أول بارقة أمل بالهروب، ربما كي لا يعتادها فتصير مدفنه الوحشي إلى الأبد. يحسم هيغينيو جداله مع روزا في صعوده إلى الجبال حيث امتزاج رائحة العشب مع صهيل الحياة. ما إن يخطو خارج البيت حتى تصطاده اليد الحقادة لجاره غنزالو. يتعاركان، يسقط، ثم ينهض ليجد نفسه في مواجهة بارود العسكر. في السيارة العسكرية يلوح في ناظريه مشهد الجنود وهم يصوبون إلى قلبه فتنهض فيه رغبة الحياة. يقفز من السيارة العسكرية، يتدحرج على الأرض، يركض بين حبال الرصاص، يركض ويركض لينجو صاعدًا إلى فضاء البرية. في بئر القرية المهجور يأتي الموت على شكل أصوات رجال حقادين، يموت من تقاسم معهم توًّا لفافة التبغ اليتيمة، أما هو فينجو ليواصل عودته إلى الجحر الذي قد ظن أنه تخلص من ثقله للأبد.
في إحدى الفواصل التي اتبعها مخرجو الفيلم كتحقيب لحياة هيغينيو في معزله الجديد في بيت والده، مالوا لمقاربة الحبس من جهة القسر «الحبس هو وضع شخص أو حيوان في مكان لا يمكنه تركه». الحبس وفق ذلك التصور نجده في عزلة الكائن عن المحيط، فالأصل في كل حبس عزلتان؛ عزلة الكائن الحبيس عن المحيط الاجتماعي الذي يتنمي له، وعزلته عن المكان الذي يعيش فيه. في حين ينجح هيغينيو في كسر عزلته عن المكان الذي عاش فيه، تارة عبر تأثيثه الدائم (الإضاءة، السرير، الرفوف) وتارة أخرى عبر توسيعه، فإنه يعجز عن كسر عزلته الاجتماعية عن الناس الذي يقيمون خارجه. يكتشف هيغينيو أنه أمضى وقتًا طويلًا من حياته وهو يعيش على حافة العالم، يسترق السمع والنظر إلى ما يفعله الناس في عالمهم الواقعي ويعجز عن المشاركة فيه.
واحدة من الحالات الشعورية المرافقة للحبس هي إحساس الحبيس الغامر في العجز عن الفعل، سواء لناحية قدرة تأثيره الإيجابي في حياة الناس الذين يتكفلون له بالحماية، أو لناحية رد الأذى عنهم. إن حياة المحبوس أو السجين الذي يتواصل مع العالم عبر الثقوب والشقوق عرضة دومًا للعطب العاطفي. يتمثل العطب الأول على شكل تبكيت ضمير دائم مرده العجز عن الفعل، فيما يتمثل العطب الآخر في الخوف المستطير من كشف نفسه للناس وتعريضها للخطر.
في المعزل، تتراجع كل الأسئلة ويتقدم سؤال الوجود، ما معنى أن يكون الإنسان موجودًا؟ ثم ما علاقة العجز بالوجود؟ أما بلغة وحاجات روزا، ما الفائدة من وجود هيغينيو، إذ لم يكن أبأ أو زوجًا أو صديقًا؟ ما الفائدة من رجل غير قادر على حماية زوجته من فعل التحرش الجنسي، الذي يباشره رجل آخر، هو رودريغو، على مرمى حجر؟ ما الفائدة من عدم قدرته على أن يكون أبًا؟ ثم ما هذا الوجود الضاغط لهيغينيو الذي إذا ما قرر أن يحضرفي حياة زوجته، لا خيار أمامه من الحضور إلا على شكل جريمة؟
ساهم الإخراج الجماعي لكل من: جون جارانو، آيتور أريجي، خوسيه ماري جويناجا.. في رفع سوية الفيلم فنيًّا وجماهيريًا، فقد حصد الفيلم عند عرضه في أيلول/سبتمبر 2019 في مهرجانSan Sebastian الدولي، جائزة الدرع الفضي لأحسن إخراج، كما جائزة لجنة التحكيم لأحسن سيناريو لـ Jose mari Goenaga وBerdejo Luiso. فيما حصد الفليم نجاحًا جماهريًا باهرًا، حيث بلغت إيرادته في شباك التذاكر ما يقارب المليار ونصف دولار أمريكي خلال ستة أشهر من عرضه في صالات السينما.
إذا قدّر لنا البحث في العزاءات التي شدت من أزر روزا لتحمل عبء حياة زوجها التي لا تطاق في السرداب، لوجدناها في الحب، فلولا الحب الذي تكنه المرأة لرجلها لما تحملت وجوده مع سطل الغائط ساعة واحدة. لكن ماذا نقول عن العطب الذي لحق بحبهما على مرور الزمن. ألا يصاب الحب بدوره في العطب ليصير نوعًا من التعاطف الآدمي، الذي لا يخرج عن رضانا العام بالعيش مع شخص عاجز عن حماية نفسه أو رعايتها؟
يمنحنا العزاء الطاقة الروحية لمواصلة كفاحنا الضاري ضد التحديات التي تقف بطريقنا. لكن أي عزاء للإنسان في محنة تثبته بالعيش بالحياة بأي ثمن، حتى لوكان ذلك الثمن يتضمن تخفيضًا لوجده البشري إلى مستوى الحيوان؟ أيعقل أن يتعلق الأمر بالشجاعة؟ هل كان هيغينيو شجاعًا حقًا؟ ألا تقضتي الشجاعة المسارعة بالانتحار حفاظًا على قيمة الوجود الإنساني؟ إذا كانت عزاءات هيغينيو لا تكمن في الشجاعة ولا في الرغبة بحصد الاعتراف من الآخرين، فأين كمنت إذًا؟ ألا يعقل أن تكون في التسليم بعدم قدرته على المواجهة؟ فعندما يواجه الإنسان بما يتحدى قدرته على التغيير، فإنه يميل للتسليم بشروط الواقع. أليست الحياة في جزء كبير منها خضوعًا لمبدأ الضرورة القاهر؟
على السطح، يبدو الفيلم نوعًا من إعادة تذكير الناس بكم الألم التي تسبّب به الحكم الفاشي، لأناس الخلد بخاصة، وللإسبان بعامة، إذ ما من قسوة تعادل القسوة التي يتسبب بها أناس لأناس آخرين عبر دفعهم للعيش على حافة العالم، حيث العدم يتغذى من الوجود البشري العالق في المستوى البيولوجي.
في العمق، الفيلم إدانة غير مباشرة لأتباع النظام الفاشي الذي سلموا لفرانكو بدور القائد أو المنقذ، فيما لم يتعد دوره برأي روزا دور المهرج. فما الذي جعل من فرانكو المهرج قائدًا ومن هيغينيو الطيب مجرمًا؟ أليس لاستئناس الأول في الاحتكام للسلاح لتسوية المسألة، وإصرار الثاني للإنصات لصوت القلب والعقل في صيانة كرامة الكائن البشري؟
فيلم «الخندق الأبدي».. العيش على حافة العالم

الكاتب : مصلح مصلح
بتاريخ : 06/03/2021