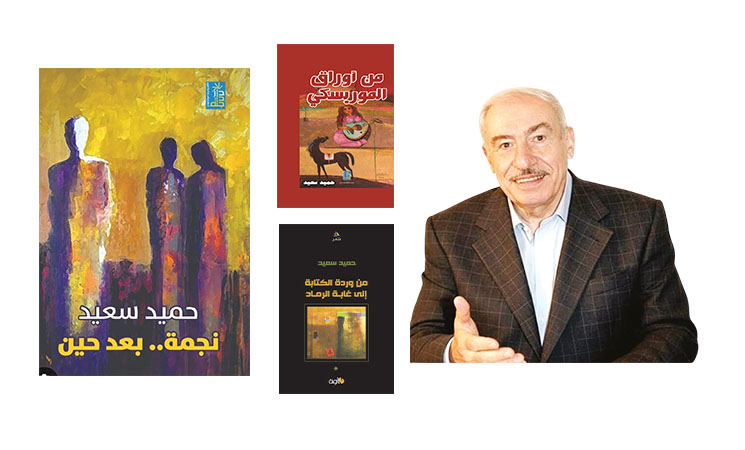شاعر يعيد صوغ الكلمات على إيقاع الدهشة الدائمة، يصر في كل محطة من سفره نحو اللامدرك الى الغوص في دغل الأسئلة الملحة ، حيث لا جواب نهائي تمنحه القصيدة… كل أسباب الجمال ذريعته لاقتراف الشعر هو المؤمن بأن لا ظهير للشاعر إلا نصه الذي يبقى ويواجه به الزمن لاحقا..إنه الشاعر اللبناني شوقي بزيع ابن الجنوب الذي رددنا قصائده مغناة بصوت مارسيل خليفة وحملنا بنادقنا في الحناجر صوب «جبل الباروك». تجربة شعرية امتدت لأربعين سنة أصدر من خلالها 19ديوانا منذ «عناوين سريعة لوطن مقنول» في 1978»وكأني غريبك بين النساء»، «سراب المثنى»، «أغنيات على نهر الليطاني»، «فراشات لابتسامة بوذا»، «وردة الندم»، «قمصان يوسف»، «مرثية الغبار»، ..وانتهاء بـ»الحياة كما لم تحدث». أربعون سنة وهو يقيم جمهورية على ضفاف الدهشة ويحصنها بلغة شفيفة قابلة للانفجار كلما نضجت أكثر، كفتنة أنثى في عين شاعر. عن الحب والحياة والأمكنة والشعر وممكنات الحياة الأخرى التي يقترحها ، هذا الحوار.
– المتابع لتجربتك الشعرية في بدايتها، يلاحظ أنها حملت نفسا ملحميا وثوريا ينتصر للهوية ولمقاومة النسيان والانمحاء، هل تنهك الأيديولوجيا روح الشعر وتفقده بعضا من حريته؟
– هذا الموضوع شائك ومطروح بكثرة على الشعراء والمبدعين.علاقة الشعر بالإيديولوجيا هي علاقة مركبة وملتبسة وغالبا ما تتم على حساب أحدهما وهو الشعر لأنه الطرف الخاسر في هذه العلاقة، بمعنى أن الإيديولوجيا لايضيرها أن تدعي امتلاك الحقيقة وأن تكون نهائية، وتتشبث باليقين من زاويتها، وأن تنبذ الأيديولوجيات الأخرى النقيضة . أما الشعر فهو رديف النقصان، ورديف الأسئلة لا الأجوبة ..هو الباحث أبدا عن حقيقة لا تكتمل. فمهما أوتي للشاعر أن يصدر من مجموعات، سيظل يشعر أن الحقيقة الفنية غائبة ، ولن يحل هذه العلاقة بينها وبينه إلا الموت. الشاعر لا يقول كلمته النهائية ولن يقولها أبدا. في ما يخص تجربتي الشخصية، كنت دائما عرضة لتجاذب بين انحيازي للنص الإبداعي الذي يعصى على التوظيف من قبل أية عقيدة أو حزب أو إيديولوجيا ولا يراهن إلا على شروطه الجمالية والإبداعية ، ومن جهة أخرى كنت أجد نفسي مطالبا، بحكم انتمائي السياسي إلى اليسار الماركسي، بكتابة قصائد تسهم في التغيير . لكن هذا لم يجعلني أنحاز الى القصيدة المباشرة التي تتسلق القضايا الكبرى والتي تعيش على الشعارات. كنت أحاول أن أقيم توازنا بين متطلبات الفن والبعد الجمالي في الكتابة وبين قضايا الناس كالمقاومة والحرية. وهذا التمزق بدا واضحا حينها من خلال الخيارين اللذين ظلا يتجاذبانني باستمرار: من جهة كوني تتلمذت على يد شعراء الحداثة الكبار كأدونيس، يمنى العيد، خليل حاوي، أنطون كرم وغيرهم، ومن جهة ثانية كان النموذج، و الذي حوله اليسار العربي آنذاك الى أيقونة، هو كتابات أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام قبل ظهور الفنان مارسيل خليفة. حاولت إذن أن أوفق بين التيارين وهو ما يبدو في مجموعاتي الثلاث الأولى.
في الواقع انحزت الى قصيدتي ولمعنى الكتابة بالذات، واستقلت من العمل السياسي مع الحفاظ على انتمائي اليساري بوجه عام ومازلت كذلك. المشكل يكمن في طريقة توظيف قيم اليسار داخل القصيدة، والتي حاول البعض أن يختزلها في مجرد هتافات أو شعارات سياسية فجة. بعد ذلك نحت تجربتي منحى مختلفا خاصة مع ديواني الخامس «مرثية الغبار» وحتى اليوم ، وهذا لا يعني إطلاقا أنني لم أعد الى كتابة قصائد متصلة بالحياة والأرض، لكن طريقة المقاربة فقط هي التي اختلفت.
– تحتفي قصائد الشاعر شوقي بزيع بعوالم شتى تمتد من العاطفة الى التاريخ والأمكنة المثقلة بالذكرى. من أين تستمد كل هذا الغنى والانفتاح في تجربتك؟
– إذا اعتبرنا الموهبة أمرا بديهيا بالنسبة لأي شاعر، فإن ما يعمقها هو التجربة والكدح اليومي والاطلاع والثقافة ومتابعة ما يجري، ليس على مستوى الشعر فحسب، بل ما يستجد على مستوى النقد والفلسفة والتاريخ والاجتماع، وأنا من الذين وهبوا للقراءة والكتابة كل حياتهم، إذ تركت الوظيفة في سن الثلاثين وتفرغت للكتابة فقط. لم أرد أن أستنزف نفسي في الوظيفة وهو نفس القرار الذي اتخذته بعد الالتزام مع بعض الجرائد كالسفير اللبنانية مثلا، وهذا التفرغ التام للكتابة هو ما جعلني أيضا أؤجل الزواج الى سن الخمسين، لكن ما اكتشفته كان مفارقا حقا، فشعري بعد الزواج نحا باتجاه التأمل أكثر في الأشياء والكشوف الداخلية وطرح الأسئلة الوجودية دون التخلي عن ماء الشعر وغنائيته التي أصبحت أكثر درامية وأكثر تركيبية عن ذي قبل، ولم يعد فيها ذلك الصوت العالي والعاطفة السيالة أو الإنشاء الرخو، بل ظلت محافظة على انسيابيتها من دون أن تفقد ثقلها المعرفي الذي يتطلبه النص الشعري. على امتداد مساري كان لدي هاجس دائم لتطوير نصي وتجربتي، وهو ما لفت إليه أكثر من ناقد ممن اعتبروا أن كل مجموعة لي تمثل إضافة لما قبلها من حيث المقاربات. فـ»مرثية الغبار» تختلف عن «قمصان يوسف» وعن «سراب المثنى» الذي يختلف بدوره عن «صراخ الأشجار» وعن عملي الأخير «الحياة كما لم تحدث».
– لامست في تجربتك الشعرية العديد من الإشكالات وعبرت عن عديد من الهواجس من زوايا نظر مختلفة، مالذي تحكم في هذه الانتقالات، أسلوبا ورؤية، هل هي الرغبة في تجديد المسار أو هي مراجعة واعية تحتكم الى معطيات الواقع وتحولاته؟
– لا شك أن الأمرين معا قائمان. فكل شاعر يشعر بأنه يأنس الى ما كتبه وينام على حرير ما أنجزه، أعتقد أنه يحكم على نفسه بالنهاية. الإنسان كائن ملول، ضجِر ويرغب دائما في اكتشاف الجديد والمختلف، والشعر بمعنى من المعاني هو سفر آخر، سفر في الداخل وهنا تحضرني قصيدة الشاعر خليل حاوي «رحلة السندباد الثامنة» التي بنيت على كون السندباد قام بسبع رحلات الى بلدان مختلفة، لكن رحلته الى دواخل نفسه كانت الأغرب من بين كل رحلاته. وهذا يفسر شغف البشر بالسفر لأن السفر جسد آخر للحياة، وهو الإقامة في حياة موازية ومضغوطة ومكثفة ومليئة بالمفاجآت قبل أن نعود الى أماكننا الأصلية والمألوفة.
ما ساعدني على هذه التحولات، والتي لم تتم بشكل أتوماتيكي ، هو إيماني بأن الرغبة وحدها لا تكفي لتطوير التجربة. فمعظم الشعراء لديهم هذه الرغبة ولديهم «نوايا حسنة» تجاه الشعر، لكن النوايا لا تكفي وحدها بل تحتاج الى طاقات حقيقية لتجاوز التجارب السابقة. بالنسبة لي ، كنت بين كل مجموعة وأخرى، ألوذ بصمت قد يستغرق سنتين الى ثلاث، وقد استغرق هذا الصمت خمس سنوات في أواسط الثمانينات بين مجموعتي «أغنيات حب على نهر الليطاني» و»ووردة الندم». فأنا أقضي سنوات في التأمل والتقصي وفي انتظار هبوب رياح جديدة وطازجة لكي تنقلني إلى عوالمها اللغوية المختلفة.كنت كلما أصبت بنوبة الصمت هاته، أشعر أنني على وشك النفاد وبأنني أعاني بشكل أو بآخر من أعراض «السكتة الشعرية». لكن بعد مرور سنتين أشعر بالأعراض التي يعيشها الكتاب والمبدعون والتي تضغط عليهم بشكل استثنائي. وحين أعود الى الكتابة، لا أكتب قصيدة أو اثنتين بل مجموعة كاملة أو نصف مجموعة، أي كل ما خزنته في داخلي يعبر عن نفسه، ويأتي ضمن لحظات الانخطاف التي أكابدها في تلك الفترة.
– يلاحظ المتتبع لتجربتك الشعرية، تراجع حضور الأنثى داخل قصائدك الأخيرة والتي كانت تضج بفتنة الأنوثة. فهل تصدق امرأة زعم شاعر على حد قولك في إحدى قصائدك؟
– هذه ملاحظة صحيحة. بعد زواجي تحديدا تراجع منسوب قصيدة الحب عندي، وهذا أمر طبيعي لأن الزواج حالة نثرية باعتبار انه يمتد على امتداد العمر ويغطي مساحة الحياة، فهو زمن البطء في الحياة وزمن الاستكانة بينما الذي يدفع الى الكتابة هو الحب، والذي هو زمن المكثف والاشتعال والرغبات المشبوبة، وهذا لا يلغي ما قلته عن تأنيث الكتابة. فاللغة في حد ذاتها تأنيث للعالم لأنها تكتب على موجة خاصة من الشفافية ومن المشاعر المرهفة وهذا ما يفسر قولة « الشعراء إناث قومهم» بالمعنى الرمزي للكلمة.
القارئ لمجموعاتي الأخيرة، يلاحظ استدعاء الأنوثة الكونية، ليس من خلال علاقة حب، لكنه استدعاء موجود في ظلال الأشياء وفي خلفية الكتابة ونسيجها.هناك قصائد عن نساء ماضيات وعن أحوال الأنوثة تطل بشكل واضح أحيانا، لكنني أعتقد أن الكتابة في حد ذاتها هي فعل حب ولو اتخذت تجليات أخرى. في نهاية المطاف إذا لم نعشق اللغة التي نكتب بها، إذا لم نعشق العالم الذي نتوجه إليه وكذا الأشياء، فلا قيمة لما نكتبه. فعندما كتبت عن الأشجار في ديواني «صراخ الأشجار»، لم أستطع الكتابة عنها إلا حينما أنّثْتُها، وبدت جزءا من أحوال أنثوية. أنا كائن ممسوس بالأنوثة، أحتفل بها كوجود مباشر من خلال هذا الجانب البلوري والمتوهج من الأشياء والذي يعوض، الى حد بعيد ،عن قسوة الذكورة وفظاظتها.
– في ديوانك الأخير «الحياة كما لم تحدث» يكتشف القارئ أن هناك حيوات أخرى وفي أماكن أخرى بما يشبه تعويضا عن خسارات الحياة الواقعية. فهل تكفي هذه الحيوات الموازية لتنسينا مرارة الواقع؟
– نحن دائما نبحث عن عزاء، عن كائنات محكومة بفظاعة الموت وهذا الإحساس الدائم بالخسران والرحيل، ونعرف أن وجودنا على الأرض مؤقت وقد لا يذكرنا أحد بعد فترة من غيابنا. يبدو أننا نحاول أن نمتلك أسلحة بديلة أو نبحث عنها لتساعدنا على قهر فكرة العدم والتلاشي. ومن ضمن هذه الأسلحة، اللغة ، بفتنتها وغوايتها الرائعة وبأرضها المليئة بالكشوف وذلك رغم معرفتنا بأنها سلاح هش ورغم عدم يقيننا بأنها ستكون دليلنا الى الخلود. فمن أصل ألف شاعر، قد يخلد اسم واحد فقط كما قال إ.س.إليوت في كتابه «الشعر والشعراء». فعندما ننظر الى الوراء، نجد غابة من الأسماء، لكن ما يبقى موشوما اسم أو اثنان .
أيضا يبدو أن المسألة مرتبطة بإرضاء أنفسنا وتزجية الحياة، بمحاولة التلهي عن فكرة الموت وذلك بخلق آخر وبإقامة حياة موازية وهو ما قصدته في ديواني الأخير «الحياة كما لم تحدث». فالفن والشعر يجسدان فكرة هذه الحياة التي لم تحدث، لأن الحياة التي حدث هي النثر والنثر العادي تحديدا ولأن كل ماهو ممتلَك لا يعول عليه إذا حوّرنا مقولة الغزالي عن الأنوثة. ولأن الشعر رديف غير الممتلَك وغير المستحيل وغير المتاح، فإنه يعطينا هذا الإحساس الدائم بالعيش في عالم افتراضي، فالعلاقات الافتراضية اليوم هي جزء من هذه الحيوات الموازية.
أعتبر شخصيا أن الشاعر المحظوظ هو الذي باستطاعته العثور على فكرة تتمم مشروعه الشعري والفكري، والذي لا يقف أمام طريق مسدود في الكتابة. فأصعب شيء على الشاعر هو أن يخلد الى الصمت لأنه نوع من الموت المبكر بل أقسى أشكال الموت. إنه موت نتعايش معه، نراه ونختبره بمرارة شديدة تجعلنا نشعر بالعقم وباننا كائنات منتهية بخلاف الموت البيولوجي الذي يبقى أقل وطأة. علينا إذن ألا ندع فكرة الموت تخرب علينا هذه الفسحة القصيرة التي اسمها الحياة.
– كيف ترى اليوم المشهد الشعري العربي والمغربي؟
– هذا سؤال تصعب الإجابة عنه، فالأسئلة العامة لا تتيح أجوبة موضوعية ودقيقة كما أن الإجابة تتطلب عملا نقديا واسعا وإلا فإننا نقدم انطباعات فقط. الحديث عن أزمة الشعر اليوم هي من صميم وجوده . فكثيرا ما قلت إن أزمة الشعر هي ألا تكون هناك أزمة. الشعر بالنسبة لي هو إحدى علامات الأزمات في العالم لأنه يقوم عليها: الأزمة بين الانسان و محيطة، بينه وبين ذاته ، بينه وبين الحياة نفسها. إذا لم يكن هناك خلل في العالم، فلا أعتقد أن هناك ضرورة للشعر. الأزمة جزء جوهري من عملية الخلق الشعري، وعدم الشعور بها هو الركون الى الحقيقة واليقين فيما الشعر جوهره عدم الركون الى اليقين الذي ينذر بنهاية الشاعر. الشعر يمنع تسلل الضجر والترهل الى الحياة، وكم هو جميل أن تظل الحياة في عملية غليان دائم.
بالنسبة للمشهد الشعري العربي ، أنا من الذين يمتلكون تصورا متفائلا بشكل عام عن حالة الشعر بالعالم العربي، فالشعر لن يموت مادام الانسان موجودا. كل الأشياء لم تُحَل، كل الإشكاليات القائمة والتي لم تجد لها حلا في الواقع، ستصبح شأنا لغويا. فرغم كل الرفاهية والتطور العلمي، إلا أن الإنسانية في أزمة تتفاقم يوما بعد يوم. وهذا الجحيم الذي يكون كامنا في الحالات العادية وفي حالات الجهل، يصعد الى مستوياته العليا حين يقترن بهذا الكم الهائل من المعرفة الإنسانية، حيث الإنسان يتعرض لضغوط هائلة. وأمام هذه التحديات والحروب والتعقيدات، فإن الإنسانية لن تجد ما يضاهي الشعر للتعبير عن نفسها لأن كل الفنون الأخرى التي تدعي أنها ترث هذا «الأب المريض» هي فعلا تعيس حالة فرويدية بامتياز، لأنها فيما تسعى وتحاول قتل الشعر لترثه، فهي تتقمصه في الآن ذاته بالكامل، إذ لا رواية ولا منحوتة ولا لوحة بدون شعر. فالشعر حالة وليس وجودا لغويا فقط. هوموجود في ثنايا الأشياء وفي روح العالم وعلاقة التناغم الكونية. قد يأخذ أحيانا استراحات. قد يتراجع هنا ويتقدم هناك. قد يتحول الى أشكال أخرى ولكنه باق .
اليوم في العالم العربي نجد تجارب لأجيال وحساسيات جديدة هامة تقطع مع كل الذين كانوا يروجون لسيادة قصيدة النثر وإلغائها لكل الأنماط الشعرية السابقة. نلاحظ اليوم عودة القصيدة العمودية وتعايشا بين كل الأشكالن ما يعني أن الأساليب تَضمُر أحيانا وتخفت في وقت آخر كما الأزياء تماما ، لكنها تعود الى الانبثاق من جديد. هناك إذن شيء من العود الأبدي في هذه الحياة.
اليوم في المغرب العربي وفي المشرق، نرى تجارب واقتراحات جديدة على الكتابة، ربما هذه التجارب تحاول الابتعاد عن القضايا الكبرى وعن اللغة الملحمية مقابل الاقتراب من ملحمة اليومي والتفصيلي والمسكوت عنه والمهمش، وهذا كله يغني الكتابة ويطرح علينا نحن المخضرمين تحديات من أجل تطوير تجربتنا. وأعتقد أن أي شاعر مخضرم لا يصغي الى الأصوات الجديدة، ستصاب تجربته بالوهن وفقر الدم.
– الجوائز الأدبية اليوم في العالم العربي ظاهرة لافتة. ورغم أهميتها إلا أنها قد تفقد الأدب قيمته إذا لم تستند الى معايير موضوعية. كيف تنظر أنت الشاعر المتوج لعدة مرات، الى هذا المعطى؟
– لقد كتبت كثيرا عن هذا الموضوع وقلت إن الجوائز ليست المعيار الوحيد والأهم لتحديد قيمة الشعراء الفعلية، وهذا لا يعني تنكرا للجوائز أو رفضا لها ، ولكن يعني ألا ننتظرها وألا نكتب تحت وطأة هذا الهاجس كما يحدث اليوم في العالم العربي مع الشعراء الذين اتجهوا إلى كتابة الرواية تحت هاجس الجوائز، وهذا لا ينسحب طبعا على الجميع لأن هناك كتابا يملكون الموهبتين معا، مع أنني ممن يؤثرون الوفاء لنوع أدبي والذهاب به الى مداه لأن الحياة أقصر من أن توزع بين نوعين من الفنون، فكل فن يحتاج الى حيوات كثيرة لكي نذهب به الى النهاية لأنه يقوم على مجموعة من المفارقات والمصادفات اللغوية التي لا تنتهي.
إننا رغم كل هذا الإرث الذي نقف عليه لقرون، نكتشف أننا ما زلنا عاجزين عن إدراك كنه الشعر والوصول الى ضفافه الأخيرة. المسألة تتعلق بكون هيئات حكومية وغير حكومية تنشئ جوائز لتكريم الشعراء وهذا لا يضير في شيء، لكن بشرط ألا نقع في فخ الكتابة تحت الطلب أو المساومة على المبادئ. وفي الأخير على من يفوز بهذه الجوائز ألا ينتشي كثيرا بها وإلا ستصبح هذه الجوائز مقبرته. كما أن عدم الحصول على جائزة لا ينتقص من قيمة الكتاب وخير دليل أن هناك أسماء نالت جائزة نوبل مثلا، لكنها أصبحت اليوم صارت غفلا في مسار الكتابة.