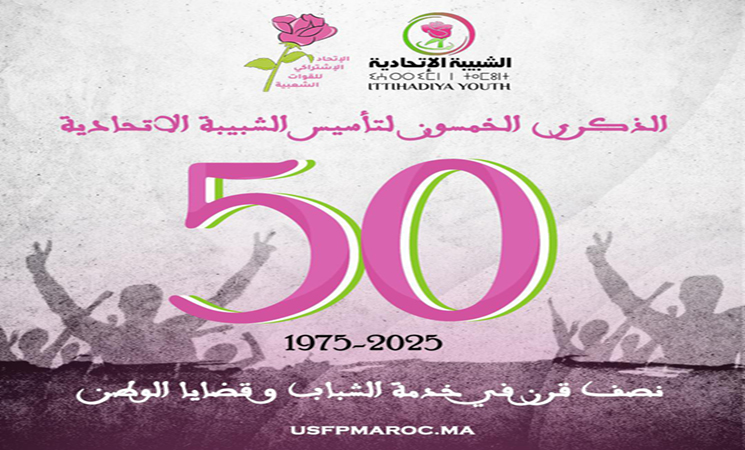– كيف يمكن للفلسفة أن تعيد صياغة مفهوم للسعادة في مواجهة اللامعنى؟
– يذكرني سؤالك هذا بما أورده «شوبنهاور» في كتابه الشهير» العالم كإرادة وتمثل « حيث يؤكد على أن كل وعي إنما هو وعي باﻷلم.وليس يخفى عليك بطبيعة الحال التمزق الذي عانى منه الرجل وهو يحاول أن يعثر لنفسه عن مخرج داركا على أن نفي إرادة الحياة يكاد يستحيل دون سلاح معرفي ناجع تغدو معه اﻹرادة واعية بذاتها قبل أن تسعى جاهدة إلى نفي ذاتها.وإذا كان وعي اﻹرادة بنظر «آرثر شوبنهاور» نتاج الفلسفة النظرية، فعملية النفي هي نتاج الفلسفة العملية. هاهنا على ما أظن نعثر على مفتاح فلسفة التفاؤل الذي توصل إليه فيلسوف متشائم،فاستطاع بفضله أن يحيا حياة سعيدة لم تخل في يوم من الأيام من الفرح والمتعة بالرغم من نفحة اليأس التي طالت تأملاته وسكنت جل خطاباته. فضلا عن طرح شوبنهاور السالف الذكر، يمكننا أيضا ردا على هذه المسألة، استعادة طروحات الرواقيين الذين كانوا يصرون على ضرورة اشتغال المرء على تمثلاته إن أراد أن يلوذ بحياة جميلة وهادئة.ذلك أن ما يزعج ليس هو اﻷحداث التي تطرأ لنا بل الطريقة التي بها نهيء أنفسنا لمواجهتها ؛ إذ والحالة هاته بدل «أن يحدونا نوع من الطموح الجارف الذي بموجبه نظل نرغب في أن تجري اﻷمور كما نشاء، وجب علينا باﻷحرى أن نقبل بها كما هي»
“ Ne demande jamais que les choses soient comme tu veux ,mais tâches seulement de les vouloir comme ellessont “
ذلك أن اﻷسوأ هو مجرد تمثل une représentation يمكننا القضاء عليه بفضل تمثلات أخرى ما إن تخلصنا من السلبي حتى تفضي بنا إلى ما يكون إيجابيا.لعل أهمية المعرفة باعتبارها اشتغالا دائما على تمثلاتنا بغاية تفكيكها والتمكن من فحواها تحديدا لكنهها وما تكون، قبل أن ننتقل إلى طرق التعامل معها وإيجاد آليات التصرف ضدها ، هو ما يدفعنا إلى التوكيد مرة أخرى، على ضرورة الفكر الفلسفي من حيث كونه سلاحا كفيلا بتشريح أمراض الذات وعذابات النفس .بديهي إذن أن يؤدي التفكير مثلا في الشيخوخة أو المرض والكتابة عنهما إلى التخفيف من حدتيهما والتلطيف من مفعوليهما بشكل ينقلبان فيه رأسا على عقب ليصبحا ممتعين بعد أن كانا مضجرين ومفيدين بعد أن كانا ضارين .علاوة عما سلف يتبدى أن اﻹنسان المعاصر،لا محيد له من استعادة الفلسفة الرواقية على سبيل الذكر لا الحصر، إن أراد أن يتخلص بهذا الشكل أو ذاك من عبء البؤس الذي ما فتئ ينخره لأنه بدونها لن يستطيع» أن يميز بين ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه» وسيظل يتخبط خبط عشواء كفريسة تنهشها قوى ميتافيزيقية سلبية. على هذا النحو يظهر أن السعادة ممكنة عمليا، خاصة إن تمكنا من تفعيل ترسانة من الرؤى والتمثلات على مقاس الرواقية أو اﻷبيقورية أو الكلبية أو غيرها من الفلسفات القديمة اﻷقرب إلى البراكسيس منه إلى التنظير. يكفينا والحالة هاته أن نستوعب على اﻷقل تصور السعادة في مستوياتها الدنيا باعتبارها غيابا للألم وتبديدا للخوف،لنؤكد على أن السعادة السلبية، إن جاز الوصف، ليست هي أن تعيش دون أن تخشى الموت أو يرهبك مآل الزوال المحتوم فحسب، بل هي أيضا أن تحيا دون مخافة المستقبل الذي يرعبك، ناسيا الماضي بذكرياته التعيسة .إلى هذا الحد يظهر على أن مواجهة «اللامعنى» كما تفضلت هو ما يقتضي منا أن نشتغل إذن على تمثلاتنا الخاطئة التي نتحكم فيها ذهنيا- تمثل الموت- وأن ندع جانبا كل ما لا نتحكم فيه؛ مادام أن ما يخيفنا ليس هو الموت بل هو باﻷحرى تصورنا للموت.
– ونحن نناقش «العيش بصحبة الفلسفة» في الوجود الأصيل (الوجود مع)، ألا يخلق العالم الافتراضي قلقا وجودياً بحيث أننا بشكل أو بآخر نعيش داخل التطبيقات؟
– إن الشاشة بشتى أصنافها وتلاوينها بدءا من التلفاز والهاتف وصولا إلى الحاسوب واللوحة والسينما، دائما ما تنجح وتفلح بسهولة خلافا للكتاب، في جذب الناس واستمالتهم بفضل حبكة الصور التي بقدر ما تخلق نوعا من الفرجة الممتعة لدى المشاهد بقدر ما تجعله في الآن ذاته، وهو تحت تأثير فيض زائد من النشوة، أكثر تشوقا ليحيا استيهامات و «فانطازمات» أبعد ما تكون عن الواقع.وها هنا ينكشف لنا أكثر من أي وقت مضى الوجه السلبي للشاشة التي كلما ازدادت استمالتها للناس كلما تمكنت من بسط سيطرتها على أذهانهم وتحكمت كليا في أحاسيسهم وعواطفهم وتلاعبت بعقولهم قبل أن تزج بهم في عالم وهمي يستقطب المتفرجين ويحولهم على وجه السرعة إلى عبيد مسلوبي اﻹرادة. وقد أضرب لك مثالا في هذا الصدد بفيلم يتناول سيرة «سارتر» و رفيقة دربه « سيمون دو بوفوار» بحيث أنني لاحظت كيف أصر المخرج على تقديم حياة الفيلسوفين بشكل مغر ومحبوك يشد المتفرج إلى سلسلة من المشاهد المتتالية قبل أن يغرقه في نشوة منقطعة النظير.نشوة بقدر ما تشعره بالمتعة والاستلذاذ بقدر ما تزج به في ردهات عالم وهمي ومزيف، مفارق تماما لما عاشه المعنيان حقيقة بعيدا عن اﻷدلجة ولعبة المونتاج. والظاهر أن ما حرص المخرج على تغييبه في هذا الفيلم من حقائق ووقائع أكبر بكثير مما عرضه، سعيا منه وهو اﻷهم إلى تجييش لا شعور المشاهد وزرع المزيد من اﻷوتان في ذهنه خاصة إذا كان المتفرج لا يقرأ السير الذاتية وغير مطلع على ما كتب في هذا الباب.وإذا علمنا أن المشاهد المدمن على الفرجة غالبا ما يكون كسولا وعاجزا عن بذل أدنى مجهود سواء بتفحصه للتاريخ الفعلي أو بنبشه في ما روي من سير، فلا بد له أن يغدو كبش فداء روح التنميط السائدة في العالم الافتراضي. تتجلى بشاعة هذا السطو التقني، من ناحية أخرى، في معدل منسوب القراءة الذي تقلص بشكل مذهل وبخاصة في العالم المتخلف حيث جرى التأكيد وفقا لإحصائيات تقرير منظمة اليونسكو لعام 2023، على أن ما يقرأه الطفل العربي يكاد لا يتجاوز سبع دقائق سنويا أي ربع صفحة بالتمام والكمال وهذا في أفضل اﻷحوال؛أما النتيجة الحتمية لذلك ،فيتبدى أن أثرها السلبي قد انعكس بشكل واضح سواء في أسلوب حياة البشر الذي تردى إلى درجة صار فيها التقتيل و العنف أمرا عاديا أو في طبيعة الأواصر الاجتماعية المسمومة و القائمة على النفاق اﻷخلاقي والنميمة وغيرها من العادات المنحرفة؛ بديهي إذن بعد تشخيصنا للمرض الذي مافتئ ينخر المجتمعات المعاصرة ، أن نقر سويا بمدى أهمية فعل القراءة لا باعتباره ما يؤسس للفضيلة والسعادة معرفيا كما كان يرى سقراط ( يقوم التفاؤل الثلاثي السقراطي على المعادلة الشهيرة التالية : المعرفة = الفضيلة= السعادة) فحسب بل أيضا باعتبار أن القراءة هي الحياة بحذافيرها lire c›est vivre كما لاحظ فيليب صولرز ذات مرة ( أنظر مقالي المترجم في حوار منشور سابقا مع فيليب صولرز )؛ذلك أن فعل القراءة هو الفن اﻷنجع إلى جانب فنون أخرى ،لبناء الذوات ونحتها بما يرقى بها إلى مستوى يؤهلها لمقاومة الرداءة واﻹنفلات من طغيان اﻹيديولوجيا. وعودة إلى موضوع حديثنا يمكنني التوكيد على أن هذا الفيلم للإشارة إذا كان يرمي إلى تقديم سارتر باعتباره بطلا وفيلسوفا اكتسب من الشهرة ما يكفيه للخلود، فالتاريخ المكتوب يروي عن سيرة رجل لا يستحق كل هذا التبجيل و التطبيل.حجتي في ذلك هي أن سارتر وبوفوار ما قبل الحرب العالمية الثانية ليس هو سارتر و بوفوار ما بعد الحرب؛بحيث أنهما لم ينشغلا إطلاقا كما يروج، بالسياسة قبل الحرب وظلا بعيدين عنها ils étaient apolitiques . وما إن تمكن الاحتلال من بسط نفوذه في كل البلاد، حتى تعاملا مع الوضع بانتهازية وقحة قبل أن يغتنما فرصة ما بعد الحرب، معلنان اصطفافهما إلى جانب الطغاة المناصرين لليسار. و توضيحا لما سلف يلزمنا التنبيه إلى أن الاثنين قد سافرا معا سنة 1937 إلى إيطاليا بتذاكر مخفضة الثمن مهداة من لدن موسولوني كما أن رائد الوجودية فضلا عن ذلك كله ، قد ساهم بمقالاته في مجلة كوميديا النازية مرتين اثنتين خلال عامي 1941 و1944 . هذا علما أن هذه المجلة ذاتها هي التي احتفت بسارتر كأفضل كاتب في عام 1943. ناهيك طبعا عن صفقة التوظيف التي تمت بإيعاز من مدير هذه المجلة و التي على إثرها اشتغلت سيمون دوبوفوار في راديو فيشي عام 1944. وعلى هذا النهج نلاحظ خلافا لما يعرضه الفيلم من ترهات تزييفا للحقائق، كيف استرسل الفيلسوفان في اقتناص الفرص واحدة تلو اﻷخرى إلى أن انتهت الحرب، فصارا يدافعان معا عن الغولاغ معلنان تأييدهما لكل اﻷنظمة الشيوعية بدءا من الاتحاد السوفياتي وانتهاء بـ»فيديل كاسترو»،مرورا بـ»كيم يونج الثاني» و»ماو سيتونغ»…وبهذا الشكل يتبدى لنا جليا كيف انتصر الكاتبان للأنظمة الديكتاتورية مؤيدين العنف كأداة بدعوى أن الغاية تبرر الوسيلة انسجاما مع النزعة الميكيافيلية.
– هل السعي نحو السعادة يمكن أن يتحول إلى عبء نفسي في ظل مجتمع الوفرة أي بدائل واختيارات لا نهائية للترويح؟
– ينبغي لنا أن نستوعب أولا بأن السعادة بقدر ما تتوقف على مدى فهمنا لذواتنا وللطبيعة والعالم الذي فيه نحيا بقدر ما يستعصي حصرها في أو ربطها ببدائل تدعي أنها تكفل للمرء الترويح عن النفس والعيش الجيد.مما يجعل مسألة السعادة ترتبط بنظري بنوعية الحياة التي نود أن نحياها وجماليتها أكثر مما ترتبط بطول العمر وعدد السنوات التي عشناها.يطغى سؤال الكيف هنا على سؤال الكم وتتفوق الحياة القائمة على الوجود عن الحياة القائمة على الامتلاك . إذ ما الجدوى من أن نحيا حياة مصطنعة ومزيفة عندما يكون بوسعنا أن نعيش حياة بسيطة وحقيقية ؟إننا في الوضعية اﻷولى إن كنا نعيش كعموم الناس متشبثين بأتفه الأشياء خاصة في مجتمع استهلاكي يجبرنا على العمل ليل نهار مستنفدين وقتنا كله في نشاط مأجور لا يفتأ ينخر قوانا، فنحن في الوضعية الثانية نولي اهتمامنا للأهم فحسب لنلوذ بما يكفينا من الوقت الممتع متحررين تماما من عبودية الوظيفة وإكراهات العمل. هكذا يتبدى لنا أن البون شاسع بين الطرفين أو النوعين من الحياة ولا يمكنك الانتقال من الحياة البئيسة لتلوذ بحياة فلسفية إلا بعد اشتغالك على تمثلاتك كما أسلفنا وتأسيسك لمنظور كفيل بأن يجعلك بعد فهمك لكل اﻹشكاليات المتعلقة بهذا اﻷمر، تنتقل إلى الوضعية الثانية حيث تستطيع» أن تستمتع بالأرض بدل أن تستهويك رغبة امتلاكها» على حد تعبير «هنري دافيد طورو». تقوم السعادة إذن على مدى تحلينا بنزعة الوجود بدل نزعة الامتلاك لنقيم بالتالي علاقة خاصة مع زمان نعيشه كـ»أوتيوم» otium متخم بسلسلة من الفنون من قبيل فن المشي وفن القراءة و الموسيقى و التأمل …ذلك أن الحياة الرائعة تكاد أن تكون مستحيلة دون ابتكارنا لإمكانات عيش جديدة تغدو فيها كل هذه الفنون، على اختلافها، أنشطة أنطولوجية غير متاحة للهواة.لنتذكر بالمناسبة كيف اعتبر شوبنهاور أن الفنون الجميلة قادرة على حل مشكلة الحياة ملحا على مدى أهمية الموسيقى في هذا المضمار، لما لها من تأثير على المرء الذي ينصت إليها بحيث أنها بقدر ما تعمل على تذويبه في «الشيء في ذاته « (باعتباره إرادة و نومين) بقدرما تخلصه كليا من الفينومين ، ولنستحضر أيضا كيف ثمن نيتشه طقس المشي حد اعتباره مبعث اﻷفكار الهامة.والظاهر أن فيلسوف المطرقة لم يهج فلوبير عبثا واصفا إياه بثقيل المؤخرة إلا بعدما أدرك مدى خطورة ما يتخلل الجسد الثابت من أفكار عدمية شعبوية قمينة بأن تجعل من المفكر القابع في مكتبه مجرد ناسك ينتهي سيكولوجيا بتبخيس الحياة معارضا إياها بعالم أخروي أفضل بحسبه من هذا العالم الذي فيه نحيا .ذلك أن المشي كما لا يخفى على محترفيه ،فن ييسر عملية التفكير، بتحريرنا من براثن الوعي والضمير باعتبار هذا اﻷخير مجرد رد فعل «اﻷنا» الذي لا يمثل سوى جزء ضئيل من النشاط الشامل للجسد. بحيث أن قدرات الجسد تتجاوز بكثير إمكانات الوعي جراء ما يعتمل فيه (أي الجسد) من ميكانيزمات فيزيولوجية خارقة .ولا بأس من اﻹشارة والحالة هاته إلى مسألة في غاية اﻷهمية بمكان مؤداها أن الفكر ليس قدرة بل حدثا تعمل حركة المشي على التعجيل بميلاده في صيغة معرفة مرحة un gai savoir ( بلغة نتشه وهو عنوان أحد أعظم كتبه) عادة ما تأتي مخلخلة ليقينيات عصر بأكمله؛ على اعتبار أن المفكر يفكر دوما ضد زمانه.معنى ذلك بتعبير آخر هو أن الفيلسوف إن كان في مسعاه لقلب القيم، لا يبدع مفاهيم تاريخية أكثر ما يبدع مفاهيم لا راهنية،فذلك لا لشيء إلا لأنه يتقن فن المشي الذي يكفل له باستمرار أن يظل قادرا على التفكير ضد زمانه .
– في كتابكم «منطق الفكر ومنطق الرغبة» تجاوزتم «تاريخ اللعنة» الذي كان يرادف الرغبة وكذلك أزلتم عن الرغبة والجسد لبوسهما الأفلاطونية والدينية والنفسية، في نظركم أستاذنا حسن هل تحقيق الرغبة يؤدي إلى تحقيق السعادة؟
– تقتضي منا اﻹحاطة بهذا اﻹشكال أن نقف عند تلك العلاقة التي يقيمها كل إنسان مع جسده باعتبارها علاقة ظلت للأسف موسومة تاريخيا بالتشنج والخصام. ويكفينا توضيحا لهذا اﻷمر أن نستأنس بتوكيدات سقراط في محاورة «فيدون» حيث يعتبر أن الفيلسوف الحقيقي هو من يهتم فقط بروحه قدر المستطاع، دون أن يكترث بالجسد وملذاته سواء في ما يتعلق منها باﻷكل أو الشرب أو الجنس.يمتثل الجسد والحالة هاته عدوا للروح لأنه دائما ما يشوش مسارها معرقلا نشدانها للحقيقة واكتساب المعرفة . من ثمة وجب على الفيلسوف الحقيقي بحسب سقراط أن يبخس جسده ويحط من قيمته بما يجعل روحه تسمو عاليا وتمضي بعيدا عما قد يزعجها ويربك سيرها نحو عالم المثل. منذ هذه اللحظة إذن جرى التأسيس للفلسفة كنمط عيش متقشف يقوم على مصادرة الرغبة ويتطلب منا أن نحيا حياة الرهبان والقساوسة. هكذا صارت الفلسفة لقرون خلت وفية لمنهج تزهدي صارم مدعوم نظريا بوصفات ومفاهيم إن لم أقل خطابات ترمي إلى تبرير الحرمان والتقشف بدل الاستمتاع و الاستلذاذ. لعل هذا الانقلاب الأنطولوجي المهين للجسد الذي ظل ينظر للرغبة كلعنة انقلاب أفلاطوني بامتياز، بلغ أوجه مع ظهور المسيحية وباقي الديانات التي قضت نهائيا على الحكمة القديمة في صيغها المتنوعة، بدءا من الفلسفة الفيثاغورية حتى اﻷبيقورية مرورا بالرواقية والكلبية والقورينائية. وعلاوة عما سلف بوسعي أن أحيل القارئ أيضا على كتاب «المأدبة « لأفلاطون حيث تم التأصيل للرغبة كنقص لتضحى كل متعة بالنتيجة إشباعا موصولا لامحالة باﻷلم.معنى ذلك أن الرغبة بحسب هذا المنظور هي دوما نزعة تجعلنا ننشد ما نحن محرومون منه في الحاضر أي ما لا نملكه ؛فاﻹنسان وفق هذا التصور لا ينجذب بطبعه إلى ما يكون بحوزته بقدر ما ينجذب نحو ما لا يملكه .لكن واستيعابا لهذا اﻷمر،لا بأس من استعادة قصة الخلق كما وردت في المأدبة تأصيلا لميلاد الحب؛ حيث يروي أفلاطون على أن اﻹله زوس قد أفلح في خلق كائن في غاية الكمال ،على شاكلة خنثى l›androgyne برأس واحد ووجهين وأربعة عيون وفمين وأنفين ؛ لكن هذا المخلوق المثالي سرعان ما بدا لله مع مرور الوقت أكثر تعجرفا وزهوا بنفسه ويكاد لا يبالي بوجود قوة تفوقه؛ مما أثار غضبه واضطره إلى شطره نصفين بمساعدة أبولون .أما النتيجة الحتمية لهذا البتر فقد تجلت في ميلاد كائن مربع الشكل le carrelet سرعان ما وجد نفسه في أمس الحاجة للبحث عن نصفه الآخر نشدانا للاكتمال المفقود ودرءا لما يشعر به من نقص دائم .هكذا صارت الرغبة منذئذ سعيا مشؤوما إن لم نقل مأساة وعقابا وألما نتكبده بحثا عن وحدة ضائعة وتكفيرا عن خطيئة أصلية .وهاهنا يميز أفلاطون الحب عن الرغبة بحيث أن اﻷول بقدر ما يدل على السعي نحو الاكتمال والتناغم والزواج بقدر ما تدل الرغبة على اللا اكتمال و النقص. بوسعي القول بأن تصور «أريسطوفان» للرغبة والذي تبنته كل الأديان تصور استمر حتى «لاكان» مرورا بشوبنهاور الذي أكد في كتابه بعنوان « العالم كإرادة وتمثل» على أن «الحياة تتأرجح كالبندول من اليمين إلى اليسار، بين اﻷلم والملل». استئناسا بهذه الشذرة يلاحظ أن شوبنهاور من جهته مافتئ ينظر إلى الرغبة على أنها نقص ما إن يتم ردمه وإشباعه حتى يتحول إلى متعة مصحوبة بدورها بالاكتئاب والاشمئزاز والحزن في انتظار ميلاد رغبة جديدة وهكذا دواليك .بديهي إذن أن تكتمل دورة الحياة بحسبانه بخضوع العود اﻷبدي للأشياء، لمنطق تراجيدي سرعان ما ينقلب فيه اﻷلم (الرغبة المكبوتة ) إلى متعة (الرغبة المشبعة) تنطوي في ذاتها على الملل؛ فتظل اﻹرادة بالتالي معلقة (مفرزة للحزن) وفي تأرجح دائم. لكن لابد لنا من التنبيه إلى الحل اﻹمبريقي الذي تمكن بفضله شوبنهاور بالرغم من نظرته هاته،وخلافا لأفلاطون، من العثور عن مخرج ناجع ،مقوضا بالتالي كل الطروحات اﻹثنينية والروحانية بل وحتى المادية ؛ حيث تبنى الرجل فلسفة واحدية moniste تنظر إلى العالم أولا باعتباره إرادة من جهة كونه «شيئا في ذاته» وثانيا باعتباره تمثلا من جهة كونه ظاهرة.ولئن بدت هذه اﻹرادة بحسبه، أشبه ما تكون بقوة عمياء تنفلت من كل تحديد معرفي (لأنها النومين بتعبير كانط) فاﻹنسان بوسعه توجيهها حسيا من حيث كونها أيضا تمثلا للعالم . يعزى هذا الربط الذي أقامه شوبنهاور بين اﻹرادة والحواس إلى إقراره على أن «الدماغ أشبه مايكون بوزارة العلاقات الخارجية» ،و يلعب معرفيا نفس الدور الذي تلعبه المعدة على مستوى عملية الهضم.مما يعني ضمنيا على أن العالم تمثل ندركه إراديا بالعقل ونصوغه عبر إفرازاته لا غير. ولما كان لكل إنسان على حدة دماغ خاص به وجب علينا تبعا لذلك، أن نقر أيضا بلا موضوعية العالم؛ ذلك أن العالم يتعدد بقدر تعدد اﻷشخاص الذين يتمثلونه ويتصورونه. العالم إذن مجرد فكرة أصوغها بعد النظر إليه والتمعن فيه إراديا كظاهرة ؛حيث بقدر ما نكون تحت تأثير سلسلة لا متناهية من العوامل la théorie des motifs القادرة على حسم أفقنا وتحديد مصيرنا بقدر ما يمكننا أن نغير المنحى بإقامتنا في حقل الظواهر تعديلا لما يمكننا تعديله .هكذا يضحى بوسع اﻹنسان عمليا أن يشتغل استراتيجيا في أفق انتزاعه لقدر من السعادة وذلك عبر تغليبه لعامل أقوى، من بين هذه العوامل الممكنة بدءا من عامل التربية و العادات وصولا إلى عامل التاريخ واﻹقتصاد واﻷذواق و غيرها . بعد هذا الجرد التاريخي أعرج للقول على أنني تقويضا لهذا التصور الفلسفي الذي يربط الرغبة بالنقص من حيث كونها طاقة تروم استعادة الوحدة الأصلية المفقودة، حاولت في كتابي «منطق الفكر ومنطق الرغبة «أن أدافع عن طرح بديل يعيد للرغبة طابعها المادي الذي بموجبه تغدو ثراء وغنى يستدعي اﻹنفاق؛ فقبل أن ينظر إلي كوحدة مبتورة بحاجة إلى نصفها الآخر كيما تكتمل،أجد أنني وحدة منعزلة وفي غنى عن تجربة الغير. توخيا لتحقيق نوع من المصالحة مع أجسادنا، إذن، حاولت في هذا المؤلف الكشف عن آليات التنميط التي ما انفكت تسوق للتصور اﻷفلاطوني منذ أن حل رجل الدين ( ترتيليان 160-220 م ) محل رجل العلم ( الطبيب جالينوس 129-216 م) وصارت الخرافة والطروحات المزاجية تسود للأسف على حساب الطروحات البيولوجية والكيميائية . لأختم بالقول اختصارا على أن الهاجس الذي شغلني طيلة هذا العمل، هو الخروج من حقل اﻹبستيمات المهيمنة التي اختزلت سؤال الرغبة في قضية مغلوطة هي قضية الماهية (ما معنى الرغبة ؟) للتفكير في كيفية اشتغال الرغبة؟ وعلى أي نحو نبني المتعة خارج الوضعيات الاجتماعية المألوفة ؟ وهل من سياسة لفن الاستلذاذ في ارتباطه بالرغبة كتدفق خارج اﻷنساق المعهودة ؟ ذلك أن الطابع الثوري للرغبة يجعلها دوما أكثر تمردا كطاقة على كل تلك اﻹطارات القطيعية التي سرعان ما تعمل على إلحاقها بأخطبوط اﻷودبة على اختلاف ألوانه كما أكد الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز .