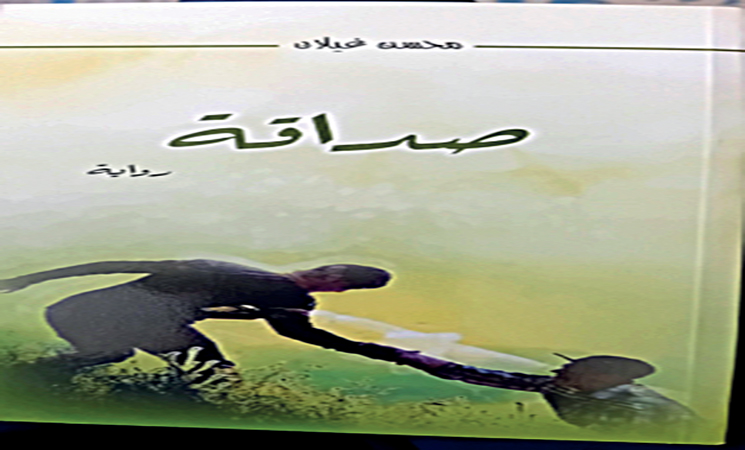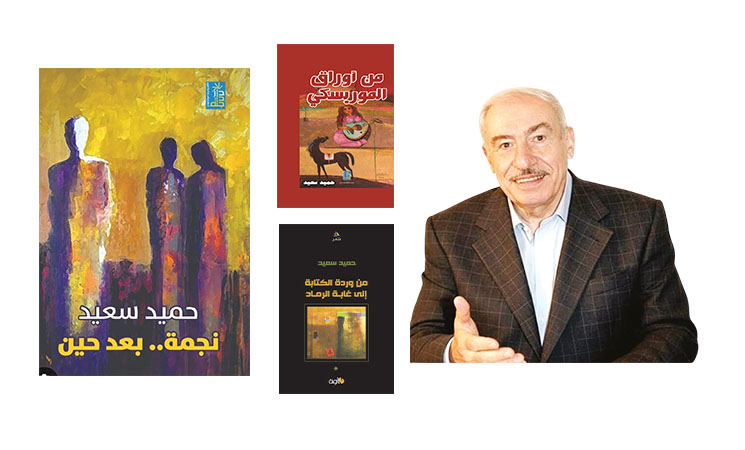استطاع المبدع محسن غيلان اكتساب الكثير من عناصر صنعته المخصوصة داخل تجارب الإبداع والكتابة، ليس -فقط- بالنظر لغزارة إنتاجه داخل مجالات اهتماماته الإبداعية والفنية، ولكن -أساسا- لأهمية ثمار حرصه المنتج لقيم الفردانية، في الموقف وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الإبداع. استطاع محسن غيلان نحت معالم تجربة رائدة داخل المشهد الثقافي لمدينة أصيلا، من خلال الآثار المترتبة عن رئاسته للمكتب الإداري لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية الإمام الأصيلي خلال مرحلة التحول والنضج عند منتصف سبعينيات القرن الماضي. يومها، كان محسن غيلان شابا يافعا، بمشاريع طموحة جمعت بين نزوات الذات الثائرة على أشكال التنميط المتوارثة، والمتدثرة بيوطوبيات التغيير التي حملها المد اليساري للمرحلة. وإذا كانت ظروف الرحلة نحو فرنسا لاستكمال التكوين الجامعي قد أبعدته عن مواكبة -عن قرب- مسار الجمعية، فإن عودته اللاحقة وترؤسه للمكتب الإداري المنتخب سنة 1986، أعطت لمحسن غيلان الفرصة لإعادة بلورة رؤى مجددة في الفعل الثقافي وفي العطاء الإبداعي، لا شك وأنها تشكل أحد أبرز معالم التوهج داخل تربة جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الإمام الأصيلي.
استطاع محسن غيلان بلورة رؤاه المتقدمة بخصوص أشكال احتفائه بحميمياته، وأشكال استثمار نزوعاته الفردانية، في الموقف وفي السلوك، في القراءة وفي الإبداع، في الممارسة المهنية وفي مجاوراتها الفنية والإبداعية. ظل محسن غيلان يعيش فردانياته المخصوصة بأدق تفاصيلها، غير ملتفت لضجيج المرحلة، ولا لبريق الألوان، ولا لإغراء الإعلام. استطاع تحويل عزلته الخلاقة، إلى بؤرة للعطاء المنتج، وللتأمل الخصب، وللاستثمار الراقي. انفتح على حقول إبداعية ومعرفية وثقافية ظلت على هامش اهتمامات حاملي أحلام تغيير الكون، واستطاع أن يجعل منها سرديات حبلى بقيم إنسانية وجمالية تشكل نبعا للانتشاء وللمتعة وللافتتان. أخص بالذكر – في هذا المقام- تجربته في حلقات التكوين في مجال الترجمة، وانفتاحه على مناجم تراث فن الملحون والموسيقى الأندلسية، ثم انتقاله إلى استثمار ذلك في كتابات سردية، لم يكن هدفها تكريس الكتابة السير- ذاتية الخطية الكلاسيكية، ولكن إشراك «الآخر» في تقاسم متع العودة للإنصات، والإنصات الجيد، لنبض الذات في خلق عوالمها العجائبية الفريدة، من خلال محكيات السفر التي تبتدئ -عند محسن غيلان- لكي لا تنتهي أبدا.
في هذا الإطار، أصدر محسن غيلان نصا روائيا جميلا تحت عنوان «صداقة»، وذلك سنة 2023، في ما مجموعه 94 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. تختزل هذه الرواية محطات من السيرة الذهنية لمحسن غيلان، من خلال تحولاتها العميقة داخل جغرافية الانتماء الممتد عبر مدن أصيلا، والصويرة، وتور الفرنسية، وطورنطو الكندية. لا أقصد -في هذا المقام- الانتماء المادي المباشر، ولكن الانتماء الثقافي والفني الذي يجعل روح المبدع وسفره الدائم أمرا مستساغا بين المدن والأقاصي، هنا وهناك، داخل المغرب وخارجه. تقوم بنية السرد داخل رواية «صداقة» على استحضار حوارات ممتدة بين شخصيتي «رحال» و»ياسين»، ومعهما شخصيات الجوار التي تستكمل حلقات السرد، مثل رشيدة، وحسناء، وإيزابيل.
وبين هذا وذاك، ينحو النص نحو توسيع مفهوم التثاقف للانفتاح على عوالم الفن والإبداع خارج سياقها المغربي الخالص. في هذا الإطار، تحضر أسماء الضفة الأخرى لتوجيه بنية السرد وإدماجه داخل معالم الأفق الثقافي للسارد، مثلما هو الحال مع الشعراء رامبو، وبودلير، وبريفير، ومثلما يحضر «المعهد الدولي للثقافة والترجمة» بمدينة طورنطو الكندية كجسر للعبور نحو ضفاف العالم. وفي الواقع، إن هذا المنحى لم يعمل إلا على إلباس شعراء مثل بودلير لباس العربية ورداء عوالمها اللغوية المذهلة، الأمر الذي ينسجم -تماما- مع أفق اشتغال محسن غيلان على امتداد سنوات طويلة من البحث ومن التأمل ومن التنقيب. لذلك، أمكن القول، مع كل التحفظ الضروري الذي يستلزمه هذا المقام، إن محسن غيلان يكتب في هذه الرواية سيرته الثقافية من خلال تأصيل انتمائه لعوالمه الفريدة في الترجمة ولفضاءاتها الرحبة. يقول بهذا الخصوص على لسان «ياسين»، مبررا دوافع اختياره للموضوع: «أعتقد أنني أحب ممارسة الترجمة لأنني ببساطة في حاجة إليها. حاجة أحصرها في ثلاث حالات: 1- الحالة الأولى: الترجمة مع التلاميذ. أحب ممارستها لأنني في العمق ألبي رغبة قديمة، على ما أعتقد، لم أكن أعِيها. كنت أتمنى لو كان أساتذة اللغة يمارسون معنا ترجمة نصوص… 2- الحالة الثانية: ألتقي بكتب أو نصوص تستهويني إلى حد أحب معه أن أراها تتكلم بالعربية، عربيتي… 3- الحالة الثالثة: أعمال شهيرة ومكتنزة. أعمال أعتقد معها أنها ستقوي من تكويني. هنا تكون الترجمة تعميقا للقراءة ويكون المترجم قارئا بامتياز، لأنه يُقلب النص جملة جملة وكلمة كلمة ويدفعه إلى أن يتحدث لغة أخرى… وأخيرا هناك حاجة تتوج كل هذه الحاجات… وهو أنني أعتقد أن الترجمة ستضخ دما جديدا في عربيتي وهذا ما يهمني مادمت أحاول أن أكتب أدبا…» (ص ص. 33-34).
على أساس هذا التصور، تحفل رواية «صداقة» بإحالات مسترسلة على غواية فعل الترجمة، في تلازم مع فعل الترحال والتنقل، وكأني بهما أفعال متلازمة، ومُكملة لبعضها البعض. يتحول السفر، في هذه الرواية، إلى متع لامتناهية أمام الخلق وأمام إنتاج الرموز الفردانية المسؤولة عن نظيمة التميز داخل وسط قد لا يكون جيد الإنصات لرنين الجمال داخل المحيط المباشر. وتزداد قوة هذا المنحى بروزا، إذا كان التنقل يتم على متن «الحصان الحديدي» الذي سمح لمحسن غيلان بقطع مسافات على مسافات، وعوالم على عوالم، الأمر الذي خلف بصماته على صفحات ذاكرة الحكي، من خلال مواقع طوبونيمية قائمة، مثل أصيلا، والصويرة، وطنجة، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، وسيدي إيفني،… بل ومن خلال مواقع قروية تنتمي للأقاصي، حيث الفطرة وحيث الخصب، حيث البساطة والعمق، وقبل كل ذلك، حيث الهامش المنسي والأحلام المؤجلة، مثلما هو الحال مع مراكز «ثلاثاء الحنشان»، و»باب برد»، و»واد لاو»،…
يستحضر محسن غيلان المكان، ويستنطق فضاءاته بلغة سردية سلسة، تنساب بهدوء مثير، وبإثارة أخاذة، وبإبداع يُشيد لغته الخاصة أو «عربيته» الخاصة حسب تعبيره الأثير. يقول مستحضرا عودته إلى فضائه الفطري بمدينة أصيلا: «نزلت من القطار في محطة أصيلة. المحطة تبعد عن المدينة ببضع كيلومترات وتُلقي بركابها مباشرة في الشاطئ. غاصت قدمي الأولى في الشاطئ حين سمعت هدير القطار وهو يكمل رحلته. لِلحظة الوصول إلى البلد هي الأخرى ألمُها ومعاناتها. مرت أربعون ساعة على فراقي مع إيزابيل. انتبهتُ إلى أنني تعرفتُ عليها هنا في هذا الشاطئ الذي تطأه قدماي الآن في هذا الصباح الباكر الجميل والمنعش. الأمواج هادرة. كيف قضت ليلتها إيزابيل؟ مررت بدور واطئة تطل مباشرة على البحر. قطنت مع ياسين في إحداها خلال سنة دراسية بكاملها. المدينة فارغة. صعدت من باب البحر المُدخل مباشرة للمدينة القديمة. محراب مسجد يخرج كحدبة من حائط. كثيرة مثل هذه المحاريب في المدينة القديمة. أجدها جميلة ومثيرة. باب أخضر مشقق قديم طلاؤه. مقر جمعية ثقافية اشتغلت فيها لسنوات مع أصدقاء هم راحوا الآن كما رُحت أنا. مدرستي الابتدائية. جدرانها بدأت تتشقق. سي الخدير، سي القريشي، سي مصطفى، سي المختار وغيرهم… هذه الأقسام تطن بداخلي. وقفت ماسكا بشباك الباب أنظر للساحة. مثل سجين. هنا كنا نصطف قبالة الراية المغربية (يا علمي يا علم العُرب اطلُعي واشرقي…) وكانت لرمضان رائحة خاصة حين نخرج مساء وقد أخذ الجوع منا، ونحن نقصد منازلنا للوجبة العائلية المشتركة. نزلت للشاطئ الصخري بعد أن أنهيت المدينة القديمة. صعدت عبر مقبرة اليهود كي ألتحق بمنزل والدي، هناك قبالتها، بعد أن أعبر مرجا أخضر. على شواهد القبور كتابة عبرية وفُطر جاف من فعل السنون… لاتزال أمام عيني تلك الألوان، أحمر، أخضر، أبيض وغيرها، منشورة على خضرة المرج…» (ص ص. 40-41). وعندما ينتبه السارد إلى تحولات «المكان» وإلى انفراط عقد وجوهه التي كانت تصنع ألفته «التي كانت»، يقول متحسرا: «أصيلة مقفرة وأصدقائي حملتهم بقاع أخرى…» (ص.54).
يبدو أن السارد لم ينجح في إخفاء غوايته الأولى، وفطرة عشقه الأول، لذلك ظل حريصا على استلهام فضاءات مدينة أصيلا، وعلى استنطاق وجوه أناسها البسطاء، بل وإضفاء على هذه الفضاءات وعلى هذه الوجوه صيغا كونية، ارتقت بها إلى مفاتن الانبهار باللحظة الأولى، لحظة الميلاد والنشأة. تُعلمنا رواية «صداقة» أن السفر يُقرب المسافات، وأن الترجمة طريق سيار نحو الانخراط في العالم، وأن الإبداع ملح يغتني بغنى الحضارات والثقافات والقيم والتجارب، وأن الأصل في الانتماء المنفتح على العالم، كل العالم، يظل البوصلة المُوجهة للاهتمام والمُرشدة للانزياحات والمُؤطرة لليوطوبيات الحاملة لمراقي السمو ولعوالم التميز ولمداخل الانخراط في مسار الخلق والإبداع.