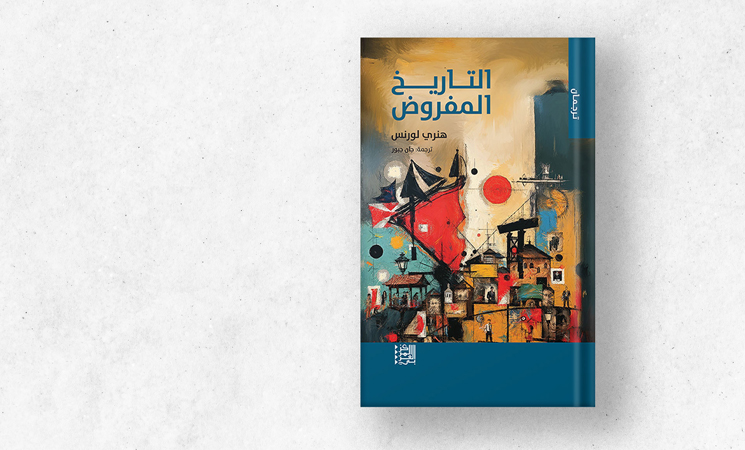– وَاشْ أنْتَ مْزَنْزَلْ؟
– وَاهْ مجنون.
تصدّعت جُملتي من هول الزّلزال؛ وتسربت الصور إلى عيني على شاكلة مِزَق. مِزَقٌ هذا المحكي، مكتوبٌ غير متآلف، لم أعرف كيف أربط بين فقراته. جُماع كلمات تحاولُ أن تُعَلِّقَ على صور من «الزَّنْزَال» الذي ضربنَا قبل أسبوع.
أقفُ هنا وأنظُرُ؛ أنظُرُ وأتساءلُ:
ما علاقة الموقف بالنّظرة؛ بالإدراك بالوعي بالرأي؟
ما علاقة الموقف بالطفولة وبالتراب؟
ما علاقة الموقف بالخبر وبالحقيقة؟
كيف انتهى بنا الأمرُ في هذا المكان؟ نعم، في هذا المكان الأخير من المكان.
مكانٌ تغربُ فيه الشّمس ويرقد فيه بحر الظلمات؛ مكانٌ يحلمُ فيه النور بغدٍ مشرق.
إن ما يَشدُّنَا إلى الحياة هنا، في هذا المكان القصي، هو الحياة نفسها.
تلفزاتُ العالم تتناقلُ خبَرَ «الزَّنْزَالِ»؛ لا أذكر أين قرأْتُ أو سمعتُ بأن «الأخبارُ أصبحت ترفاً»؛
نعم، المذيعات والمذيعون ليسوا أقل غرابة من نجوم الموضة، وتلفزاتُهم علامات/ ماركات لأنواع الأزمات.
قُدّامي على طاولة في زاوية من البيت وُرَيْقَة مهملة مكتوبٌ فيها جُمل مقتبسة من ديوان «كونشرتو القدس» لأدونيس؛ وُرَيْقة ظلت في مكانها لأكثر من شهر، طالها الغبارُ بعد أن جفّفها وعوّجها صهد غشت وحرارته. فانحنيتُ قليلاً نحوها وشرعْتُ أقرأ من مسافةٍ الآتي:
«صُراخٌ لا يقْدِرُ فَمُ اللّغَةِ أن يَقُصَّهُ علينا» ص 85.
«بشفتيْ رغيفٍ يُقالُ الواقِعُ / بيدَيْ دِرْهَمٍ تكتب أيّامَهُ وأعْمَالَهُ…». ص 87.
«… الكذِبُ سيّدٌ على الكَوْنِ / ولا شَرْعَ للشَّرَفِ / ما أشَدَّ عذابَكَ، أيّها الصِّدْقُ.». ص 87. بعد لحظةِ تأمّلٍ رفعتُ بصري إلى التّلْفَزَة، لا شيءَ غير أخبارنا. وشرعْتُ أنظُرُ كمن لم يصدّق (بَعْدُ) أنّ ذلك الجُرْحَ الّذي يتفرّجُ عليه هو جُرْحُهُ. أنظرُ وأسمعُ في ذهول كيف يتحدّثون عن جرحنا، وكيف يبحثون فيه عن مسوغات لزوايا نظرهم، لأحكامهم… يبحثون عن مبررات لأكثر من شفقة، يبحثون عن العجائبي في تُرابِنا… يبحثون في الجرح عن أسباب كل الأزمات؛ يبحثون فيه عن الأخلاق والجغرافيا والسّحر والسّباع والجوع والسياحة والدّعارة والأصالة والسماء والماء والمعجزات… أسمع أصوات مراسلين يتهجّون جرحنا بلكنات تَجْرَحُ الجُرْحَ، تلوثه، تسمّمُهُ. ثم سمعْتُ صوتاً في رأسي يقول:
– «يَسْخَرُ من الجُروحِ كلّ من لا يعرف الألم».
شاهدتُ مراسلاً يقترب من رجل إنقاذ، برغم الإجهاد وقلة النوم وهول الفاجعة رَدَّ المنقذُ بوجه معفّر بالتراب وكانَ يجفّفُ دموعه بقبضته قائلاً: «إن لله وإنا إليه راجعون»… والتفَتْتُ إلى الطاولة قُدّامي، فوقها حاسوب صغير، أكثر من مذكرة، كتاب، مجلتان، جريدة مطوية، مفاتيح البيت، قنينة ماء، مقص أظافر، وريقات ملونة، علب أدوية، وريقات من شهرية بوعياد… وعلى ظهر وريقة من شهرية بوعياد قرأتُ الآتي:
«هناكَ أشخاصٌ حتّى عندما يكونُ مزاجهم سيّئاً يحدّثونك بأدب، هؤلاء فعلاَ من يستحقّون الاحترام».
وأحسستُ أن هذه المقولة تردُّ على صفاقة ذلك المراسل الذي سأل المنقذ عن تقديره للوقت الكافي للإنقاذ، في حين أن بلاغة (صور) الفاجعة تجعلك أخرسَ؛ وطلعت في ذهني تلك الصورة (الكونفوشيوسية) التي تقول، من صفاء الماء صارَ العمقُ سطحاً. ولا أعرف كيف انتبهتُ أن ما يبدو لي غريباً في هذه الجهة، لما أحوِّلُ عنه بصري، أجدُ رَدّاً عليه في الجهة المقابلة، وكأن موجودات العالم في سجال مفتوح: الكلُّ يردُّ على الكُلِّ.
قلتُ في نفسي، ربما بدأتُ أقتربُ من الحقيقة، وتداركْتُ نفسي واستفهمتُ: لكن، عن أي حقيقة أتحدث؟ وأنا لا أبحث عن شيء محدّد، أنا في حداد، أنا تالف، أنظُرُ فقط، جسمي هو من يتكفّل بحركتي، جسمي هو من يمدّني بفكرتي التي يصهرها الألم. ثم تذكرت أنني قرأت يوماً، أن العالم كله أرقام، يخضعُ لنظام رقمي دقيق، وتجهّمتُ؛ إذ لا أطيق منطق الأرقام… عدد الضحايا، عدد الخيام، عدد القتلى، عدد الجرحى، عدد التلاميذ الذين قضوا تحت الأنقاض، عدد النّساء الحوامل، عدد الكاميرات، عدد المساعدات، عدد المغالطات، عدد اللصوص… اللصوص في كل مكان. إعلام متعجرف، إعلام غبي، إعلام لا ينقل الخبر بأمانة، إعلام يصنع الخبر الذي يريد به تَمْكِينَ جهةٍ يريدُ الإعلاءَ من شأنها… نعيش حرب الإعلام.
(…)
بعد ثوان من الزلزال أحسستُ وكأنّني استيقظْتُ في مكانٍ آخر، وفي جسدٍ آخر. والصوتُ الرّهيبُ الّذي كانَ يرغي في مصارين الأرض، ذلك الصوت المرعب، اخترقَ جسمي كتيّارٍ، بلى كَدُبٍّ هائجٍ وليس ذَبْذَبَة عابرة. ما زال ذلك الصوت المخيف يتردد صداه في رأسي إلى الآن. مضى وترك لنا الصّدى والوجع. ولا يكفي قرص «دُولِبْرَانْ»، ولا حتّى جعبة من الأقراص، لإسكاته، و… كأنني آخرٌ، إنني آخَرٌ… أتفرَّجُ عليَ فقط؛
ولا أريدُ أن أبكي أيّها الزلزال.
هبّةٌ مُضادّة؛
هبَّ الزلزالُ وهبَّ المغاربةُ
كالزّلزال.
شكّلوا صفّاً يمتدُّ من الصّباحِ إلى المساء؛
صَفُّ التّبرُّعِ بالدّم.
هذا شَعْبُ يقطعُ الأنفاس
هل أستطيعُ ألاّ أبكي وأنا أشاهدُ
هذا الشّعب المجنون بعظمة
ألمه،
يبكي ويتوجع ويضحك في آنٍ؟
لا أريدُ أن أبكي
ولا أستطيع أن أحبس الدّموع
(…)
هذا شعبٌ يريدُ أن يُثبتَ لأهله ولنفسه أنه حيّ موجود مفيد قادر مسؤول حاضر ناظر نافع، نافع، نافع… مهم.
هذا شعبٌ يريدُ أن يكون مُهماًّ؛ يريدُ أفراده أن نراهم وهم يزاولون أعمالاً مُفيدة؛ يريدُ كلّ واحد من أفراده أن يقول حتّى أنا أستطيع أن أخدمكم… وبعد «الزَّنْزَالِ» حتى ذلك المشرد المنسي المرمي على هامش الرصيف هبَّ وقال، وأنا أيضاً أستطيع أن أعطي دمي، ودخلَ إلى الصّفِّ… هكذا نحنُ؛
شعبٌ مُهِمٌّ لا يعرفُ أنّه مُهِمّ؛ ولأنّهُ لا يعرفُ، فهو: حزينٌ غاضبٌ، كتوم، عبوس خدوم، فقير، غني، جائر، ظالم، مظلوم، حاقد، حالم، يائس، صامت، لص، تعيس بئيس، قلق، حذر… يغني، يغني على أكثر من إيقاع لنفس اللازمة: الأزمة: الحياة.
آه من غناء هذا الشعب، من أهازيجه، من إيقاعات قلبه وتلون لسانه إذ يحاكي بسلاسة كلّ اللهجات؛ هذا الشّعبُ الحرباءُ المفرومُ اللسانِ، السّاكتُ، السّاكنُ، الغارقُ في قلبه كالزلزال؛ هذا الشّعب الّذي لما تدُخُل حَقْلَهُ، لما تقترب منه، يسكتُ كالزِّيزِ؛ أنتَ لا تراه، هو يجعلك تقترب، يثير فضولك، يسحرك، تبحث عن مصدر الصوت، تريد أن تتحقّق من صورته إذ في مخيلتك هو مجرد هيولى: مادة أولى تشبه كل شيء ولا شيء… وَكَيْ تراهُ عليكَ أن تُبرهنَ على تواضعك؛ عليك أن «تطلبُ التّسْليمْ» كما يقول المغاربة. أو كما أمام المجهول «إِكْسْ»، عليك أن تبرهن على إنسانيتك… ولا شيء يُوصِلُ إليه غير صوته الذي لما يخترق نفَقَ أذنيك يُحاصركَ؛ تُحِسُّ به يأتيك من كل الجهات. ولما تقترب أكثر في عماك، يُغيّر المكان كالزّيزِ، يطيرُ دون أن تراه، «يبدّلُ الساعة» كما يقول المغاربة؛ يتركُ لكَ الصّمتَ والسّؤال. بعدَ حينٍ، تسمعه خلفكَ، أمامكَ، على يمينكَ، على شِمالكَ، في اللاتّجاه… إذ لينهي تلاوة كتابه، عليه أن يختفي عن الأنظار.
أنا اليوم على قناعة من أنني أنتمي إلى شعبٍ «مُزَنْزَلٍ»: شَعْبٌ مجنون، شعبٌ لا يشبه إلا نفسه، شعبٌ له ثلاثة أرواح اسمها: تمغربيت؛ وتاريخ تمغربيت: هذه الروح العظيمة، قرين بطبيعة جبال الأطلس. لذلك، أرى اليوم، أن البراديغمات المتناقضة التي راكمتها طوال (سنوات) من بحثِ سُؤالِ (الهوية)، براديغمات شكلت جزءاً كبيراً من نظرتي، أراها اليوم كجلاميد الصخر التي هزّها الزّلزال وانْجَرَفت وجَرَفَت معها أخرى وطمرت قُرى بكاملها، وسدّت المسالك التي توصل إليها.
أنا «مُزَنْزَلٌ» لأنني سليل مغرب مجنون؛ مغرِبٌ تنامُ عندَهُ الشّمسُ، وقبلَ أن تخلُدَ للنوم يغني لها: «نِينِّي يا مُومُّو، حتّى يْطِيبْ عْشَانَا، وِلَا مَطَابْ عْشَانَا، يْطِيبْ عْشَا جِيرَانْنَا…». ولأنني بتْتُ على يقين من أنني مجنون (قرّرْتُ) أن أفضحَ أنَايَ، تستّرتُ عليها طويلا، آمنتْ بغربٍ نَصَّبَ نفسه عالمَاً أول، غربٌ ما لبث يُقَدّم بلدانه كنماذج لإنسانية بلا حدود، ويُعلّمُ بالعصا أن عقلانيته وديمقراطيته هما سببا العدالة والاستقرار اللّذين ينعم بهما. لذلك، فَ(أغلبنا)، بلا سؤال وبلا تمحيص، اعْتَقَدَ أن تلك النّماذج هي الحياة. حقيقة أن العقلَ الغربي توفّقَ ببراعة في تطوير مناحي كثيرة من الحياة، لكنه لا يمثل كلّ الحياة، وليس هو كلّ العقل. إن الحياة تمشي في كل الاتجاهات، مرة عاقلة، مرة كسولة حاقدة، مرة قاتلة، مرة تزغرد، ومرة تنوح كما الأطلس اليوم. لقد انْفَطَرَ قلْبُ الأطلس بعد قرونٍ طويلةٍ من الصَّبْرِ… اليوم أطلسنا يتألم؛ ومن شدّة الوجع لم يعرف كيف يعبر عن ألمه. يتألم بكبرياء. أطلسٌ تعوَّدَ على النّأي بنفسه إلى الأعالي، تعوَّدَ كالنسور على الصمت والنظر من أعلى. أطلسٌ علّمته الرّيحُ كيفَ يمسحُ المنحدرات من كلّ طفح أخضر. أطلسٌ علَّمَ أهاليه الطيبين كيف يعيشون في كبرياء وهم يقفون على شفير الهاوية؛ يمشون ويجرون ويرقصون على خط في المنحدر؛ ليسوا بهلوانيين، لكنهم فرع من جنون هذا الشّعب الرائع.
أنا فخور بمغربيتي.