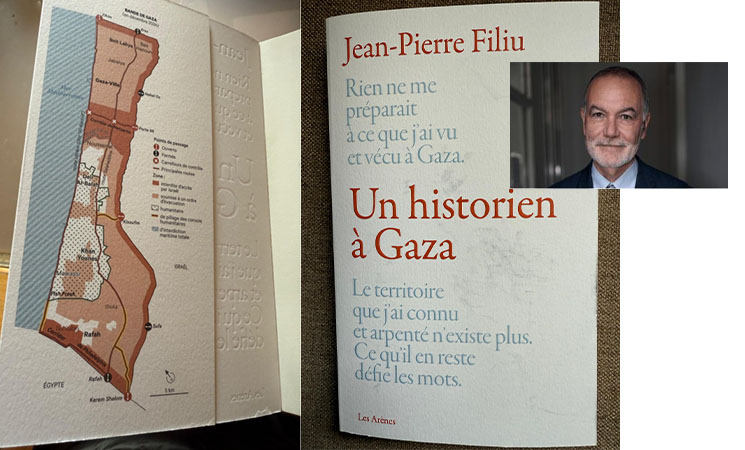لازمت الأوبئة كظاهرة اجتماعية مرضية وضرورة حتمية واقتران استثنائي بتاريخ المغرب، فاختلفت طبيعة العدوى الوبائية، وتنوعت أعراضها ودرجة حدتها واتساع رقعة انتشارها ومخلفاتها البشرية، بسبب الجفاف المتواصل والجذب الحاد والقحط الشديد.
فمنذ قرون عديدة، وكلمة “الوباء” أو “الطاعون” أو “الجائحة” تثير الرّعب في الناس، تقشعر لها الأبدان، وتضيق أمامها النفوس؛ لأنها، ببساطة، صارت في ذهنية المغاربة مرادفًا لفقدان الأهل وللخوف الرّهيب من الموت، إذ تكفي الإصابة به ليَعدّ المصاب نفسه ممن سيلتحقون بطوابير الموتى الملتحقين زمرا إلى العالم الأخروي. هذه النّظرية التي جاء العلم ليفندها ويثبت أنه يمكن التّشافي من الطاعون والعيش بعده طويلًا لنقل الحكايات عنه لمن لم يعرفوه أو يدركوه.
في هذه الحلقات نرصدبرفقتكم محطات من “اوبئة” ضربت بلاد المغرب، فخلفت ضحايا في الخلف من إنس وحيوان٠
وكان المخزن يتدخل أيضا لتحديد الأسعار تفاديا لارتفاعها، خاصة أسعار المواد الغذائية، ومحاربة الاحتكار، وتوزيع الطعام على الفقراء، واستيراد الحبوب من الخارج، وإعادة توزيعها حسب المناطق، وإلغاء بعض الضرائب أو تأجيل سدادها مراعاة للظرفية الصعبة. ورغم التدابير التي اتخذها المخزن فإن فعاليتها ظلت محدودة للأسباب التي ذكرناها سلفا، ولأسباب أخرى تتعلق بالتدخل الأجنبي في القرن التاسع عشر الذي استنزف ميزانية الدولة… كما يرى الأستاذ الطاهري أن المخزن كان يتسبب أحيانا في انتشار العدوى عن طريق الحرْكات السلطانية، أي تلك الجولات العسكرية التي كان يقودها السلطان أو من ينوب عنه، لفرض الأمن الداخلي مواجهة القبائل المتمردة. ومن الأمثلة على ذلك مساهمة حركة السلطان مولاي سليمان نحو الجنوب قصد إخضاع قائد عبدة وآسفي في انتشار طاعون 1798-1800، فقد مرت الحركة من الرباط والدار البيضاء وآسفي والصويرة ومراكش ثم عادت إلى مكناس وفاس. وكانت مسؤولة عن تفشي الوباء بهذه المناطق، ويقول المؤرخ الضعيف الرباطي بأن عددا من المناطق لم يكن بها الوباء حتى دخلها جيش السلطان. ماهي أبرز العادات الاجتماعية التي رافقت والجوائح؟ كان للجوائح وقع على التمثلاتوالسلوكات الفردية والجماعية. فقد كان كثير من الناس يرون فيها عقابا سماويا بسبب الفساد والمعاصي والمنكرات مثل انتشار الزور والبهتان والخمور وإهمال الشعائر الدينية والفتن والحروب الداخلية… وكان بعضهم يحمل المخزن أحيانا مسؤولية ذلك بسبب عدم منع هذه المنكرات، والتجأ الخطاب السلطاني إلى الأمر نفسه، كما هو شأن المولى سليمان الذي كان يرى في الجائحة والوباء عقابا إلهيا بسبب معاصي الرعية ومفاسدها. وقد انقسمت النخبة المثقفة في تفسيرها للأوبئة وكيفية التعامل معها. فبينما حاول البعض أن يلتمس لها تفسيرا علميا مثل ابن خلدون الذي ربط الطاعون بفساد الهواء وكثرة انتشار العفن لكثرة العمران، وابن سينا الذي أرجعه إلى مادة سُمِّية تحدث ورما قاتلا، جنح البعض الآخر لما عجز عن إيجاد تفسيرات مادية إلى ربطها بالخرافات أو الغيبيات أو العقاب الإلهي… وفي حين دعا بعض الفقهاء إلى التسليم بالقضاء والقدر في مواجهة الجائحة، قال البعض الآخر إن تعاليم الإسلام تدعو المؤمنين إلى اتخاذ الأسباب والتدابير الاحترازية للوقاية من الأوبئة. وكان الناس يقبلون على الإكثار من الصدقات وعلى المساجد والأضرحة والتضرع إلى الله لرفع البلاء. وفي سلوك مناقض، كان البعض منهم ينغمس في الملذات والخمر فرحا بالنجاة من البلاء، كما فعل بعض من جند العبيد الذين عمدوا بعد إقلاع الوباء إلى حارة اليهود بفاس فنهبوها وسبوا النساء وافتضوا الأبكار وشربوا الخمر في رمضان خلال المرحلة المعروفة بالفترة والتي تميزت بالصراع على السلطة بين أبناء المولى إسماعيل بعد وفاته. وإضافة إلى ذلك، كانت تنتشر أجواء الاضطراب والإحساس بالقلق واليأس والإيمان بقرب نهاية العالم، والحنين إلى ظاهرة المهدي المنتظر الذي يخلص الناس، والفرار نحو المجهول، والظلم والطغيان واللصوصية وقطع الطرق، وبيع الأطفال والنساء ووأد الأبناء والبغاء، والارتداد من الدين خاصة بالنسبة لليهود الذين كانوا يعلون إسلامهم لنيل ما يمكنهم من النجاة من الوباء من طعام وغيره. وكانت ظروف المجاعات والأوبئة تدفع الناس إلى أكل النباتات مثل الدغفل والخروب والنبق والبلوط والدوم وأكل الجراد، وافتراس الحيوانات الأليفة في حالات مثل القطط والكلاب وأكل الخنزير والجيف، بل وحتى أكل الجثث الآدمية، وهناك فتاوى فقهية أباحت ذلك في حدود الضرورة. وكما أنه كانت للجوائح ضحايا كثر، خاصة في صفوف الفقراء، فقد كان البعض يستفيدون منه لمراكمة الثروات عن طريق الاحتكار ورفع الأسعار وشراء أمتعة وممتلكات الفقراء الذين كانوا يضطرون لبيعها بأثمنة بخسة جدا بسب الجوع ولإنقاذ حيواتهم. وقد ساهم ذلك في توسيع شقة التباينات الاجتماعية. وبحكم الخبرة التي تكونت لدى الناس بفعل توالي الجوائح، خاصة المجاعات والأوبئة، فقد كانوا يلجؤون أيام الرخاء إلى الادخار وتخزين الحبوب في المطامير أو المخازن الجماعية المعروفة بإكودار وذلك تحسبا للأيام العصيبة، كما كانت تنتشر في المجتمع مختلف مظاهر التضامن الاجتماعي والإحسان والصدقات والتبرع المالي للمساهمة في التخفيف من وقع الجوائح على الفقراء والمعوزين على الخصوص…