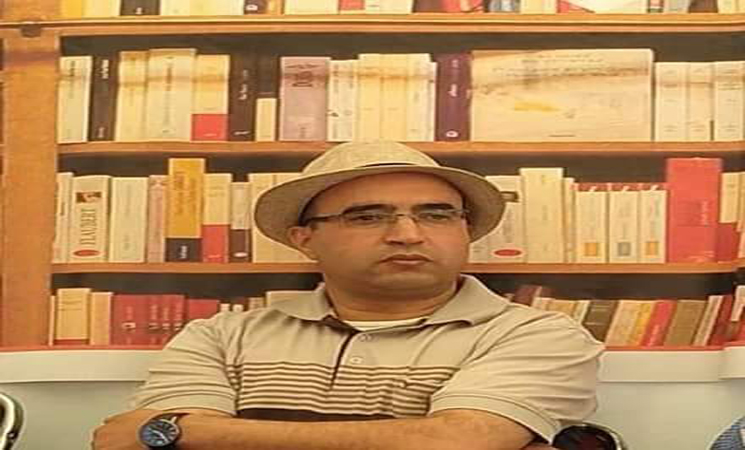زرتُ زاكورة، منتصف شهر ماي الأخير، لحضور ملتقاها السنوي حول القصة القصيرة، الذي ينظمه نادي الهامش القصصي هناك، بمبادرة بعض المبدعين الشباب في المدينة، أمثال محمد الحفيضي ولحسن آيت ياسين وسعيد حنضور وغيرهم، وبمشاركة رموز بارزة في مجال هذا الجنس الإبداعي، تأتي من مختلف ربوع المغرب، أمثال أحمد بوزفور ومصطفى الجباري وأبويوسف طه وعبد الحميد الغرباوي وسعيد منتسب وعبد الحفيظ مديوني ولطيفة باقا ولطيفة لبصير وربيعة عبد الكامل وليلى بارع وأحمد شكر وغيرهم. لم تكن هذه زيارتي الأولى، بل هي العاشرة ضمن زياراتي المختلفة إلى هذا الربع القصي في الجنوب الشرقي. وقد لاحظتُ، كما في المرات السابقة، هذا التركيز اللافت للنظر على كلمة/ مفهوم ‘الهامش’، وعلى حمولته الفكرية والأيديولوجية- السياسية في المقام الأول، وإن كان الملتقى لا يقام أساسا- كما تبيّن أدبياته على الأقل- ليحتفي بهامشية المدينة وأناسها، وإنما بجنس القصة ومبدعيها ونقادها، وقرائها أيضا.
هل قلتُ إن ملتقى زاكورة القصصي السنوي يقام ليحتفي بالقصة ومبدعيها ونقادها فقط؟ لا، هذا غير صحيح. ثمة ما يؤكد أن ملتقى القصة القصيرة في زاكورة ينعقد سنويا بوعي يعكس إصرار أصحابه على الاحتفاء بهؤلاء المبدعين والنقاد، الضاربة جذورهم في عمق الهامش المغربي؛ ومن ثمة، إلحاحهم على افتراض مفاده تفكيك هيمنة المركز وإعادة توزيع علاقات القوة- ثقافيا وأدبيا على الأقل- بينه وبين والهامش، كما يقول المفكر الفلسطيني الراحل إدورد سعيد. وهذا الإصرار ذو بعد ضمني يراهن، من الناحية الجوهرية، على خلق أفق ثقافي أدبي، ومراكمة تجربة جمالية وفنية في الهامش، دورة بعد أخرى، رغم الإكراهات المادية؛ ومن الناحية الثانوية، على نقد الموقف السياسي والأيديولوجي، الرسمي والشعبي، ومحاولة تحريره من النظرة الضيقة القائمة على الاعتقاد القائل بأسبقية المركز وأولوية شؤونه على سواه. ولعلها النظرة التي خلقت، على امتداد العقود، تمثليْ ‘المغرب النافع’، بما هو مركزٌ، و’المغرب غير النافع’، بما هو هامشٌ.
الهامش الاستعارة
ليس من باب العسف تأويل الكلمة، التي ألقاها القاص محمد الحفيضي خلال افتتاح دورة الملتقى الأخيرة، بأنها استعارة تحول هذا الهامش إلى فضاء «ممتد فينا بلا سواحل ولا كثبان»، يغوص فيه الإنسان الهامشي- هذا الكائن الأسطوري- «غير آبه بأي صنف من صنوف الطعم الساعي» إلى إخراجه من لذة الانتساب والانتماء؛ أي من طيب العيش خارج دائرة الضوء وقوالب السبك والضبط والانتظام. والامتداد هنا، بما هو واقع واستعارة في الآن ذاته، هو أفق «الحرية والإيمان بالممكن،» بتعبير الحفيضي، وهو أفق مُشْرَع على الترحال والسعي في الأرض؛ وعلى التجدد والتغير، بما يعنيه ذلك من أفق موازٍ منذور للتمرد على الاستقرار والسكون والكمون. لذلك تجد ابن الهامش أدرى بالمكان والفضاء، رغم امتدادهما الشاسع.
يطلّ الهامش- زاكورة مثلا- على هذا الامتداد الشاسع، ويندفع إليه بشغف، رغبة في الحياة، من غير خوف من أن يقوده ذلك إلى الموت، كما يقول الفيلسوف الألماني ‘جورج زيمل’ في وصيته الشهيرة التي تحذر الذات من التهلكة جراء اندفاعها المتوثب نحو الحياة. يصير المركز ذاته جزءا من هذا الامتداد، يتحول إلى إقامة مؤقتة، إلى أن تحين لحظة العودة إلى الأصل؛ أي الهامش. حتى وإن امتدّ المقام بأبناء الهامش في المركز، فإنهم يعودون إليه، في ما يشبه رحلة الصيف والشتاء، في الأعياد والمناسبات العائلية والعطل، في انتظار أن يؤوبوا إليه نهائيا بعيد التقاعد، أو حين نهاية رحلة الحياة نفسها. وفي هذا انتصار على ما يقصده الحفيضي بـ’الاكتواء بنار الكيد’، الانتصار للأصل على الغواية التي يتقنها المركز؛ ذاك الذي يـزرع «ما يكفي من الشتلات ظلا في وجه القيظ (والحرائق المتعمدة) وعلامة على حسن النية.»
أدب الهامش
نال ملتقى القصة القصيرة في زاكورة، على امتداد سنواته التسع عشرة، سمعة طيبة مردها، أساسا، إلى الجهد الفكري الذي ظل، ولا يزال، يبذله مؤسسوه والأجيال التي توالت على تسييره، وكذا إلى الأفكار والاقتراحات التي تعالجها كل دورة على حدة. كما تعود، من جانب ثان، إلى مضمون النتاج الأدبي، القصصي على نحو خاص، الذي يعنى بالإنسان وهمومه اليومية، بصرف النظر عما يدبّر- في ليل أحيانا- لاستلابه وإخضاعه وإضعاف وجوده وسلب إرادته التواقة دوما إلى التحرر. وإذا كان القصاصون يصفون جنسهم الأدبي هذا بأنه فن الهامش بامتياز، ويرون أن هذا الأخير هو الحافز على الكتابة أصلا، فلا عجب إذا أن تقام له الملتقيات والمنتديات، والندوات والحوارات، في مدن وفضاءات هامشية، مثل زاكورة نفسها أو مشرع بلقصيري أو بركان أو خنيفرة أو تارودانت أو غيرها.
أضف إلى هذا طبيعة القضايا التي تطرحها القصة القصيرة، إذ احتضنت الهامش، بمختلف تجلياته الإنسانية والوجودية والفضائية… ذلك أن السمة البارزة في طبيعة التأليف القصصي، منذ تجاربه المبكرة إلى اليوم، تتمثل في عنايته بالكائنات أو الفضاءات الواقعة خارج دوائر الضوء. وهكذا، يظهر كأن القاص لا يكون كذلك، وأن القصة لا تستحق اسمها، إلا إذا اهتما بالمعطلين عن العمل والمياومين والمهملين والمشردين والسكارى والعرابدة والعاهرات والمقموعين والجوعى والمتروكين لحالهم في أحياء الصفيح والسكن الاقتصادي، وبعمال المناجم ومقالع الأحجار والرمال، وسكان الفلوات القاحلة والجبال الباردة. قدرهما الوحيد هو أن يستوحيا حكيهما وصورهما من العوالم التي بلا اسم، ولا عنوان، ولا بوصلة، ولا خرائط، وأن يرفعا كؤوسهما المعتقة في صحة الكسارى والخائبين والمهزومين، وهما يعلنان انتصارها لجميع هؤلاء ضد العالم المخملي الساكن والمطمئن.
لا بد من الإشارة إلى أن القصة القصيرة، حتى وإن كانت لا تهتم في الغالب إلا بالهامش، فإنها تنسج منه حكايات وقصصا، كما تنسج النساء بالخيط والإشفى طرزا بديعة من القماش والصوف. تُحوّل المهمل والمهجور والقبيح والشائن والشنيع إلى دِنَانٍ مترعة بالكلمات والعبارات والمجازات. من هنا، كانت القراءات القصصية، في ملتقى زاكورة الأخير، تنهل من مآسي الأرواح المنكسرة والمصائر المحطمة، ومن ضجيج الأحياء المتداعية والأرصفة المشقوقة وباقي الأمكنة الرثة البالية، ومن الندوب القديمة والجراح الغائرة، خيالات وصورا ترمّم الواقع المتهاوي وتعيد تركيب أحداثه، بحثا عن حقيقته الضائعة: حقيقة امرأة بلغت خريف العمر قبل الأوان، وحقيقة رجل ضائع بين إكراهات الحياة ووعود أيديولوجيات اليمين واليسار الواهية، وحقيقة أرض استنزفتها مشاريع براقة تمضي إلى نهايتها المفلسة مثل السراب… باختصار، هي حقيقة واقع تنكسر آماله الهشّة، مثلما ينكسر الفخار، كما يقول الشاعر محمود درويش.
فكر الهامش
دشن ملتقى زاكورة نقلة نوعية في فعالياته الأخيرة، وهو ينحو منحى التفكير في بعض القضايا الإشكالية الكبرى في المغرب، إذ فتح النقاش حول ‘الثقافة والرقابة’ في دورة 2019، وحول ‘مساهمة المثقفين في الحركات الاحتجاجية’ خلال دورته الأخيرة (2023). تبدّت من هذا النقاش، الذي أدارته الإعلامية فاطمة الإفريقي في الدورتين المذكورتين بمشاركة باقي المشاركين في الملتقى، رسالتان جوهريتان على الأقل هما: أولا، إعادة التفكير في النظرة السلبية إلى موقف المثقف مما يجري في الفضاء العمومي وما يشهده الشأن العام من تحولات كبرى، خاصة خلال السنوات العشر الماضية؛ وثانيا، الإقرار بدور الثقافة المركزي، تنظيرا وإجراء، في مواكبة هذه التحولات، وفي طرح الأسئلة الجوهرية حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة، وفي الكشف عن منزلقات القرار السياسي والاقتصادي، الخ.
ومن المواقف الأساسية، التي برزت من رحم هذا النقاش، مساءلة تهمة التخلي أو الانسحاب التي يواجهها المثقف، كلما كانت هناك فترة مفصلية في تاريخ البلد، خاصة في جانبه السياسي. لماذا يُحَمَّل المثقف وزر فشل القرار السياسي والاقتصادي الذي لا يشارك في صنعه وإقراره؟ في الواقع، لا يتمتع المثقف إلا بدور هامشي في المشاركة السياسية، سواء داخل مؤسسات الدولة أو داخل الأحزاب السياسية. وحتى اقتراحاته النظرية والفكرية لا تؤخذ بعين الاعتبار، أمام سطوة السلطة المالية والاقتصادية التي لا تنظر إلا إلى جانبي الربح والخسارة في كل اقتراح. من هنا، لا يمكن أن تكتسي أدوار المثقفين ومواقفهم أهمية ما إلا إذا وجدت شريكا سياسيا واقتصاديا يشاركهم النظر إلى تاريخ البلد ضمن مقاربة حضارية واسعة، ولا يكتفي بالنظر من زاوية الكسب الفوري المباشر.
في الواقع، يمكن لمختلف الهوامش المغربية، على غرار الخيار الذي أخذ ملتقى زاكورة يؤسسه بوعي، أن تنخرط في نسج خطاب ثقافي وحضاري، من شأنه أن يشكل مرجعية نظرية وفكرية لنقد الاختيارات الراهنة ووضعها موضع تساؤل، ولتأسيس ممارسة حضارية وتاريخانية تراهن على أفق سياسي وثقافي وإنساني يحترم وجود الإنسان المغربي، كيفما كان انتماؤه ووسطه وهويته وقناعته. إن هذا الخطاب لقادر على أن يبني نوعا من التوازن بين الهامش والمركز، بين الأنا والآخر، بين الفقير والغني، بين السلطة والحركات الاجتماعية… بل أن يلغي المسافات الفاصلة بين هذه الثنائيات المتضادة.