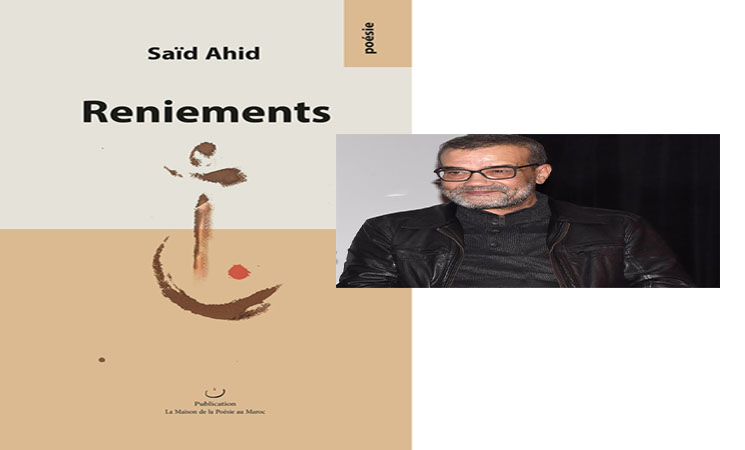أستعير جزءا من هذا العنوان من الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري ومن كتابه « ميتافزيقا الأنقاض «(1).
وهو يعني بالأنقاض ما تخلّفه البراكين و الأوبئة والكوارث و الحروب والغوائل..في واحدة من أجمل المناطق الأروبية : إيطاليا في القرن 16 و 17 م .
إنها ميتافيزيقا تبحث في ما وراء الفيزيقا . في عمق الأسئلة التي تتجاوز ما هو قائم كائن للغوص في ما هو رسوم وأنقاض ودمار وخراب ، فيما تلاشى وبات متواريا ، خفيا ، مضمرا .
ميتافيزيقا تسائل أسفار ومغامرات فنانين من فرنسا في نفس الحقبة ، قصدوا في ضرب من الحج والتعبد و التنسك بعض المدن الإيطالية وعلى رأسها روما ثم نابولي ثم فينيسيا … للوقوف على خرابها و قفرها آنذاك . لكن هذه الميتافيزيقا لا تهتم بالكوارث كموضوعات في حد ذاتها بقدر اهتمامها بصباغة ورسوم هؤلاء الذين رسموها ورسموا مخلفاتها و أنقاضها …
من هؤلاء الفنانين ن . بوسان و ج . كايو و ك.جيلي ولكن أساسا د . بارا و ف . نومي . يطلق عليهما اسم مشترك هو «مونصو ديسيديريو» يعتبره م . أونفري «شخصية مفهومية»………..
……………..في مسار آخر وبعيدا عن الكوارث والمواجع، قريبا من الحياة اليومية وتجدّدها وتغيرها وتبدّلها، يتسكع الفنان علي البزّاز في أحياء المدينة القديمة للرباط ( الملاح ) والأحياء الشعبية ( المحيط ) ليلتقط أشياء عافها الناس وزهدوا فيها وأعرضوا عنها فتخلصوا منها في شكل قمامة وبقايا ومخلفات ما يشبه الإصلاح المنزلي المعماري الداخلي : إطارات ، نوافد، طاولات مهترئة ، أبواب أكل عليها الدهر و شرب …
يمكن تلخيص جزء كبير من التجربة التشكيلية للفنان علي البزّاز في هذه العبارة : « البحث عن الآثار المتبقية في مخلفات الإنسان ومتلاشياته، تقشيرا وتنقيبا وتدويرا ، من أجل الكشف عما هو جميل فيها أي عما هو إنساني ..»
ومفاد ذلك أن هناك في الكتابات و التأملات الجمالية إقصاء مضاعف لقيمة القبح . أولا كشيء تندب الجماليات نفسها لمحاربته والقضاء عليه، وثانيا كقيمة غالبا ما ننساها في ثنائية القيم .والحال أن القبح والجمال كالأسود والأبيض والخير والشر . لا تستقيم الثنائية إلا بطرفيها .
إن تسامح الجماليات لا يجب أن يتأسس على الإلغاء والنفي والإقصاء لأن القبح هو الوجه الآخر للجمال، والشر هو في ما وراء الخير والأسود هو البياض فاقدا نوره .
كل النظريات الفنية، بدءا من المحاكاة ( ميميسيس )، لا تروم سوى الجانب الجميل والخيّر والمضيء في الشيء وتنسى الشيء في حد ذاته لتعلي من شأن النسخة .
عكس أولئك الذين يبجلون الطبيعة و جمالها ، ينتمي ش. بودلير إلى الموقف الهيجلي الذي يعتبر الطبيعة غفلا من كل جمال ووعي . يقول بهذا الصدد» الطبيعة قبيحة .أفضل وحوش ومفازات خيالي على سخافاتها الوضعية «، وهي ليست قبيحة فقط بل قاسية أيضا . لهذا فهي غريبة يمكنها أن تمنح الجمال كما يمكنها أن تفرز القبح .
يؤمن بودلير بوجود ثنائية داخل الجميل الواقعي ويرفض ترّهة الجميل المطلق أو فكرة الجميل .وثنائية الجميل الواقعي تنفصم إلى جميل يولّد الفرح والانشراح والحيوية وإلى قبيح يدخر الحزن والاكتئاب والخمول « الجميل أفق لازوردي و عماء غور جهنمي في آن واحد «. بعبارة أخرى « الجمال هو دوما أمر غريب ، و لا أعني – يقول بودلير- أن غرابته إرادية باردة مقصودة و إلا سيكون وحشا قد أخطأ طريقه في الحياة ، إنما أقصد أنه يتضمن في ماهيته دوما نوعا من الغرابة اللاإرادية اللاواعية . وهذه الأخيرة هي ملح جماليته .» من هنا ميتافيزيقيا الفن : فهو نهائي ولانهائي في آن واحد ، يتراوح بين الإله و الشيطان بين السماء و الأرض .. وحصول الانسجام في هذه المفارقات الغريبة هو ما يوطد الفن كانتصار غير مرتقب للجمال الذي يروق الإنسان .
الفن الإنساني يملك قدرة باهية لتصفية القبح والسماجة والوحشية ، مثلما تشفي النار من الأمراض المعدية .
سمة هذا التصور هي حداثة بودلير التي هي بسعة حب ما هو زائل وزمني مدعوما بحلم قديم لا يعدّ و لا يحصى . (2)
« أيها الجمال ،
هل جئت من علياء السماء أم خرجت من جوف الهاوية.
رؤيتك الإلهية و الجهنمية ،
تسقي دهاقا الرحمة و العذاب ،
لذا يمكننا مماثلتك بالنبيذ .»
(شعر بودلير)
المحاولات الجمالية الحديثة كمبولة دي شان وإرساء أو تهيئة البراز أو تجميع القمامة و ما شابه ذلك ، تندرج ضمن ردود الفعل الطلائعية التي تعمل جاهدة على تجاوز الانحباس الفني التراجيدي الذي آلت إليه الجمالية السائدة بكل تلويناتها . بمثل هذا الطموح يمكن ، ربما ، تفسير بعض مواقف ما بعد الحداثة حين تنحو نحو القديم و العتيق إبداعا، وحين تعتبر الترميق إوالية فنية إبداعية.
يجوز تأطير اختيار الفنان علي البزّاز لتيمة «الأبواب القديمة « المهترئة المتخلي عنها في القمامة وهوامش المدينة وعلى قارعة الطريق .. ضمن هذا السياق . سياق البحث عن الجمال في قلب القبيح وعن الخير في صلب الشر في
المتلاشيات والمخلفات القبيحة أو تلك التي تصنف في قائمة القبح .
لماذا اختار الفنان علي البزّاز البحث عن هذه الأشياء وفيها بهذه المواصفات؟؟
إنها أشياء متخلى عنها . لم يعد من ورائها أي نفع يرجى .الإهمال مصيرها . كل دلالات هذه الأوصاف والأحكام تحيل على حكم واحد مضمر هو «القبح». أي عدم النفع .و عدم الرضا و الاشمئزاز من القديم الذي نتخلى عنه طواعية . ولأن الفنان يستطيع أن يرى ما لا يراه عامة الناس، و يستطيع أن يحول أحكام العامة ويغير من فداحتها ،اختار شق هذا الطريق بهذا النوع من المغامرة عبر عملية «التقشير» .
تقشير النصوص الأدبية والفلسفية هي عملية نقدية تنتمي إلى فكرة «معول» التفكيك كما أرصاها ج . ديريدا حين افترض أن النص طبقات متعددة فيها المركز والهامش ، الترقيم والتوضيب ،الإحالات والاستشهادات ،البياضات والهفوات ،الشعور واللاشعور …مثلها مثل طبقات الخشب المكون للباب وطبقات الصباغة الملونة له ، للوقوف على الخشب في بدايته وتكون ذاكرته . وعلى مزج أمشاج من تلك الطبقات في أخرى بالحفر تارة والكشط تارة أخرى، تتحول تفاهة الباب إلى شيء جميل إلى شيء دال إلى لوحة جديدة جميلة تفتح على مصراعيها للأحلام وللذكريات كما تفتح الأبواب . كل ما دخل وخرج منها لما كانت بابا تحول على يدي الفنان إلى لوحة رصت فيها ذكريات وأطياف وأثلام آثار، ذهابا وإيابا ….
إن هذا الحفر في طبقات صباغة الأبواب يتم بحثا عن الأثر . وهذا الأخير هو ما يسمح بقيام الدلالة، فهو يحافظ على أثر العنصر السابق المؤثر فيه وينقله للاحق عليه ، سواء كان العنصر لفظا أو صباغة .
الأثر ليس غيابا ولا حضورا إنه بين بين . ضرب من البينونة تذكرنا بسيمولاكر أفلاطون إلا أنه حقيقي وهذا مزيف في جانب منه . الانمحاء هو خاصيته البنيوية لأن ماهيته فارغة غير ممتلئة ، لا شيء فيه سوى بقايا رسوم أو صباغة أو أثلام خشب. الأثر يوحي بالقرب الذي تركه مؤثر بعيد ، إنه «كالهالة» كما وصفها والتر بنيامين ،»ظهور بعيد أفرزه ما هو قريب «. الأثر يوهمنا بامتلاك الشيء في حين تحسسنا الهالة بامتلاكنا من طرف الشيء .
الأثر في الفن يشكل البقية وهو اسم آخر للكتابة عند ديريدا يتجلى في الخطية كما يتجلى في الصباغة . البقية ليست هي حضور الشيء ولا حقيقته، إنما هي الأثر المتروك وكأنه مستغنى عنه لا قيمة له و الحال هو الذي يحرك العمل الفني والأدبي . إنه ما يعود ويبقى . حقيقة الباب التي يبحث عنها الفنان علي البزاز هي ذاكرته ، وهي صنفان :
ذاكرة الاستعمال منذ صناعة الباب وتركيبه
وذاكرة تكوينه ونموه منذ بذرته إلى استخراجه من ماهيته .
هذه الأخيرة كذاكرة حين تتماهى مع طبقاته و أثلامه يمكننا قياس عمر الخشب . الأثران المتبقيان على مادة خشب الباب هما حقيقته ، هما الوشم والرسم . لمسات الفنان لا تضيف شيئا للباب الذاكرة ، بل تبحث تنقب وتقشر فقط أي تبحث عن البقية .
ما يعتقده الناس تافها، يحمل في طياته قيمة جمالية متبقية، لا تكشفها سوى عين الفنان، هذه العين تعبر عن الحقيقة بطريقتها الخاصة هي إظهار ما كان خفيا غير مرئي، وإزاحة الغلالة التي أتى عليها الدهر والنسيان واليومي .لا ننسى أن الحقيقة في الفن هي الوجه الآخر للشيء . أي شيئيته .التي تصدّ الرؤية وتحجبها وهي تتراوح بين إفشاء وإخفاء ما هو حميمي أي ما يسميه فرويد «الأونهايمليش». الباب يفتح الحقيقة ويغلقها على اللذة والمتعة.
فيهما يبحث الفنان عن غايته لا بالوقوف مليا على الجمال والجمالية، وإنما بالتركيز على إناسة العملية الجمالية برمتها، فما يبقى يؤسسه الإنسان الفنان .
============
1-Michel Onfray. Metphysique des ruines.livre de poche.
2-Claude Stephane Perrin.Beaudelaire .Une esthétique de la modernité.sep.2012.
3-Beaudelaire.Ecrits sur l art.livre de poche.1999.