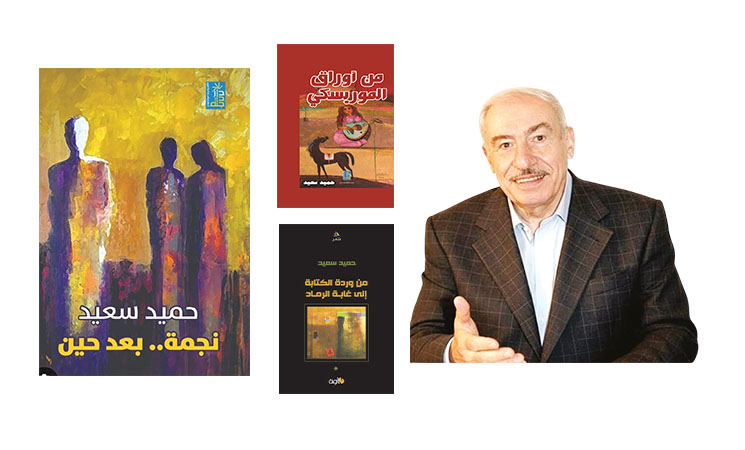من بين الإشكالات الكبرى التي نلحظها في عدد كبير من الدراسات الإسلامية «الغربية»؛ أنها عادة ما تسقط في فخ «العمومية» تارة، أو في فخ «الشمولية» تارة أخرى. وهذا الأمر يبدو جليا في كثير من الكتابات الغربية التي تتعلق بالتصوف، والتي يفتقر مؤلّفوها إلى خبرة كافية بالأدبيات الصوفية.
أبلغ مثال على ذلك، ما دونه مايكل كوك في كتابه الضخم: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي» (910 صفحة من القطع الكبير في ترجمته العربية. إذ عرض كوك – في صفحات قليلة تحت عنوان «استطراد» – لما يتعلق بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن الـمنكر عند الصوفية (ص 646- 658)! على الرغم من مركزية هذه القضية في الفكر الأخلاقي الصوفي من جهة، وعلى صعيد الممارسات العملية للمتصوفة من جهة أخرى.
ومع أنه اعترف صراحة بكونه «غير معتادٍ على قراءة الأدب الصوفي، «لذا سيجد القارئ مصادري لهذا الفصل قليلة نسبيًّا، وفهمي مفرطًا في التبسيط»[3]، إلا أنه مضى في بحث المسألة بطريقة ساذجة جدًّا، كما قام بفصل الاقتباسات القليلة التي استشهد بها عن السياقات العامة للمنظومة التربوية الصوفية؛ ما يفسّر إشاراته المتكرّرة إلى أن «فلانا» لفت انتباهه إلى هذه المقولة أو تلك. وفي الواقع لا يملك قارئ هذه الصفحات القليلة سوى أن يتساءل عن سر إقحام كوك نفسه في تخصص علمي دقيق لا علاقة له به من قريب أو من بعيد؛ باستثناء رغبته في بحث موضوع الكتاب في فروع “الفكر الإسلامي» كافة.
أحكام عامة
لكن الإشكالية الكبرى في مقاربة كوك هذه لا تكمن في ما سبق فحسب؛ وإنما في كونه سارع إلى تقديم العديد من الأحكام العامة التي تنسحب على الفكر الصوفي الممتد لأربعة عشر قرنا، ومن قبيل ذلك قوله: «والحق أنَّ التصوف مفهومٌ غامضٌ وفضْفاض، ويجب أن يظلّ كذلك». أمَّا أنَّ التصوُّف مفهوم غامض، فهذا مما لا شك في عدم صحته، فقد عرّفه أصحابه وقعَّدوا لأبرز مسائله منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وأمَّا القول بإن التصوف مفهوم «فضفاض ويجب أن يظل كذلك»، فليس صحيحًا أيضًا.
الأغرب من ذلك قوله تاليا: «وواضح أنّ الصوفية لم يكونوا مجموعة كالفرق ومذاهب الفقه التي اعتبرناها، [حيث] يمثلون بالأحرى شكلا من التدين لا تحتل فيه الشريعة ولا السياسة المرتبطة بالدين مركز الصدارة»! وهذا القول بمفرده كفيل بأن ينسف مقاربة كوك برمتها، فالتصوف الإسلامي نشأ ونما في الأساس معبّرا عن المثل الديني الأعلى، ولذلك حرص شيوخه الكبار على ربطه بالشريعة، على نحو ما هو مبثوث وبكثرة ضمن تضاعيف كتابيْ اللُّمع للسراج الطوسي والرسالة القشيرية بصفة خاصة. لكنّ الغرض الرئيس الذي كان سببًا في تصدير كوك الجزء الخاص بالتصوف بكلامه هذا، يرتبط ارتباطا مباشرا في حقيقة الأمر بالنتيجة النهائية التي يود أن يصل إليها؛ ألا وهي قوله: «لا يشكّل التصوف في أيٍّ من المجالين؛ الشَّريعة والسّياسة- حيث النَّهي عن المنكر بندا مهما – عنصرًا أساسيًّا في التصوُّف في حدِّ ذاته».
ولا أدري كيف يستقيم قول كهذا مع الأسباب السّياسية والاجتماعية والدّينية التي دفعت في اتجاه تنامي حركات الزهد إبَّان عهد الفتوحات الإسلامية؛ اعتراضًا على ما أصاب المسلمين من أخلاق الدّعة والتّرف والانهماك في ملذات الحياة الدنيا؟.. لقد نشأ التصوف في الأساس تعبيرًا عن الغربة التي اجتاحت الإسلام، كما كان الزهد تعبيرًا عن احتراز وتحفُّظ سلبي إزاء الصّراعات السّياسية التي عمَّقت الخلاف والشِّقاق بين جموع الصحابة، ثم تحول إلى موقفٍ أو حزبٍ سياسي معارض إبَّان الفتنة الكبرى وطيلة عهد الدولة الأموية.
إشكالية النهى عن المنكر
وعلى كل حال يصادر كوك على المطلوب إذ يقول: «لذا لا جدوى من البحث عما يمكن أن ندعوه نظرية الصوفية في النهي عن المنكر. يكفي أن ننظر في فهارس أمّهات كتب الصوفية لنرى أنَّ النَّهي عن المنكر ليس موضوعًا يهمُّهم حقًّا». والواقع أنَّ المعيار الذي ارتكز عليه كوك في تقييمه هو معيار سطحيٌّ للغاية، خصوصًا وأنَّ كتب طبقات الصوفية تزخر بالعديد من النماذج التي تقف شاهدة على اضطلاع المتصوف بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخيًّا؛ ليس فقط في مواجهة رموز السلطة السياسية، وإنما أيضا في مواجهة جموع الفقهاء والقرَّاء وغيرهم من ممثلي وأرباب السلطة الدينية.
صحيح أنه من الصعوبة بمكان القول بوجود «نظرية صوفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وفق المعنى المتعارف عليه حاليا، لكنّ ذلك لا يمنع من التأكيد بأن هذه المسألة قد شغلت حيزًا واسعًا في اهتمامات الصوفية. ويكفي للدلالة على هذا الأمر تفحُّص التفاصيل الصغيرة التي ترد هنا وهناك ضمن تضاعيف تراجم الزهاد الأوائل أمثال: إبراهيم بن أدهم، والحسن البصري، وداود الطائي، وسفيان الثوري… إلخ.
من جانبه شدَّد الحارث المحاسبي (ت 243هـ/857م) على أنَّ الأصل الذي بنى عليه «أهلُ المعرفة بالله» طريقتهم في الزُّهد والتصوف لا يخرج عن حدود «التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق، وتقديم العلم على حظوظ النفس، والاستغناء بالله عن جميع خلقه».
أما في ما يتعلق بالممارسة العملية لهذا الأصل الذي انبنى عليه أمر الطريقة الصوفية؛ فيكفي ما ساقه المؤرخون من إدانة الحسن البصري (ت 110هـ)، التي سجَّلها بعبارة عميقة المعنى، المجتمعَ الذي يُعظِّم جلاديه، بقوله عن الحجَّاج بن يوسف الثقفي: «أتانا أُعَيْمِش أُخَيْفِش فقال بايعوني فبايعناه، ثمّ رقى هذه الأعواد ينظر إلينا بالتَّصغير وننظر إليه بالتّعظيم، يأمرنا بالمعروف ويجتنبه، وينهانا عن المنكر ويرتكبه».
وعلاوة على ذلك؛ فإنَّ اسم الصوفية قد أُطلِق لأوَّل مرَّة في مصر تاريخيًّا على جماعاتٍ كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتتدخّل في شؤون الحكم متصدّية لجور الحكَّام وتعسُّفِهم، وممّا أُثِر عنها في هذا السياق أنها تسبَّبت في خلع بعض الولاة، كأبي إسحاق المُعتصم، أحد ولاة مصر في عهد المأمون العباسي. وبذلك «اقتفى كبار الصُّوفية أثرَ سلفهم في هذه النّزعة العملية، وفي الإيمان بجدوى العمل السّياسي، ولم يمنعهم تصوُّفهم من المشاركة الفعلية في أمور الدُّنيا، واعتبروا التصوف عقيدة وجهادًا».
أخيرا يدفع كوك في اتجاه القول بأنَّ الموقف الصوفي «يركّز على الباطن ولا يحْفلُ بالفروض الظَّاهرة»، وأنَّ «من ديدنه الباطن لا يأبه بفروض الجوارح»[8]، وأنَّ «النهي عن المنكر يأتي في درجة متدنية نسبيا من مقامات سالكي طريق التصوف»، والواقع أنَّ كبار المتصوفة كانوا لا يحبِّذون «المُسارَعة إلى النَّهي عن المنكر»، خوفًا من وقوع المريدين في فخ الكبر أو الرياء ليس إلّا.. وتلك قضية أخرى.