بسبب فيروس كورونا، دخلتُ في عزلة موحشة منذ أربعة أيام. أخرج مرّة واحدة في الصباح لمدة نصف ساعة لأشتري حاجياتي ثمّ أعود لأرتدي بذلة رياضية وأفتح الحاسوب كي أقرأ وأكتب بجنون نادر.
وللأمانة فقد صرتُ شاعريّا ورخوًا في إقامتي الطوعية هذه. ألاحظ ذلك عندما أرفع كأس القهوة وأدنيه من فمي بلطفٍ غير مسبوق. عندما أفتح التلفاز وأسبق مقدّم نشرة الأخبار في إحصاء ضحايا كورونا، فأتألم. عندما أفتح النافذة وأطل على الخواء وعلى قطط غير معنية بالشأن العام فأرتعب. وعندما أقف أمام المرآة وأتخيل نفسي البحتري ينشد شعرًا بطريقته الغريبة في حضرة الخليفة المتوكل المنشغل بمداعبة جارية ذميمة.
انتبهتُ إلى أنني لا أستطيع أن أكتب إلا من وحي الأزمات ومشاهد الخوف والأبواب المغلقة وخيبة حذائي. وقد كتبت لحد الآن ثلاث قصائد من وحي الفيروس اللعين، والذي أنتظر منه أن يتراجع إلى الخلف كي أطرحها. لابدّ أن نكون في مزاجٍ جيد وفي منأى عن شبح القيامة كي نقرأ شعرًا ونستسيغ معانيه. وهناك دائمًا قصائد تدور في الرأس، لكن أجملها على الإطلاق هي تلك التي تنسل على أصابع رجليها وتخرج لتنتدب زاوية مظلمة في شارع عام وتموت بسبب كورونا أو غيره دون أن يبادر أحدنا ويسعفها.
آهٍ على القصائد العظيمة التي ضاعت منّي بسبب سوء التقدير وسوء السريرة أحيانًا، ووصلتُ إلى الصباح خائبًا. ولا أحد منكم فهمني !
مساء هذا اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، سأستحم على عجل ثم أحلق وجهي متعمدا أن أجرحه قليلا كي يخرج الدم وألعقه بلساني. سأرتدي بذلة سوداء تليق بحزن العالم وأتعطر بمبيد الحشرات ثمّ أصعد إلى سطح البيت وأغرس عصا طويلة في كومة رمل توجد في الزاوية. أن أتخيل العصا هي الميكروفون ثم أقرأ شعرًا حزينًا هو الآخر قبل أن أنزل الأدراج وأعود إلى إقامتي الطوعية، والتي صارت إجبارية منذ مساء البارحة عندما تمّ تعميم حظر التجول في المغرب.
سمعتُ أنهم سيوزعون علينا تراخيص الخروج من أجل التبضع. وسيتكلف أعوان السلطة بإيصال هذا القسط من الهواء إلى بيوتنا بمعدل حفنة واحدة لكل أسرة. شعرتُ بضيق في صدري أنا الذي لم أتعوّد على هذه الأجواء التي لم أرها سوى في نشرات الأخبار وقرأتُ عنها في الجرائد. حتّى صوت الرصاص لم أسمعه إلا خدعة في قاعات السينما أيام زمان أو صامتًا يخرج من مسدسات في روايات بوليسية. دائمًا كان لديَّ يقين أن الحرب تدور رحاها في الصحراء، وفي مكان بعيد حيث يموت الرجال بفداحة لتظهر الجرافة بفمها الواسع وتدفن الجثث في قبر جماعي.
ارتبطت الحرب في ذاكرتي بطفل صغير يرشق الدبابة بالحجارة قبل أن يتدخل جندي ضخم ويطلق الرصاص ببرودة أعصاب على الطفل الذي يسقط مضرجًا في دمائه. ويحدث أن تطل من التلفزيون حنان عشراوي أو صائب عريقات أو غيرهما ويقول كلامًا غاضبا قبل أن يحوّل مقدم نشرة الأخبار الدفّة إلى مشهدٍ أكثر سعادة. دائمًا كنتُ مأخوذًا بمشهد الطفل وبنظافة ملابسه أكثر من هؤلاء الذين يحتاجون فقط إلى ميكروفون وقضية عالقة كي يستطيلوا في الكلام. أمّا الجندي الضخم فكنتُ أتخيله يمضغ العلك ويفكرّ في ابنه الذي يلهو بدرّاجة. قرأتُ أن هناك دائمًا من يريد أن تستمر الحرب ويفاوض من أجلها بهذه القناعة الراسخة كي يفتح صندوق جمع المساعدات في المتاجر والسوبر ماركات ويحول الأموال إلى أبناك بعيدة ويتبعها بالطائرة. لا أدري.
هذه فرصة لا تعوّض لأجدد اللقاء بعون السلطة (المقدم) الذي لم أره منذ أن وقّع لي شهادة السكنى قبل ثماني سنوات، أريد أن أحييه بحرارة، من مسافة متر طبعًا، وأشكره بلا سبب. ولا بدّ أن أمنحه عشرين درهمًا دون أن أفكّر على أنها رشوة بقدر ما هي ثمن قهوة عربونَا عن تعاون غامضٍ. هو سيتلكأ في أخذها كالعادة وأنا سأصرّ على أن تستقر في جيبه معبّرًا بذلك على حُسن تربيتي وعلى الحفاظ على جزءٍ مهم من تقاليدنا المغربيّة التي ورثنا أبًا عن جدّ. شخصيا أحتفظ لنفسي بإعجاب كبير تجاه «المقدمين» لأنهم اسم على مسمّى، بل لا أجد فرقًا واضحًا بين تجويف الصحن الهوائي المعلق على سطح البيت وبين تجويف أذن المقدّم سوى أنّ اللاقط الهوائي ثابتُ في مكانه ينتظر مرور سرب من الطيور كي تبزق عليه بينما لا أحد يعرف أين توجد أذن المقدّم، ومتى يطيل هو الحبل ويرمي بأذنه السحرية بعيدًا، ومتى يستعيدها بخفة ويركض ليفرغها في مكتب سرّي ثمّ يعود ليواصل.
إنّها فرصة أخرى كي أتنسك في البيت وأريح نفسي من النوم المتقطع في المقهى. ومن ضجيج مباريات الدوري الإسباني. وكي أحسمَ في مشاريع أسرية طالما مهرتها بالتسويف الذي جرّ عليّ غضب الزوجة وحيرة الأولاد. ولحدّ الآن أنا جيّد هنا، بل أكثر عندما استأنستُ بالمطبخ وصرتُ أحشو الأواني بالصابون ثمّ أفتح الصنبور وأغسل. صرتُ أقشر البطاطس والجزر لأول مرّة في حياتي، ففي اليوم الأول جرحتُ أصبعي وسال دمٌ كثير، وفي اليوم الثاني جرحتُ أصبعًا آخر لكن الجرح كان طفيفًا بينما تحسّن شغلي في اليوم الثالث وكسبتُ ثقة مشغلي الذي ليس سوى زوجتي، والتي من جهتها لم تقصّر في حقيّ واقتحمت هذا الصباح خلوتي وسط بخار الحمّام، فأخذت تحك ظهري قبل أن تطوقني بحصة من الصابون الرخو. كنت جالسًا على كرسي صغيرٍ فأوشكتُ أن أبكي من كثرة الحنان المتساقط عليّ من علٍ لو أن انتبهت إلى أنّني كبرت بما يكفي. واكتفيتُ بإطلاق بولة صغيرة قبل أن أغرفَ الماء بيدي وأدفع بالسائل الأصفر إلى ثقوب البالوعة دون أن أثير انتباه الملاك الذي يحرسني، فقط تخيلتُ نفسي طفلا إفريقيا يجلس على دلوٍ مقلوب أمام البيت المفتوح على طريق متربة أصرخ بين يدي أمّي التي تمرغّ جسدي بالصابون وتغني في أذني أغنية قديمة، وهناك دراجة نارية تمرّ بالجوار.
هذه فرصة من ذهب (أو من قصدير؟) لأنتبه إلى أطفالي، وإلى لعبة التراشق بالمخدات التي لم تنقرض بعدُ من بيوتنا المغربيّة. ومن باب التنويع كي أطلّ من ثقوب الشباك على فراغ الزنقة 4 بين وقتٍ وآخر، وأتذكر بغصّة سجناء الرأي العام وناشطين حقوقيين في زنازين السجون المعتمة. وأيضًا قتلة ولصوصًا والذين لا بدّ لهم أن يبقوا هناك.
يوميات الشاعر حسن بولهويشات في الحجر الصحي : أتعطّر بمبيد الحشرات

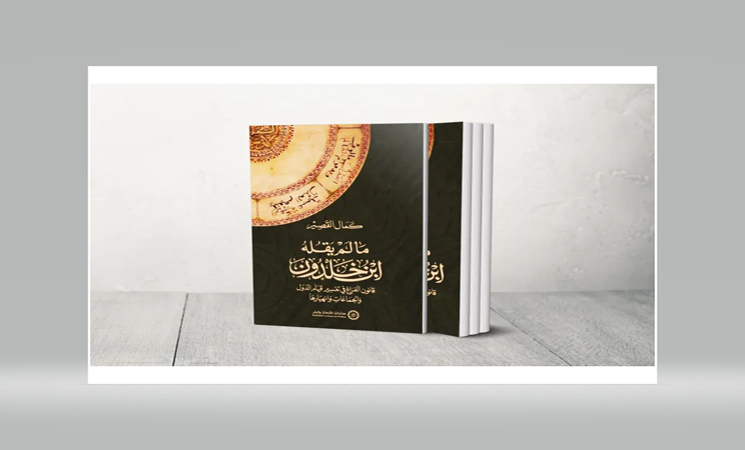





اترك تعليقاً