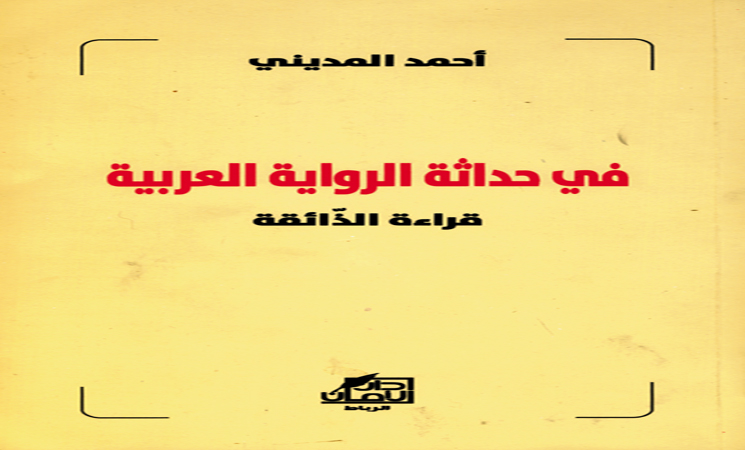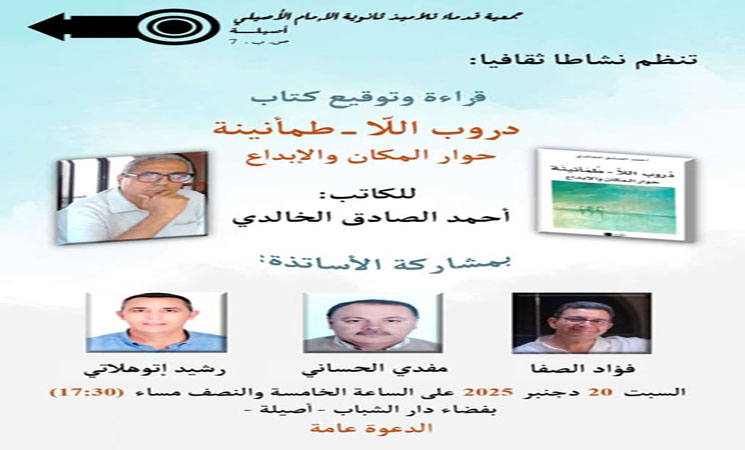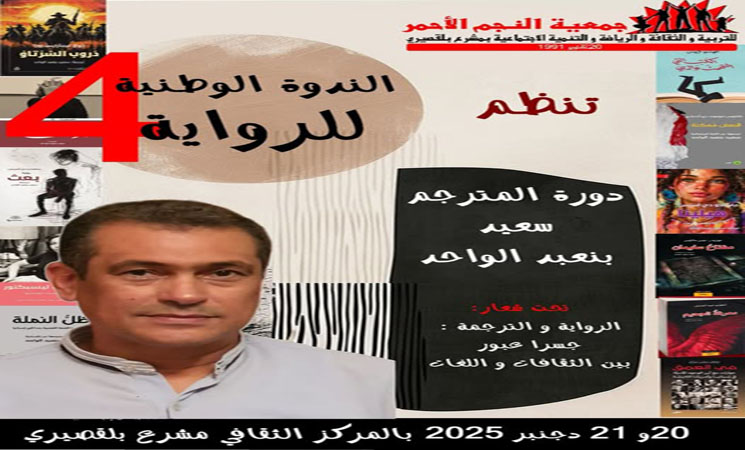نحو خطاب جديد عن الحداثة الروائية

امتدادا لأعمال نقدية سابقة، رصد فيها تطور المتن السردي العربي وتحولاته النوعية في المشرق والمغرب على ضوء مفاهيم شكلت روائز في مشروعه النقدي أهمها: المغايرة ، الاختلاف، الحداثة، التجريب والتحول، صدر حديثا للكاتب والروائي والناقد أحمد المديني كتاب نقدي جديد موسوم ب «»في حداثة الرواية العربية: قراءة الذائقة»» عن دار الأمان بالرباط.
الكتاب امتداد لمسار الناقد في الحفر في أركيولوجيا الرواية العربية التي ساهم فيها، كتابة وتنظيرا، ما بين قصة ورواية على مدى خمسين عاما، انْهَمَّ فيها بالتجديد ومقاربة التحولات السردية في الرواية العربية، وما تطرحه من قراءات جديدة تمتد من التاريخ الى السرد ثم الوظيفة فالقراءة، ثم الذائقة موضوع هذا الكتاب الأخير والتي تتحصل بالقراءات المثابرة وتنتج ما يسمى بالمتعة «متعة النص».
دون الخوض في تحديد مفهوم الحداثة والتباساته التي لم تنجح التجارب الروائية العربية في ترسيخها في بيئة عربية لها سياقاتها التاريخية والاجتماعية والسياسية عكس تربة منشئها الغربية التي أسست لها معالم التحديث علميا وصناعيا، ومهد لها عصر الأنوار، فلسفيا وحقوقيا، يقر أحمد المديني وهو يقارب حداثة الرواية العربية في كتابه الأخير «في حداثة الرواية العربية: قراءة في الذائقة» أن» الحداثة حداثات، ومن العسف حبسها في معنى وتقييدها بخصائص نهائية مطلقة» ص : 28، مؤكدا أن ما يدفع الى القول بهذا التعدد «زيادة على تنوع الاختيارات الجمالية والرؤى الاجتماعية والإنسانية في أدبنا الحديث، هو التدافع والتهافت على كل جديد من آفاق أجنبية «دون التعمق المعرفي والحفر الجمالي في مناجم الإبداع الأدبي بما يسهم في دعم الصرح التنويري والتحديثي».
لقد راهنت الحداثة، في شقها الإبداعي عموما والروائي خصوصا، على رواية عربية تتجاوز طرائق السرد وأشكاله إلى ملامسة القضايا الحارقة والمتجذرة في تربة اليومي العربي، بلغة تستوعب التحولات الحاصلة وتخلخل البلاغة المحنطة، بميلها نحو تدمير جميع ثوابت الشكل التقليدي الروائي، لكن المديني يطرح بخصوص هذه النقطة تساؤلا استنكاريا حول هذا التدمير أو القطيعة التي أنتجت لنا «حداثة كيفما اتفق»: «كيف نمحو أو نلغي بضربة لازب ما قدمت أيدينا، لن يكون ذلك جحودا لعمل أسلاف رواد، وتبخيسا لتراكم لا يستهان به، هو على كل حال ما نملك وبه نواصل» ص 30.
يسوق المديني للتدليل على تعدد الحداثات بأن ما كتب في نهجها وبشكلها ومحتوياتها، عربيا، مراتب وطبقات، سواء في السرد أو الشعر لكن للأسف لم يوازه «تحديث يبرهن على انتسابها إليه، انتساب هوية وتمثيل وتأريخ لزمن» كما حصل في الغرب.
يصر المديني، وهو يعرض للحداثة الروائية العربية، على ضرورة الترابط بين بنية النص ودلالته وأفق تفكيره، معتبرا أن الحداثة الروائية «بنية واحدة لا تتجزأ أو يقع ضمنها الانتقاء، تمتح من معين واحد، مبنى ومعنى»، وهذا في نظره «أحد الأعطاب الكبرى للإبداع العربي الحديث» ص: 42 لأنه إبداع يوغل في التجريب الى أقصاه في محيط اجتماعي وثقافي غارق في التقليد، ما يدفعنا إلى التساؤل، مع المديني، عن إمكانية إنتاج خطاب جديد قبلي في» أدب متعدد الروافد ومتفاوت النشأة والتطور» عن الحداثة والحداثة الروائية.
إن التناول النقدي للنصوص يقتضي، بجانب التوفر على عدة منهجية وأدوات مفهومية وجمالية ، حسب الناقد أحمد المديني، الإلمام والاطلاع والقراءة ، هو الذي يُخضِع أعماله النقدية لصرامة المنهج، بعيدا عن الإنشائية والانطباعية السهلة، مستفيدا من المدارس والتيارات النقدية التي تعلي من قيمة النص، لأن «النص الحداثي ليس المجدد فيه، فقط، بل هو ما تخلقه كذلك قراءة حداثية».
إن المسار القرائي المتعدد والنقدي المتجدد للمديني، بقدر ما سمح له بفهم الأدب وتذوقه وتحديد رؤيته الذاتية للنصوص، و إعادة ابتكار الحياة بوعي جديد، جعله يعلي من قيمة قارئه، بعيدا عن أية وصاية أو أبوية: «إليه عملي يتوجه…لا لأعلمه، فكل قارئ ملكاته وقدراته ترشده لما يقتني». ص32.
يعتبر أحمد المديني أن قراءة الذائقة الأدبية هي المرحلة القصوى في مسار الدارس والناقد، إذا ما استحضرنا أن هذا الناقد يتكئ على ثقافة نقدية وتراكم قرائي يصدر عنه ويحقق لقرائه ، عبره، متعة متابعة ما يخضعه للتحليل والتنظير.
إن الناقد، وهو يقرأ الذائقة، يجب أن يكون مستقلا عن سلطة المؤسسة النقدية حتى وهو داخلها، ليتخذ موقع القارئ المحترف أي أنه في الوقت الذي يُخضع النصوص لأدوات النقد المعيارية، يجب أن يحتكم الى ذائقة قرائية متمكنة، ذائقة قارئ مثابر على القراءة.
إن المتعة القصوى لا تتحقق في العمل النقدي إلا إذا تحرر الناقد من سلطة المؤسسة، ومن جبة الأستاذية التي يتمسك بها ناقد التصنيف والتجريد والأحكام ، وتحول الى قارئ محترف، سيد حر ومختلف، أي أن يصبح له في القراءة النقدية ما يطلق عليه الناقد أحمد المديني «ذائقة الفسحة والدليل» التي تسمح له بالإنصات إلى النص وهو «يغرد وحده مع السرب وبدونه، غايتي وأنا أستمتع بحداثة لحنه، فرز الصحيح من النشاز، ولن أحكم عليه، سأقول ملء فمي، بأكثر من طريقة، يعجبني أو لا يعجبني» ص:35، والحكم عليه انطلاقا من «ملكة الذائقة».
هذه المقاربة لا يقصد بها المديني العودة إلى الاتصال البسيط مع النص الأدبي في حدود التلقي الدنيا، وربط هذا الاتصال بذاتية محض، منفصلة عن المعايير والقواعد النقدية المؤسسة ، بل إلى جانب هذه المعايير البانية للنقد يجب أن تحضر الذائقة التي يسميها المديني «الحاسة السادسة « للناقد الأدبي، والتي بافتقادها لا يعدو أن يكون من «بين عشرات شرّاح يتناوبون على قراءة نص، وينتقلون إلى غيره بقياسات آلية ومجسات باردة لا تصل إلى جوهره، روحه، ما يميزه حقا ويصنع أدبيته الداخلية «ص: 36.
إن الكتابة النقدية لابد أن تنطلق، إذن، من «تذوق» تسنده القواعد والأحكام والمنهج، كما أن الحديث عن الذائقة الأدبية يتطلب استحضار أطراف العملية الثلاثة: الكاتب والنص والقارئ. وهذه العلاقة التكاملية بين هذه المكونات الثلاثة لتشكيل الذائقة والارتقاء بها لا تتم إلا عبر عملية القراءة التي تشكل وعينا الذي يعمل على تدريب الحواس والتي بمقدورها – في حضور هذا الوعي- أن تؤسس لما يمكن تسميته بـ»أفق التوقعات». لهذا يعتبر أحمد المديني أن هذه العلاقة «ليست اعتباطية خاضعة للصدفة، أي متأتية من قدوم ناقد مؤول عابر أو قارئ زائر بالصدفة»، وأن « القراءة عند الطرفين عملية هادفة، تتجاوز الاطلاع على العمل الى ما بعده، وهذا الأخير هو ما يحدد مصيره، بالبقاء والتلاشي من الذاكرة وبعدها لن يندرج في سجل الذاكرة» ص 33. كما أن القارئ هو من يمنح الخلود للنص، سواء كان قارئا عاديا يمكن أن يكون شريكا في كتابة النص واستكمال ملء البياضات التي تركها الكاتب قصدا، أو قارئا ناقدا ذا خبرة «وعشرة مع النصوص وطول مراس في التنظير والتحليل». بل إنه في تركيزه على مسألة الذائقة، يؤكد أن امتلاك الذائقة من عدمه يزيد من تعقيد وضع الناقد الأدبي، «إذ لا يكفيه أن يتسلح بالثقافة المطلوبة لمقاربة مادة عمله، باختبار عدته،» ما لم يتوفر على منظومة من المفاهيم والمقاربات والتصورات والتمثلات ضمن شبكة علائق معرفية وأدبية وخبرة إنسانية.
يقدم المديني في هذا العمل النقدي الجديد آراءه وتأملاته في حداثة الرواية العربية، عبر تقديم نماذج تمثيلية لها من الرواية العربية والمغربية، كقارئ محترف وليس كمنظر يقرأ بنظارتي المعايير الأدبية الصارمة، ومقتضيات ما يتحكم في الكتابة السردية التخييلية فقط، لكن كقارئ «متخم بعقيدته الحداثية، يجرؤ على المس بقدسيتها، سواء كانت قائمة، مفترضة أو متوهمة». يحاور بجانب عمله النقدي، النصوص المجددة، في أشكالها ورؤءاها والمفهوم المتولد عنها عن الأدب، نصوص توفر المتعة ولها قلبية قراءة توافق ثقافة الناقد، وأخرى توفر اللذة وهي النصوص الخلاقة التي تنزاح عن اليقينيات المكتسبة. وهكذا يتناول في متن القراءة والتحليل «ذاكرة أنا الشاوي ومتحف مرابع السلوان»،» التركيب والنسق التعبيري في رواية وحيد الطويلة»، «الميلودي شغموم: كاتب وجد أسلوبه»،»عبد اللله ساعف روائيا: مأزق الكتابة بين التاريخ واحتمال التخييل»، «الخالة أم هاني التاريخ والمخيال الاجتماعي»،» السيرة الذاتية العربية بين المعيار والانزياح»، «رواية الدكتاتور في «آخر الرعية و» في بلاد القائد»،» المشاءة بين تيمة العنف والكتابة الخلاقة»، وفي باب القراءات المونوغرافية نقرأ عن « لعبة الباروديا في السيرة العطرة للزعيم»، «حجي جابر يتفوق على «رامبو الحبشي»، «كوفيد لطيفة لبصير»، «حفريات طارق البكاري في تضاريس الهوية».
كما يتطرق في باب قضايا أدبية في صلب الرواية الى «ملاحظات نقدية حول رواية عربية معطوبة» «في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ»، «في ذكرى رحيل محمد زفزاف»، «ما هو النقد الأدبي»؟ «نحو تمثيل جمالي للأدب المغربي».