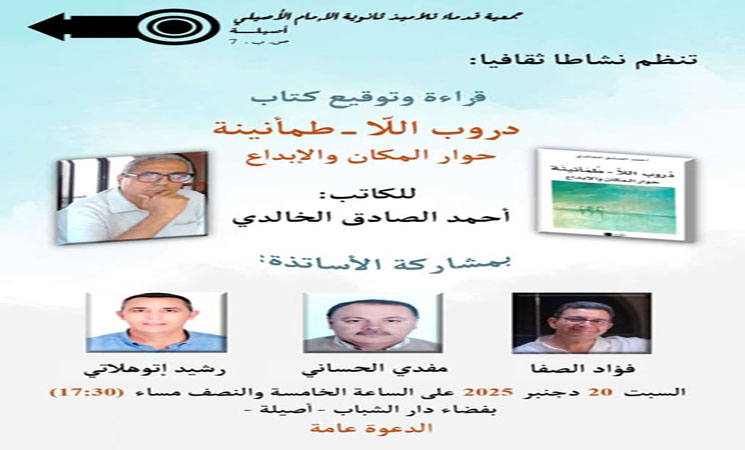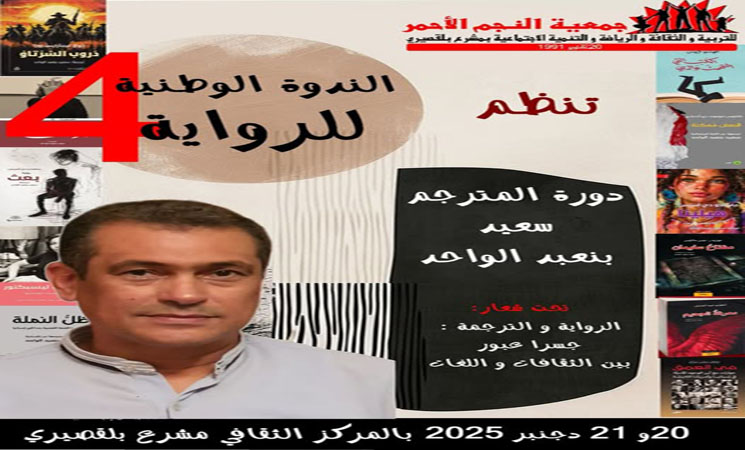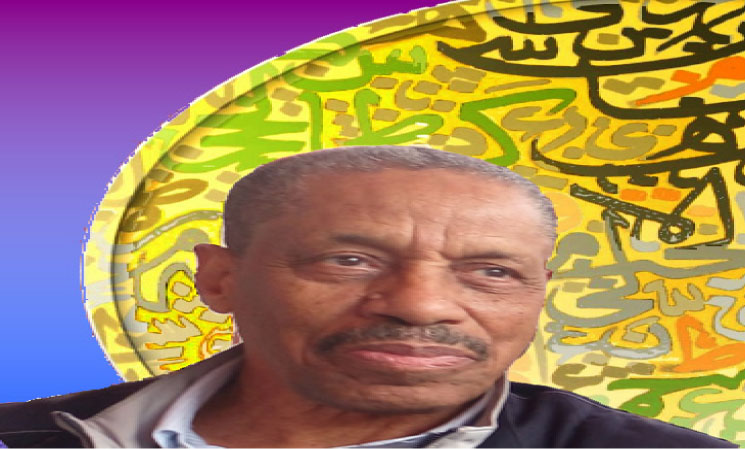ذيوع التجريب الفني واللغوي والتخييلي والبنائي سبعينيا في القرن الفائت، الذي طال الشعر والقصة والمسرح والرواية والأغنية، والتشكيل، وانفجاره ثمانينيا بالمعنى التطويري، قاد إلى خلخلة البنى المسكوكة، ومساءلة حاضر وواقع المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا.
مرحلة زمنية اتسمت بالخذلان والخيبات، وتراجع الأحلام، والحريات، والديموقراطية. وإذا كان الشعر المغربي السبعيني الحديث والمعاصر فتَّح عينيه واسعا على تلك الحرائق والمطبات والانكسارات، فإن الثقافة المغربية الموضوعاتي لا الموضوعي، وتوجهها التبريري، وتيماتها المعرفية الموطوءة ـ إلا في ما ندر ـ استمرت تقليدية تقف سدا منيعا أمام الجديد، وتقاوم بشراسة تلك التبدلات الفنية التي اعتبرتها ضلالة وبدعة ومروقا، وخروجا عن ” الجماعة”، و” النظام العام”، و”الصراط المستقيم”.
كان عبد لله العروي، ومحمد عزيز الحبابي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد برادة، ومحمد السرغيني، وأحمد المجاطي، وعبد الكبير الخطيبي، وعلي أومليل، وأحمد المديني، ومحمد زفزاف، وإدريس الخوري، ومحمد شكري، وعبد اللطيف اللعبي، ومحمد مفتاح، ومحمد بنيس، ومحمد الأشعري، وآخرون محسوبون، قد شرعوا في تكسير ” الطابوهات “، بالتضييق المنهجي والمعرفي والإبداعي، لتحجيم حضور تقليدانية الفكر السائد، ورجعية وماضوية منطلقا وأهدافا.
مع الحداثة الفكرية التي أطلقها ومارسها المفكرون المذكورون وأضرابهم، وناضلوا من أجل أن تكون، فضلا عن الحداثة الشعرية التي بدأت تترسخ معلنة عن منظور جديد في الخطاب الشعري، ومساءلة جديدة للغة الشعرية، ورج للأسئلة النمطية المكرسة، وطريقة مخصوصة في الكتابة الشعرية، شُرِعَ في الكلام عن البياض والسواد، والفراغ، والمكان، والحذف، والتوازي، والتشذير، والومضة، والكتابة. كما شرع في الكلام عن مقدار حضور السياسي في الشعري، ومنسوبه وكيْفِه. هكذا، أفاق التلقي والنقد المغربي، وصحا ـ ذات صباح ـ على تجربة شعرية جديدة:(هل كانت مغامرة؟)، قوامها: الهندسة الخطية، والتشكيل الشعري، والاحتفاء بالحرف، والانتصار للحبر والمداد، واليد، على الطباعة والآلة، على النمطية والمعاد المكرور. وكان وراء هذه “الفتوحات” التي ما فتئت تسعى إلى بعث الحياة في الرفات، وإخراج الدروس من الطروس، ومداواة الشخير والغطيط باليقظة والنطيط، ورش الشعاع على مناطق الظل والعتمة؛ كان وراءها الشاعر محمد بنيس، والشاعر عبد الله راجع، والشاعر أحمد بلبداوي. لم تكن العملية لعب “عيال”، وتزجية للوقت الفارغ، وتمهيراً للأصابع والعين على من يدمغ بالبقعة أو اللطخة السميكة أو الخفيفة بالبنط الرفيع أو العريض على النص الشعري، فيصبح مبهراً يُسَامِتُه النقد والتلقي، والقراءة العاشقة ليقضيَ مفعولاً أُعِدَّ له، وخُطِّطَ له، وهو رجُّ الساحة، وخضُّ المشهد الثقافي، ومعالجة القصيدة بجرعات، تقل أو تكثر، من توشية وترقيش، وتوشيح وزخرفة وتزيين. جرعات محمولة على لغة شعرية أخرى، لغة شعرية مختلفة لا عهد لجيل علال الفاسي، والمختار السوسي، ومحمد بنبراهيم، ولا بجيل الرومانسيين المغاربة الذين جاؤوا بعدهم، ك: عبد القادر حسن، عبد المالك البلغيثي، محمد الحلوي، عبد الكريم بن ثابت، عبد المجيد بنجلون، ومصطفى المعداوي. ولا بجيل الستينيين أنفسهم على الرغم مما حققوه للقصيدة المغربية من هواء جديد، وفسحة إبداعية، ولغة قطعت، نسبيا، مع السابقة، وشرعت تنكتب في الوعد المطل، والرهان المُرْجإِ.
“كتاب المحو”، “بيان الكتابة”، “حداثة السؤال”، سلسلة” الثقافة الجديدة”، وصولا إلى ” العبور إلى غابة زرقاء”، إلى ” شطحات لمنتصف النهار”، إلى ” الحداثة المعطوبة”، إلى.. إلى الخ. دماءٌ سرتْ في المكتوب والفكر، والموقف البنيسي لتطبع وتصنع وجهاً، وجوهاً جديدةً متغضنة من فرط التحديق في الآلام، والحسرة الموجوعة على مآل الثقافة والمؤسسات والأحزاب، والوطن. صنعت شعراً سرعان ما عرَّشَ ودنا وتدلى وانتشر ودخل أعمالا شعرية لعبت دور الرافد والمكمل والمختلف أيضا، والصوت الكوكبي. وهو الصوت الذي انصقل بعد فترة من المخاض والإجهاد ليغدوَ متفردا، أنوياً يحتفي بالذات، ويقول هواجسها وانتظاراتها ورهاناتها، وأحلامها، ويعيد الاعتبار الجمالي للأنا الغنائي بالمعنى الشكلاني الأوسع والدقيق لكلمة:” غنائي “. ثم، يذهب بهذا “الأنا” الملكي إلى الصمت. من الصوت العالي إلى الصوت الخفيض، إلى الحفيف، إلى الصمت المتلألئ في واحديته وتجوهره، كُتِبت القصيدةُ المغربية بعد جهد وإجهاد، وعَنَتٍ وسفر وترحال وغبار، وإقامة في ليل الليل، وليل الشعر، وصلصال البدايات، وعجين الشعر والأدب والإبداع والفن القادم من سلالات شعرية فرقتها الجغرافيةُ، ولَمَّها الوعدُ والسعدُ، ووحدَّها الهمُّ الوجودي العاتي.
أصداء أصوات غافية .. الشعر المغربي السبعيني والهواء الجديد

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 24/10/2025