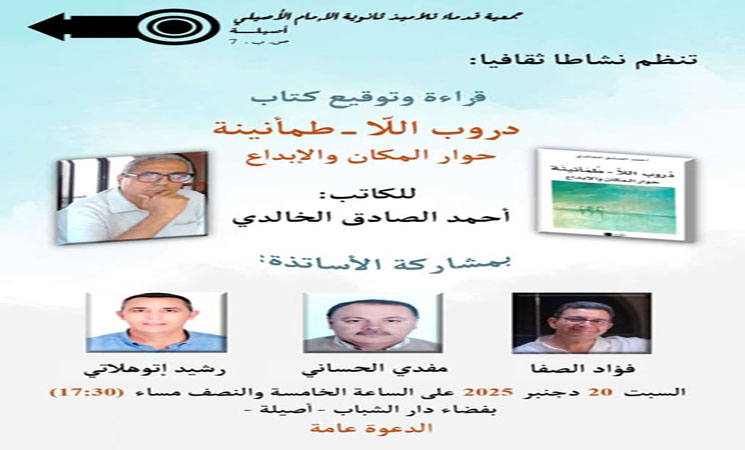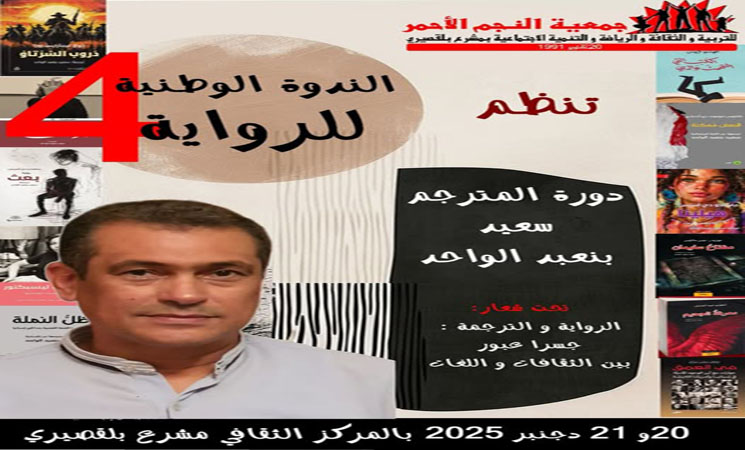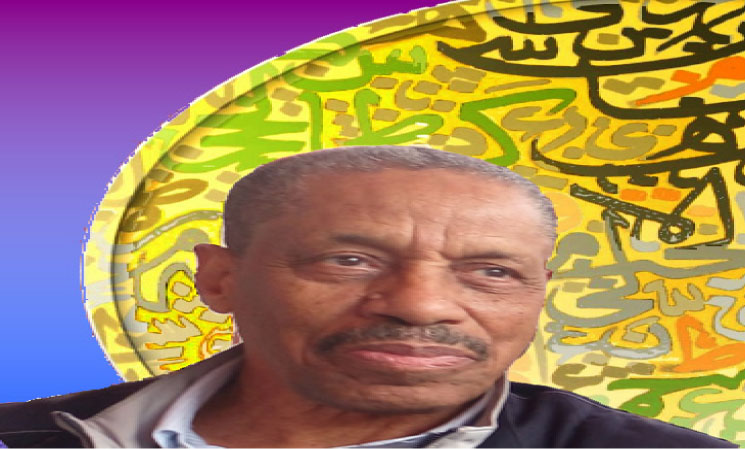لننصتْ إلى الشاعر أحمد المجاطي يقول: «أومن أن المجتمع المغربي قضى عصورا طويلة لم يستطع فيها أن ينجب شعراء حقيقيين. لا نحتاج إلى شاعر يكتب عشرات الدواوين، ولكن إلى شاعر يكتب القصيدة الأولى».
ومن ثمة، تكون القصيدة المغربية الحديثة الأولى قد انكتبتْ، وتعاورَ عليها أفذاذ ستينيون لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، رغم أن الحركة التحديثية كانت حركة أفراد، ولم تكن حركة مدرسة أبدا. «فهؤلاء الستينيون الشعراء بحساسيتهم الواعية، كانوا يقدمون شرطا من شروط التغيير على صعيد بنية الوعي المغربي في المجال الشعري، وهم كمجموعة من المثقفين التقدميين الذين انتبهوا في ميدان الشعر إلى ضرورة إعادة النظر في المسيرة الشعرية التي يعيشها المغرب، كانوا يعملون بثبات وصبر من أجل تأسيس علامة تتجه نحو المستقبل، وهم بذلك كانوا يضعون أسسا لتغيير الواقع الشعري الذي طالما عطل الفاعلية الشعرية من ناحية، والوعي التاريخي من ناحية ثانية، والإبداع الخلاق من ناحية ثالثة». (محمد بنيس : ظاهرة الشعر المغربي المعاصر ص 383).
إنها القصيدة التي بناها بعض الستينيين الذين سماهم المقترب النقدي الشعري الجمالي، وتلقفها بالتعهد والتشذيب والتجريب، والدفع إلى المجهول، والحرائق والمهاوي البعيدة، جيل الشباب آنئذ الذي لم يكن غير الجيل السبعيني: محمد بنيس- محمد بنطلحة- عبد الله راجع- أحمد بلبداوي- أحمد بنميمون ـ حسن الأمراني- رشيد المومني- المهدي أخريف ـ محمد علي الرباوي..إلخ. وهو الجيل الذي شرع يمارس الكتابة وفق قوانينها المعاصرة، مسجلا بذلك الخروج الثاني على النمطية والمراوحة والاستنفاد. إنه – في تقديري- جيل الريادة الشعرية لا الريادة التاريخية التي تستنيم إلى الإحياء والاجترار والتقليدانية، والرقص في الدائرة المرسومة سلفا.
وما كان لهذه القصيدة أن تحوز صفة التجديد والتحديث لو لم تراهن على المغايرة والاختلاف والاصطدام والإدهاش، ولو لم تختبر وضعية اللغة داخلها، وتجترح إبدالات نصية أساسية مغايرة، تحققت من خلال خلخلة النسق الطاغي، والمهيمنة الموضوعاتية، والمعنى الواحد، أو واحدية المعنى، والقيم البالية. ثم تحققت بنفخ روحٍ جديدة في اللغة والتخييل والصورة والإيقاع، روحٍ مستمدة – أساسا- من تجربة اليومي المائج، والإخفاق التاريخي، وسقوط الأحلام. واختلاف صَمَّمَ على بَصْم المرحلة بقول الشعر لا بزخرف النظم، والاحتماء بالسؤال والمخاطرة عوض القناعة والرضا والكسل والاسترخاء.
أما الاصطدام فمع اليقينيات والغيبيات والقوالب الموطوءة، والموضوعات المستهلكة التي كانت تُداورُ استعارة متحجرة أُحْفورية، يتناوب عليها كُتاّبٌ أكثرهم نَظّامون وأقلهم شعراء.
وما أسس فرادةَ تجربة هذا الجيل، هو ربطُ ممارسيها بين الفاعلية الشعرية، والفاعلية النظرية حيث انصهرت التصورات المعاصرة حول مفهوم الشعر ونظريته، فأصبح الشعر فاعلية كلغة، واشتغالا بها، كما قال هنري ميشونيك.
ولئن أمكن الحديث عن لحظات شعرية مزمنة بحسبان العقود أو الأجيال، فإنه لا مناص من الإقرار بأن ذلك يكمن في الإبدالات التي تحققت بهذا القدر أو ذاك للمضامين والأشكال مع تنامي وَعْي الشعراء بما يأتونه في صنيعهم من خلخلة للأنساق والمستويات والرؤيات.
هكذا نرى مع محمد بنيس، ومع آخرين، أن القصيدة الحديثة الأولى في المغرب، هي خلاصة تمرحلاتٍ وتحولات مَرَّ بها الشعر المغربي من ذاتٍ جمعية إلى ذاتٍ فردية إلى ذات مجردة، أو (لاَ- ذات)، ومن وصف الواقع إلى تحويله إلى أمثولة، ثم إلى التخلي عنه.
وترافق ذلك مع التحويلات البنائية في نقل الإيقاع من البيت إلى التفعيلة، ثم من التفعيلة إلى السطر المدور، فإلى الجملة الشعرية الكبرى الاستغراقية، وفي الموقف من الظواهر الأخرى كالقافية والوزن والبلاغة. ومن الواضح أن كل ذلك حصل بتأثير من احتكاك الحداثة العربية بالحداثة الغربية.
هذا الاستطراد ضروري حتى نؤطر ثقافيا حداثة القصيدة المغربية، أو القصيدة الأولى التي نادى بها الشاعر أحمد المجاطي: قصيدة التغيير والتحديث وفقا لرؤيا بعيدة تَحْتَفِرُها عينٌ أخرى، ويدٌ نِتْشيَّةٌ ثالثة، وجسدٌ ضاجٌّ بالإيقاع والعذاب والنشيد، وروح حيرى معلقة في لَمْبو دَانْتي أليغوري.
قصيدة أولى مضادة لسابقة نمطية تصادر السؤال والقلق والفطنة لتقيم في البطنة والكسل وزهو الذباب، وتسيل هانئة في المجرى المحفور لها سلفا والإطار البَشِم بالموضوعات المطروقة والجاهزة.
إنها القصيدة المغربية الأولى التي كتبها أحمد المجاطي في: «الفروسية»، والخمّار الكنوني في: (رماد هسبريس)، ومحمد السرغيني في: (ويكون إحراق أسمائه الآتية)، وعبد الكريم الطبال في: (الطريق إلى الإنسان)، ومحمد الميموني في: (آخر أعوام العقم) وادريس الملياني في: (في مدار الشمس رغم النفي)، ومحمد بنيس في (في اتجاه صوتك العمودي)، ومحمد بنطلحة في: (نشيد البجع)، وعبد الله راجع في: (الهجرة إلى المدن السفلى)، ومحمد الأشعري في: (سيرة المطر)، وأحمد بلبداوي في: (سبحانك يا بلدي)، والمهدي أخريف في: (سماء خفيضة)، ورشيد المومني في: (مشتعلا أتقدم نحو النهر..)، وعلال الحجام في: (الحلم في دقيقة الحداد)، ومليكة العاصمي في: ( أصوات حنجرة ميتة)، وعبد الله زريقة في: (فراشات سوداء).
وترتيبا عليه، هل بالإمكان القول: إنها القصيدة التي أجادتْ الإنصاتَ لكل الأشكال والاتجاهات الشعرية القادمة من المركز العربي والغربي بوصفهما سلطة تاريخية، ومعرفية وأدبية وعلمية وسياسية؟.
إنه الإنصات الباطني لدبيب الانتصارات والخسارات في آن، الذي عرف كيف يستثمر بعض ممكنات هذه الأشكال والاتجاهات من دون انقياد واستسلام وانشداه، بل في إطارٍ وَعَى المغايرةَ، وأدْرَكَ الإختلافَ والإضافة التي بها يكون.
بهذا المعنى، نستطيبُ الحديثَ عن تجربة شعرية مغربية هنا والآن، بما يتخطى ضيق المعجم الذي يجعلها محصورة في «اختبار الأمور ومعرفتها، أي بما يفيد من الأفق الللغوي والفلسفي اللاّتيني الذي مُنِحَ للمفهوم ليتسق مع الكتابة كاشتعال ووجود، وهو الاختبار والخطر في آن. يقول روجي مُونْيِي: (إن فكرة التجربة كعبور تكاد لا تنفك، على المستوى الاشتقاقي والدلالي، عن فكرة الخطر، والتجربة في المنطلق، وبالأساس، من دون شك، هي المخاطرة).
بدم وحبر المخاطرة هذه التي يتكلم عنها مُونْيِي، كُتِبَتْ القصيدةُ المغربية الحديثة الأولى، ولا زالت تنكتب في الفردانية والصمت واليتم واللاَّ تكامل، والظلال، مشدودةً إلى اللاّمرئي واللاّنهائي، مرتميةً بكل الجنون في سجوف المجهول.. وفي الأعماق الرهيبة والغامضة لنهر النسيان من أجل أن تورق غدا، وتنهض في سوسنة الذكرى والأبد.