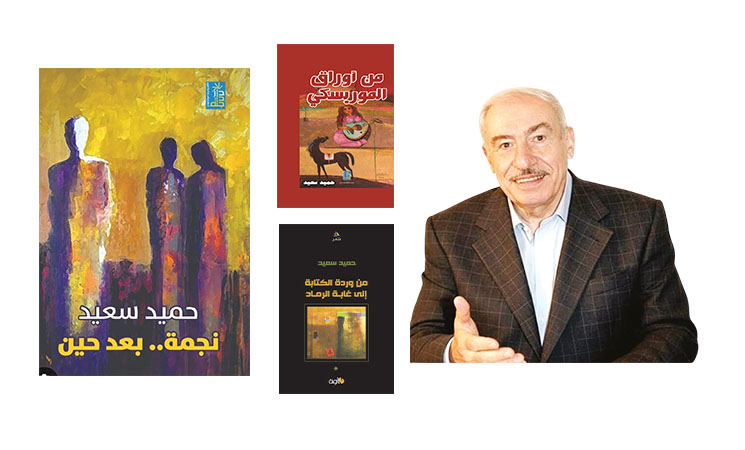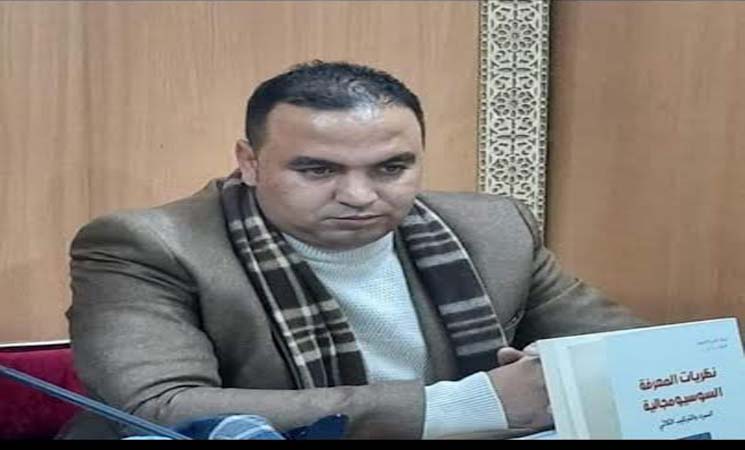«حمدا لابتكارنا.. حمدا للصفر»
أدونيس
عقدة الأفضلية والسمو العرقي، والرفعة السلالية والنبوغ النوعي، والمحتد النقي، لم يسلم منها دين من الأديان. فالتوراة تقول عن أتباعها ومنتسبيها بأنهم شعب الله المختار، الذين مكَّن لهم في الأرض، وجعلهم خير الوارثين. والأناجيل الكنسية تفضل الكاثوليك على البروتستانت، والعكس بالعكس. وتعتبر رسالتها السماوية هي الحق وغيرها الباطل والهباء. أما الإسلام ـ وما أدراك ما الإسلام ـ، وبما أنه خاتم الديانات السماوية، وبه انقفل الوحيُ أي النص الأعلى، وبالرسول محمد الأكرم انتهى التفويض الإلهي لعبيده، وألا يكرز أيا كان في البرية وفي الناسوت بما أتاه الله وما أنزل عليه ـ فإنه يصف العرب العاربة والعرب المستعربة ب: خير أمة أخرجت للناس.
عقدةٌ لم تُحَلَّ أبداً، بالرغم من الموائد العلمية، والحوارات الدينية المقارنة والأنتربولوجية التي تَتْرَى بين الجوامع والكنائس والكُنُس ( في حدود )، أي بين الأئمة والعلماء والمشايخ الإسلاميين، وبين الأساقفة والكردينلات والبابوات أحيانا والحاخامات والأحبار. هي عقدة تاريخية قديمة متأصلة لم يتيسر لها أن تنحل وتجد لها مشتركا إنسانيا ربانيا واحدا وموحدا. وربما، تكون الحروب الصليبية التي اندلعت بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، لا تزال ثاوية مترسبة في جيناتنا ودمائنا جميعا يبعثها ويؤججها الخوف من الآخر، والشك في نواياه متكلما وصامتا، والعمل ـ بكل ما في الوسع ـ لاتقاء شره، والاكتفاء باستهلاك ما باليد وما وصل « تاما « من الماضي غير متصرف سِواء عندهم كما عندنا، والانكفاء عليه بمخْضه إلى ما لانهاية، ولا يهم ما يجري من تحولات وتبدلات وقطائع إبستمولوجية ولغوية وثقافية ومعرفية هي ما حقق للغير، للآخر: للمسيحي ولليهودي ـ يا للمفارقة ـ ما ينعم فيه من جديد وحديث وروح متوثبة أبداً، وارتباط دينامي بمنطق العصر والتاريخ والزمن السائل.
فاللغة ـ بما أنها محمولة على جناح وطي كتاب مقدس الذي هو القرآن ـ تُعَدُّ نقية صافية مغسولة من كل شائبة أو اعتلال، متعالية لا تعرف البِلى ولا يعتريها التحلل والذبول، فكيف نسمح لأنفسنا بتغيير بعض أبنيتها وقواعدها الصرفية ونحوها وقوالبها الدلالية، قصد تليين « صلابتها «، وتزييت تخشب مفاصلها وأطرافها؟. كيف ـ إذاً ـ نسمح لأنفسنا بذلك، وكيف يوسوس الشيطان لبعضنا أن يقترف في حقها جريرةً وإثما، بل: كبيرة من الكبائر؟. أليست اللغة العربية لغة أهل الجنة، نزل بها القرآن الكريم ( مع العلم أنها السابقة في الزمان والمكان )، فكَرَّمها، وأعلاها و « عَبْقَرَها «؟. فَلِمَ يَنْعَبُ الناعبون، والمغفلون المُسْتلبون الذين يبغون ويسعون إلى تجديد دمها، وتقشير لحاءاتها الميتة تساوقاً وخدمةً للتعريب والنحت اللغوي، والترجمة والمثاقفة؟. هم الموتى الحفارون لا هيَ، والمستشرقون الأفّاكون أو وكلاء المستشرقين المغرضين الذين يريدون الإجهاز والقضاء على ما بقي من روح ووجدان وعقل وضمير لأمة العرب. وما بقيَ لهم إنما هو لغتهم حاملة هويتهم واختلافهم وعبقريتهم، ونبوغهم. ولئن اجترأوا على مسها بسوء أو حسن نية، وإخضاعها لفكر العصر وعلمانيته، فإنهم يئدونها، فإن لم يئدوها، فهم يلوثونها ويُغَرِّبونها، ويبذرون السوس والعثَّ في جذعها وجذرها وجذمورها. وإذا كان المسيحيون واليهود قد تجاوزوا ضَعَتهم وتواضعهم المعرفي والعلمي اليومَ، بالأنوار والفلسفة الحديثة، وفصل الدين عن الدولة، و» تجميد « الماضي إلى حين في القرن الثامن عشر، فإن عقدة التفوق الإسلامي لغةً وتاريخا وحضارة وثقافة، ظلت ملازمةً للعرب المسلمين، واستمرت عائقا نفسيا وعقليا ووجوديا إلى اليوم. ولا آتي بجديد إن أنا قلت بأن المُحْدَثَ والمُوَّلد والمُعْرب، كان ـ عبر أعصر السُّنَّة والجماعة والجمهور ـ مرفوضا مطرودا، ومطاردا.
قال الصحابي ابن مسعود في ما نسب إليه: ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ). وقد شمَّرَ للذود عن حديث ابن مسعود، ونشره بالقوة وبالسيف والتخويف، نفرٌ من « الفقهاء « السُّنيين والأشاعرة بعد أن نالوا من الفكر المعتزلي وداسوا أنواره، وشآبيب الفلسفة العقلانية لابن سينا والفارابي، وابن رشد.. وغيرهم. داسوا أنوارهم وإشراقهم وتشوفاتهم العقلية والمنطقية. استند هذا الرعيل إلى قوله تعالى: (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) ـ ( النحل ـ الآية «103 ). وعبثاً، تصدت لهم فرقة إسلامية متنورة ومستنيرة، بالحجة الدامغة، والدليل العلمي ـ وفيهم لغويون أفذاذ، ونحاة كبار، وأدباء ذوو باع، وفلاسفة مشاؤون راسخون ك: ابن جني ـ وابن فارس ـ والسيرافي ـ وابن قتيبة ـ والفارابي ـ وابن رشد ـ وابن حزم ـ وابن خلدون. إذْ أن الغلو في تقديس السلف « الصالح «، وغلق باب الاجتهاد، وحماية الخلفاء والحاكمين للمتحجرين ذوي القلوب الغُلْف والعقول الموصدة، كان وراء طَمْرِ الاجتهاد، واضطهاد العقل والتنوير والشك والسؤال. ولولا الترجمة، لَتَرَسَّخَ الانكفاء أكثر، وعرف الانغلاق أبعد مدىً، وساد الفقر الفكري، وعَمَّ العَمَى المعرفي. حركة الترجمة ـ إذاً ـ، هي ما فتَّح أعين لغتنا على ثقافة وفكر وذهن وتقاليد وعادات الأمم الأخرى، وولَّتْ الظهر ـ نسبيا ـ للقبلية والبدْوَنة والعروبية. ومع ذلك، استمرت الغلبة لعرب التيار العروبي الشمولي المحافظ، على عرب التيار التجديدي والمنفتح. فالنفي والتضييق والمطاردة والسجن، والسَّحْل والقتل والصلب الذي استمر وتنامى على مدار الأعصر العربية الفائتة، يقول كل شيء؛ وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه، فضلا، بطبيعة الحال، كما أسلفت، عن تغليب مذهب النقل على مذهب العقل منذ القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، وصولا إلى الحاضر الرمادي المتجهم.
ما نحن فيه لا يسر عدوا ولا صديقا، إذ انكمش الاجتهاد والجهر بالرأي الحر، وتعطل الحفر المعرفي، وغاض السؤال الفلسفي المخلخل لليقينيات، والفكر المثير المؤجج المتسائل، وضمرت معانقة الآفاق الثقافية المختلفة. أقلية رائدة مستنيرة فقط، في طول العالم العربي وعرضه، هي من تحاول جاهدة، تَعْبى أن تحرك ماء البركة الآسن، وتنفخ الروح في الرماد، وتوقد الجمر الخامد، من خلال النبش والحفر والتصحيح والتأويل، مسنودة بالعلم والمعرفة والمناهج الفكرية والإبستمولوجية الحديثة والعصرية. تحاول رغم « الداء والأعداء «، تفتيح العيون والعقول والأفئدة على واقعنا المهزوم، والأخذ بالأيدي معرفيا نحو وجهةٍ نرتضيها جميعا، وجهة العدل والحرية والحق والجمال والاختلاف والخلق والإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنسانيات، والآداب والفنون. هي قلة تَتَلَقَّى بصبر أيوبي، سهاما من هنا ومن هناك، لعل أخطرها سهم الهرطقة والزندقة والإلحاد إِنْ لم يكن التكفير، وأدناها سهم العلمانية واللاأدرية والاستلاب. نعم، وهو كذلك، فالتاريخ تاريخ الأمم والشعوب، يعلمنا أن القلة هي من قادتْ مواطنيها إلى الشأو الحضاري، والآدمية الحق، والقيادة والثقافة والرفاه.