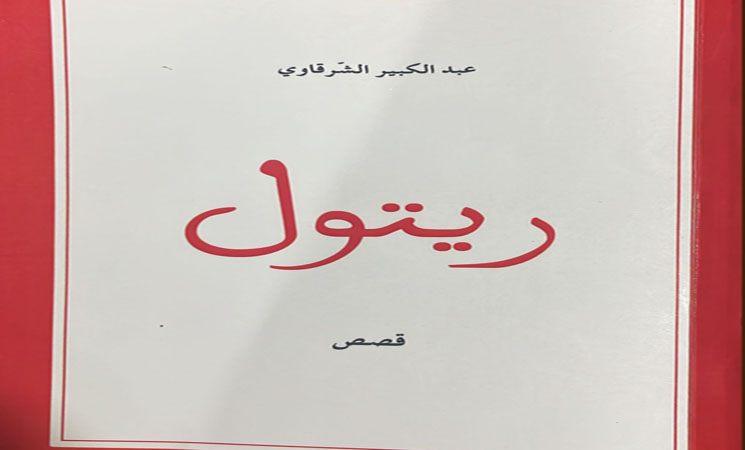كأنها سميتْ عائشة لأنها ستستمر عائشة دوما وأبدا فينا ومعنا، ومع القادم من الأجيال. تسكن ضمائرنا، ضمائر المناضلين والحقوقيين والمثقفين التنويريين رجالا ونساء، وضحايا الوحوش الضارية. هي التي عاشت ـ بالعرض والطول ـ أيقونةً ولا أبهى، ورمزا للتحدي والصبر والأمل لا أقوى ولا أصلب. فوحدها طودٌ شامخ بجبروتها « الناعم «، وعنادها وإصرارها، وقوتها واقتناعها بنبل فعلها وعملها وصنيعها الذي لم يتزحزح قيدَ أنْمُلَة منذ أن عوَّلتْ على أن تكون راعية وحادبة وساهرة على حياة الأطفال المتخلى عنهم.. اليتامى، الملفوظين، المقطوعي الصلة والنسب بفعل فاعل زَنيم، بفعل جبناءَ رعاديدَ معدومي الضمائر، فارغين من كل ما يمت، بخيط ولو واهٍ، إلى وجدان رحيم، وعقل سليم، وحسٍّ قويم. وقفت عائشة الشنا في وجه الطغاة، وفي وجه الريح السافية المحملة بالشر والرمل والغبار، وفي وجه العواصف الهوجاء، والدعاوى الدينية المتحجرة الرعناء، وخاضت حربا موجعة، فأنقذت بما يسَّر الله لها من حنكة وحكمة ودراية، وبما قيِّضَ لها وخَبَرَتْه من تجارب وخبرات حياتية معيشية باحتكاك يومي ونضالي وحقوقي مع الشارع العام، والمدن السفلى، والدروب الخلفية، والدور التحتية، أنقذت أمهات عزباوات غٌرِّرَ بهن في مجتمع بتْريرْاكي ذئبي يستصغر المرأة ويحتقرها، ويُشَيِّئُها، ويباشرها كدمية، كجسد يطفيء فيه هزيمته وتخلفه، وحيوانيته، وشهوته القذرة، وشبقه المرضي. وأنقذت ـ بالتلازم ـ أطفالا أبرياء ليس لهم في ما جرى لهم شَرْوَى نَقيرٍ من يدٍ ووعيٍ بوجودهم وبموجوديتهم، وقَدَرِهم ووضعهم في الأسرة والمجتمع والعالم. أنقذتهما كلاهما: نساء وأطفالا بغاية إدماجهم في الحياة العامة العادية، الحياة الكريمة من خلال ما توافر لهم ـ بفضلها ـ من رعاية أمومية ضافية، وسقف ٍ واقٍ، وفضاء مريح، وأكل وطعام وشراب وأغطية وأدوية، تسابق المحسنون والحقوقيون والشرفاء أُولُو رحمةٍ ومحبة وإنسانية، وإعجاب بشخصها ـ تسابقوا إلى دعمها وإحاطتها بكل ما هي جديرة به من توقير وتقدير وتبجيل، ولْتَذْهَبْ الفتاوى الدينية المغرضة، ورجال « النبل « الغشوم، والطهرانية الكاذبة، والمواعظ البالية الزائفة، إلى الجحيم، لِتَذْهَبْ إلى المزبلة مثل أي نفاية زَنِخَة، وقاذورة كريهة. وذلك لأن عائشة، وهي تمنح لهؤلاء المقذوفين إلى الهامش، فرصة للعيش، وإمكانا للحياة، ومناسبة سانحة للانخراط في معمعة اليومي الصاخب والمضطرب الفرحان والحزنان معاً، ولإقامة علائق سويّة مع الأشباه والأغيار، إنما تعيد لهم ما سُرِقَ منهم، من دون شعور بالدونية والنقص والصَّغَار، ومن دون إحساس بأنهم نُفُوا إلى دواخلهم، وانزَوَوْا في جحور معتمة، وأن كرامتهم امْتُهِنَتْ، وأنهم عالة وعبءٌ ثقيل على الناس والمجتمع، ضالون ومغضوب عليهم.
ثَمَّةَ، وقد رُبّوا تربية قويمة، وتعلموا كما تعلمن ( أقصد الأطفال والنساء ) الأبجدية الأولى، والأبجديات الأخرى، وحذقوا كما حذقن فن الخياطة والحياكة، والنجارة والصباغة والسباكة والإلكترونك، والتفنن في النسج والنَّمْنَمة، ثمة ـ إذاً ـ ما يملؤهم آدمية وانتصارا على « عقدتهم «، وإقبالا عل متطلبات العيش الكريم، والحياة الإنسانية العملية والعلمية والحرفية الرفيعة. ثمة، ـ وقد كانوا وكُنَّ مناط عناية وحدب ورعاية ـ ما يُفْضي بهم إلى القطع مع ماضيهم الذي لم تكن لهم ولهن يدٌ فيه ولا في صنعه، كما لم يكن لهم ولهن حظٌّ في التَّفلُّت من براثن جشع وشبق أولئك المرضى المأفونين الذين زَيَّنَتْ لهم فحولتهم كما زَيَّنَ لهم بعض رجال الدين المأجورين والمتفيهقين، أنهم ذكور ـ وأيْم الله ـ الراكبون الممتطون الرافسون ب « أظلافهم «، الغاصبون والمغتصبون كل فتاة فقيرة أو صغيرة حسناء لا حول لها ولا قوة في دفع شبق هؤلاء الهَمَج الذين عسّلوا الكلام وزخرفوا الإيماءة والإشارة واللجام، وباعوا أرواحهم وضمائرهم للشيطان، فسقطتْ، سقطْنَ فرائس في حبائلهم الممدودة، وشباكهم المعدودة، وفخاخهم المنصوبة. فكيف ـ إذاً ـ يَقْدِرُ إنسان له ضمير، وله نصيب من الثقافة العامة، والثقافة الدينية بخاصة، قَلَّتْ أو كَثُرَتْ، ويطاوع الرّعاع الذين يرزحون تحت نير أمية ظالمة ومظلمة، يقدر أن يزج، من دون أن يرف له جفن، وينخسه ضمير، بهؤلاء الأطفال وتلك النسوة المغصوبات المغتصبات، في قاع سقر، أقصد في دفع وتأليب المجتمع للتبرؤ والنفور منهم، واعتبارهم مارقين وخارجين عن الملة والدين، مستدلا بالأحاديث الضعيفة المدخولة، وبسلطان الرواسب التاريخية الأبيسية المنقوعة في الخرافة والشعوذة، والعُهْرُ ينضح من وجهه، ويختلط بعرقه. وهو يعرف حق المعرفة، أنهن ضحايا ومُغَرّرٌ بهن، مُنَوَّماتٌ بفعل الفقر والحاجة و» سحر الإغراء والكلام «، حتى أنهن لم يُفِقْنَ إلا بعد فوات الأوان، بعد إنكار الرجل « الشهم « لفعلته الدنيئة، وإلصاق تهمة الدعارة والبغي والفساد بهن، بالنساء العزلاوات غِبَّ قضاء وطره منهن في نزو حيواني لم يحسب عاقبة لنزوه الحقير، ونزوته الغادرة.
أَلاَ نعتبرُ ـ بعد هذا ـ عائشةَ التي غادرتنا بصمت جليل يليق بالصالحات، امرأة ًعظيمة متفردة، ومانحة للحياة وهي تهيء الفرص، وتخلق شروطها وأجواءها، وتُعَبِّدُ طرقها رغم الكيد والدسيسة والحط من شخصها. لقد كرَّمها وطنها في شخص رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس، وكرمتها كبريات وشهيرات الجمعيات والمؤسسات والأندية الحقوقية والإنسانية والاجتماعية عبر العالم، ضدا على من رماها بأقدح الصفات، وأسَفِّ النعوت، فبقُوا حيث هم رجالا جُوفاً، وقَصبا خاوياً تصفر فيه الريح، بينما علا سهمُها، وارتفع شأنُها، وعظُمَ اسمُها وأثرُها.
إن عائشة الشنا ـ في اعتباري ـ قِدّيسةٌ لا تقل مكانة وعظمة وروحانية وشأنا عن الأم تيريزا تمثيلا. هي قدِّيسةٌ لا بالمعنى الكاثوليكي الديني الضيق، وإنما بالمعنى الإنساني الرَّحْب والعريض. لذلك، ستظل وتبقى خالدة في ضمير الوطن والكون والإنسان أينما كان، وارفة مرفرفة روحها تحف بها الملائك والولدان المخلدون هناك في الأعالي لدى الملكوت، وهنا في كل رقعة من رقع البلاد عند الناسوت. ألم تكن أمّا لهم جميعا؟، بلى. وإذاً، فالجنة تحت قدميها رحمة الله عليها.
أصداء أصوات غافية : عـائـشـة الـشـَّنـا

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 07/10/2022