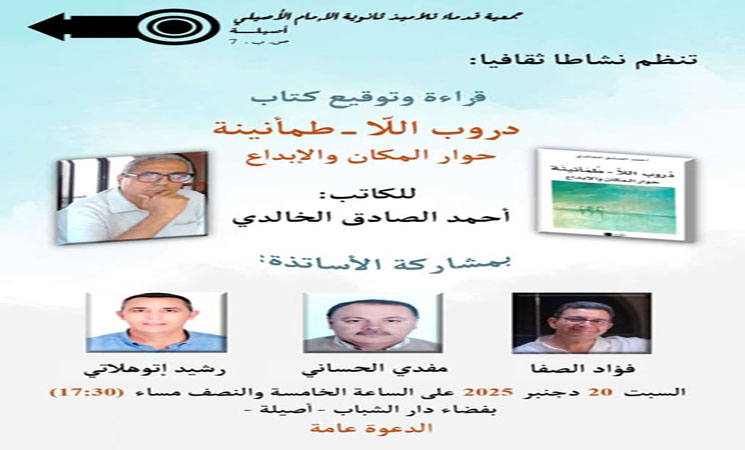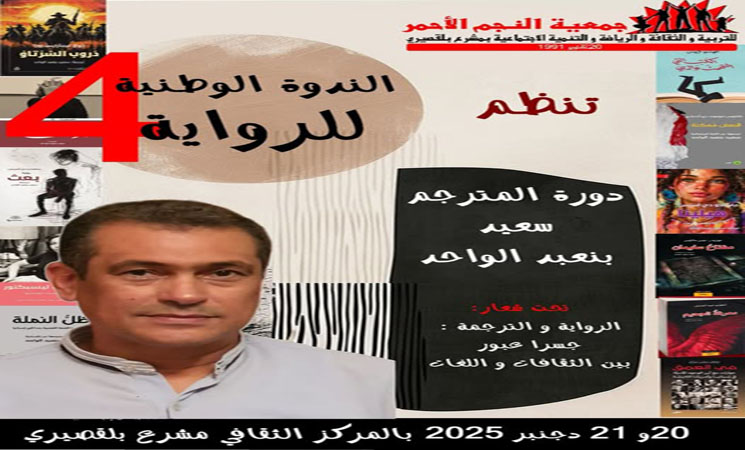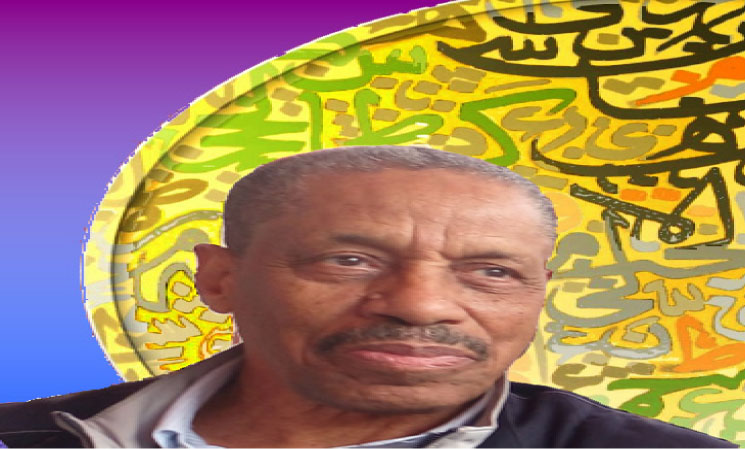أقدر أن الفن بإجمال ومنه الشعر، يستبشع ما صنعته يد الإنسان من غرس لأزهار الشر، ونشر للفساد، وسعي لا يَعْيَا إلى القمع والقتل من أجل إشباع رغبة جَوْعى إلى البطش والاستبداد والرَّهَبوت. قدر الشعر -إذا- أن يقول هذا، ويتخطى باللغة والحلم عالم الخسارة والخسائر. ضمن هذا المنظور، يندرج في –زعمي- جوهر الفن، وجوهر اللغة بما هما جوهران ميتافيزيقيان يرددان، بطريقة أو بأخرى، رؤية شُوبْنَهَاوَرْ، وكلام كيرْكيغارْدْ: (نحن في وجود موجود على حافة الهاوية، إن لم يكن فيها).
لن ألتفتَ إلى عدِّ «عز الدين المناصرة «– شعراء قصيدة النثر، كتابا فقط لا شعراءَ، وأن ما يكتبون ليس غير قصيدة خُنْثى ملتبسة، ولا إلى رأي «محمود درويش» الذي اعتبر أن غياب الإيقاع يعد أحد أعطاب ومزالق قصيدة النثر، على رغم انتصاره للنصوص الجياد منها، فيما ظل أحمد عبد المعطي حجازي متصلبا مصمتا متخندقا في نَاهٍ وزْنيٍّ يراوح المكان، ويشكل صدىً لأصوات الآباء والسلف.
لن ألتفت إلى هذا وسواه لأنني أومن أن كل نص شعري يُبْدِئُ ويجترح مداه، ويخلق مجراه في أثناء الكتابة، وإبانَ المبادهة والمراودة. ليس هناك ما قبل، وما بعد، أي ليس هناك نموذج إسْمَنْتي قَار، وقالب منته ومكتمل مستلهم ومستوحى، ومن ثمة، فقراءتها – قراءة هذه القصيدة- تتطلب مقتربا خاصا، ومراودة من طراز نوعي. فنحن أمام كتابة متشذرة أو متشظية أو مفتتة إلى توقيعات، أو مؤثثة بعناصر السرد، ومداليل الغرابة والعجائبي، وأمام انزياح الانزياح، والمباعدة القصية حتى لاَ مَعنى، وإنْ كان «المعنى» ثاويا في قرارة التجربة ، ثواء لؤلؤة المستحيل.
يكشف هذا المتن الشعري الجديد بالجمع والإفراد أوجاع الذات، وانسحاقها في رَحَى الخيبات والخسارات. ويكشف، من جهة ثانية، عن مقوم الإدهاش، إذ الإدهاش سمة هذه التجربة الشعرية طُرًّا. والإدهاش جمال..
كل جمال مُدْهشٌ، وكل مدهشٍ جميل.. هذا سِوَارُ التجربة وهذا عنوانُها.
إنها حساسية شعرية «لا تتحدد بالمهمة الشعرية للشعر، بل تُعْنَى باكتشاف العالم، ومواجهته، ورفضه، وعلى أساس هذه المناكفة والمناوأة، سيتحدد موقع شاعر قصيدة النثر نفسه، فتكون قصيدة النثر بتعبير من كتابها الأوائل، ومشاغبيها المبكرين: (أنسي الحاج):
عمل شاعر ملعون، ونتاج ملاعين، وبنت عائلة من المرضى. اللعنة والمرض هما تسميتان مشاكستان، وصادمتان « لمظهر من مظاهر الوعي الوجودي الممكن بالقصيدة النثرية، وتجسيد لكونها تجربة داخلية ولا نهائية تكمل القانون الحر لقصيدة النثر الذي يسلتزم وجود الشاعر الحر أيضا. علما أن النصوص تنزع –في العادة غريزنا- إلى تأكيد انتمائها النوعي إلى الشعر بإعادة اشتراطه ومزاياه « (حاتم الصكر).
وَيتَحَصَّلُ من خلال تأمل بعض المتون الشعرية، ورصد أبعادها، أنها تستضمر، وتستبطن- في إطار من التناص- أصواتا شعرية ذائعة عالميا ومشرقيا ومغربيا: رامبو- بيسوّا- لوركا- روني شارْ- ماتشادو- سليم بركاتْ ـ سركون بولصْ ـ وليد خازَنْدارْ- وديع سعادة – أحمد بركات – عقيل علي- باسط بن حسن- وساط مبارك- عبد الله زريقة- محمد السرغيني، وزكريا محمد، وعبد المنعم رمضان، ومحمد بنطلحة، وحسن نجمي، الخ.. إلخ.
وتستضمر، ثانيا، البعد الوجودي والواقع المغربي المشروخ، والعربي الدائخ والمترنح، بما يفيد تشخيص الذات والواقع المعطوبين ضمن جدلية القلب والإلغاز أحيانا، حيث تجد الفكرة المعروفة: (الواقع أَغْرَبُ من الخيال) كامل تفسيرها في هذا المتن الشعري الجديد.
فإشارتنا الخاطفة إلى المُنَاصَصَة تقود إلى الكلام عن الأسطرة، ما يعني –أن بعض النصوص ضمن الأعمال الشعرية التي تصفحناها بحرص المتفحص وعين القارئ العاشق – تؤسطر أبعادها بإيراد تسميات لشعراء بأعيانهم، أو تدمغ عناوين مجاميعها الشعرية بهم، تيمُّنا وطلباً ربما «للتزكية»، و» عبور الصراط «.
وهي الأَسْطَرةُ التي تفارق تماما، المرجعية الميثولوجية التي اغتذت بها ومنها حركة الشعر العربي الحديث والمعاصر في سَمْتِه التفعيلي تحديدا.
كما لا يمكن بحال إدارة الظهر تماماً لتجربة شعرية متألقة لعبت دورا في كشط الصدأ، وشفط الدهون، يتعلق الأمر ب: «الغارة الشعرية» التي كان وراءها ثلة من الشعراء خرجوا من القمقم، وأطلقوا أصواتهم الشعرية البهية الندية في البرية الوسيعة. وهي أصوات راهنت في تشكيل عوالمها على الرسوم والأيقونات والخطوط، وراهنت ـ قبل هذا وذاك ـ على تجربة لغوية مغايرة شكلا ومحتوى من خلل إعادة الاعتبار إلى أجواء الطفولة، وكتب قرائية مدرسية شكلت وعينا الممراح، وشقاواتنا اللذيذة. أفكر في كتابات: ياسين عدنان وطه
عدنان، وسعد سرحان، وهشام فهمي، ورشيد نيني.
اشتغل شعراء «الغارة» على مكون الإيقاع الذي يتيحه التكرار، والانهيال اللغوي، وعلى أسلبة مغايرة للشعر السابق، قامت على تَنْطيفٍ لغوي جديد، وإدهاش تصويري، فاستحقوا بذلك لعنة الانتماء ـ اللعنة الجميلة التي تحدث عنها بودليرْ وأنسي الحاجْ وغيرهما ـ إلى شعراء الهدم والفوضى الطفولية الرائقة بالمعنى الذي يفيد إعادة قلب الأشياء المقلوبة أصلا.
بهذا، تكون «الغارة الشعرية» قد شكلت ـ في تقديري الشخصي ـ إلى جانب مناصصات شعرية أخرى سابقة ومحايثة ك:» أصوات معاصرة»، و»البحور الألف»، و»إسراف2000 «ـ ،لاَوَعْيَ الحساسية الشعرية الجديدة، ونصها الغائب. تلك الحساسية الشعرية التي أضحت تقيم في قلق الحالة، مبلبلة سؤال المؤسسات المستفزة، والرضا بالقسمة والنصيب، وقالبة طاولة العصيان في وجه المرحلة، ووجه القول البليد: (ليس في الإمكان أبدع مما كان). وهي شعرية منقوعة في ماء الألم والخسارات. ففي أكثر الأعمال الشعرية الجديدة التي تنتمي إلى التسعينيات فما بعد من القرن المنصرم التي قاربنا، تومضُ كلمة خسارة كإيماضِ عين «نَمِر» وِلْيَامْ بْلاَيْكْ في نصه البديع : (the tiger). يقول سعيد البازْ: [أنا دائما مع الخسارة لأنها أكثر ثراء من أي نص متعجرف]. ثم إنها مشاهد حية من مشاهد الحُبوطات واليأس العام، والألم الشخصي والوجودي كتيمات مركزية، راسمة بطريقتها اليومي والعابر والأشياء الصغيرة الناتئة والمخبوءة. ذلك أن (السلالة الشعرية الرجيمة هي، دائما، تلك التي تستفز فينا الذهاب نحو أقاصي الروح؛ والكتابة الممكنة، في ظل الشرط الراهن، هي الخروج الدائم والمستمر عن الأنساق الثابتة، والمطمئنة إلى غبائها) . [ سعيد الباز] .
ويستند المتن إياه إلى: «المعنى الذاهب حتماً إلى أُفُولِه بالمعنى الأنطولوجي والميتافيزيقي أيضا، رغم أنه يعلي من شأن شعرية الكلام لكن في قماطها الأول بما هي أصل ومنبع ورحم: في البدء كانت الكلمة».
في ذلك الأفول والتلاشي، «ثمة الكثير من البوح الشعري القائم أصلا على التوليد والتداعي والنسيان، والذي يقوض جوهريا منطق «الإنشاء» لتنمو الفكرة الشعرية، وتتحرك طليقة خارج سياق الخطاب».
وبالإمكان القول مع الشاعر «وديع سعادة» أيضا: إنها (تلك النصوص) النحيلة الوحيدة، العزلاءُ التي ترسم كينونة خائفة، حذرة وحائرة».
بيد أنها نصوص لاهثةٌ تركض وراء المعنى المنفلت، المعنى الذي يضفي على يباس الوجود غضارة وألقا، ويجعل من الانوجاد في الكون مدعاة إلى الأمل، وحافزا على الاستمرار والحياة. ففي هذا اللهاث اللاَّ ينتهي، يكمن سر المأساة، وسر انكفاء الذوات على جراحاتها، وسر امتداح الموت.